
 |
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
المنهج الإلهي الأصيل الطريق والتلمذة 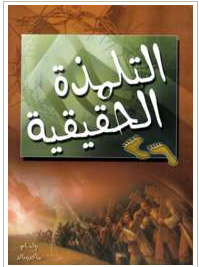 + أما سبيل (طريق) الصديقين فكنور (مُتلألأ) يتزايد (إشراقه) ويُنير إلى النهار الكامل (أمثال 4: 18) + في سبيل (طريق) البرّ حياة وفي طريق مسلكه لا موت (أو في طريق البرّ الخلود) (أمثال 12: 28) المنهج عموماً يخص الشخص الذي يُريد أن يسير في طريق مُحدد لكي يصل لغاية وضعها أمام عينيه بقرار واضح بكل إصرار وعزيمة، أي أنه ينتهج طريق معين فيسير فيه وفق شروطه الخاصة (أي شروط الطريق نفسه)، مثل من يُريد أن يُحدد مستقبله من جهة طريقة حياته الشخصية، فمثلاً غايته أن يصبح طبيب فأنه يجتهد في أن يصل لكلية الطب، وهذا الاختيار الخاص يُحدد ملامح الطريق الذي ينبغي أن يسير فيه، وبذلك يعلم يقيناً أنه سينتهج منهج الطب المُخصص والموضوع في الجامعة من قِبل المُتخصصين ولا يستطيع أن يُغيره أو يسير وفق هواه الخاص طالما اختار أن يسير في هذا الطريق، لأن كل طريق نختاره له منهجه الخاص الذي ينبغي أن نخضع له بدون أن نتأثر بأهوائنا الخاصة ورغبتنا في تغيير المنهج وفق شروطنا الخاصة، لأن كل مُخالفة أو خروج أو تمرد على المنهج الموضوع فأنه يُسبب عدم الوصول للغاية، لأن الفشل وعدم النجاح وعدم الوصول للهدف سيصير أمر حتمي لا محالة. معنى المنهج: مِنْهَجٌ جمعه مَنَاهِجُ، وهو الطريق الواضح أو وسيلة موضوعه ذات خطة مُحددة المعالم للوصول لغاية مُعينة، والمنهج تحكمه قَوَاعِدُ مَضْبُوطَةٌ لِلْوُصُولِ إِلَى الهدف الحقيقي المرجو منه، وهو عِبارة عن حَقَائِقَ خاصة مثبته بِالبُرْهَانِ والدَّلِيلِ العلمي الخاص به. لأن كل منهج له برهانه ودلائله الخاصة التي توضح ملامح طريقه وكيفية السير فيه للوصول للغاية المنشودة منه في النهاية. باختصار المنهج هو مجموعة الركائز والأسس المهمة التي توضح مسلك الفرد أو المجتمع أو الأمة لتحقيق الآثار التي يصبو إليها. أهمية المنهج: في الواقع العملي أن قضية المنهج قضية في منتهى الأهمية الشديدة للغاية، لأن من أخطارها هو غياب المنهج الصحيح أو عدم وضوحه للسامعين، لأن من خلال الاستقراء في المناهج عامة نجد أنها قسمان: صحيحة وفاسدة، فالمنهج الصحيح عموماً يكون وفق الشروط والمبادئ الموضوعة للوصول لغايته بوضوح وسهولة، والمنهج الفاسد يضع العراقيل الصعبة والحواجز العالية ويُصيب الشخص الذي يتبعه بالتشويش التام حتى أنه يخرج عن الطريق السليم الذي اختاره ولا يصل لغايته قط بل يطيح به بعيداً جداً حتى يُصاب بالفشل والتيه التام عن غايته. ونستطيع أن نُلَّخص أهمية المنهج السليم القانوني ودواعي العناية به والإصغاء إليه من خلال النقاط التالية: 1 – السير بخطوات سليمة هادئة تتسم بالوضوح والبيان. 2 – اختصار الطريق للوصول إلى الهدف المنشود والمرسوم بسهولة ويُسر. 3 – ضمان من التعثر وتجنب العقبات التي تقف حائل منيع للوصول للغاية الموضوعة. 4 – الثبات وعدم التردد والتخبط وما يبني عليهم من فوضى نتاج أفكار منحرفة سلبية. 5 – زيادة العزم والتقدم في طريق النجاح باستمرار للنهاية. + سَبِيلُ (طريق) الصِّدِّيقِ اسْتِقَامَةٌ، لأَنَّكَ تَجْعَلُ طَرِيقَ الْبَارِّ مُمَهَّدَةً (أشعياء 26: 7 – ترجمة تفسيرية) عموماً مما سبق نستطيع أن نفهم لماذا كثيرون يفشلون أو يتعثرون في الطريق الإلهي، وذلك لأنه حينما انتهجوا الطريق المؤدي للحياة الأبدية باختيار إرادتهم الحُرة، لم يصغوا لدعوة الله المُقدمة لهم بكل دقة وتدقيق وتبعوا شخص الرب مسيح القيامة والحياة في الطريق الذي حدده بفمه الطاهر، وعاشوا تلاميذ خصصوا أنفسهم وكرسوها لهُ، وتبعوا تعاليمه بدقة حسب المنهج الذي أعلنه وحدد ملامحه بشخصه، لأن لا ينبغي قط أن نضع من أنفسنا منهج خاص شخصي لنا أو حتى منهج عرفناه حسب الناس، أو توارثناه حسب أفكار بعض الناس البعيدة عن إعلان الإنجيل، وننتهجه ونقول ونُعلِّم أن هذا هو المنهج الصحيح والمستقيم للحياة الحقيقية مع الله، لأن في تلك الحالة سيكون هذا هوَّ طريقنا الشخصي الخاص بنا نحن والذي يُدعى طريق الناس لا طريق الله على الإطلاق، لأن الطريق الذي سأختاره بحريتي وإرادتي أنا، لابُدَّ من أن أسير فيه وفق الشروط الموضوعة الخاصة به، وأولها أن أخضع لصاحب الطريق نفسه، واخضع تمام الخضوع لمنهجه الخاص لكي أسير فيه سيراً مُنضبطاً لكي أصل في النهاية لغايته الموضوعة والمرسومة من قِبَل صاحب الطريق نفسه، وأُكلل بالنجاح طبيعياً حسب الجهاد القانوني الخاص بهذا الطريق: [ ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يُرضي من جنده، أيضاً أن كان أحد يُجاهد، لا يُكلل أن لم يُجاهد قانونياً ] (2تيموثاوس 2: 5) الطريق الإلهي 1 – تمهيد: في البدء خلق الله الإنسان على غير فساد وزرع فيه ملامحه الخاصة فصار على مثال الله، ووضعه في جنة مهيأة لأجله ليحضر ويمشي معه في لقاء مُحبب على مستوى شخصي جداً كعلاقة محبة قوية لها غاية وهي حياة شركة مقدسة غرضها حياة أبدية لا تزول في الحضرة الإلهية المملوءة بهاء ومجد عظيم، لكن بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم حينما استمع لهُ الإنسان فحاد عن الطريق المرسوم لهُ من قِبّل الله، فسار في طريق آخر بمنهج غريب مشوش فصار مُتخبطاً يسير من ضلال إلى ضلال، لأن الفساد تغلغل فيه حتى أنه صار أعمى لأن نور الذهن الروحي انطفأ، فتعثر طبيعياً لأنه ضل عن طريق الحق والبرّ وعاش بمنهج غريب يخص الموت الذي تملَّك عليه حتى أنه تأصل فيه وأمسك كل أعضاءه وصار كالإسفنجة امتص منه كل حياة فيه ولم يبقى سوى مرارة وحزن وخوف الموت، حتى أنه فشل تماماً في كل محاولة شخصية منه ليصل لطريق الحق والبرّ لكي يتخلص من حالة التغرب عن الحياة التي كانت تملأهُ، فصار يحكمه تقليد الناس وعاداتهم ومعرفتهم المُظلمة عن الله، لأن حتى الدارس والواعي فيهم والعارف طريق الحق وهو في حالة انعزال عن الله، قد وضع طريق مشوش بمنهج شبه روحي لكنه غير أصيل، فأخرج منهج سيء للغاية، لأنه كالظلال الباهتة التي تخدع الآخرين بسبب أنها تُشابه النور، لكنها ليست النور الحقيقي الذي يُنير كل إنسان بالصدق والحق عملياً.الطريق الروحي السليم وبسبب هذا كله ظهر الله الكلمة في ملء الزمان لكي يهدم الموت ويزيل الظلمة وكل آثارها ويُبددها بنوره الخاص، حتى أن كل من يؤمن به ويتبعه ويسير وراءه في الطريق المرسوم من الله، يكون لهُ نور الحياة الحقيقي يملأ كيانه كله من الداخل إلى الخارج حتى انه هو نفسه يشع نفس ذات النور عينه فيظهر أمام الجميع كأنه نور مثل نفس ذات النور الذي أشرق عليه فأناره: + كان النور الحقيقي الذي يُنير كل إنسان آتياً إلى العالم (يوحنا 1: 9) + ثم كلمهم يسوع أيضاً قائلاً: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، بل يكون له نور الحياة (يوحنا 8: 12) + أنتم نور العالم، لا يُمكن أن تُخفى مدينة موضوعة على جبل (متى 5: 14) + لأنك أنت تُضيء سراجي، الرب إلهي يُنير ظُلمتي (مزمور 18: 28) + هو يُعلي النفس ويُنير العينين، يمنح الشفاء والحياة والبركة (سيراخ 34: 20) + لا تكون لك بعد الشمس نوراً في النهار، ولا القمر يُنير لك مضيئاً، بل الرب يكون لك نوراً أبدياً وإلهك زينتك (أشعياء 60: 19) + ولا يكون ليلٌ هُناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله يُنير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الآبدين (رؤيا 22: 5) 2 – ما قبل السير في الطريق: المسيح الرب قبل أن يدعو أحد للسير في الطريق، فهو يُعلن عن ذاته أولاً، لأنه حتماً وضروري أن يُظهر للنفس من هوَّ لا كمعلومات ومعرفة عقلية بل حقيقة واقعية ملموسة، لأن كيف يسير أحد وراء شخص لا يعرفه ولا يعرف عنه سوى مجرد كلمات منقولة أو معلومات مشهورة، أو قراءات عامة او حتى خاصة، أو حتى دراسات مُفصلة دقيقة درسها عن شخصيته، بل لابد من اللقاء وضرورة إظهار نور وجهه في داخل القلب بشكل شخصي: + جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبال فاران، وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم (تثنية 33: 2) + نورٌ أشرق في الظلمة للمستقيمين هو حنان ورحيم وصديق (مزمور 112: 4) + الشعب السالك في الظلمة أبصر نوراً عظيماً، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور (أشعياء 9: 2) + قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليكِ (أشعياء 60: 1) + لان الله الذي قال أن يُشرق نور من ظلمة، هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح (2كورنثوس 4: 6) فالمسيح الرب ضروري يشهد لذاته في القلب من الداخل ويُعرِّف نفسه من ناحية واقعية قبل أن ينطق بالدعوة، لكي يعرف الإنسان من هو الذي يدعوه لطريق جديد لم يعرفه من قبل من جهة الواقع العملي لا من جهة المعرفة العقلية فقط: أنا هوَّ الشاهد لنفسي ويشهد لي الآب الذي أرسلني (يوحنا 8: 18) لذلك لن نعرف شخص الرب يسوع من جهة الإيمان إلا إذا عرفنا من هوَّ على وجه التحديد – حسب إعلانه عن ذاته – وماذا يُعطي على وجه التدقيق، لأنه لا يُعطي شيء غريب عنه أو من خارجه، بل يُعطي ذاته، فكل من لا يعرفه على مستواه الإلهي ويعترف اعتراف الإيمان الحسن، سيفلت حتماً من معرفته الحقيقية على مستوى لمسه من جهة كلمة الحياة فيموت في خطاياه: [ فقلت لكم أنكم تموتون في خطاياكم، لأنكم أن لم تؤمنوا إني أنا هوَّ تموتون في خطاياكم ] (يوحنا 8: 24) ولماذا الموت في الخطية في تلك الساعة، لأن الرب قال: + انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، أن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أُعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم (يوحنا 6: 51) + أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا (يوحنا 11: 25) + أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء (رؤيا 1: 8) فأن كنت أنا لا أؤمن ولا التصق بمسيح النور وغذاء الحياة الأبدية، كيف أنجو من الموت الأبدي وأنا في انفصال تام عن الحياة والبر والنور المجيد، لأن في تلك الساعة وانا منعزل عن حياة الله، فأنا متغرِّب طبيعياً عن الطريق الصحيح مهما ما حييت بمنهج ذات شكل أعمال صالحة تُشابه نفس ذات الأعمال الصحيحة حسب إعلان الإنجيل، ومهما ما جاهدت جهاد شكله حسن جداً وقانوني، لكن في الواقع العملي المُعاش أنا منفصل داخلياً ومتغرب عن حياة الله وخارج عن طريق الحق والبرّ ولا أسير أو أُجاهد قانونياً حسب قصد الله المُعلن في الإنجيل وبصوت الروح القدس في القلب من الداخل، وبالتالي سأكون مشوشاً ومضطرباً في النهاية، وهذا هو سر كآبة البعض ومللهم من الاستمرار في الطريق الروحي، لأنه سالك بمنهج بعيد كل البُعد عن المنهج الإلهي الأصيل، لأنه لازال تائهاً عن الطريق يحيا باستنتاجه الخاص وتأملاته الشخصية الناتجة من نشاط عقلة أو من كثرة المعلومات التي قرأها أو سمعها والتي قد تكون صحيحة 100% لكنها بدون واقع اختباري في حياته الشخصية على مستوى الذي سمع ولمس الرب من جهة كلمة الحياة فنال قوة شفاء مع تغيير وتجديد لنفسه مستمر: [ ونحن جميعاً ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح ] (2كورنثوس 3: 18) 3– الطريق والقائد: أولاً قبل كل شيء ينبغي أن نعرف ما معنى كلمة طريق حتى نعي كيف نسير فيه كتلاميذ حقيقيين نحيا وفق المنهج الإلهي الأصيل كما سبق وشرحنا، فكلمة طريق في الكتاب المقدس حسب ما أعلنها الرب عن نفسه تأتي في اللغة اليونانية όδος – hodos بمعنى: سير – مشي أو يمشي – رحلة – سفر – ممر – سلوك. فالقصد من الكلمة كما أعلنها الرب يسوع عن نفسه (أنا هو الطريق – يوحنا 14: 6): (أ) هو الممر الذي تسلكه السفينة أو الطريق المستقيم المرسوم أي الطريق المؤدي لهدف معين يخص هذا الطريق وحده فقط، مثل القطار الذي يسير على طريق مُحدد من مكان بداية الانطلاق إلى الوصول لنهاية الخط المُحدد بدقة، بدون أن يخرج عنه يميناً أو يساراً، لذلك يعتبر الطريق – في كلام الرب – الممر المُحدد أي الممر الضيق المرسوم الذي ينبغي أن يتم السير فيه وعدم الحيدان عنه أو الالتفات فيه لأي اتجاه لا يميناً ولا يساراً ولا للوراء، بل النظر للأمام دوماً واستكمال المسيرة بلا توقف، لأن بطبيعة الطريق الضيق (مثل طريق القطار) لا توجد فيه فرصه للالتفات في جميع الاتجاهات، بل في اتجاهين فقط يا إما للأمام أو الرجوع للخلف. (ب) وتعبير الطريق يحمل أيضاً معنى مجازي يُقصد به الوسائل السليمة والإجراءات المُعينة من قِبَل قائد الطريق لكي يتم السير بأمان وفق الطريقة الصحيحة. (جـ) أو يأتي بمعنى eisodos - εἴσοδος أي دخول، أو اشتراك في، وذلك بالمعنى المكاني، أي دخول مكان أو الوصول إلى مكان مُحدد أو مبنى مُعين. * عموماً كلمة όδος – hodos تأتي في السبعينية حوالي 900 مرة تقريباً وذلك بمعنييها الحرفي والمجازي. وفي معظم الحالات تأتي ترجمة للكلمة العبرية derek طريق، ومن خلال العهد القديم نقدر نفهم بكل دقة وتركيز ما شرحناه من معنى، لأننا سنلاحظ دائماً أنه يوجد طريق مُعين مرسوم من الله الذي صار قائداً فيه واضعاً شروط المسيرة وضبطها: (أ) لقد قاد الله شعبه في الطريق بشروط مُحددة وبطريقة دقيقة هو من دبرها ونفذها بواسطة موسى النبي، وقد قضى فيها الشعب 40 سنة في البرية، ثم بعد ذلك إلى أرض الميعاد التي كانت الهدف الموضوع أمامهم من قِبَل الله، والطريق عَبر البرية حدث فيه امتحان للشعب من جهة الإيمان: [ جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها، لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أقسم الرب لآبائكم. وتتذكر كل الطريق التي فيها سار بك الرب إلهك هذه الأربعين سنة في القفر لكي يذلك ويُجربك ليعرف ما في قلبك أتحفظ وصاياه أم لا. فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آبائك، لكي يُعلِّمك أنهُ ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيا الإنسان. ثيابك لم تُبلى عليك ورجلك لم تتورم هذه الأربعين سنة. فاعلم في قلبك أنه كما يُؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك. واحفظ وصايا الرب إلهك لتسلك في طرقه وتتقيه. ] (تثنية 8: 1 – 6) ونجد في أشعياء أن الله هو الصانع والراسم الطريق بنفسه: + أنا الرب قدوسكم خالق إسرائيل ملككم. هكذا يقول الرب الجاعل في البحر طريقاً وفي المياه القوية مسلكاً... هانذا صانع أمراً جديداً الآن ينبت ألا تعرفونه: أجعل في البرية طريقاً، في القفر أنهاراً؛ استيقظي استيقظي البسي قوة يا ذراع الرب، استيقظي كما في أيام القدم، كما في الأدوار القديمة، ألستِ انتِ القاطعة رُهب، الطاعنة التنين. ألستِ أنتِ هي المنشفة البحر مياه الغمر العظيم، الجاعلة أعماق البحر طريقاً لعبور المفديين، ومفديو الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بالترنم وعلى رؤوسهم فرح أبدي، ابتهاج وفرح يدركانهم، يهرب الحزن والتنهد. (أشعياء 43: 15 و16 و19؛ 52: 9 – 11) (ب) طبعاً رأينا في الآيات السابقة من هو صانع الطريق وشروط دخول الأرض التي وعد بها الرب وفرح الدخول إلى صهيون، وهذا يؤدي بنا إلى التعرّف على الله القائد والمُعين، لأن هو بشخصه قائد شعبه في الطريق، فكلمة يقود وردت حوالي 44 مرة تقريباً في العهد القديم بالإشارة إلى الله سواء بتصريح مباشر أو غير مُباشر: + وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم في طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة لأن الله قال لئلا يندم الشعب إذا رأوا حرباً ويرجعوا إلى مصر. فأدار الله الشعب في طريق برية بحر سوف وصعد بنو إسرائيل متجهزين من أرض مصر (خروج 13: 17) + من مثلك بين الآلهة يا رب، من مثلك مُعتزاً في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعاً عجائب. تمد يمينك فتبتلعهم الأرض. ترشد برأفتك، الشعب الذي فديته تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. (خروج 15: 11 – 13) أما في المزامير نجد الاعتراف الصريح بقيادة الله في حياة الإنسان بصفته راعي وقائد بارع يسوق الإنسان بالخير والرحمة نحو السكنى في دياره إلى الأبد: + الرب راعي فلا يعوزني شيء. في مراعٍ خِضر يُربضني، إلى مياه الراحة يوردني. يرد (ينعش) نفسي، يهديني إلى سُبل البرّ من أجل اسمه. أيضاً إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شراً لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يُعزيانني (يُشددان عزيمتي). ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي (تبسط أمامي مأدبة على مرأى مِن أَعدَائِي) مسحت بالدهن رأسي كأسي رياً. إنما خيرٌ ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام (مزمور 23) ولذلك كان التوسل إلى الله دائماً لأجل قيادة النفس وإرشادها: "يا رب اهدني إلى برك بسبب أعدائي (يَا رَبُّ أَرْشِدْنِي لِعَمَلِ بِرِّكَ عِنْدَ مُوَاجَهَةِ أَعْدَائِي لِي) سهل قُدامي طريقك" (مزمور 5: 8) وطبعاً من البديهي أن الله في قيادته يُرشد النفس دوماً إلى الحكمة ويصير مُعين ونصير قوي بل وحصن حصين يحفظ شعبه ويقودهم بالبرّ نحو الغاية التي وضعها: + وقد وهبني الله أن أُبدي عما في نفسي وأن أُجري في خاطري ما يليق بمواهبه، فأنه هو المُرشد إلى الحكمة ومثقف الحكماء. وفي يده نحن وأقوالنا والفطنة كلها ومعرفة ما يصنع (حكمة 7: 15 – 16) + أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. لا يدع رجلك تزل، لا ينعس حافظك. أنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. الرب حافظك، الرب ظل لك عن يدك اليمنى. لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. الرب يحفظك من كل شر يحفظ نفسك. الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر (مزمور 121) + اعترف لاسمك لأنك كنت لي مُجيراً ونصيراً (سيراخ 51: 2) + الرب صخرتي وحصني ومُنقذي، إلهي صخرتي به احتمي، تُرسي وقرن خلاصي وملجأي (مزمور 18: 2) + أما خلاص الصديقين فمن قِبَل الرب حصنهم في زمان الضيق (مزمور 37: 39) + الساكن في ستر العلي، في ضل القدير يبيت. أقول للرب ملجأي وحصني، إلهي، فاتكل عليه. لأنه يُنجيك من فخ الصياد ومن الوبا الخطر. بخوافيه يظللك، وتحت اجنحته تحتمي، ترسٌ ومجن حقه. لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار. ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك ألف، وربوات عن يمينك إليك لا يقرب. إنما بعينيك تنظر وترى مُجازاة الأشرار. لأنك قلت أنت يا رب ملجأي، جعلت العُلي مسكنك. لا يلاقيك شرّ ولا تدنو ضربة من خيمتك. لأنه يُوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك. على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك. على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس. لأنه تعلَّق بي أُنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي. يدعوني فاستجيب له، معه أنا في الضيق أُنقذه وأمجده. من طول الأيام أُشبعه وأُريه خلاصي (مزمور 91) |
|
|
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||
|
..::| الإدارة العامة |::..
|
موضوع مهم وجميل
ربنا يبارك خدمتك |
||||

|
|
|
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||
|
..::| VIP |::..
|
ربنا يعوض تعب محبتك
|
||||

|
 |
|
| قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً |
| الموضوع |
| يسوع هو الطريق للحياة الحقيقية |
| الطريق إلى الحرية الحقيقية |
| الطريق الثاني للرِفعة الحقيقية والكرامة السماوية |
| الطريق إلى العظمة الحقيقية |
| الطريق إلى العظمة الحقيقية |