
 |
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
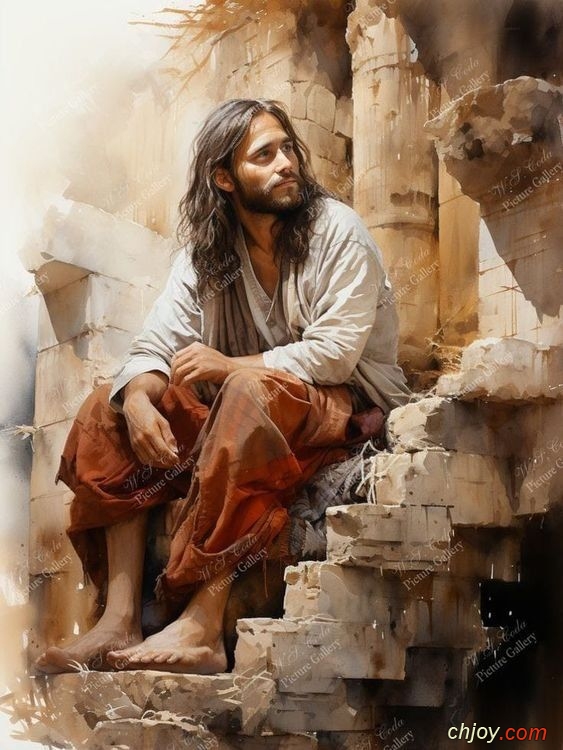 الأَيَّام الأَخِيرَة «وَلكِنِ اعْلَمْ هذَا أَنَّهُ فِي الأَيَّامِ الأَخِيرَةِ سَتَأْتِي أَزْمِنَةٌ صَعْبَةٌ، لأَنَّ النَّاسَ يَكُونُونَ مُحِبِّينَ لأَنْفُسِهِمْ، مُحِبِّينَ لِلْمَالِ، مُتَعَظِّمِينَ، مُسْتَكْبِرِينَ، مُجَدِّفِينَ، غَيْرَ طَائِعِينَ لِوَالِدِيهِمْ، غَيْرَ شَاكِرِينَ، دَنِسِينَ، بِلاَ حُنُوٍّ، بِلاَ رِضًى، ثَالِبِينَ، عَدِيمِي النَّزَاهَةِ، شَرِسِينَ، غَيْرَ مُحِبِّينَ لِلصَّلاَحِ، خَائِنِينَ، مُقْتَحِمِينَ، مُتَصَلِّفِينَ، مُحِبِّينَ لِلَّذَّاتِ دُونَ مَحَبَّةٍ ِللهِ، لَهُمْ صُورَةُ التَّقْوَى، وَلكِنَّهُمْ مُنْكِرُونَ قُوَّتَهَا. فَأَعْرِضْ عَنْ هؤُلاَءِ» (٢كو ٣: ١-٥). يُبيّن الرسول بولس الطابع العام للأيام الأخيرة في كلمتين «أَزْمِنَةٌ صَعْبَةٌ» أو أيام ”محفوفة بالمخاطر“. وجدير بنا أن نضع هذا التحذير باستمرار في فكرنا، لأنه ليس هناك أدنى شك أننا نعيش في ”الأَيَّامِ الأَخِيرَةِ“ وأن الأخطار الروحية القاتلة تُحيط بنا من كل جانب. وفي هذه الآيات (٢تي ٣: ١-٥)، ترتسم أمام عيوننا صفات الناس في الأيام الأخيرة. وتتجسد هذه الصفات في قائمة رهيبة تفوق القائمة في رومية ١: ٢٨-٣١ التي تصف شرور العالم الوثني القديم. والشيء الخطير جدًا وراء القائمة الحالية في هذا الأصحاح هي أن كل هذه الشرور تتخفى وراء «صُورَةُ التَّقْوَى»، أي أن الأشخاص الذين وُصفوا بهذه الصفات مسيحيون حسب الظاهر والشكل، ولكنهم، بهذه الصفات ينكرون قوة المسيحية كُلية. ولنتأمل في بعض هذه الصفات: مَحَبَّة الْمَال «لأَنَّ النَّاسَ يَكُونُونَ مُحِبِّينَ لأَنْفُسِهِمْ، مُحِبِّينَ لِلْمَالِ» (ع ٢): إنّ احدى أبرز صفات الناس في الأيام الأخيرة هي محبة الذّات. كلّنا نحب أنفسنا، لكن الأنانية البغيضة هي المقصودة هنا. قد نقول إنّنا نُحبّ الله والناس، لكن أعمالنّا تشهد علينا وتُظهر أنّ محبتنا لذواتنا ورغبتنا في إرضائها مُستفحلة، وهكذا نعيش لأنفسنا فقط، محاولين ارضائها بشتى الوسائل. وفي محاولات الانسان ليرفع نفسه، لكي يستمر متربعًا على عرش الذات، نراه لا يتورع عن ازدراء الآخرين، بل قد يدوس غيره غير عابئٍ بأحدٍ، إلاّ بنفسه؟ النتيجة النهائية هي «مَنْ يُحِبُّ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا» (يو ١٢: ٢٥). تظهر محبة الذّات بوضوح في “مَحَبَّةَ الْمَالِ”؛ والمشكلة ليست في المال، وسيلة التعامل في البيع والشراء، بل في “مَحَبَّةَ الْمَالِ” التي هي “أَصْلٌ لِكُلِّ الشُّرُور”، ومن يسير في رَكب هذه المحبّة الفاسدة، يَضلّ عن الإيمان والاتكال على الله، ويُسبِّب لنفسه ولغيره أوجاعًا كثيرة (١تي ٦: ١٠). وضَّح الملك سليمان الغنيّ والحكيم، الفرق بين المال كبركة، وبين التعلّق المَرَضي به: «كُلُّ إِنْسَانٍ أَعْطَاهُ اللهُ غِنًى وَمَالاً وَسَلَّطَهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ، وَيَأْخُذَ نَصِيبَهُ، وَيَفْرَحَ بِتَعَبِهِ، فَهذَا هُوَ عَطِيَّةُ اللهِ» (جا ٥: ١٩)، ولكن «مَنْ يُحِبُّ الْفِضَّةَ لاَ يَشْبَعُ مِنَ الْفِضَّةِ، وَمَنْ يُحِبُّ الثَّرْوَةَ لاَ يَشْبَعُ مِنْ دَخْل» (جا ٥: ١٠). وفي السعي اللاهث نحو الغنى هناك نجاساتٍ كثيرة أيضًا، لأن «الْمُسْتَعْجِلُ إِلَى الْغِنَى لاَ يُبْرَأُ» (أم ٢٨: ٢٠). وهذا النوع من الإدمان ليس للأغنياء فقط، فقد تكون فقيرًا أو متوسط الحال، لكن إن كنت تفكّر دائمًا بلهفة وتحلم بولعٍ بالمال، بل وتلهج به كل الوقت؛ أليست هذه هي العبودية بعينها؟ هل يجعل هذا كلّ شيء في نظرنا قابل للبيع؟ هل يشمل ذلك الضمير والأخلاق والقيم؟ إن كان الجواب نعم، فنحن غارقون في مستنقع “مَحَبَّة الْمَالِ”، والله وحده قادر أن ينقذنا منه. التَّعَظُّمَ والْكِبْرِيَاء «لأَنَّ النَّاسَ يَكُونُونَ مُحِبِّينَ لأَنْفُسِهِمْ، مُحِبِّينَ لِلْمَالِ، مُتَعَظِّمِينَ، مُسْتَكْبِرِينَ، مُجَدِّفِينَ» (ع ٢): إنّ ”مَحَبَّةَ الْمَالِ“ تجعل الناس مُتَعَظِّمِينَ مفتخرين بكثرة غناهم، يسعون لتحقيق كل ما تشتهيه نفوسهم. آه ... لو كان الإنسان يذكر دائمًا أنّ كل عطية صالحة وكل بركة هي من الله، لما كان للتعظُّم مكان! (يع ١: ١٧). لكن تذكّر العطية والتمتع بها، دونما تقدير للّه الذي أعطاها، تقود الإنسان إلى الافتخار بنفسه. بالطبع هناك الكثيرون من المُحسنين الأسخياء، وما أحوج مجتمعاتنا لمثل هؤلاء، لكن كثيرين منهم يبتغون الشهرة والتقدير والمكانة وليس العطاء البعيد عن الأنظار، أي العطاء لمجرد العطاء، الذي يمجّد الله ويخدم شعبه. إن المُتكبِّر يُعبِّر بالفكر والقول والعمل، أنه أفضل من الآخرين؛ ربّما بمركزه الاجتماعي، أو بوضعه الاقتصادي، وأحيانًا بِحَسَبِه ونَسَبِه، وربما بموهبة باركه الله بها، ويا للعجب! وبدل التواضع وشكر الله على عطاياه، ترى الكبرياء والانتفاخ يسودان على القلب بجملته. قمة السخرية هي أننا نعلم أن الكلّ سيزول أو يصبح قديمًا، وهناك ما سيفقد بريقه بمرور الزمن، فعلام الافتخار؟! لاحظ أنّ الكبرياء تقودنا للهجوم، بل والتعدّي على الآخرين، لكن الطامة الكبرى هي أن المتكبّر يُجدّف أيضًا على الله: «لأَنَّ الشِّرِّيرَ يَفْتَخِرُ بِشَهَوَاتِ نَفْسِهِ، وَالْخَاطِفُ يُجَدِّفُ. يُهِينُ الرَّبَّ. الشِّرِّيرُ حَسَبَ تَشَامُخِ أَنْفِهِ يَقُولُ: لاَ يُطَالِبُ. كُلُّ أَفْكَارِهِ أَنَّهُ لاَ إِلهَ» (مز ١٠: ٣، ٤). إنه حضيض الفساد البشري، الذي ينكر فيه الإنسان وجود الله وسلطانه، بل ويحاول أن يظهر هو نفسه كإله، حالمًا بذلك الوهم الذي غرسه إبليس في ذهن أمّنا حواء قديمًا: «وَتَكُونَانِ كَاللهِ» (تك ٣: ٥). ليت الله يلمس القلوب لمعرفته، وبهذه المعرفة الاختبارية يتحوّل التعظّم لانكسار حقيقي، والتكبّر لتواضع قلبي، والتجديف لشكرٍ دائمٍ لربّ الكلّ. أَطِيعُوا وَالِدِيكُمْ! «مُجَدِّفِينَ، غَيْرَ طَائِعِينَ لِوَالِدِيهِمْ، غَيْرَ شَاكِرِينَ» (ع ٢): هل تُصدّق أنّ من يتعالى، بل ويجدّف على الله، يُمكن أن يحترم ويطيع والديه بشكل صحيح؟ إنّ إكرام الوالدين هي الوصية الخامسة في الوصايا العشر، لكنّ الوصايا الأربع الأولى تتعلّق بعبادة الله ومهابته، لذلك فمن يتعدّى على الله ولا يعتبره، لا يمكنه أبدًا أن يُقدِّر والديه حقّ تقدير. اسمع الجاحدين يقولون لله: «ابْعُدْ عَنَّا، وَبِمَعْرِفَةِ طُرُقِكَ لاَ نُسَرُّ. مَنْ هُوَ الْقَدِيرُ حَتَّى نَعْبُدَهُ؟ وَمَاذَا نَنْتَفِعُ إِنِ الْتَمَسْنَاهُ؟» (أي ٢١: ١٤، ١٥). إنّ عدم الخضوع لله يظهر بالتالي في عصيان الوالدين، وهكذا تقلّ هيبة وسلطة الوالدين كثيرًا ممّا يؤدّي إلى التفكك المستمر للعائلات، كما يُلاحظ في العقود الأخيرة. حاول أحبار اليهود المساومة على ذلك قديمًا بإنشاء تقليد يعفي الابن من مساعدة والديه المحتاجين، إن كان يُكرِّس ممتلكاته لله أو للهيكل، وقد شجب السيّد ذلك قائلاً لهم: «رَفَضْتُمْ وَصِيَّةَ اللهِ لِتَحْفَظُوا تَقْلِيدَكُمْ!» (مر ٧: ٩-١٣). أكثر من ذلك، إنّ من لا يُقدِّر والديه اللذين أنجباه وربّياه، فمن المؤكّد أنه لا يحترم ولا يشكر الآخرين أيضًا. كم نفتقد التقدير والشكر والعرفان بالجميل في هذه الأيام! وما أندر استخدام الكلمات الإنسانية الأساسية: شكرًا، من فضلك، لو سمحت ... وغيرها من الكلمات الدمثة. في أيام أخيرة وشريرة، ليتنا نضع في قلوبنا أن نُطيع والدينا في الرب، لأن هذا حق، بل كل ما نعمله بقول او فعل، فلنعمل الكل باسم الرب يسوع، شاكرين الله والاب به (أف ٦: ١، كو ٣: ١٧). ألا نتمثل بسَيِّدنا المبارك الذي اتّسمت أيام جسده بالشكر؛ فنقدِّم له حياتنا كذبيحة شكر دائمة، نشكر الله على نسمة الحياة وعلى البركات اليومية من هواء ومأكل ومشرب. ليتنا نقدّر شخصه، وأعمال عنايته، فنتعلّم كيف نُقدِّر ونشكر الآخرين أيضًا. الْخِيَانَةُ «خَائِنِينَ، مُقْتَحِمِينَ، مُتَصَلِّفِينَ» (ع ٤): صلّى عزرا واعترف وهو باكٍ، وصام، «يَنُوحُ بِسَبَبِ خِيَانَةِ أَهْلِ السَّبْيِ» (عز ١٠: ١، ٦). أمّا اليوم فالخيانة من السمات البارزة المُميّزة للأيام الأخيرة، فخيانة الأهل والناس صارت طبيعية. لقد فُقد الإحساس بشناعة غشّ الآخرين وخداعهم وتضليلهم لأجل مآرب شخصية خسيسة. وفي كل مكان نجد خيانة الأصدقاء والشركاء لأجل المصلحة الشخصية؛ لقد استشرت الخيانة في القلوب تعيث فسادًا بشراسة وبلا رادع. وحتى الخيانة الزوجية صارت تُسمّى بمسمّيات أخرى، وتُعطى ألف مبرّر لإراحة الضمير، لكن عبثًا؛ إنها تَعدٍّ على الله الذي شرَّع الزواج، وكذلك خيانة لشريك الحياة الذي ارتبطتَ به بعهد دائم أمام الله والناس. والخائنون لا يهتمون بالآخرين، ويعيشون بلا انضباط، فهم يتكلمون ويتصرّفون كما يريدون، وهكذا نجد الصفة التالية هي الاقتحام أي التعدّي. في أيامنا هذه، قد يسمّي البعض الاقتحام انتهازًا للفرص، ريادة أو طلائعية، لكن عندما يكون ذلك انفلاتًا ودوسًا على الآخرين والقيم والمبادئ، فهو اقتحام وتعدٍ لا أقل. بعدها نصل إلى الغرور، فبعد أن ابتدأ الإنسان بمحبة الذات والمال متعظّمًا (٢تي ٣: ٢)، فإنه يصل بسهولة وسرعة إلى هاوية الغرور والكبرياء. إنها “الأنا” المتربّعة على عرش الحياة بلا مساومة، وكأن الإنسان لا يرى إلاّ نفسه. عبثًا قد يقول ذلك الشخص أنه يهتم بالله أو بالآخرين، فالعالم في نظره صار يدور حوله وحوله وحده. والمثال الأشرس هو الشيطان الذي أراد أن يصعد الى السماوات ويرفع كرسيّه... ويصير مثل العلي (إش ١٤: ١٣، ١٤). انه رائد مدرسة العجرفة والمباهاة والرغبة في الامتلاك. أرجوك، لا تكن من أتباع هذه المدرسة، وتربط مصيرك بمصير الشيطان المحتوم، وهي النار الأبدية المعدّة أصلاً لإبليس وملائكته (مت ٢٥: ٤١). بالأحرى إنه وقتٌ للرجوع الحقيقي إلى الله؛ إنه وقت التوبة، وباب التوبة مفتوح الى الآن. مَحَبَّة اللَّذَّات «مُحِبِّينَ لِلَّذَّاتِ دُونَ مَحَبَّةٍ ِللهِ، لَهُمْ صُورَةُ التَّقْوَى، وَلكِنَّهُمْ مُنْكِرُونَ قُوَّتَهَا» (ع ٤، ٥) في منحدر رهيب نحو الهلاك، تلمع مفارقة مصيرية، فإما محبة الله أو مَحَبَّة اللَّذَّات. بكلمات أخرى، إن لم تكن محبة الله فوق كلّ محبة، فإنّ مَحَبَّة اللَّذَّات ستحتل مركز الصدارة وتقود الشخص في طريق المُتع الحسيّة والملذّات الوقتية التي تدمّره ومَن حوله. اسمع هذا التشبيه لإنسان سقط في خطية الزنى «ذَهَبَ وَرَاءَهَا لِوَقْتِهِ، كَثَوْرٍ يَذْهَبُ إِلَى الذَّبْحِ ... كَطَيْرٍ يُسْرِعُ إِلَى الْفَخِّ وَلاَ يَدْرِي أَنَّهُ لِنَفْسِهِ» (أم ٧: ٢٢، ٢٣). والمحزن أنه بينما يقول الله: «لَذَّاتِي مَعَ بَنِي آدَمَ» (أم ٨: ٣١)، فان بني آدم يبحثون عن اللَّذَّات بعيدًا عنه، ساعين وراء المسرّات النجسة المحرّمة والتمتّع الوقتي بالخطية. إنّ واحدة من سمات الأيام الأخيرة هي التديّن الظاهري وهو أخطر ما يمكن أن يحدث في حياة إنسان. إنه “قناع” يُظهرنا بمظهر خارجي مُلفت للآخرين، لكنه يخفي حقيقتنا في الداخل! يمكن للإنسان بالطبع أن يخدع كثيرين، ولكن الله هو العالم بداخل الإنسان وخارجه، ولا يمكننا خداعه. قناع القداسة الوهمية والتديّن الخارجي هو ما نتكلَّم عنه، إنه مظهر زائف خالٍ تمامًا من القوة الروحية، بكلمات أخرى “صُورَةُ التَّقْوَى بِلا قُوَّة”. يا له من قناع مُقنع جدًا يُعطي غطاءً مثاليًا لعمل الشر! هكذا يعيش كثير من الناس حياة الرياء والازدواجية، فيحيون في الخطية وفي الوقت ذاته ينادون باسم الله، دون أن يعرفوه معرفة حقيقية اختبارية. أرجوكم أن تتحذروا من هذه الحياة التي تنافي المخافة وتناقض التقوى لدى الله (أي ١٥: ٤). يظنّ البعض أنّ “التَّقْوَى تِجَارَة”؛ «أَمَّا أَنْتَ يَا إِنْسَانَ اللهِ فَاهْرُبْ مِنْ هذَا، وَاتْبَعِ الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَالإِيمَانَ وَالْمَحَبَّةَ وَالصَّبْرَ وَالْوَدَاعَةَ» (١تي ٦: ٥-١١). |
 |
|