
 |
 |
 |
 |
|
|
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
سُم الحية 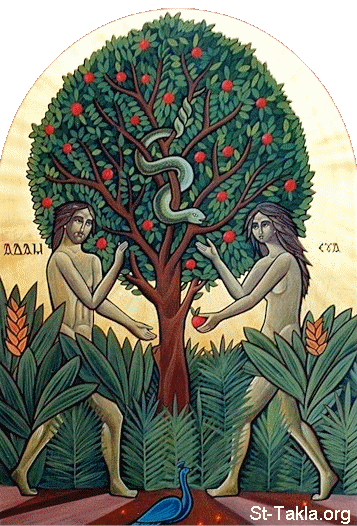 ذهبت إلى المَشفَى لزيارة صديق فاضل يجتاز ظرفًا قاسيًا، إذ تجتاز زوجته الغالية أزمة صحية بالغة الخطورة، عجز فيها الطب، كعادته في كثير من الأحيان. وبعد قليل من الكلمات الركيكة التي حاولت تشجيعه بها، نظر إليَّ أخي الحبيب “رجائي” وبادرني بالقول: “أوَ تدري ما هو سُمّ الحيَّة؟” “أيَّة حيَّة تعني يا صديقي؟” نظرت إليه مُستفهمًا. استفاض صديقي في حديثه قائلاً: “كنت أقرأ اليوم عن هذا الأمر، أوَ تذكر مدخل الحيَّة في حديثها مع حواء؟” صمتُّ راغبًا أن يواصل حديثه. استطرد رجائي قائلاً: “كان مدخلها سؤالاً خبيثًا: «أَحَقًّا قَالَ اللهُ لاَ تَأْكُلاَ مِنْ كُلِّ شَجَرِ الْجَنَّةِ؟» (تك3: 1). إن الحيَّة تُلقي في قلب حواء وآدم بذور الشك في الله؛ إنه يريد أن يحرمكما من لذة قصوى ومنفعة عظمى، فإن أكلتما مِن الشجرة، تنفتح أعينكما، وتكونان آلهة مثله: «عَارِفَيْنِ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ» (تك3: 5). “لقد كانت غاية الحيَّة هي أن تزعزع ثقتهما في صلاح الله ومحبته، لقد ألقت الحيَّة في بالهما أن هذه الشجرة «جَيِّدَةٌ لِلأَكْلِ ... بَهِجَةٌ لِلْعُيُونِ ... شَهِيَّةٌ لِلنَّظَرِ» (تك3: 6). وكأنها تقول لهما: إن الله، بأمره غير المفهوم هذا، يحرمكما مِن فوائد جمّة؛ إنه لا يريد مصلحتكما. كيف يُحبكما ويُحرمكما من أمر كهذا؟! “وللأسف، أعطت المرأة، ومن بعدها رَجُلَهَا، آذانًا صاغية لأكاذيب الحية، ليسري فيهما سُمَّ الحيَّة: عدم الثقة في الله. ومن بعدهما سرى هذا السم في جنسنا البشري قاطبة”. “صَدَقْتَ يا صديقي”. همست إليه مودَّعًا متفكرًا؛ إننا نشعر بهذا السم في مواقف كثيرة؛ لماذا يحدث هذا الأمر أو ذاك؟ وأين الله مما يحدث؟ نشعر بسريان السم فينا عندما يُهيِّج إبليس الدنيا مِن حولنا، ونحاول أن نستجمع شتات ثقتنا في الله، ولكننا نفشل! تنحني نفوسنا في حزن ويأس، نندب حظنا، ربما نلعن يوم مولدنا كأيوب (أي3)، أو نرثي لحالنا كإرميا (مرا 3)، ونلوم الله ونتهمه بكلمات قاسية! إن سُمَّ الحيَّة يعمل حقًا فينا، فيدفعنا إلى الأمر ذاته: يُشككنا في صلاح الله: لماذا يحرمنا الله مما هو جَيِّدٌ؟ ممّا يُبهجنا ويسعدنا - بحسب اعتقادنا؟ لماذا يحرمنا من الشفاء؟ لماذا أخسر وظيفتي؟ لماذا يحرمني من زوجي أو أخي أو فلذة كبدي؟ هل يتلَّذذ بسحقي وتعذيبي؟ لماذا أُعاني هكذا؟ ما هذه القسوة؟! آه يا أصدقائي ... إنه سُمَّ الحية: عدم الثقة في الله، وهو أصل وجذر الخطية. لم يكن الله ليترك المشهد بهذه الصورة. لم يكن ليتركنا فريسة لهذا السُمّ القاتل؛ فأعدَّ - في مطلق نعمته ومحبته وصلاحه - الترياق اللازم لعلاج هذا السُمّ. لقد صنع لهما أقمصةً مِن جِلْدٍ - عن طريق الذبيحة - ليُعالِج ما حدث مع آدم وامرأته في جنة عدن نتيجة عصيانهما. وقد جهّز لنا أيضًا - نحن ذريته ووارثو لعنته - الترياق أو العلاج لهذا السُمّ القاتل: لقد وهبنا الله ابنه، أعطانا أغلى ما عنده ليُعالج شكوكنا وشكوانا. إن أساس علتنا هو أننا نشك فيه؛ نشك في محبته، جود قلبه وصلاحه؛ فقصد أن يُعطينا أغلى مَن يملك ليُعالج أصل وأساس الداء، ولكي يُعالج أيضًا ضعف ثقتنا وشكّنا في صلاحه أثناء مصاعب رحلتنا الكثيرة، لأن «اَلَّذِي لَمْ يُشْفِقْ عَلَى ابْنِهِ، بَلْ بَذَلَهُ لأَجْلِنَا أَجْمَعِينَ، كَيْفَ لاَ يَهَبُنَا أَيْضًا مَعَهُ كُلَّ شَيْءٍ؟» (رو8: 32). فإن كنا وثقنا به لضماننا الأبدي، فكيف لا نثق أيضًا بما يتعلق بأمورنا اليومية. إن مَن أعطانا الأغلى في حبه لنا، هل يحرمنا مما هو لصالحنا وخيرنا في رحلتنا القصيرة في البرية؟! أَوَ ليس هذا علاجًا وافيًا لكل مظاهر الشك في صلاحه وجود قلبه تعالى. كم كان هذا الحديث عن صلاح الله، مع صديقي المتألم، حافزًا ومُشجّعًا لي وأنا أستمع إليه وهو في هذا الموقف المُرّ. واستمر إيمان “رجائي صالح” وحديثه العذب عن إلهه الصالح حتى بعد رقاد زوجته. صديقي المتألم: إننا لسنا أفضل حالاً بطبيعتنا من زوجة أيوب التي تكلَّمت بجهل أثناء تجربتها، لقد كان وقع التجربة عليها قاسيًا عنيفًا، أصعب من أيوب نفسه كما أظنّ؛ لقد فقدت كل ثروتها تباعًا، ثم انهار بيتها، وكم كان مرًا ومؤلمًا أن تفقد جميع أولادها العشرة، ثم تنظر في النهاية زوجها الغالي مريضًا بهذه القروح الرديئة، جالسًا وسط الرماد وبيده شقفة يحتك بها؛ كان كل هذا أكثر مِن احتمالها، كان مريرًا عليها بعد كل ما فقدت أن ترى زوجها في مثل هذه الصورة البشعة، فجاءت أقوالها التي عبرت عن يأسها وعن عدم إيمانها في صلاح الله: «بَارِكِ (جَدِّفْ عَلَى) اللهِ وَمُتْ!» (أي2: 9). لقد قَبِلَت مِن الله فقط ما كانت تراه خيرًا في كل حياتها الماضية، ولم تستطع - مثلنا في أحيان كثيرة - أن تقبل ما قد رأته شرًا مستطيرًا، مات أولادها جميعًا، فقدت كل ممتلكاتها، وفوق كل هذا زوجها - الحبيب البار - في مرضٍ لم تَرَ له مثيلاً، فيا لثقل المصيبة! هل ردَّتها كلمات زوجها إلى صوابها (أي2: 10)، تلك التي دعتها أن تقبل - كهدية من يد الله - ما رأته شرًا، كما قَبِلَت الخير قبلاً؟ ... لا نعلم! هلاَّ تَرُدّنَا نحن عن جهلنا، فلا يتبادر إلينا الشك في صلاح الله في تجاربنا؟! لم يُجب الله أيوبَ عن أسئلته الكثيرة عن سبب كل هذا الألم الذي تعرّض له، ولكن حديث الله إليه كان عن مدى قوته وحكمته وعلمه (أي38-41). ولكن بعد موقعة الجلجثة لدينا إجابة إضافية تحمل لنا علاجًا فعّالاً، إن إلهنا الصالح - كلي القدرة والحكمة - يُحبّنا جدًا لدرجة أنه بذل ابنه نيابةً عنّا، فهل يُعقل أن يصنع معنا ما يؤذينا؟! أو أن يُعطينا ما ليس لخيرنا؟! إن إلهنا لا يُخطئ أبدًا ... إنه يصنع الكل حسنًا في وقته، وحتى الشر يستخدمه ليُخرج لنا الأفضل (جا3: 11؛ تك50: 20). وإن كنا، ونحن أشرارًا، نعرف أن نعطي أولادنا عطايا جيدة، فهل يصنع أبونا السماوي معنا شيئًا ضارًا، أَوَ لا يَهَبنا في صلاحه كل ما هو لخيرنا؟ (مت7: 11). أعلم كم تختلف الآراء في تفسير ماهية الخير. كثيرًا ما ترجمه البعض في صورة: صحة كاملة، حياة مريحة خالية من المشاكل والمتاعب، سيارة فارهة ورصيد في البنوك ... هذه صورة الصلاح كما رسمها “سقراط”، والتي مقياسها رغبة الإنسان وشهوته. إن صاحب هذا الفكر يعامل الله وكأنه مارد مصباح علاء الدين؛ إنه يستخدم تعبيرات تبدو وكأنها روحية، مثل آمن أكثر، صلِّ أكثر ... إلخ. والحقيقة إنه يريد أن يستخدم الله، لا أن يخدمه. إنه يتعامل مع الله وكأن الله موجود ليَخدمه - في سعيه الأناني - فيما يظن أنه يُسعده ويُشبعه. إن إلهنا الصالح يعلم تمامًا أن خيرنا الحقيقي هو في قربنا منه، لذا فهو يستخدم شتى الطرق لكي يُبقينا قريبين منه «قَرِيبٌ هُوَ الرَّبُّ مِنَ الْمُنْكَسِرِي الْقُلُوبِ، وَيُخَلِّصُ الْمُنْسَحِقِي الرُّوحِ» (مز34: 18). كان يُمكن لله أن يحفظ يوسف من السجن، ويحفظ إرميا من الجب المُوحِل، ويحفظ دانيآل من جب الأسود، والرفاق الثلاثة من أتون النار، وبولس من انكسار السفينة والسجن؛ لكنه لم يفعل. لقد سمح لتلك المشاهد أن تحدث، فاختبر هؤلاء الأشخاص قُربًا خاصًا لله لم يحدث من قبل، أوَ ليس في هذا كل الخير لهم. إننا نتعلَّم أشياء عن الله، في وقت الألم، لا يمكننا تعلّمها بأية طريقة أخرى (مز119: 67)، لكن ماذا عسانا فاعلون أمام حقيقة صلاح الله التي يُحاربها العدو منذ القديم؟ أولاً: الإيمان كثيرًا ما ردَّدت في أوقات حالكة الظلام: «لَوْلاَ أَنَّنِي آمَنْتُ بِأَنْ أَرَى جُودَ الرَّبِّ فِي أَرْضِ الأَحْيَاءِ --- انْتَظِرِ الرَّبَّ. لِيَتَشَدَّدْ وَلْيَتَشَجَّعْ قَلْبُكَ، وَانْتَظِرِ الرَّبَّ» (مز27: 13، 14). ما من كلمات أفضل تُعبّر عن الحالة التي يُمكن أن نتردّى فيها، لولا إيماننا بصلاحه، وبعظمة جوده. وما من كلمات أوضح تصف هاوية اليأس التي يمكن أن ننحدر إليها إذا ضعف الإيمان. أصلي أن يقينا الله هذا المصير! فلنحمل تُرْس الإيمان الذي يُطفئ جميع السهام المُلتهبة التي يُطلقها عدونا - بكثافة - في وقت التجربة؛ إيمان الثقة العملية والحيَّة بإلهنا الصالح المحب. ثانيًا: الإعلان لنهتف بأعلى أصواتنا حتى من قلب الألم: «إِنَّمَا صَالِحٌ اللهُ» (مز73: 1) أو كما تترجم أيضًا: “بكل يقين صالح الله”. بل «لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ اللَّهُ» (مت19: 17). يوم رقاد أحد الخدام الشباب، تاركًا زوجة شابة وأطفالاً صغارًا - وكانت تُسْمَع كلمات الإشفاق على الزوجة والأطفال – وكأن الجميع يحبونهم أكثر من الله، ويلومونه على ما صنع، وكأنه - تعالى - لا يعلم أن لأخينا الذي رقد زوجة شابة، وأطفالٌ سيتيتمون، في هذا التوقيت كتب أحدهم مخاطبًا الله: إنت اللي قلبك كله جود مش قلبنا كلك صلاح أبدًا ما ترضى تُضرِّنا رغم الألم عندك بنيجي وننحني فكرك أكيد أعلى كتير مِن فكرنا إن ما نريد أن نشهد به هو أن الله صالح في كل الظروف. إنه لا يصنع إلا الخير والصلاح مهما بدا ظلام المشهد. قال كاتب المزمور: «خَيْرًا صَنَعْتَ مَعَ عَبْدِكَ يَا رَبُّ حَسَبَ كَلاَمِكَ» (مز119: 65)، أو كما تُتَرجم أيضًا: “عاملتنا حسنًا يا رب”. وهذه هي شهادتنا في كل الظروف، في كل الأوقات، في كل التجارب: «خَيْرًا صَنَعْتَ مَعَ عَبْدِكَ يَا رَبُّ حَسَبَ كَلاَمِكَ». |
|
|
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||
|
..::| الإدارة العامة |::..
|
وهذه هي شهادتنا في كل الظروف، في كل الأوقات، في كل التجارب: «خَيْرًا صَنَعْتَ مَعَ عَبْدِكَ يَا رَبُّ حَسَبَ كَلاَمِكَ». موضوع جميل ربنا يبارك خدمتك مرمر |
||||

|
|
|
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
شكرا على المرور |
||||

|
 |
|