
 |
 |
 |
 |
|
|
رقم المشاركة : ( 8271 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
مثل اللؤلؤة الثمينة  يروي هذا المثل قصّة رجلٍ باع كلّ ما يملك للحصول على لؤلؤة ثمينة. عادةً ما يفسر المثل مجازيًا بأنّه يخبرنا عن مركزيّة الإيمان، أو الكنيسة، أو يسوع، أو الملكوت. ولكنّ هذا التفسير يتجاهل ما الذي تمثّله اللؤلؤة. لن نستطيع فهم روح السخرية الكامنة في هذا المثل من منظورنا اليوم، فالمثل أقرب للفكرة التالية: التاجر (بائع بالجملة) الّذي يبيعنا بالعادة ما لا نحتاجه بسعر لا نتحمّله… يبيع كلّ أمواله من أجل لؤلؤة، مهما علا ثمنها يبقى بخسًا بالنسبة للتاجر. لا يمكن للتاجر أن يأكل اللؤلؤة، ولا أن يجلس عليها، ولا أن تكسي عريه، لكنّه كان يؤمن أنّ هذه اللؤلؤة تُتمّم مشاريعه الاقتصاديّة (غايته من هذه الحياة). والسؤال ماذا لو كان المثل يتحدّانا لنحسم أمرنا تُجاه لؤلؤتنا الثمينة؟ إذا كنّا نعرف طموحنا المطلق، عندها سنصبح أقل اكتنازًا. فنحن لن نكدح من أجل أشياء صغيرة. وعلاوةً على ذلك، سنصبح قادرين على محبّة جيراننا بشكلٍ أفضل، لأنّنا سنعلم ما هو الأكثر أهميّة بالنسبة لهم. إنّ أمثال يسوع تستفّزنا، لأنّها تخبرنا بطريقةٍ ما، ما نعلمه مسبقًا بأنّه صحيح، ولكن لا نريد أن نعرفه. والسؤال الأخير: ماذا لو كنت غير مسيحيّ؟ ألا أجد معاني عميقة في هذه الأمثال؟ إذا كان الغريب تحرّكه أمثال يسوع لهذه الدرجة، فكم بالحريّ الأشخاص الذين يسبّحونه إلهًا ومخلّصًا؟ |
||||
|
|
|||||
|
|
رقم المشاركة : ( 8272 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
أربعة أمثال ليسوع مازلنا نفهمها بطريقةٍ خاطئة  بقلم الأب جيمس مارتن اليسوعيّ نقلتها إلى العربية حلا بصّال قيل: "وُضع الدين ليُعزّي المتألّمين وليُحزن المُرتاحين". وهذا ما ينطبق على أمثال يسوع، فببساطتها هي قصصٌ قصيرة تحمل قيَم أخلاقيّة - لكنّها وُضعت بطريقةٍ مماثلة: لتُحزن. فهي تأسر قلوبنا بعذوبتها، ولكنّها تُقلقنا في الوقت نفسه. بالتأكيد يمكن قراءة هذه الأمثال على أنّها الحبّ الإلهيّ وسبيل خلاصنا. ولكنّها كانت رسائل تحدٍّ لِمَن رويت لهم في القرن الأوّل، يهود الجليل واليهوديّة. فقط عندما نضع أنفسنا مكان أتباع يسوع ومستمعيه، نختبر عمق هذه الأمثال، ونجد أنفسنا مندهشين أمام التحدّي الّذي تضعه أمامنا في يومنا هذا. ولبلوغ هذا الغرض، سنعرض أربعة أمثال ليسوع: مثل الابن الضال:  يروي لنا هذا المثل قصّة أبانا الّذي يحبّنا مهما بلغت أفعالنا من حقارة، إنّها فكرة مُحبّبة لدى الجميع، ولا أريد أن أنفيها. ومع ذلك، فلم تكن هذه الفكرة ما رغب يسوع إيصاله لمستمعيه، فهم يعلمون مُسبقًا أنّ أباهم الّذي في السماوات، مُحبّ وغفور ورحوم. لكنّ لوقا يُحضّر في إنجيله لهاتين الفكرتين (التوبة والمغفرة) بالطريقة التالية: إذ استهلّ هذا المثل بمثلَين قصيرين هما: مثل الخروف الضائع، ومثل الدرهم المفقود. ويُنهيهما الإنجيليّ بحقيقة أنّه سيكون في السماء فرحٌ بخاطئ تائب أكثر من تسعة وتسعين صالحين لا يحتاجون إلى التوبة". ولكن، أهذا بالفعل ما ترغب الأمثال أن تقوله لنا؟ لم يتكلّم المسيح عن خطيئة الخروف أو عن جشع النقود؛ فالخروف لا يشعر بالذنب والنقود لا تتوب. أكثر من ذلك، الراعي يفقد الخروف؛ والمرأة تفقد نقودها. ولكن الله لا يفقدنا بل يتفقّدنا. فالمثلَين الأوّلَيّن ليسا عن التوبة والمغفرة. بل عن العدّ: لاحظ الراعي خروفًا مفقودًا من أصل مئة، ولاحظت المرأة فلسًا مفقودًا من أصل عشرة. بحثوا، وجدوا، فرحوا، فاحتفلوا. وبعدها نصل إلى المثل الثالث. فتبدأ قصّة الابن الضّال: "كان لرجلٍ ابنان..." إذا ركزنا على الابن الضال، سنفهم البداية بشكلٍ خاطئ. كلّ يهوديّ مثقّف في الكتاب المقدّس يعلم أنّه في حال وجود ابنان، الله يرجّح كفّة الابن الأصغر: هابيل على قايين، اسحق على اسماعيل، يعقوب على عيسو، افرايم على منسى. ولا تسير الأمور في المثل كما نظنّ. لا يمكننا أن نعتبر الأمر مماثل مع الابن الأصغر هنا، الّذي "بذّر كل ما أخذه من أموال أبيه على حياة الفسق". وبعد ذلك إذا تأمّلنا في دهشة الأبّ وترحيبه بعودة ابنه الأصغر إلى المنزل، سنفهم بشكلٍ خاطئ الهدف من المثل مرةً أُخرى. ابتهج الأبّ ببساطة لمجرّد عودة ابنه: ابتهج وأقام وليمة، اذا توقّفنا هنا، فهذا يعني أنّنا فشلنا في العدّ. فالابن الأكبر ذكّر أباه عندما سمع صوت الموسيقى والرقص بأنّه كان يملك الوقت ليقيم احتفالاً ووليمة، ولكنّه لم يفكر بأبنه الأكبر أبدًا. هو لديه ابنان، ولكنّه لم يدخل في مسألة العدّ. مَثَلنا هذا هو أقلّ عن المغفرة وأكثر عن العدّ، والتأكّد من أنّ الجميع موجود ومعدود. مثل السامريّ الصالح:  عادةً ما يتيه بنا فكرنا ومعلوماتنا عن الكتاب المقدّس عن الغاية الّتي ضرب يسوع من أجلها هذا المثل بالتحديد، وسنكتفي هنا باثنتين: إمّا أن يفترض القرّاء بأنّ اللاويّ والكاهن تجاهلا الشخص الجريح كي لا يتجنّسا. لكن هذا ليس له معنى، فكلّ هذه التفسيرات تُظهر الشريعة اليهوديّة بصورةٍ سلبيّةٍ. فلم يكن الكاهن ذاهبًا صعودًا إلى أورشليم، المكان الّذي يهتمّ فيه الشخص لطهارته، بل كان نازلاً إلى أريحا. والشريعة لا تمنع اللاويّ من لمس الجثث، وهناك العديد من الأسباب الأُخرى التي تبيّن أنّ طقوس الطهارة هنا ليس لها علاقة بالموضوع. يذكر المسيح الكاهن واللاويّ ليبيّن الفئة الثالثة. أن نذكر الفئتين الأوليّتين يعني بأنّ الحديث موّجه للفئة الثالثة أيضًا، على مبدأ: "الحكي إلك يا كنّة… اسمعي يا جارة". أو يُنظر عادةً إلى هذا المثل على أنّه قصّة الأقليّة المضطهدة: المهجّرون، الشاذّون،السامريّون. ولكنّهم ليسوا الأقليّة المضطهدة، بل الأعداء. ونحن نعلم هذا ليس فقط من المؤرّخ يوزيفوس، وإنّما من لوقا الإنجيليّ. في فصلٍ واحدٍ فقط قبل هذا المثل، نرى المسيح يعبر بمدينة السامرة، ولكنّهم رفضوا حسن ضيافته. علاوة على ذلك، السامرة كان لها اسم آخر: شكيم. في شكيم، اغتصب شيخها دينا ابنة يعقوب. وكان مركز أبيمالك القاتل. لذا، إذا كنّا عند البئر لحظة وصول يسوع إليه، ورأينا السامريّة، فأوّل ما يتبادر في ذهنها: "سيغتصبني. سيقتلني". ثم نُدرك: أنّ عدوّنا قد يكون أوّل شخص قد ينقذنا. وأعمق من ذلك، إذا سألنا ذواتنا ببساطة " أين السامرة اليوم؟"  مثل عمال الساعة الأخيرة: يروي لنا هذا المثل قصّة مجموعة من العمّال أتوا ليعملوا في الحقل بأوقاتٍ مختلفة من النهار، لكنّ المالك دفع لهم الأجرة ذاتها. يُقرأ هذا المثل في بعض الأحيان من نظرة مُعادية لليهود، وبالتالي فإنّ الأجير الأوّل هو "اليهوديّ" الّذي يُعيد إرسال الوثنيّ والخاطئ إلى حقل الرّب، وهذا سوء فهم آخر. لم يستقبل مستمعي يسوع هذا المثل على أنّه توجيه للخلاص إلى الحياة الأبديّة، بل قصّة تتناول حالتهم الاقتصاديّة في وقتها. درسًا عن كيفيّة مطالبة العمّال بحقوقهم. وكيف لأصحاب الأموال والموارد أن يتيقّظوا لحالة البطالة في بلادهم. لم يطرح يسوع فكرة محاربة البطالة أو مشاركة الموارد من عدم. فالمشكلة عينها كانت منذ أيام داوود الملك. ولكن، إن كنّا لا نعلم المصادر التوراتيّة والإنجيليّة، مرةٍ أخرى سنقع في سوء فهمٍ للمثل. مثل اللؤلؤة الثمينة:  يروي هذا المثل قصّة رجلٍ باع كلّ ما يملك للحصول على لؤلؤة ثمينة. عادةً ما يفسر المثل مجازيًا بأنّه يخبرنا عن مركزيّة الإيمان، أو الكنيسة، أو يسوع، أو الملكوت. ولكنّ هذا التفسير يتجاهل ما الذي تمثّله اللؤلؤة. لن نستطيع فهم روح السخرية الكامنة في هذا المثل من منظورنا اليوم، فالمثل أقرب للفكرة التالية: التاجر (بائع بالجملة) الّذي يبيعنا بالعادة ما لا نحتاجه بسعر لا نتحمّله… يبيع كلّ أمواله من أجل لؤلؤة، مهما علا ثمنها يبقى بخسًا بالنسبة للتاجر. لا يمكن للتاجر أن يأكل اللؤلؤة، ولا أن يجلس عليها، ولا أن تكسي عريه، لكنّه كان يؤمن أنّ هذه اللؤلؤة تُتمّم مشاريعه الاقتصاديّة (غايته من هذه الحياة). والسؤال ماذا لو كان المثل يتحدّانا لنحسم أمرنا تُجاه لؤلؤتنا الثمينة؟ إذا كنّا نعرف طموحنا المطلق، عندها سنصبح أقل اكتنازًا. فنحن لن نكدح من أجل أشياء صغيرة. وعلاوةً على ذلك، سنصبح قادرين على محبّة جيراننا بشكلٍ أفضل، لأنّنا سنعلم ما هو الأكثر أهميّة بالنسبة لهم. إنّ أمثال يسوع تستفّزنا، لأنّها تخبرنا بطريقةٍ ما، ما نعلمه مسبقًا بأنّه صحيح، ولكن لا نريد أن نعرفه. والسؤال الأخير: ماذا لو كنت غير مسيحيّ؟ ألا أجد معاني عميقة في هذه الأمثال؟ إذا كان الغريب تحرّكه أمثال يسوع لهذه الدرجة، فكم بالحريّ الأشخاص الذين يسبّحونه إلهًا ومخلّصًا؟ |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 8273 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
معنى الصوم  بقلم الأب رامي الياس اليسوعيّ مقدمة تاريخية: الصوم الكبير هو زمن توبة بالنسبة لنا المسيحيّين. مدّته 48 يوم ابتداءً من أثنين الرماد وحتى يوم الفصح. فكرة إقامة الصوم الكبير أُوحي بها للكنيسة انطلاقًا من فكرتين أساسيّتين: * ممارسة التوبة. * تقليد صوم المسيح خلال أربعين يومًا في البرية قبل بدء حياته العلنيّة. فكرة جعل الصوم إلزامي تعود إلى القرن الثالث ميلاديّ وهذه الفترة الطوية كانت قصيرة في البداية ثم أصبحت 10 أسابيع بالنسبة للكنيسة اللاتينيّة و 7 أسابيع بالنسبة للكنيسة اليونانيّة. في البداية كان الصوم يكمن في اتخاذ وجبة طعام واحدة في اليوم، وكانت تؤخذ في المساء بعد غروب الشمس. في القرن السادس أُضيفت وجبة ثانية خفيفة. في كلا الأحوال منذ البداية كانت فكرة الصوم موجّهة باتجاه الفصح والقيامة، جوهر وأساس الحياة المسيحيّة. فالمسيحيّون كانوا يعيّدون ويعيشون ذكرى معموديّتهم بمشاركتهم في صلوات وقداس ليلة الفصح حيث كانت تجري العمادات. فصلواتهم لأجل من سيعمّدون ومساندتهم لهم في مراحل التجارب كانت تُذكّرهم بالمراحل التي خاضوها قبل العماد والمتطلّبات الناتجة عنها. الكتاب المقدّس بشكل عام الكتاب المقدّس يقدّم لنا الصوم على أنّه أفضل وسيلة للاعتراف بسموّ الله، كما أنّه يجعل من الصوم والصلاة مع الصدقة إحدى الوسائل التي تُبيّن أمام الله تواضع ورجاء وحبّ الإنسان. ففي العهد القديم، الصوم المصحوب دائمًا بالصلاة، يعبّر عن تواضع الإنسان أمام الله. فالصوم هو نوع من إزلال النفس (أح 16). بالصوم نعود إلى الله في موقف التبعية والخضوع وذلك قبل القدوم على عمل صعب، أو لطلب الغفران عن خطيئة ما ارتكبتها، أو لطلب شفاء ما، أو بعد مصيبة كبيرة، أو لطلب الانفتاح على النور الإلهيّ، أو لطلب النعمة الكفيلة بإتمام مهمّة ما (أع 12)، أو التحضير لملاقاة الله (خر 34، 28). الأسباب متعدّدة والدوافع أيضًا، لكن في كلا الأحوال الهدف هو واحد: أن أكون متواضعًا أمام الله وبموقف إيمانيّ وذلك لاستقبال عمل الله ولكي أضع نفسي في حضوره. هذه الفكرة أو النيّة، تلمّح وتعبّر عن معنى الأربعين يومًا التي قضاها موسى بدون طعام (خر 34)، وإيليا أيضًا (3 مل 19، 8). أمّا فيما يخصّ الأربعين يوم التي قضاها يسوع في البريّة، لم يكن هدفها الانفتاح على الروح، بما أنّه مملوء منه: قاده الروح إلى البريّة ودفعه للصوم حتى يدشّن حياته العلنيّة، المسيحانيّة بعمل استسلام وثقة بالله أبيه، وبالتالي يُثبّت على أنّه ابن الله فعلًا (متى 4، 1 - 4). في العهد القديم عُرف الصوم الكبير على أنّه يوم المغفرة، وكانت ممارسته شرطًا للانتساب إلى شعب الله. وكان هناك بعض الملتزمين يصومون خارج هذا الصوم الكبير. مثلًا، كان تلاميذ يوحنا المعمدان يصومون مرّتين في الأسبوع وذلك لتحقيق أحد عناصر العدالة المُحدّدة لدى الأنبياء (لو 18، 12). فإذا كان المسيح لم يعطِ قوانين محدّدة لممارسة الصوم، فذلك لأنّه أتى ليكمّل الصوم، وقد دعا إلى تجاوز هذه العدالة: «لا تظنّوا أني جئت لأحلّ الناموس والأنبياء، لم آتي لأحلّ لكن لأتمّم. إنّي أقول لكم، إن لم يزد برّكم على برّ الكتبة والفريسيّين فلن تدخلوا ملكوت السماوات» (متى 5). فالمسيح يركّز أكثر على عدم التعلّق بالأرضيّات والغنى (متى 19)، وخاصة على التخلي عن الذات لحمل الصليب (متى 10). يدعو المسيح إلى ممارسة الصوم بكثير من «الحشمة»، معروف من قبل الله، هذا الصوم يصبح التعبير الأفضل عن الرجاء بالله، صوم متواضع يفتح القلب على العدالة الداخليّة، على عمل الله الذي يرى ويعمل في الخفية (متى 6). أعمال الرسل يسرد لنا بعض الممارسات الدينيّة الطقسيّة والتي تتضمّن الصوم والصلاة معًا (أع 13، 14). بولس الرسول كان يصوم بمناسبات عدّة (2 قور 6، 11). والكنيسة، إذا حافظت على هذا التقليد، رغبة منها بالحفاظ على أبنائها في موقف انفتاح كامل على نعمة الله بانتظار عودة المسيح الثانية، فالصوم الحقيقيّ هو إذن صوم الإيمان، الحرمان من رؤية الحبيب، والبحث عنه باستمرار. بانتظار عودة العريس إلينا، الصوم من أجل التوبة له مكانته وأهميّته في الكنيسة «هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم؟ فما دان العريس معهم لا يستطيعوا أن يصوموا، ولكن تأتي أيّام يُرفع العريس من بينهم حينئذ يصومون» (مر 2). المسيح والصوم  لقد ربط المسيح كلّ من الصلاة والصدقة بالصوم، واعتبرهم من الأمور الهامّة بالنسبة للحياة الروحيّة (متى 6). لكنّه طلب ممارستها بكثير من «الحشمة» والتحفّظ وخاصة بدون انتظار مقابل وبدون حسبان. فقبل أن نفهم بشكلٍ عميق العلاقة بين الصوم والصلاة والصدقة، يجب علينا أن نفهم معنى وأبعاد الصوم. سأقوم بذلك على ضوء تجربة المسيح في البرية. الروح القدس الذي نزل على يسوع ساعة عماده وأعلنه ابن الله: «هذا هو ابني الحبيب الذي عنه رضيت»، هذا الروح هو الذي قاد يسوع إلى البريّة ليجرّبه إبليس. هذا يعني أن محتوى التجربة هو إثبات يسوع بأنّه بالفعل هو ابن الله. كلّ تجربة يبدأها المجرّب بعبارة «إن كنت ابن الله». وبالتالي يمكننا القول بأنّنا نواجه التجارب الثلاث التي عاشها يسوع. فالتجربة والخطيئة تتواجدان في كلّ مرّة نحاول فيها الاقتراب من الله والاتحاد معه، والعيش كأبناء له. لذلك نرى أنّ أعمال الشيطان وحضور الروح القدس يتواجدان في البريّة مع يسوع إذ أنّ الروح يريد أن يُثبّت بأنّ يسوع هو المسيح ابن الله، والمجرّب يريد الاستفادة من هذه الفرصة لكي يستغلّها لحسابه ومصلحته. (الصوم والقيامة). هناك توازي مهمّ جدًا بين تجربة يسوع في البريّة وما عاشه شعب العهد القديم في الصحراء وصلاة الأبانا (نحن). هذا التوازي يسمح لنا بأن نفهم بأنّ هدف الصوم في النهاية هو أن نعيش كأبناء لله. عاش يسوع التجارب الثلاث التي تعرّض لها شعب العهد القديم، إنّما الفارق هو أنّ يسوع لم يقع في التجربة، لم يستسلم لها وانتصر على المجرّب، على التجربة وعلى الخطيئة. في العهد القديم عندما جاع الشعب في الصحراء، أعطاه الله المنّ طالبًا إليه عدم الاحتفاظ به، وأنّه سيعطيه هذا المنّ كلّ يوم بيومه لأنّ الله لا يتخلّى عن شعبه. لكنّ الشعب وقع في التجربة وراح يخزّن المنّ خوفًا وضمانًا، بينما في البريّة يجيب يسوع المجرّب الذي يسأله: «إن كنت ابن الله فحوّل هذه الحجارة إلى خبز» قائلًا: «ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكلّ كلمة تخرج من فم الله». هذا يعني أنّ يسوع الابن، وهذا ما يميّز موقف الابن «طوبى للفقراء بالروح فإن لهم ملكوت السماوات»، يعيش الله الآب على أنّه مصدر حياته هو لكونه الابن. هذا يعني أيضًا أنّ الله الآب وحده قادر على اشباع الإنسان، وأنّ الجزع الماديّ هو مجرّد صورة عن الجوع الحقيقيّ والجوهريّ، الجوع إلى كلمة الله وحضوره في حياة الإنسان « تأتي أيام يُرفع العريس من بينهم حينئذ يصومون». والوقوع في هذه التجربة يعود للقول بأنّ يسوع فضّل وتمسّك بالصورة هو الذي يملك الواقع والأهمّ: الإنسان خُلق ليصبح على صورة الله، والمسيح يرفض أن يصنع من الله صورة الإنسان، ونحن بدورنا مدعوّين إلى تحقيق ذلك وبالتالي عندما نصلّي نقول: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، خبزنا الجوهريّ كفاف يومنا. أثناء مسيرته في الصحراء شكّ الشعب بأمانة الله فجرّبه: «لماذا أصعدتنا من مصر؟ ألِتقتلني أنا وبنيّ ومواشيّ بالعطش؟». وكان جواب موسى: لماذا تجرّبون الربّ؟ والمسيح بدوره يجيب المجرّب: لا تجربنّ الربّ إلهك. خصوصًا أنّ المجرب استعمل المزمور 91: «يوصي ملائكته بك فيحملونك على أيديهم لكي لا تصطدم رجلك بحجر». جواب يسوع للمجرّب يعني أنّ يسوع هو حقًا ابن الله وليس هو بصدد أن يلعب دور الابن كما يريده المجرّب. وفي صلاة الأبانا نقول لا تدخلنا في التجربة، أي لا تسمح بأن نقع، نستسلم للتجربة. في تجربته الثالثة صنع شعب العهد القديم عجلًا من ذهب وعبده وقدموا له الذبائح. والمجرّب يعرض على يسوع أن يعطيه جميع ممالك الأرض ومجدها شرط أن يسجد له. ويسوع يجيب: «للربّ وحده تسجد وإياه وحده تعبد». وفي صلاة الأبانا نقول: «ليتقدّس اسمك، ليأت ملكوتك». يسوع يبقى إذن أمينًا للآب ولرسالته، رسالة الابن. لم يتخلّى عن الواقع من أجل الصورة، ولا عن ملكوت السماوات من أجل ملكوت أرضي. فعمله الخلاصيّ يمرّ في الواقع من خلال الواقع الإنسانيّ: آلام وموت بدل المجد والعظمة. فابن الله هو حقًا إنسان ويسوع لا يريد الهروب من هذا الواقع. لا يريد الهروب من الحقيقة. لذلك لدى خروجه منتصرًا على التجربة، آنذاك فقط أتت الملائكة لتخدمه. نحن والصوم  يبقى السؤال: ما علاقة الصوم بذلك كله؟ أو كيف نفهم الصوم على ضوء خبرة وتجربة يسوع في البريّة؟ لكي نفهم جيدًا ما حدث في البريّة بين يسوع والمجرّب حيث عرض هذا الأخير على يسوع أن يحوّل الحجارة إلى أرغفة، وأن يلقي بنفسه من أعلى الهيكل، وأن يصبح ملك ذو سلطة على العالم أجمع. لكي نفهم ما حدث علينا أن لا ننسى أنّه على الصليب تتمّ السخرية من يسوع «أنقذ نفسك... انزل من على الصليب». لكن نهاية المطاف هي القيامة حيث يعلن الملاك بأنّ المسيح سبق تلاميذه إلى الجليل. ففي فترة الصوم، كزمن تحضير للقيامة نعيش كل هذه التجارب مع الصلب من خلال الأناجيل التي نقرأها في هذه الفترة. فالمعركة التي خاضها يسوع ويدعونا على خطاه تكمن في: * رفض علاقاتنا المزيّفة، والمشوّهة مع الله: ارم بنفسك من أعلى الهيكل. * رفض علاقاتنا المزيّفة والمشوّهة مع الآخرين، التسلّط على العالم. * رفض علاقاتنا المزيّفة والمشوّهة مع ذاتنا: أن نتغذى من حجارة تحوّلت إلى خبز. إذن نحن مدعوّين لنعيش فعليًّا كأبناء لله، كأحبّاء الله. ولنخوض هذه المعركة، لدينا ثلاثة أسلحة، إن صحّ التعبير، ثلاثة وسائل تسمح لنا بالخروج منها منتصرين: الصوم والصلاة والصدقة. يسوع الذي عاش وحقّق ذاته كأبن لله وذلك من البريّة حتى ساعة التخلّي الكبرى ساعة الصليب، إذ أنّه: استقبل ذاته من أبيه، ولذلك يصوم. يلتفت إلى أبيه فيصلّي، يلتفت إلى أبيه وإلى الآخرين فيعطي (الصدقة). فالصلاة ليست مجرّد ترداد بعض الصلوات، والصوم ليس فقط الامتناع عن الأكل، والصدقة ليست مجرّد عطاء ماديّ للآخر. بل هذا كله يعود للقول بأن أعيش علاقة حقيقيّة مع الله ومع الآخر ومع ذاتي. فالصوم إذن لا يكمن فقط في الامتناع عن الأكل أو عن بعض الرغبات. هذه الأمور تبقى تعبير رمزيّ لما هو أعمق وأكثر جوهريّة، إنّها تدعنا نقول بأنّ الله هو الوحيد الذي يستطيع أن يعطينا الخبز الحقيقيّ، الجوهريّ، أو بمعنى آخر هي تعبير على أنّني أُسلّم ذاتي لله واستقبلها منه، أنني ابن الله وليس لي إله غيره. وهذا الأمر يُعبّر عنه بطريقة إيجابيّة: أن أفتح عينيّ وأذنيّ حتى أنظر فعلًا لما يحدث من حولي حتى أستطيع أن أرى وأسمع المحتاج: «الحقّ، الحقّ أقول لكم، كلّما فعلتم بأحد أخوتي هؤلاء الصغار فلي أنا فعلتموه». فالخطيئة لا تكمن فقط في العمل السيّء والمؤذي، بل هي جوهريًا عندما لا أسعى للقيام بالخير، بمدّ يديّ لمن هو بحاجة إليّ، أن أكتفي بذاتي «الحيط، الحيط ويا ربّي السترة»، كما نقول باللغة العاميّة. مساعدة الآخر، هي صدقة، وليس فقط العطاء الماديّ، الصدقة هي أن أصغي للآخر، أن أكون حاضرًا له بالفعل، أن أعيش علاقات حقيقيّة، على مثال المسيح الذي ذهب إلى عطاء ذاته حبًّا بنا. فالصوم هو أولًا أن أقوم بأمور إيجابية، أن أعيد علاقاتي بشكل حقيقي، وبهذه الطريقة أعيش كابن لله. الصوم هو أخيرًا أن أفرّغ ذاتي من كلّ ما يحجبني عن الله والآخر وذاتي، لكي أستطيع انتظار العريس الآتي والقائم من بين الأموات، ولذلك ارتبط الصوم بالقيامة في الكنيسة. فالصوم أخيرًا هو مسيرة تحرّر وموت عن الذات، لكي أستطيع عيش القيامة. إذا كان يسوع قد عاش كلّ ذلك في صميم حياته اليوميّة، فكم بالأحرى نحن، علينا أن نعيشها واقعيًا. ولكن هذا غير ممكن بدون الصلاة. فبالصلاة أستقبل ذاتي من الله ولكن بالأخصّ أستمدّ منه العون والقوّة. بالصلاة أكتشف ذاتي وضعفي ممّا يسمح لي بالانطلاق بشكلٍ صحيح وحقيقيّ باتجاه ذاتي والآخرين. الصوم والصلاة والصدقة يشكّلون معًا التوبة الحقيقيّة التي تكمن في الاعتراف بابتعادي عن الله والعودة إلى «حظيرة خرافه». فالصوم بدون التوبة لا معنى له ولا فائدة. بالصوم والصلاة والصدقة أموت عن ذاتي (أعيش معموديتي) لأقوم مع القائم من بين الأموات. لذلك مرحلة الصوم هي مرحلة فرح، فرح قدوم العريس، فرح الاكتشاف بأنّنا أبناء الله. بالمعموديّة أصبحنا أبناء الله، وروحه يسكن فينا لكي يساعدنا للعودة إليه وإلى أخوتنا البشر. فإذا كنّا ننادي الله أبانا، فهذا يعني أنّنا أخوة. ولكي نستطيع القول بأنّنا اخترنا المسيح وأنّنا حقًا أبناء الله، علينا أن نتحقّق من ذلك في واقعنا اليوميّ. علينا أن نتحقّق فعليًا بأنّنا أحرار وحقيقيّين. فالصوم إذن هو فترة فرح حيث نكتشف بنوّتنا لله، وهذا يقودنا بالضرورة إلى المحنة والتجربة، يقودنا إلى البريّة. لذلك لا بدّ من التخلّي عن الحزن لأنّه لا يأتي من الله، لا بل هو دلالة غيابه من حياتنا. في هذه الفترة نكتشف إلى أي حدّ نعمل ونتصرّف انطلاقًا من أحكام مسبقة، وأنّنا نضع الله في أفكار جامدة، وأنّنا نقف أمامه في موقف العبد بدلًا من الابن. فلنقف بشجاعة، شجاعة الأبناء ونعيش بالفعل كأخوة وكأبناء. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 8274 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
رسالة التطويبات  بقلم الأب سمير بشارة اليسوعيّ مقدمة ليس من السهل على الإنسان أن يعيش في عالم مخضوض بالصراعات السياسيّة والاجتماعيّة والدينيّة خاصةً...كم هي عديدة التعزيات التي يقدّمها مجتمعنا، وكم هي عديدة أيضاً الانقباضات! يتبيّن لنا أنّ السعداء اليوم، كما البارحة، هما الأغنياء والأقوياء والجالسين على العروش... فهل من وصفة سحريّة للسعادة؟ وهل يكفي، لنعيش سعداء، أن... ربّما أن نقرا الكتاب المقدس! يتمّ التعريف عادةً، في الكتاب المقدّس عن الأفراح والأتراح عبر كتالوجات أو لوائح محدّدة.  كان العهد القديم يتلو بصوت عال وعلى الجبل (جبل جرازيم وعيبال) لائحة رسميّة باللع نات (راجع تث 12)، بينما الإنجيل لن يتردّد أن يتلو بصوت عال وعلى الجبل أيضاً لائحة رسميّة التطويبات. وينتهي العهد القديم مع سفر ملاخي بلعنة علنيّة فاضحة (الفصل 6)، بينما يُفتتح العهد الجديد مع الإنجيل ببركة علنيّة ملمّحاً أنّ الشريعة، أمس، كانت محامية الموت، أمّا الانجيل، اليوم، فهو محامي الحياة. أن نكون سعداء: ربّما كان هذا هدف مجيء المسيح على الأرض... فما هي شروط السعادة؟ وإلى أي مدى رسالة التطويبات في إنجيل متى قادرة أن تعطينا جواباً واضحاً؟ سنلقي نظرة شاملة على بنية التطويبات، ومن ثمّ نعرض تحليلاً لبعض المصطلحات. متى 5: 3 - 12: 3طوبى لِفُقراءِ الرُّوح فإِنَّ لَهم مَلكوتَ السَّمَوات. 4طوبى لِلوُدَعاء فإِنَّهم يرِثونَ الأَرض. 5طوبى لِلْحزانى، فإِنَّهم يُعَزَّون. 6طوبى لِلْجياعِ والعِطاشِ إلى البِرّ فإِنَّهم يُشبَعون. 7طوبى لِلرُّحَماء، فإِنَّهم يُرْحَمون. 8طوبى لأَطهارِ القُلوب فإِنَّهم يُشاهِدونَ الله. 9طوبى لِلسَّاعينَ إلى السَّلام فإِنَّهم أَبناءَ اللهِ يُدعَون. 10طوبى لِلمُضطَهَدينَ على البِرّ فإِنَّ لَهم مَلكوتَ السَّمَوات. 11طوبى لكم، إِذا شَتَموكم واضْطَهدوكم وافْتَرَوْا علَيكم كُلَّ كَذِبٍ مِن أَجلي، 12اِفَرحوا وابْتَهِجوا: إِنَّ أَجرَكم في السَّمَواتِ عظيم، فهكذا اضْطَهدوا الأَنبِياءَ مِن قَبْلِكم“. أ - نظرة شاملة تتألّف المجموعة المدوّنة في متى 5/3-12 من تسع تطويبات، ويشير إلى ذلك تكرار المصطلح “طوبى” تسع مرّات. تُكوّن التطويبات الثمانية الأولى وحدة أدبيّة: تكرّر التطويبة الثامنة حرفياً السعادة المذكورة في التطويبة الأولى:”فإنّ لهم ملكوت السموات”. فيبيّن هذا الاحتواء مضمون المكافأة التي تدور حول “ملكوت السموات”. فما هو مفهوم هذا الملكوت؟ وما هي في الواقع شروط الدخول إليه؟ تنقسم هذه التطويبات أدبياً إلى قسمين؛ وكل قسم مؤلّف من أربع تطويبات: تذكر التطويبتان الرابعة والثامنة المصطلح ذاته: “البرّ”: سيأتي التركيز في العظة على الجبل على البِرّ الذي يطلبه يسوع من التلاميذ ليدخلوا ملكوت السموات (5/20 و6/1 و30)؛ فيشكّل البرّ إذاً الصلة ما بين العظة على الجبل والتطويبات. إنّ التطويبة التاسعة من طراز مختلف: التطويبات الأولى مختصرة أما هذه فهي موسّعة. التطويبات الأولى في صيغة الغائب (بُعد الشموليّة) أما هذه فهي في صيغة المخاطب (أنتم) وهي موجهة مباشرةً إلى التلاميذ. التطويبة التاسعة إمتداد واضح للسلسلة السابقة إذ تخصّ، كما التطويبة الثامنة، أناس سيعانون الاضطهادات؛ وبتوجيهها إلى التلاميذ مباشرةً تُكَوّن مدخلاً إلى القسم الثاني من العظة على الجبل. نحن إذاً أمام مجموعة من ثماني تطويبات تنقسم إلى مقطعين؛ ثمّ هناك تطويبة تاسعة تمهّد للوصايا المقبلة والتي توضّح الدور الذي سيقوم به التلاميذ أمام العالم (مثل دور الملح في الأرض والنور في العالم،...). ب- تحليل تتبع التطويبات هيكليّة أدبيّة واضحة: منادى“طوبى”؛ يليه“هويّة” الأشخاص الذين ينالون التطويبة؛ ومن ثمّ ذكر “السعادة” أو المكافأة الموعود بها. 1- طوبى (makarioi) تعني عبارة “طوبى” تهنئة وبركة في آن واحد وتضمّ الاعتراف بحالة سعادة تتحقّق أوعلى قيد التحقيق. ويرد المصطلح “طوبى” بإنجيل متى في أربع مراجع أساسيّة: 1- ...الموتى يقومون والفقراء يبشَّرون، وطوبى لمن لا أكون له حجر عثرة (11/6). إنّ الإطار هو شهادة يسوع أمام تلاميذ يوحنا المعمدان: والتطويبة مرتبطة بـجذريّة الرسالة التي ترافق افتتاح الملكوت من قبل يسوع (وعدم تعطيل هذه الشهادة). 2- طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع (13/16). إنّ الإطار هو اعتلان يسوع أسرار الملكوت: والتطويبة مرتبطة برجاء الأنبياء والصديقين لمشاهدة المسيح: “إِنَّ كثيراً مِنَ الأَنبِياءِ والصِدِّيقينَ تَمَنَّوا أَن يَرَوا ما تُبصِرونَ فلَم يَرَوا، وأَن يَسمَعوا ما تَسمَعونَ فلَم يَسمَعوا”(13/17). 3- طوبى لك يا سمعان بن يونا... (16/17). إنّ الإطار هو شهادة إيمان بطرس: والتطويبة مرتبطة بالكشف عن هوية يسوع الحميمة: “أَنتَ المسيحُ ابنُ اللهِ الحَيّ”(16/16). 4 - طوبى لذلك الخادم الذي إذا جاء سيّده...(24/46). إنّ الإطار هومثل الوكيل الأمين: والتطويبة مرتبطة بعلامات الأزمنة التي سترافق مجيء إبن الإنسان (24/44). نلاحظ أنّ المصطلح “طوبى”مرتبط في إنجيل متى وبشكل واضح بشخص المسيح، والكشف عن هويّته ورسالته، وفي الإطار ذاته: تدشين ملكوت السموات. 2- هويّة الأشخاص الذين ينالون التطويبة ترتبط السعادة أو المكافأة الموعود بها١بهويّة الأشخاص الذين ينالون التطويبة. وعدّة مصطلحات تكشف عن هذه الهويّة :فقراء – حزانى – ودعاء - جياع وعطاش – رحماء - أطهار – فاعلوا السلام - مضطهَدون. فقراء (ptokhoi) يرد المصطلح “فقراء” ثلاث مرات في إنجيل متى: - “إذهبوا فأخبروا يوحنا...: الموتى يقومون والفقراء يبشّرون”(11/3؛ الإطار: يسوع يعلن بشارة الملكوت). إنّ "تبشير الفقراء" هو دليل واضح للكشف عن هويّة يسوع؛ راجع في هذا الإطار سؤال تلاميذ يوحنا المعمدان ليسوع: “أأنتَ الآتي؟...”(11/3)، فيأتي حواب يسوع علناً: “إذهبوا فأخبروا... الفقراء يبشّرون...”؛ كما هوشرط أساسي لإعلان بشارة الملكوت (11/2-6). من جهّة أخرى، يحرّم المسيح من الطوبى من لا يسعى معه إلى تبشير الفقراء: “...الفقراء يبشّرون، وطوبى لمن لا أكون له حجر عثرة” (6/11). يُشار بوضوح من خلال هذا “الحرمان” كم المسيح مُعنى بالفقراء لدرجة أنّ كلّ من يعارضهم أو يتصدّاهم يكون بمثابة عدوّ له ولرسالته. - “أعطِ أموالك للفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال فاتبعني”(19/21؛ الإطار: دعوة الشاب الغني). يوضّح هنا يسوع أنّ إغاثة الفقراء هي سبيل لنيل الكمال: “إذا أردت أن تكون كاملاً، فاذهب وبع...” (19/21)، كما أنّها شرط أساسي للتتلمذ للمسيح؛ ومن لا يسعى إلى هكذا تخلّي يبقى حزيناً (عدم الطوبى): “انصرف حزيناً لأنّه كان ذا مال كثير”(19/22). يبرز هذا الحدث تمثّل المسيح بشخص الفقير، بحيث أنّ الذي لا يتخلّى عن كلّ شيء ويفتقر مثله لا يستطيع أن يكون له تلميذاً. - “الفقراءعندكم دائماً أبداً، وأما أنا فلست عندكم دائماً أبداً”(11/26؛ الإطار: دهن يسوع بالطيب). الفقراء - عندكم - دائماً أبداً // أنا - لست عندكم - دائماً أبداً يُبرز التوازي القائم بين شطرَي هذه الآية أنّ يسوع بمثابة فقير يحقّ له الإكرام. ويرتبط هذا الإكرام بالإشارة إلى موته ودفنه. كما يُعتبَر هذا الإكرام “بشارة” (أي مساهمة في تدشين الملكوت: “الحقّ أقول لكم: حيثما تُعلَن هذه البشارة في العالم كلّه، يُحدَّث بما صنعت إحياءً لذكرها” (13/26). تعبّر هذه المراجع الثلاثة بوضوح عن رغبة يسوع في تماثله بالفقراء، وعن جذريّة ارتباط مصيره بمصيرهم. إنّ كلمة “فقراء” مقترنة في هذه التطويبة بكلمة أخرى: “الروح”... يرد المصطلح "روح" – بالمعنى “البشري” – مرّة واحدة في إنجيل متى: “إسهروا وصلّوا لئلاّ تدخلوا في التجربة. الروح مندفع وأمّا الجسد فضعيف”(26/41). إنّ الإطار هو صلاة يسوع في بستان الزيتون)؛ ويطلب يسوع من التلاميذ أن يمكثوا معه ثابتين في السهر والصلاة: “أمكثوا هنا واسهروا معي” (26/38). إنّ “اندفاع الروح” عليه أن يُلزِم التلاميذ على مرافقة المسيح في ساعة التخلّي هذه، التخلّي عن مشيئته الشخصيّة: “فلتبتعد عنّي هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أشاء، بل كما أنت تشاء”(26/39). يتّضح لنا من خلال هذه المراجع الثلاثة أنّ الفقر الروحي يكمن في الاستعداد الجذري للتتلمذ للمسيح، في السهر والصلاة، والتخلّي عن المشيئة الشخصيّة لكي، على غرار المعلّم، الفقير الأول، نسعى بتواضع الى تحقيق مشيئة الآب. حزانى (penthountes) - “أيستطيع أهل العرس أن يحزَنوا ما دام العريس بينهم؟” (9/15). يرد المصطلح “حزن”مرّة واحدة في إنجيل متى، في إطار جدال يسوع مع تلاميذ يوحنا حول مسألة الصوم. جواب يسوع واضح: ما يسبّب الحزن هوغياب العريس (موته ورفعه). ويتّضح مفهوم الحزن هذا، إذ يأتي الفعل“حزن” في تواز مباشر مع فعل “صام” (أي “إمتنع”): “لكِن سَتَأتي أَيَّامٌ فيها يُرفَعْ العَريسُ مِن بَيْنِهم، فَحينَئذٍ يَصومون”(9/15). يكمن الحزن إذاً في حالة الغياب عن أو الامتناع: وهو الغياب "عن الأكل" في الصوم – والغياب عن الحبيب عند ساعة الموت. تشير التطويبة“طوبى للحزانى” في هكذا إطار الى وضع المؤمن الذي يفتقد إلى الحبيب ويتوق إليه دائماً؛ ولم يزل حزيناً ما دام الحبيب غائباً. نستنتج أنّ الحزن هنا ليس بالضرورة شعوراً سلبيّاً لكن حركة داخليّة تمتاز بالبحث عن الحبيب والسعي المستمرّ الى الالتقاء به. ودعاء (praés)  - “احملوا نيري وتتلمذوا لي فإني وديع متواضع القلب” (11/29)؛ - “هوذا ملككِ آتياً إليكِ وديعاً راكباً على أتان... (21/5)؛ ترتبط الوداعة في هذين المرجعَين "بدراما الآلام": يشير الإطار الأول إلى ضرورة حمل النير، والإطار الثاني الى دخول المسيح أورشليم؛ ويتّضح هنا مفهوم الوداعة: إنّها تعزية للمتعبين والمرهقين وتفترض تواضعاً وانحناء قلب (11/28 -30)، كما عليها أن تنفي حبّ الظهور والصدارة (راكباً على آتان...) وأن تتقبل إهانة الصليب وذلّه. جياع وعطاش (peinontes-dipsontes) يرد فعل جاع أربع مراّت في الإنجيل وفعل عطش مرّة واحدة؛ والملفت أنّ يسوع هو المعنى دائماً في هذه المراجع: - “فصامَ أَربَعينَ يوماً وأَربَعينَ لَيلةً حتَّى جاع” (3/2؛ تجربة يسوع في البرّية). - “في ذلك الوَقْتِ مَرَّ يسوعُ في السَّبْتِ مِن بَينِ الزُّروع، فجاعَ...” (12/1؛ أكل السنابل يوم السبت). - “وبينَما هو راجعٌ إلى المَدينَةِ عِندَ الفَجْر، أَحَسَّ بِالجوع”(21/18؛ يسوع يلعن التينة). - ”لأَنِّي جُعتُ فأَطعَمتُموني، وعَطِشتُ فسَقَيتُموني، وكُنتُ غَريباً فآويتُموني”(25/35؛ مثل الدينونة الكبرى). يتبيّن لنا، من خلال إطار كلّ حدث، أنّ لجوع المسيح وعطشه مفهوماً واضحاً: في الإطار الأول (تجربة يسوع في البريّة)، إنّه الجوع لكلمة الله: “مكتوبٌ: ليسَ بِالخُبزِ وَحدَه يَحيْا الإِنْسان بل بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخرُجُ مِن فَمِ الله”(3/4). وفي الإطار الثاني (أكل السنابل يوم السبت)، إنّه الجوع لكي تكون الشريعة في خدمة الإنسان: “ولو فَهِمتُم مَعنى هذهِ الآية: إِنَّما أُريدُ الرَّحمَةَ لا الذَّبيحة، لَما حَكَمتُم على مَن لا ذَنْبَ علَيهِم. فَابنُ الإِنسانِ سَيِّدُ السَّبْت” (12/7). وفي الإطار الثالث (لعن التينة)، إنّه الجوع لنمو الإيمان عند التلاميذ: “فأَجابَهم يسوع: الحَقَّ أَقولُ لكم: إِن كانَ لَكم إِيمانٌ ولم تَشُكُّوا، لا تَفعَلونَ ما فَعَلتُ بِالتِّينَةِ فَحَسْبُ، بل كُنتُم إِذا قُلتُم لهذا الجَبل: قُمْ فاهبِطْ في البَحر، يَكونُ ذلك. فَكُلُّ شَيءٍ تَطلُبونَه وَأَنتُم تُصَلُّونَ بِإِيمانٍ تَنالونَه“ (21/21-22). وفي الإطار الرابع والأخير (مثل الدينونة الكبرى)، إنّه الجوع والعطش لعمل الخير تجاه كلّ إنسان: “الحَقَّ أَقولُ لَكم: كُلَّما صَنعتُم شَيئاً مِن ذلك لِواحِدٍ مِن إِخوتي هؤُلاءِ الصِّغار، فلي قد صَنَعتُموه” (25/40). طوبى للجياع والعطاش إلى... البرّ: يتّخذ البرّ في ضوء ما سبق مفهوماً واضحاً: يرتكز البرّ على تعزيز كلمة الله في حياة الإنسان، وتنشيط إيمانه، والسعي إلى عيش فضيلة المحبّة والخدمة جاعلاً الشريعة للإنسان ولا الإنسان للشريعة... رحماء (eleémones) ترد كلمة “رحمة” في ثمان مراجع كلّها خاصة بيسوع (مصدر وفعل)٢. ويتبيّن لنا أنّ رحمة يسوع موجّهة دائماً إلى فئتَين من الناس: المرضَى والخطأة. وليست هذه الرحمة نظريّة لكن فعّالة وعمليّة، وهي مبنيّة على واقع“الشفاء”: الشفاء من المرض الخارجي (عمى وشلل، إلخ...)، ومن المرض الداخلي: الخطيئة. أطهار (katharoi) - “فأخذ يوسف الجثمان ولفّه في كتّان طاهر”(27/59). من الملفت أن المصطلح “طاهر” لا يرد إلا هنا في الإنجيل، في إطار دفن يسوع٢. يفيد النصّ أنّ يوسف الرامي طلب من بيلاطس الجثمان ليدفنه، وكان يوسف الرامي قد تتلمذ أيضاً ليسوع (27/57). كما يوضّح أنّه وضع الجثمان في قبر جديد (27/60). تحيط بدفن يسوع بعض المؤشّرات: يُعنى بالكتّان الطاهر أنّه لم يستخدَم سابقاً: وهذا يعني أنّه خال من كلّ دنس ناتج عن اللمس أو الإتصال بجسد آخر. كذلك الإشارة الى القبر الجديد: يقول الإنجيلي إنّ يوسف الرامي حفره هو نفسه، ملمّحاً أنّه صنعه له. لم يكن للمسيح منزلاً خاصاً في حياته، ولن يكن له قبراً خاصاً في موته. يملك الإنسان عادةً في مفهوم العهد القديم شيئَين: خطاياه وقبره؛ فالقبر هو إرث الخاطئ (اي 24/19): لم يكن للمسيح قبراً لأنّ لم يكن له خطايا – كونه طاهراً في قلبه وجسده. قد تشير طهارة القلب في هذا الإطار المحدّد الى الامتناع عن الخطيئة وعدم الاحتكاك بها: هي طهارة تعتمد الزهد والتجرّد (إشارةً إلى ما سبق) والابتعاد الجذري عن كلّ أمر مدنِّس للقلب. فاعلوا السلام (eirenopoioi)  - - “وقد حقّق السلام بدم صليبه” (قول1/20). إنّ المصطلح “فاعل السلام” لا يرد إلا مرّة واحدة في العهد الجديد: في الرسالة الى أهل قولسي؛ هل قرأ متى هذه الرسالة؟ ... ينبغي علينا أن نوضّح هذا المصطلح في ضوء هذا المرجع الوحيد. إنّ الإطار الذي يرد فيه “فاعل السلام” هو إطار "المصالحة": مصالحة جميع البشر مع الله: “فقَد حَسُنَ لَدى الله أَن يَحِلَّ بِه الكَمالُ كُلُّه. وأَن يُصالِحَ بِه ومِن أَجلِه كُلَّ موجود مِمَّا في الأَرْضِ ومِمَّا في السَّمَوات وقَد حَقَّقَ السَّلامَ بِدَمِ صَليبِه” (قول1/19-20). ولا يمكن أن تتمّ هذه المصالحة إلاّ بذبيحة دم المسيج على الصليب. تأخذ التطويبة هذه بعداً دراماتيكيّاً، إذ يتّضح لنا أنّ القيام بفعل السلام يقتضي بذل ذات وتضحية تامّة: تضحية قد تقود المؤمن الى الاستشهاد، من أجل مصالحة البشرمع الله. مضطهدون (dediogmenoi) - “أَحِبُّوا أَعداءَكم وصَلُّوا مِن أَجلِ مُضطَهِديكُم، لِتَصيروا بني أَبيكُمُ الَّذي في السَّمَوات”(5/44-45). يرد هذا المصطلح في خطبة يسوع على الجبل٤. ويتّضح فيها أنّ محبّة الأعداء والصلاة من أجل المضطهِدين هما باباً للدخول في الشركة الإلهيّة: ففي الاضطهاد ينال المؤمنون "البنوّة الإلهيّة". تدخلنا هذه التطويبة في سرّ ”أخوّة يسوع”: نصبح في الواقع إخوة يسوع بقدر ما نتضامن معه في تحمّل نير الاضطهاد ومحبّة الأعداء: وهو إضطهاد يقود الى الكمال: "...فكونوا أَنتُم كامِلين، كما أَنَّ أَباكُمُ السَّماويَّ كامِل"(5/48). خاتمة لاحظنا من خلال قراءتنا للتطويبات أنّها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برسالة المسيح الشخصيّة. وكأنّها "تتدفّق من جنبه المطعون" ... فهي رسالة تعانق دراما الصليب كما أشارت إلى ذلك معظم المراجع. وهي تجتاز "برّية ملتهبة"، من "صحراء" التجارب إلى "صحراء" القبر الفارغ. وهي رسالة مدوّنة بإنسانيّة المسيح، والتي تشكّل النافذة أو الباب الضيّق لدخول ملكوت السموات. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 8275 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
إن لم تكن فيّ المحبة فلست بشيء  بقلم نيكول كاريه نقله للعربية الأخ ميشيل داود والأب غسان السهوي اليسوعيان ماذا لو لم أحب أو أُحَب؟ وهل الفرق بين الاثنين كبير جداً؟ عندما لا أشعر بحبٍّ تجاه أحد، أو يتصحَّر قلبي وينطوي على ذاته، عندها أنا لست بشيء لأنني غائب عن العالم، والعالم غائب بالنسبة لي. فإن لم أشعر بأنني محبوبٌ فما أنا بشيء، لأني وحيد في هذا العالم. فما من أحدٍ يمكنه أن يحيا بذاته ولأجلها (رو 14: 7). ما من أحد يُختَزَل بذاته، سواء أكان متزوجاً أم لا، حسب ظروف حياته أو في علاقته بإلهه الذي يؤمن به؛ إنه والحق يُقال: لا أحد يوجد بدون الآخرين.  فبدون الرغبة في الانجذاب، أتُراني أخرج من ذاتي؟ أفلا أُحسب عندها في عداد الأموات! فالرغبة هي الحياة التي تتفتّح؛ والله بذاته هو رغبة. لوحدي، أنا لست مكتملاً، ولكن أتراني عندها أكون لا شيء؟ "أأكون وحشاً يا ترى، طالما أنه ما من أحدٍ على الإطلاق يقول لي: أحبّك؟" هذا ما قالته بتوجع امرأة في الأربعين من عمرها؛ فعلى الرغم من علمها بأنها كانت تروق لكثيرين لم يكن ذلك يرضيها، لأنها كانت ترغب بكل جوارحها أن تكون "شخصاً" لأجل شخصٍ آخر. فالحب يقول: "أنت شخصٌ"؛ كلا! لا يقول ذلك! بل يعيشه. ولذا فهو اندهاش وكل ما يلمسه يصبح فريداً؛ وحينما يلمس رجلاً أو امرأة يجعل كلاً منهما "إلهاً". أقول "إلهاً" لا صنماً! فالله هو الذي نجثو أمامه وننحني بكل احترام، فهو الأوحد، أما الصنم فهو الإله المزيّف الذي لأجله يضحّي الإنسان بذاته أو بما يملكه. إنّ من اختبر الحب يعرف أن الحبّ إلهي ولئن غاب ذلك عن باله، فالحب في اللقاء هو هذه المجانيّة التي تتجاوزنا، هو الاندهاش من أنّ هناك آخر وآخرون! الحب هو كياننا العميق؛ إنه هويتنا وغايتنا. فبدون حبّ لا نستطيع أن نحيا. لذلك فالأهل والأصدقاء والإخوة والأخوات كما الشيخ والطفل، جميعهم، ضروريون لنا؛ والحياة لا تنسج خيوطها إلا متى كنا مع بعضٍ ومن خلال بعض. فنحن بأجمعنا لا نحيا إلا بالحب. ولكن إذ نجهل بأننا قد ولدنا من الحب ترانا نجري في إثره معتقدين بأنه ينقصنا. هذا ما يجعلنا نجد صعوبةً كبيرة في أن نحب. علامة عدم اكتمالنا: ثمة فينا شيء لا يمكن قط إرواؤه في بحثنا عن الحب. ولقد وجد القديس أوغسطينوس جوابًا على هذا الألم حينما هتف بتعجب: "كنت أبحث عنك في الخارج وكنت أنت في داخلي!" لقد كان يجري من امرأة لأخرى، ومن نجاح لآخر، ومن خبرة فلسفية لأخرى، بحثاً عن الجمال ولم يكن يرى أنه كان يبحث في الخارج عمّا كان في داخله. أيجب إذن أن نكتفي بالداخل بدل الخارج فنتعلّم الاكتفاء بذاتنا؟ لا، لم تكن هذه حال أوغسطينوس، الذي بعد اهتدائه، راح يتعلّم كيف يحبّ بشكل مختلف. هل يجب علينا بالتالي هجر العالم؟ إن ذلك لمستحيل. فثمة فينا انجذابٌ نحو الآخر، ولكن سواء أكان هذا الانجذاب رغبةً في أن نجد في الآخر انعكاساً لنا، أو رغبة في معرفته، أو في اقتناء ما لا نملكه، فهو يشكّل، في الأحوال كافة، العلامة على عدم اكتمالنا، وعلى أننا أحياء بالتالي. تحضرني الآن ذكرى امرأة كانت تتعالج وتذرف الدموع باكية على كل الحب الذي نقصها. كانت تعاني كما لو أنها مبتورة الأعضاء. وفجأة بدا وكأنّها استفاقت من نوم طويل وقالت بصوت جلي: إن الذي كانت تحتاج اليه هو أن تحبّ. ولدى إصغائي إليها كنت أزداد إدراكاً بأن الحبّ هو هويتنا العميقة. ولقد كان أمرًا مذهلاً أن نرى كم أصبحت تفيض بالحياة، وكيف صار الحبّ يشع منها حتى من غير علمها، ما إن راحت تخرج من عزلتها التي ما برحت تتوق لآخر. الحب هو تحريرٌ لكيان الحبيب والمحبوب معاً. إنه تلك العلاقة التى تتيح لكل إنسان، المُحبّ كما المحبوب، أن يكون ذاته. إنه تدفّقٌ؛ فما هو الأول في الحب ليس الأنا أو الأنت بل الـ"نحن". إنّ لدينا حنينًا إلى "الواحد"، وما علينا تعلّمه هو أنه لا يمكن تحقيق هذا الواحد إلا في الاختلاف، فالاختلاف هو شرط الهبة اللامحدودة: اختلافٌ في صميم الله بالذات، اختلافٌ بين الله والإنسان، بين الرجل والمرأة. فالحب هو فيضان الكيان وهو فرح. هذا ما يقوله يسوع: "ليكونوا واحداً، كما أنت وأنا واحد" (يو 17). إذا أعوزني الحب، وأعني هذا الارتباط الأساسي مع الآخر، فلست بشيء. لأن فعل المحبة هو هذا الارتباط نفسه، هذا الفرح بأن نكون كلانا: أنت وأنا واحداً، أنت فيّ وأنا فيك (يو 17). فالمحبوب والمحبّ وفعل المحبّة ليست جميعها إلا حقيقة واحدة. والله هو المحبة التي يكمن فرحها في أن يكون الآخر آخراً ليس إلا. سرّ اللقاء: "إني مستعدٌ لترك كل شيء في سبيل أن أعود فأجد امرأتي..." هذا ما كان يقوله رجلٌ عجوز بعد سنواتٍ عاشها وحيداً في الترمّل. كان يعلمني أن أستقبل الحب؛ فأنا لا أهبه لنفسي. فما هو خارجٌ عني يُظهر لي في الوقت عينه ما هو في باطني، ويوحي لي بأن الحبّ هو في البداية؛ ومهما كان ماضيَّ فأنا مولود من الحب ولأجل الحبّ. ليس ثمة حب ما لم يكن هناك تبادل. وذلك صحيح حتى وإن علمنا بأنه يمكن للكراهية أو اللامبالاة أن تكون جوابًا على المحبة. هذا صحيح، ليس على الصعيد الملموس بل كيانيًا، لأن الأنا هو علاقة، والجنس الآخر هو وجه ذاك الآخر المطلق الذي هو حضورٌ لكل ذي نسمة. الجنس الآخر هو تذكيرٌ لي بأنني مكوّن لأجل العلاقة، علاقة لا تنتهي أبدًا لأنها تشكّل كياني. غالباّ ما أظن نفسي وحيداً، في حين أنني لا أوجَد إلا متجهاً نحو الآخر، لا في القدرة على العطاء أو الاستقبال بقدر ما في التوق عينه وإن يكن صغيراً للغاية. ففيه لا أعطي بل أتواصل في حميميتي وأستقبل فيها. وإذا ما شكّل الاثنان جسداً واحداً، فما ذلك بفضل عملنا، بل هو هبة محض. والآخر هو الحماية التي وُهِبتُها حتى لا تحيد بي قدرتي الكليّة عن الحياة. فالحياة أودعت بين يديّ حبنا، ونحن وعدٌ؛ لأنه لمحدوديتنا قد أُودِع من هو غير محدود. إنّ ما علينا استقباله هو هذا النداء إلى الـ"نحن" الذي يجعلنا قادرين على تجريد أنفسنا من "أنانيتنا"، فنحن نجرد ذواتنا بفضل ما قد استقبلناه قبلاً. الحب هو خروجٌ من الذات؛ لأنني محدود وفي الوقت نفسه غير محدود في كياني العميق، بيد أنه لا يمكنني أن أعرف أن غير المحدود هذا، هو الطريق إلى كياني، إلا إن اكتشفت أولاً أنني محدود. كما لا أستطيع النمو في الحب إلا إذا عرفت محدوديتي. لا يحدث الحب بسبب هذا "الرجل" أو تلك "المرأة"، فإن ذلك لَيُعبّر بالأحرى عن السرّ، سرّ فرادة كل كائن، سرّ اللقاء. فحينما يتمّ اللقاء بالآخر في حميميته، فعندئذٍ ترانا وَلجنا في سرّ الكيان. الحبّ مُغمَّس في سرّ اللامتناهي، وهذا ما يجذبنا ويخيفنا. فإنه لَباستطاعتنا أن نشعر بالارتياح مع أحدهم بفضل التواصل بين تاريخينا وطباعنا، بيد أن الحب هو شيء مختلف تماماً عن الشعور معاً بالارتياح أو بالتعاسة.  ظهور الآخر بجماله: نعتقد، أو علمونا أن نعتقد بأن الحبّ يكمن في العطاء. وهذا الاعتقاد يناسبنا جيداً فيعزّز كبرياءنا. هناك جيل من النساء، ومنهم أنا، بتضحيته بذاته شوّه الحب. فلو فرقت جميع أموالي لإطعام المساكين وأسلمت جسدي لأُحرق ولم تكن فيّ المحبة فلست بشيء (1كور 13: 3)؛ ذلك أن الحبّ لا يعرف العقلية الحسابية التي تقود - حتى بحجة مساعدة الآخر - إلى سحقه والسيطرة عليه؛ فهو لا يقوم بحسابات. الحبّ لا يقوم في التضحية، ولا في العمل، ولا في تفريغ شيء نملكه من واحدٍ لآخر؛ كما لا يقوم في التبادل المعرَّض دوماً للحسابات؛ فحيث الحساب لا مجال للحبّ. الحب هو في نوعية الكيان الذي هو حياة، ويمكنه بالتالي أن يهب الحياة. فالحب إذن هو بلا حدود وما مَن يحدّه، إنه يمتدّ ليطال الجميع والحياة بكليتها، ويرى الرابط بين الكل. وإذا كان الحبّ يعذر كل شيء (1كور 13: 7) فهذا لا يعني أنه أعمى، بل إنه يذهب نحو الجوهري وحسب. كان شابٌ يقول: "أن نُحِبّ ونُحَب، هو أمر رائع حتى أنه علينا - إن كان الله موجودا حقًّا - أن نرغب في ترك كل شيء لأجله"؛ فالله الذي كان هذا الشاب يتصوره، من خلال ما كان يختبره من الحب، ما هو إلا الإله الذي يجددّ كل شيء؛ ليس على أنه يجعلنا نذهب نحو الجوهري، بل على أنه يتيح لنا اختبار ما هو جوهري، وهذا الجوهري هو الـ"نحن" الذي فيه تصبّ كل "أنا". إن الآخر الذي يمكنني إدراكه على أنه علامة كيانية (أنطولوجية) لحدودي وحاجزٌ أمام رغبتي في أن أكون كلّي القدرة، يصير موحياّ لكينونتي، "لما أكونه": فمقولة "اعرف ذاتك" غير ممكنة إلا عبر لقاء الآخر؛ فهكذا يمكنني أن أهب للآخر أن يكون ذاته، كما يمكن للآخر أن يهبني لذاتي. إن الحب هو تلك المسؤولية التي نضطلع بها، واحدنا تجاه الآخر، في الـ"نحن". إنه ليس في إفراغ أنفسنا لأجل الآخر، بل هو في فرح التخلي عما هو محدود، من أجل بلوغ الملء؛ ولذلك فالحب مرتبط دائماً بالعفة، لأنها احترامٌ وتخلٍّ عن إرادتي في امتلاك الآخر. في الواقع، غالباً ما نخلط بين أمور ثلاثة: الانجذاب والتعلّق والحبّ، ولكن الحقيقة أن الانجذاب والتعلّق ليسا سوى معابر إلى الحب. فالانجذاب عند الإنسان تحرّكه مجموعة من الحتميات، عددٌ كبيرٌ منها لا واعية، وكلّها مهمة، لكنها غير كافية، وما هي هنا إلا لتعلّمنا الحب. فليس الآخر هو مَن يجعلني سعيداً وإنما علاقتنا نحن الاثنين؛ العلاقة التي هي أكثر من أنت وأنا، لأنها وحي الآخر المطلق فينا. تماماً كما حدث للرسل يوم التجلّي، فإننا لا ندرك إلا ما أُعطي لنا أن إدراكه؛ وهذا هو كشف "الآخر المطلق" في جماله. وبالنسبة للمؤمن، هو حجاب سر الله الذي يتمزّق في سرّ رجل أو امرأة. ففي الرجل أو المرأة اللذين يجذباننا، يهب الله ذاته على أنه الأكثر قرباً. ذاك الذي لا يكفّ عن أن يكون "الآخر المختلف على الإطلاق". فالرجل لا يمكنه أن ينكشف للمرأة، ولا المرأة للرجل، إلا إذا كفّ كلاهما عن البحث عن كيفية امتلاك الآخر والسيطرة عليه. جوهر المحبة ليست المحبة في ما أعطيه؛ فهي مَن تسبقني، وهي التي تجعلني قادراً على أن أكون حاضراً هنا. إنها الينبوع الذي في أعماقي، ذاك الذي يجعلني أكون ذاتي، ويجعلني لا آتي إلى ذاتي إلا بانفتاحيعلى الآخر. فإن لم أحب ذاتي، أي إن لم أعترف بالينبوع فيّ، فلا أستطيع لقاء الآخر. وأن نحب ذواتنا بتواضع يعني أن نحبها ليس لأجل ما نعمل، بل لأجل هذا الينبوع الذي يذكّر كلاًّ منا بأن الحياة قد وُهبت له، ولهذا السبب بالضبط يمكنه أن يهبها. فإنّ كل واحد يمكنه أن يكون بدايةً للآخر بدون أن يكون على الإطلاق هو مصدره، وهذا الينبوع هو الروح الذي يأتي من لدن الآب، وما يهمّ هو اكتشاف أنه باستطاعتنا أن نشارك بعضنا بعضاً بهذه الحياة. فعمق أعماقنا هذا ليس في ما نملكه بل في ما نكونه. إذا تقدمنا بالرغم من الليالي، فلأننا نعتقد بأن هناك مَن سبقنا، وبأننا أكثر مما نبدو عليه، وبالتالي أكثر من حدودنا ومخاوفنا. إذا ما استمرينا نؤمن بالمحبة، فليس بفضلنا ولا بفضل الآخر – فلطالما اختبرنا صغاراتنا - ولكن بفضل هذه العظَمة التي أوُدعت فينا. المحبة هي هبة، وهذا بالضبط ما يسمح لنا بأن نلتزم. فإننا نلتزم بالمحبة متيقّنين من أن الـ"نحن" تسبقنا، فنحن لا نملك شيئًا إن لم يُعطَ لنا أولاً (1كور4: 7)، كما لا نستند إلى ذواتنا بل إلى ما رأيناه ولمسناه، إلى ذاك الذي يشكّل لنا وعداً لكونه نداء. لا يمكن للمحبة أن تستمر إلا إذا حركت معها، في عمق حدودنا نفسها، ما فينا من لا محدود، على ما كتب الأب الشهير موريس زَندِل: "إنكم تعلمون أنكم تحبّون عبر تحوّلٍ يجعل من كيانكم علاقة بالمحبوب تحيونها على صعيدِ أعمق ما فيكم. وبالتالي ألا يكون التحرّر من الذات والسعي عبر ذلك لتحرير الشريك هو الحبّ الأعظم؟ أليس الحبّ هو تلك الإرادة الشغوفة بأن يكبر المحبوب؟ إلا أنّه لا يمكن بلوغ هذه العظمة إلا عبر أنسنة الغرائز (...) وبالتالي فالحب الكامل سيكون بكل بداهةٍ ذاك الذي يمكنه أن يربط الواحد بالآخر عبر التحرير المتبادل". أليس الحبّ الكامل حاضرٌ هنا في الوقت نفسه بمثابة برعم؟ أليس هو حب ذاك الإله الذي اتخذ جسداً بشريًا؟ أليس هو ذلك الأنين الفائق الوصف الذي يُصدره الروح في أعماق القلوب (رو8: 26)؟ فالمحبة ليست غزوة نقوم بها؛ إنها مطلبنا وطريقنا كيما نُكوِّن بأجمعنا جسداً واحداً (رو 12)، كل واحد بمقدار: الناذر نفسه لله، والمتزوج، ومن لم يزل بعد أعزبًا. فلا يضطرب قلبنا؛ فنحن نعرف المحبّة، لأنّ الله هو الذي أحبّنا أولاً (1يو1: 10). |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 8276 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
أيُّ رجاءٍ لسورية اليوم؟ 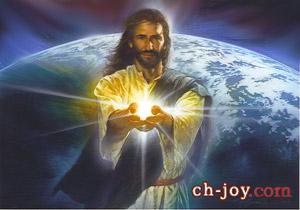 بقلم الأب نورس السمّور اليسوعيّ نُشرت في مجلّة المشرق الإلكترونيّة - العدد الخامس - كانون الأوّل ٢٠١٤ مقدّمة في خضمّ حرب لا تعرف رحمةً ولا هوادة، تحرق المدن والقرى وتتسبّب بمقتل عشرات الألوف وتهجير الملايين، ويلاحق عنفُها الأعمى الأطفال والنساء والعجّز حيثما حلّوا وارتحلوا، يمتلك نفسَ المرء شعورٌ باليأس، ولا سيّما في ظلّ غياب بوادر حلٍّ يُعطي بارقة أمل بقرب انتهاء جولات الجنون. غير أنّ ثمّة وجوهَ أشخاصٍّ تستيقظُ في الذاكرة تحمل معها نورَ الرجاء. فكيف لا يمكن ذكرى أشخاص أمثال ديترِش بونهوفر الراعي البروتستانتيّ الذي استشهد في معسكر اعتقال نازيّ، وإغناطيوس ألِّيكوريا ورفاقه اليسوعيّين الذين قضوا في السلفادور في العام 1989 أثناء الحرب الأهليّة، وأسقف الجزائر بيار كلافري الذي بذل حياته في تلك البلاد العام 1996 ، والأب اليسوعيّ فرانس فاندر لُخت الذي استشهد في مدينة حمص العام 2014 وغيرهم، إلاّ أن تكون مصدر إلهامٍّ ورجاء في زمن البربريّة؟ فكلٌّ من هؤلاء سعى على طريقته ليشهد لكرامة الإنسان في ظلّ ظروف لم تعرف من الإنسانيّة شيئًا، ويشهد، بفضل تمسّكه بإيمانه، لأخوّة ممكنة بين البشر جميعًا، مهما اختلفت ثقافاتهم وأعراقهم وجنسيّاتهم وأديانهم. لنتوقّف بوجازة، في البداية، على ظروف سورية الاستثنائيّة، قبل أن ننظر، من ثمّ، في أوضاع المسيحيّين السوريّين، ونختم بتفكير في رسالة الرجاء التي يلهمنا إيّاها هؤلاء الأشخاص. أوّلاً: مأساة تفطر القلوب منذ ثلاث سنوات  بدأت الأزمة في سورية ربيعَ 2011 ، واتّخذت بدايةً شكل مظاهرات قبل أن تتحوّل تدريجيًّا إلى مواجهات عنيفة تستمرّ إلى اليوم. تكمن في أصول الأزمة هذه مشاكل سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة. ذلك بأنّ سورية كانت تفتقر إلى البُنى الضروريّة التي كانت لتؤول إلى تحديث الدولة وتأمين شروط ديمومتها، بالرغم من الاستقرار الظاهريّ الذي ساد طويلاً، والازدهار الذي بقي هشًّا بل ورمزيًّا. أمّا نتائج الأزمة الجارية والمتفاقمة على المستويات النفسيّة والإنسانيّة والاقتصاديّة والتربويّة، فهي مأساة بكلّ ما للكلمة من معنى. فالخوف والقلق وانعدام الأمن تسود جميع السوريّين؛ فما من مكان بمنأى عن العنف والوحشيّة. فأعمال الخطف، ومنها يتمّ بدافع طلب الفدية، والاغتصاب والسرقات وغيرها من اعتداءات، تأتي لتنزع كلَّ شعور بطمأنينة نسبيّ حتّى في المناطق التي تُعدّ هادئة. وتبعًا للإحصاءات غير الرسميّة المتداولة إلى حين كتابة هذا المقال، سقط ما لا يقلّ عن 165 ألف ضحيّة نتيجة المواجهات العسكريّة، منهم حوالى 15 ألف طفل، من دون أن تشمل هذه الأرقام المريعة المخطوفين بقصد الاحتجاز أو التصفية. كما تشير الإحصاءات عينها إلى أنّ ما يقارب ثلاثة ملايين مواطن قد غادروا الأراضي السوريّة نهائيًّا ولجأوا إلى البلدان القريبة وتحديدًا لبنان والأردنّ وشمال العراق وتركيا، ومنهم من قصد بلدان بعيدة مثل مصر والجزائر. ولا داعي للكلام على المعاناة التي يعيشها العدد الأكبر من هؤلاء اللاجئين في المخيّمات التي تأويهم على الصعد كافّة، من صحّيّة وغذائيّة وتربويّة. كما يرد في الإحصاءات أنّ هنالك ثلاثة ملايين مواطنٍّ داخل الأراضي السوريّة يحتاجون إلى مساعدات غذائيّة وطبّيّة فوريّة. أمّا على المستوى الاقتصاديّ والتربويّ فإنّ المعارك قضت على البُنى التحتيَّة لهذَين القطاعَين الحيويَّين، وأدَّت إلى انقطاع الخدمات العامّة في أرجاء واسعة من البلاد وتراجعها كثيرًا في مناطق أخرى. وتأتي هجرة العقول المفكّرة ورؤوس الأموال لتزيد من نتائج الأزمة السلبيّة حدّةً ومأسويّة. وعلى المستوى الاجتماعيّ، تشهد البلاد تفكّك رباطها الاجتماعيّ وتصاعد التيّارات الدينيّة المتطرّفة وتفاقم العصبيّة الدينيّة. وممّا لا شكّ فيه أنّ ثمّة مجموعات أصوليّة تستلهم عقيدتها من تنظيم "القاعدة"، فاعلة في مناطق من سورية، وتسعى لتفرض برنامجها على أطراف المعارضة. وتدّعي بعض مرجعيّات الجيش السوريّ الحرّ في هذا السياق أنّ المجموعات الأصوليّة تتمتّع بقدرات ماليّة تفوق بكثير قدرات أطراف المعارضة الأخرى، وهذا ما يجعل تلك المجموعات قادرة على استقطاب العديد من الأشخاص لضمّهم إلى صفوف مقاتليها. وفي إطار متّصل، يحتار المراقبون والخبراء المحلّيّون والخارجيّون في تحديد ما الذي يجري في سورية اليوم؛ سؤال يبقى برسم الجواب. فالأصوليّون يكتسبون نفوذًا في أوساط المعارضة التي لها أوجه عديدة؛ والقتال الدائر يتّخذ طابع حرب أهليّة تنطوي على ألوان طائفيّة ومذهبيّة وعرق يّة ذات امتدادات إقليميّة ودوليّة، الأمر الذي يُنتج مشهدًا معقّدًا أيّ تعقيد. ثانيًا: ضيقُ المسيحيّين السوريّين في ظلّ هذه الأوضاع، تعيش الجماعة المسيحيّة في سورية ضيقًا شديدًا. لا شكّ في أنّ السوريّين جميعًا يعانون من الضيق هذا، ومن وطأة العنف الذي لا يميّز بين الناس. غير أنّ المسيحيّين، بسبب قلّة عددهم أصلا، وبسبب صعود الإسلام الأصوليّ، وما حلّ بمسيحيّي العراق ابتداءً من العام 2005 ، وتعرّض ، بعض أوساط مسيحيّي مصر وكنائسهم بعد ثورة كانون الثاني/يناير 2011 ولأكثر من مرّة، لاعتداءات، فإنّهم يشعرون بضيق وقلق أشدّ من مواطنيهم المسلمين. ويأتي استهداف المجموعات التابعة لتنظيم "القاعدة" المسيحيّين وباقي الأقليّات، بل وحتّى السنّة الليبراليّين والمعتدلين، في المناطق التي يسيطرون عليها، لتضاعف من القلق. فهذا ما حصل في مدن صغيرة مثل القصير وشَدَدْ وغيرهما. ومن المألوف، في الواقع، أن تكون الحلقة الأضعف في المجتمع عرضةً لتتحمّلَ عواقب سلوك الآخرين السلبيّة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنّ غياب مرجعيّة مسيحيّة وموقفٍّ كنسيّ يناديان بمبادئ الإنجيل وتعاليم الكنيسة الاجتماعيّة وكرامة الإنسان والعدالة، يُساهمان في إضعاف دور المسيحيّين ويزيدان من الضيق. فلا عجب، إزاء هذه الأوضاع، أن نلاحظ ثمّة خطرًا يتهدّد المسيحيّين السوريّين ومسيحيّي الشرق عمومًا، ألا وهو خطر التغرّب عن واقعهم، إذ يجدون أنفسهم يحلمون بالعيش في مكان آخر، أو يبحثون عن قوّتهم في الماضي أو في المستقبل، مُغيِّبين دورهم أو متجاهلينه في اللحظة الراهنة. بالطبع، ليست اللحظة هذه سهلة؛ فالموت يتحوّل لعبةً سهلة سخيفة يوميّة، قد تصطاد في شباكها في أيّ لحظة أيًّا كان. لقد بات السوريّون جميعًا يعيشون والموت حاضر في أذهانهم. ولكن هل يعني هذا الواقع القاسي انتهاء سورية المضيافة والمسالمة؟ هل يجب الاستسلام للعنف والانقسامات والدمار وآلة الموت؟  ثالثًا: أيُّ رسالة رجاء؟ هل من مكان بعدُ للرجاء؟ هل ثمّة بصيص نور في هذا الظلام الحالك؟ لعلّ نظرةً واقعيّة وعقلانيّة إلى ما يحصل تُعطي جوابًا قاطعًا: لا يمكن بعدُ فعل أيّ شيء! ولكن حيث يبدو الوضع إنسانيًّا ميؤسًا منه، تبرز رسالةُ الرجاء بقوّة: "حيث لا يمكن بعدُ القيام بشيء، فيجب وبكلّ تأكيد القيام بكلّ شيء مرّة أخرى" (إغناطيوس ألِّيكوريا). ليست هذه الكلمات مجرّد تعزيات رخيصة، بل تنبع من قناعة كلّ مؤمن يعرف أنّ الرجاء الذي يحمله يجعله قادرًا على تجاوز حدوده الشخصيّة وظروف مجتمعه. ما هو مدخل رسالة الرجاء هذه في سورية؟ تُبيِّن لنا الصفحات الحالكة من تاريخ البشريّة أنّ من دواعي معاناة الإنسان الأشدّ افتقاده الوسائل التي تسمح له بالتعبير عن ضيقه وخوفه؛ عندما تخونه اللغة وتعوزه الكلمات الضروريّة ليصف ما يعيشه ويخبر عن حياته الممزّقة. لذا، فالسؤال الذي يُطرح هو الآتي: كيف يُعطى الصوت لمن لا صوت لهم؟ من وجهة نظر مسيحيّة، يُترجم هذا الوضع بمفارقة تفتحنا على الرجاء: فالحالة الميؤوس منها إنسانيًّا، الحالة التي تعرف "لاإنسانيّة"، تصبح فرصة بل ونعمة. فالشعور بالضعف وسطوة الظروف القاسية يسمح بتجلّي قدرة الله وقوّته (2 قورنتس 21: 9). ماذا يعني أن نكون نحن المسيحيّين السوريّين ضعفاء؟ وكيف يكون الضعف هذا نعمة؟ بصفتنا ضعفاء، فنحن لا نهدّد أحدًا ولا نُخيف أحدًا. ولعلّ بعضهم بسبب هذا الوضع ينظر إلينا نظرة استخفاف. ولكنّ ذلك كلّه فرصة لنا للمبادرة في الانطلاق نحو الآخر حيث هو، لنكون معه في معاناته وفي ادّعائه امتلاك القوّة والنفوذ، بل وحتّى تسلّطه على الحياة نفسها، إذ يحافظ عليها أو يقضي عليها كيفما شاء. فالله ينتظرنا في انطلاقتنا تلك؛ إنّه "لا يزال يعمل" في تلك المبادرة عينها. ذلك بأنّ الله إله منفتح، هو أبو الجميع، أبٌ لا يستثني أحدًا من أولاده. إنّه المخلّص الذي يبحث عن خرافه الضالّة ليعيدها إلى حظيرته (لوقا 15: 4 – 5. أنظر أيضًا: يوحنّا 10 :1 – 16). لذا، باسم الإنجيل نفسه، لا يحقّ لنا أن نستسلم ونصاب بالهمود، بل "يجب وبكلّ تأكيد القيام بكلّ شيء مرّة أخرى". فهذه كلمة الرجاء التي نحملها ونقدر على التعبير عنها. بالطبع، إنّ نظرتنا المليئة بالرجاء هذه إلى الواقع دعوة إلى خوض مغامرة لا تُعرف نتائجها، مغامرة لا ضمانات لها. غير أنّها تقوم على الله الذي يدعونا إلى الالتزام الحرّ في الإيمان المعاش من خلال عمل مسؤول. ولكن أليس الإنجيل، في نهاية المطاف، دعوة إلى المغامرة؟ أليس الإنجيل مغامرة قبل خوضها بحرّيّة يسوع الذي أسلم نفسَه بشجاعة إلى "جهالة الصليب"؟ وبكلام آخر، يدعونا الإنجيل إلى الشهادة للحرّيّة المفتداة، حرّيّة تحثّ المؤمن على الاتّكال الكامل على الله، وتجعله يألف موتَه نفسه، بقوّة الحياة وتعرّضه اليوميّ لخطر الموت، وبفعل طاعته الحرّة. فهذا ما عاشه الأب فرانس فاندر لُخت اليسوعيّ الذي استشهد في حمص يومَ 7 نيسان/أبريل 2014 . فقد عرف هذا اليسوعيّ الشهيد كيف يشهد لقيمة حياةٍ وُهبت له نعمةً، ويألف بذلك موته نفسه. لذا، في صميم بلاد غاب عنها الاستقرار وتعيش تحت وطأة الخضّات المتنوّعة والعنف، يثبت مَن لا يركن إلى منطقه ولا إلى مبادئه ولا إلى حرّيّته أو فضيلته، بل يتمسّك بالله وحده، مستعدًّا ليضحّي بكلّ شيء حتّى بنفسه، "لأنّ إيمانه يدعوه إلى عمل مطيع ومسؤول. فإنّه لا يريد أن تكون حياته إلاّ تجاوبًا ونداء الله وسعيًا للإجابة عن سؤال طرحه الله عليه" (بونهوفر). وما من سؤال سديد يطرحه الله علينا اليوم في سورية إلاّ هذا: "أين هو أخوك؟" (تكوين 4: 1). لذا، يجد المسيحيّون مكانهم عندما يفطنون دعوتَهم ورسالتَهم بأن يكوّنوا "كنيسةً" في الظروف التي تصلب الإنسانيّةَ، إذ تقضي عليها وعلى وحدتها. "نحن إذّاك في مكاننا الفعليّ، لأنّنا في هذا المكان فقط يمكن أن نرى نورَ القيامة، ومعه الرجاء بتجديد عالمنا" (بيار كلافري). خاتمة تبعًا لقولٍّ مأثور، هم المنتصرون مَن يخطّون حروف التاريخ. ولكن في نظر الربّ سيّد التاريخ، لا يعني هذا القول البشريّ الكثير. بصفتنا مسيحيّين نكوّن كنيسة، "لا نريد أن نكون مراقبين ولا انتهازيّين، ولا يجب أن نكون كذلك. بل علينا أن نكون أناسًا يشاركون الآخرين، بدافع إيمانهم بالله إله التاريخ، في مسؤوليّة بناء التاريخ، في كلّ حالة وفي كلّ لحظة، أكنّا منتصرين أو مغلوبين" (بونهوفر). بصفتنا نكوّن "كنيسة"، تقع علينا إذًا مسؤوليّة مستقبل الأجيال في سورية. ويبدأ تحمّل هذه المسؤوليّة بالتربية، وتحديدًا بالتربية على الحريّة المسؤولة التي ترفض كلَّ حطٍّ من كرامة الإنسان، وتعارض كلّ استبداد. فإخضاع العقل للمصادرة واتّباع شرِّ الآخرين بعناد، ما هو - كما يقول بونهوفر - إلاّ العدوّ الأخطر الذي لا يمكن التغلّب عليه بمجرّد عمل تعليميّ، بل بعمل تحريريّ شامل من خلال الحبّ. هو هذا الحبّ الذي أسَّس الكنيسة وهي تحمله. لذا، فكنيسة عقيمة غير مثمرة ليست كنيسة أسَّسها المسيح وأرادها. لذا، نجهد لنكون صوت الغالبيّة الصامتة التي تريد الأفضل لبلادها؛ تريد بلادًا منفتحة، تعدّديّة، موحّدة، عادلة لجميع المواطنين من دون تفرقة أو تمييز. ولا يتّصل الكلام في هذا السياق بعمل سياسيّ كما يقوم به السياسيّون. بل نعني ذلك الحضور اليوميّ البطوليّ الصامت وسط شعب سورية المتألّم، حضور يعرف كيف يتضامن مع الجميع متجاوزًا خطوط التماس، ويحمل شعلة الرجاء في وجه كلّ أسباب الإحباط والاستسلام. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 8277 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
معلومات مهمة عن القداس
 1 – كم عدد لفائف المذبح فى القداس و ما هى بعض رموزها ؟ ج: 12 لفافة اللفافة المستديرة فى الصنية رمز للتبن فى المزود و الابروسفارين رمز للحجر الذى دحرج على باب القبر . 2 – كم مرة يغسل الكاهن يدة قبل رفع الحمل وماذا يقول ؟ ج : 3 مرات ويقول : 1 – تنضح على بزوفاك فاطهر تغلسنى فابيض اكثر من الثلج 2 – تسمعنى سرورا وفرحا فتبتهج عظامى المتواضعة 3 – اغسل يدى بالنقاوة واطوف حول مذبحك يارب كى اسمع صوت تسبيحك . 3- كم يد بخور يضعها الكاهن فى دورة البولس والى ماذا يرمزون؟ ج: يضع 5 ايادى يخور ويرمزون الى الخمسأشخاص الذين قدموا ذبائح في العهد القديم وهم : هابييل – نوح – ملشيصادق – هارون – زكريا . 4 – ماذا يقول الكاهن والشماس فى دورة البولس ولابركسيس من الداخل الهيكل؟ ج: يقولون 3 اواشى هما ( السلامة – الآباء – الاجتماعات ) 5 – الى ماذا يرمز رفع الابروسفارين بعد صلاة الصلح؟ ج: يرمز الى دحرجة الحجر عن باب القبر و قيامة مخلصنا الصالح.. و هزه يرمز الى الزلزلة التى حدثت عند نزول الملاك من السماء ودحرجة الحجر . 6- فى مقدمة القسمة يغمس الكاهن يده فى الدم الكريم ويدهن به الجسد المقدس الى ماذا ترمز ؟ ج: ترمز الى لتخضب الجسد المقدس بدمه من اثر المسامير واكليل الشوك وطعن الحربة 7- لماذا يضع الكاهن الاسباديقون مقلوبا فى الكاس ؟ ج: اشارة لعملية الصلب فالسيد ا المسيح عند صلبة ارقدوة على ظهرة و بدأ وا بدق المسامير فى يدية ورجلية . 8- الى ماذا تشير ال9 ساعات الصوم قبل التناول ؟ ج: مدة الام السيد المسيح 9 ساعات بدءا من صدور الحكم من بيلاطس بالموت صلبا و الجلد واكليل الشوك مرورا بالصلب حتى تطبيقة وتكفينة الساعة الثانية عشر ( 6 مساءا ) الدفنة. الهامى |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 8278 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
لكل واحد صليبة  كانت فتاة جميلة في إحدى مدن إيطاليا، عاشت في بيت جميل سعيد، وكان طريق حياتها ناعماً. تزوّجت في سنّ مبكّرة من شاب جميل وأنجبت منه ثلاثة أطفال. كان البيت سعيداً وكان جوّه مبهجاً، لكنّ المصائب لم تتركها، فقد داهمتها كارثة شديدة إذْ حملوا لها زوجها يوماً ما ميتاً، وقد سقطت عليه شجرة في الغابة. كانت التجربة قاسية حتى أنها لم تستطيع أن تقبل إرادة الله، فتمرّدت وأصبحت قاسية، وكافحت كثيراً لتصدّ الفقر عن بيتها، واشتغلت ليلاً ونهاراً لتتمكن من إطعام أولادها. على أنها كانت تفعل ذلك بروح ناقمة، خالية من الحب حتى أنَّ أولادها بدؤوا يخافون منها وكانوا يختبئون إذا ما اقتربت منهم وقت لعبهم. وفي إحدى الليالي شعرت أنها لا تستطيع أن تحتمل أكثر مما احتملت، فصلّت قبل أن تنام وقالت: "يا ربّ خذ نفسي. هذا أكثر مما أستطيع احتماله". فرأت في نومها حُلماً. كانت واقفة في غرفة ليس فيها سوى صلبان، بعضُها كبير وبعضها صغير، بعضُها أبيض والآخر أسود، وقد وقف إلى جانبها المسيح نفسه وقال لها: "أعطني صليبكِ الثقيل عليكِ واختاري لنفسكِ صليباً بدلاً منه من هذه الصلبان المعلّقة على الجدار". وما كادت المرأة تسمع هذه الكلمات حتى وضعت في يدي المسيح صليبها، صليب حزنها، ومدّت يدها وأخذت صليباً بدا صغيراً وخفيفاً، ولكنها ما إن رفعته حتى أحسّت أنه ثقيل جداً. فقال لها الرب:"هذا صليب شابة أصيبت بالكساح في سنّ مبكرة وستظلّ كسيحة كل أيام حياتها وستعيش داخل أسوار المستشفى لا ترى الحقول ولا الطبيعة الجميلة ويندر جداً أن ترى وجه صديق. فإذا عاشت عشرين سنة أخرى فستكون عشرين سنة على فراش المرض". سألت السيدة: "لكن لماذا يبدو صليباً صفيراً" أجابها السيد: "لأنها تحتمله من أجلي"!. وتحركت السيدة ببطء وتناولت صليباً آخر، كان صغيراً وخفيفاً أيضاً ولكنها ما إن أمسكته حتى ألهب يدها بنار حامية، فصرخت من شدّة الألم وسقط الصليب من يدها، فسألت: "صليب مَن هذا يا إلهي؟" أجابها السيد: "إنه صليب امرأة، زوجها شرير جداً، وهي تحتمل صليبها دون أن تُظهره مع أنه يحرق كل ساعة قطعة من جسدها – وكثيراً ما تخبئ أولادها منه لئلا يسيء إليهم – ومع كل هذا لا تزال شجاعة و شفوقة"ّ! أخيراً رفعت المرأة صليباً آخر، وقد ظهر أنه صغير وخفيف وغير مُلتهب، ولكنها حالما أمسكته شعرت أنَّ جليداً يلمس يدها، فصرخت: "يا سيدي، صليب مَن هذا؟" أجاب: "صليب امرأة كان لها يوماً ستة أطفال أخذوا منها واحداً بعد الآخر، وقلبها الآن يعيش عند القبور الستة في المقبرة!". فطرحت المرأة ذلك الصليب أيضاً، وقالت: "فهمت، سأحتفظ أنا أيضاً بصليبي من أجلك |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 8279 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
صفات الإله الحقيقي
 لا يستطيع الإنسان مهما بلغ في الرقي أن يدرك كنه الله الأزلي بمجرد البحث والاستقصاء. فأن الله عظيم وطاهر وسام جداً عن أن تدركه المخلوقات الضعيفة الخاطئة المحدودة الإدراك مثلنا. ومع ذلك فلئن كنا لا نستطيع إدراك كنه الإله القدير تماماً فإنه يمكننا إدراكه جزئياً لأنه هو نفسه قد أعطانا في خلقه السموات والأرض وفي كلمته ومضات مدهشة لصفاته وكمالاته العجيبة. فينبغي أن نلاحظ هذه الأمور ونتحقق منها وندرسها لنتمكن من إدراك شيء عن شخصيه هذا الكائن البديع الذي نُسميه " الله" إذاً دعنا نسير في طريقنا مسلمين بمحدوديتنا ولنتأمل ببعض صفات الله العظيمة هذه. يقول الله، لا يستطيع أحدٌ أن يختفي عنه. فهو موجود في كل مكان في الوقت نفسه. قال النبي داود: من وجهك أين اهرب؟ إن عبرت البحار فأنت هناك. إن حاولت الاختباء في الظلمة فتراني (موجز مزمور 7:139-11). 2. الله بكل شيء عليمفهو يعلم جميع أفكار قلوبنا وأسرارنا. قال النبي داود: "فهمت فكري من بعيد... ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها" (مزمور 2:139و3). قد نستطيع أن نخفي بعض الأشياء عن الناس لكننا لا نستطيع أن نخفي شيئا عن الله. "إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة أفما أراه أنا يقول الرب. أما أملأ أنا السموات والأرض" (أرمياء 24:23). 3. الله المهيمن على العالمينلم يخلق الله الكون فحسب ولكنه يحافظ على بقائه وسيره. فهو يسيطر على جميع حركات الأرض، على نور الشمس وسقوط الأمطار وعلى كل ما في الكون. "الرب في زوبعة وفي عاصفة طريقه، والسحاب غبار رجليه ينتهر البحر فينشفه" (ناحوم 3:1،4) 4. الله الصمدلم تكن لله بداية قط ولن تكون له نهاية. كان منذ الأزل وسيكون إلى الأبد 5. الله عادل"من قبل أن تولد الجبال أو أَبدأتَ الأرض والمسكونة منذ الأزل إلي الأبد أنت الله" (مزمور 2:90). كل ما يعمله حق وعدل. "عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء. عادلة وحق هي طرقك" (رؤيا 3:15). 6. الله قدوسإن السرافيم الملائكة في السماء يغطون وجوههم أمام الله وينادون قائلين: "قدوس قدوس قدوس رب الجنود" (أشعياء 3:6). فماذا يعني هذا سوى أن الله سامٍ ومتعال إلى ما لا نهاية. منفصل عن جميع حدود المخلوقات ونقائصها وبالأخص عن خطايا البشر. فهذا يعني أن الله يحب الخير والبر والحق والطهارة حباً كاملاً، وكذلك يمقت الشر والإثم والغش والدنس مقتاً تاماً أيضاً. ولان الله قدوس ولا حد لقداسته فانه لا يستطيع أن يتغاضى عن خطايانا بل يجب أن يعاقب عليها. 7. الله رحيمفلنتحقق الآن بان الأمور الشريرة التي نفتكر بها أو نقولها أو نعملها هي خطايا وأنها مكروهة جداً لديه تعالى لأنه قدوس. قال النبي داوُد: "لأنك أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة لكل الداعين إليك" (مزمور 5:86). ومع أن الله يكره الأمور الشريرة التي نعملها فهو رؤوف ورحوم تجاهنا. انه يحبنا ولكنه لا يحب خطايانا بل يريد أن نكون صالحين وقديسين، لأنه رحوم فقد دبر طريقاً لغفران خطايا جميع الذين يقبلون رحمته. وستجد هذا الطريق مبيناً بكل وضوح بينما تستمر في متابعة هذه الدروس. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 8280 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
آدم وحواء 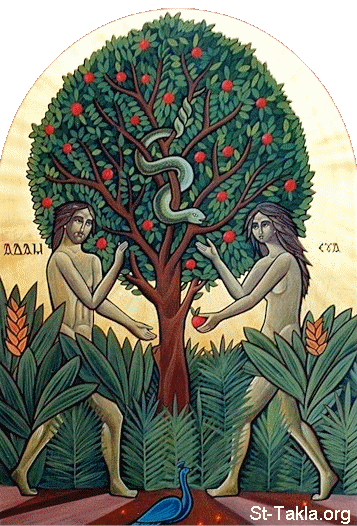 إن أول رجل وأول امرأة عاشا على الأرض لم يولدا قط. في حين أن كل كائن بشري عاش على وجه البسيطة - خلا آدم وحواء - أتى عن طريق الولادة الجسدية. أما آدم وحواء فقد كان لهما ميزة خاصة بهما لأن الله خلقهما إنسانين كاملين مباشرة. ففي اليوم السادس للخليقة أخذ الله قليلا من تراب الأرض وجبله وعمل منه إنسانا. ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار أول إنسان حي، ودعا الله هذا الإنسان آدم. وهكذا نرى أن الله خلق آدم مباشرة. وإذ رأى الله أنه ليس حسنا أن يكون الإنسان وحده لذلك صمم أن يصنع له معينا نظيره. فأوقع سباتا على آدم فنام. وبينما هو نائم فتح الله جنبه واخذ إحدى أضلاعه وملأ مكانها لحما. وبنى الله الضلع الذي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم الذي سماها حواء. وغرس الله جنة عدن ووضع فيها آدم وحواء وقال: "اثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض" (تكوين 28:1). واحضر الله كل الحيوانات والطيور إلى آدم وليدعوها بأسماء. "فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية" (تكوين20:2). وكان في جنة عدن حيث عاش آدم وحواء أشجار كثيرة جميلة. وأوصى الله آدم قائلا: "من جميع شجر الجنة تأكل أكلا. وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها" (تكوين 17،16:2). أمر الله آدم وحواء أن يسكنا الجنة ويأكلا ما يشاءا من جميع أشجارها. فقط ينبغي أن لا يأكلا من تلك الشجرة الوحيدة المنهي عنها لئلا يموتا. أما الشيطان الذي هو مصدر كل خبث وكذب وإئم، فقد قال لحواء: "الله عالم أنه يوم تأكلان منها تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر” (تكوين 5:3). "فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون... شهية للنظر. فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل" (تكوين 6:3). وهكذا أغواها الشيطان بالغش والخداع. فلما ذاقا الشجرة انفتحت أعينهما وعلما انهما عريانان. فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر ليسترا عورتيهما. وفى اللحظة التي بها أكلا من الشجرة عصيا أمر الله. وعصيانهما هذا كان خطيئة. ولأنهما ارتكبا هذا العصيان المباشر فإنهما أصبحا خاطئين. فناداهما الله قائلا: ما هذا الذي فعلتما؟ فقالت المرأة: الحية "الشيطان" غرتني فأكلت (تكوين 13:3). فلعن الله الحية وقال: "أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه" (تكوين 15:3 ). وصنع الله لآدم وحواء أقمصة من جلد لستر عريهما. ذبح حيوان وأعطى جلده لآدم وحواء ليسترا به عريهما. فبسبب خطيئة آدم وحواء اقتضى ذبح حيوان برئ ليكتسيا بجلده. ولأنهما عصيا أمر الله طردهما من الجنة. فاضطر آدم إلى العمل بجد في حرث الأرض لتحصيل قوته. فبمعصية إنسان واحد جعل الجميع خطاة. "من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ اخطأ الجميع" (رومية 12:5). نحن جميعنا أولاد آدم. وكآدم جميعنا عصينا أوامر الله وجميعنا عجزنا عن تأدية الأمور الحقة. "الجميع اخطأوا" (رومية 23:3). لذلك ينبغي أن نعرف تدبير الله لستر خطايانا. |
||||