
 |
 |
 |
 |
|
|
رقم المشاركة : ( 57901 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
 المتابعة لرمزية نمو الشجرة لابد من رعاية ومتابعة والتنقيب حولها ووضع لها سماد ومراقبها، وفي حياتنا الروحية تحتاج منا اهتمام ويقظة أن نراقب انفسنا دائماً ونتساءل هل نتقدم أم نتأخر ولماذا، وهل حياتينا لها اهتمام روحي او العكس هل نتلذذ بالجسد، عليه يجب مراقبة من أين دخل الينا فكبر ونمى حتى تملكنا، لكن الله أعطانا معونة نستطيع أن نغلب بها أي تيار للشر داخلنا ونتابع نمو شجرتنا في الحياة الروحية و صدقوني أن ثمرنا لذيذ عندما نشعر انه بدأ يعمل، أذ لا يوجد إنسان يزرع شجرة إلا ويشتاق أن يرى بها ثمرا هكذا إرادة الله فينا أوجدنا لكي يقترب إلى أشجار حياتنا و يأخذ منها ثمر جيدا. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 57902 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
 الحصاد الذي يسعى للحصاد عليه ان يضع البذور تحت التربة لا يراها أحد، لكن الحصاد يكون في العلن أمام الجميع، ليعطنا الرب أن نزرع الخير، “فَلاَ نَفْشَلْ فِي عَمَلِ الْخَيْرِ لأَنَّنَا سَنَحْصُدُ فِي وَقْتِهِ إِنْ كُنَّا لاَ نَكِلُّ. فَإِذًا حَسْبَمَا لَنَا فُرْصَةٌ فَلْنَعْمَلِ الْخَيْرَ لِلْجَمِيعِ، وَلاَ سِيَّمَا لأَهْلِ الإِيمَانِ”(غل6: 9، 10)، وأن نزرع للروح القدس في حياتنا ونخضع له، وبالتالي نحصد ثمر الروح في حياتنا، ولكن من يزرع لجسده، أي الاهتمام بالجسد ورغباته؛ فالحصاد هو فساد، ومن يزرع الشر يحصد الشر، “فَإِنَّهُ قَرِيبٌ يَوْمُ الرَّبِّ عَلَى كُلِّ الأُمَمِ. كَمَا فَعَلْتَ يُفْعَلُ بِكَ. عَمَلُكَ يَرْتَدُّ عَلَى رَأْسِكَ” (عو 1: 15)، واعترفوا أن الله قد وجد إثمهم وكشف خطيتهم. لقد تم المكتوب: الزَّارِعُ إِثْمًا يَحْصُدُ بَلِيَّةً، وَعَصَا سَخَطِهِ تَفْنَى” (أم22: 8)، وأيضًا “قَدْ حَرَثْتُمُ النِّفَاقَ، حَصَدْتُمُ الإِثْمَ، أَكَلْتُمْ ثَمَرَ الْكَذِبِ”(هو10: 13). |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 57903 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
 ليحفظنا الرب من الخطية ومن الزرع للجسد لأن الحصاد لا بد آتٍ، ومعه الألم لأن الخطية ليست فقط ذنبًا ومديونية تحتاج إلى تبرير وغفران، لكنها أيضًا زرع له حصاد الله يقترب منا وكل من يجد فيه شجرة جيدة بثمر جيد يشير اليه أنه يحقق قصده ويمجده في خليقته، أنه يعلن عمل النعمة داخله وأنه غالب للعالم، هذه فرحة الله، “اِجْعَلُوا الشَّجَرَةَ جَيِّدَةً وَثَمَرَهَا جَيِّدًا”، لابد أن يراقب الإنسان نفسه، وينظر الى التربة و الماء وينابيع الروح والمتابعة، سيجد ثمر المحبة والفرح والسلام، وحقيقةً ذلك هي الاختبار اليومي لأنفسنا في الله، “فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا، لأَنَّهُ مَاذَا يَنْتَفِعُ الإِنْسَانُ لَوْ رَبحَ الْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ؟ أَوْ مَاذَا يُعْطِي الإِنْسَانُ فِدَاءً عَنْ نَفْسِهِ، فَإِنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ سَوْفَ يَأْتِي فِي مَجْدِ أَبِيهِ مَعَ مَلاَئِكَتِهِ، وَحِينَئِذٍ يُجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ عَمَلِهِ”(مت 16 :25، 26، 27). من المؤشرات التي توضح لنا أن كان الإنسان يعيش مع الله أم لا، هي أن يكون داخله فرح مهما كانت الضيقات، فكلما اقتربنا من نعمة الله وجدنا ان لا صراع فينا من الداخل والخارج. باركنا يا رب وأعطنا الثمر الصالح وامنحنا القدرة على غلبة العالم وابعد عنا الأخطار، وأمنح كنيستك البركة لتفيض بها على المؤمنين كي يثمروا في الايمان …… الى الرب نطلب. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 57904 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
 العوامل البيئية في الزراعة: ترتبط الزراعة بالعوامل البيئية، مثل السمات الطبوغرافية والمناخية، وخواص التربة. ولكي نفهم الزراعة في إسرائيل قديمًا، يلزمنا أن نتعرف علي مجموع هذه العوامل التي كانت تؤثر في إنتاج المحاصيل: I- الطبوغرافيا في الزراعة: الأرض المقدسة بصفة عامة أرض جبلية مع وجود مساحات كبيرة من المنحدرات شديدة الميل علي طول أخدود وادي الأردن، مما يجعل الزراعة قاصرة علي أرض الوادي الضيقة، أو حيث يمكن الزراعة علي مصاطب. ومع أن وادي الأردن يصل عرضة إلي بضعة أميال، وهو مستو نسبيًا، إلا أنه سهل جاف يعلو سهلًا ضيقًا يفيض عليه النهر. ولم يكن الري ممكنًا بالأساليب المستخدمة في مصر أو في بلاد ما بين النهرين. وكانت أريحا وغيرها تحصل علي احتياجاتها من الماء من الينابيع والعيون المتفجرة من المرتفعات المجاورة، وليس من نهر الأردن. وتتميز المرتفعات الشمالية غربي وادي الأردن بالتلال التي تتخللها أودية عديدة تضم مساحات كافية لقيام الزراعة. وإلي الجنوب في تلال يهوذا، فإن الأرض منحدرة إلي حد كبير، إلا أن المصاطب الموجودة هناك، وقمم الجبال المتموجة في الإقليم الواقع بين أورشليم وبير سبع، تسمح بقيام زراعة حقلية. أما السهل إلي الغرب من جبال يهوذا، فهو - إلي حد كبير -عبارة عن سفوح متقطعة، إلا أنه توجد أودية قليلة تتجه من الشرق إلي الغرب يمكن زراعتها. أما سهل شارون الواقع غربي أفرايم (السامرة) فصالح للزراعة، لكنه ينتهي غربًا بمنطقة مستنقعات لا فائدة منها. أما وادي اسدرالون المستوي الواقع إلي الجنوب الشرقي من سلسلة جبال الكرمل، فقد كانت تحده في القديم مستنقعات كمنطقة الحولة شمالي بحر الجليل. وإلي الجنوب من تلال يهوذا تنحدر الأرض تدريجيًا حتي النقب حيث يحد الجفاف من الزراعة. وتبدأ هضبة شرقي الأردن في الأرتفاع بشدة عن الوادي، إلا ان المنطقة المرتفعة (باشان، جلعاد، عمون، موآب) مناسبة جدًا للزراعة. II- المناخ للزراعة: يتمتع هذا البلد بتنوع مناخي مذهل بالنسبة لمساحته الصغيرة. ويتفاوت سقوط الأمطار بدرجة كبيرة، وذلك تبعًا للارتفاع وخط العرض. وتسقط الأمطار في الشمال بغزارة يمكن الاعتماد عليها، حيث تهطل علي المرتفعات أمطار مقدارها ثلاثون بوصة سنويًا، بينما لا تستقبل منطقة بير سبع في الجنوب إلا نصف هذه الكمية سنويًا مع عدم انتظام سقوطها. وكلما اتجهنا شرقًا نجد ان أمطارًا غزيرة تسقط علي المنحدرات الغربية المرتفعة بسبب العواصف الزوبعية، بينما يغلب الجفاف علي المنحدرات المواجهة للشرق. ويسقط علي غربي اليهودية في المتوسط أكثر من عشرين بوصة سنويًا، ولكن البحر الميت- الواقع علي بعد بضعة أميال إلي الشرق- يتلقي كمية مطر أقل من خمس بوصات سنويًا، وبالاتجاه شرقًا نجد أن مرتفعات عمون وموآب تتلقي كمية مطر مماثلة لما تتلقاه اليهودية، ولكنها تتناقص كلما اتجهنا شرقًا حتي نصل إلي الصحراء العربية. ويبدأ سقوط الأمطار خلال الفصل البارد، "فالمطر المبكر" يبدأ في أكتوبر، بينما يسقط "المطر المتأخر" في مارس وأبريل. وفي الأزمنة الكتابية كانت الدورة الزراعية تتوقف علي موسمي الجفاف والرطوبة، فكان الفلاح يزرع حقوله بكل الحبوب الهامة عند سقوط المطر، ويحصدها عند انتهاء موسم الأمطار. كما أن درجات الحرارة تتوقف علي الارتفاع عن سطح البحر، حيث تقل الحرارة علي المرتفعات طوال العام، مع تعرضها للصقيع في شهور الشتاء. ويقتصر انتشار الأشجار التي لا تتحمل البرودة الشديدة (مثل شجرة الزيتون) علي المنحدرات حيث تجد الحماية من صقيع المرتفعات ومن الرياح الباردة القادمة من الصحراء الشرقية. والثلج نادر إلا في الجبال العالية في شمالي لبنان. والفلاح الإسرائيلي يزرع محاصيله حسب نزول الصقيع وحسب كمية الأمطار. وكانت عمليات الزراعة والتقليم والحصاد وغيرها من العمليات الزراعية، تتم في وقت مبكر في المناطق المنخفضة. ج- التربة الزراعية: تأتي خصائص التربة في الأراضي المقدسة- كما في أي مكان آخر- تالية في الأهمية للتضاريس والصخور التي تحت التربة، والغطاء النباتي الطبيعي والمناخ. وهناك تنوع معقول في التربة في هذه المساحة الصغيرة. فالتربة في بعض الأودية الكبري، وفي سهل شارون خصبة تكونت من طبقات سميكة من الطمي، ولكنها في المرتفعات وفي المناطق الجافة عبارة عن طبقة رقيقة حجرية، وقد كانت التربة في القديم في فلسطين ومنطقة بير سبع تربة طفلية خصبة يصل سمكها إلي عدة بوصات، إلا أن الجفاف كان يحد من الإنتاج. وكانت التلال في يهوذا وأفرايم وعمون وموآب ذات تربة حجرية رقيقة ولكنها خصبة حيث أنها تربة جيرية نشأت وتطورت أساسًا من الحجر الجيري. كما أن التربة في الجليل وباشان وجلعاد خصبة ومنتجة لأنها تكونت حديثًا من طبقة البازلت التي تحتها، أما التربة علي المنحدرات شديدة الميل فهي أقل سمكًا. ويزيل الفلاح عادة الكثير من الأحجار من الحقل ليستخدمها كسياج أو كحائط للمصاطب التي يقيمها. د- امتداد الأراضي المزروعة: ليس من الواضح إن كان بنو إسرائيل قد مدوا حدود زراعاتهم إلي كل مناطق حكمهم السياسي في أيام داود وسليمان. وقد استصلحت إسرائيل في العصر الحاضر العديد من أراضي المستنقعات علي طول ساحل البحر المتوسط، وسهل إسدرالون وبحيرة الحولة، وهي مناطق لم تكن مستغلة في القديم. وهناك ما يؤكد أن شعوب المناطق المجاورة لإسرائيل، كانوا يعملون بالزراعة أيضًا حتي في النقب شبة الجاف، وعلي حدود صحراء عمون وموآب وأدوم. ولم يكن ذلك بسبب هطول أمطار أكثر. في ذلك الوقت- لأن العالم "جلوك" Gluck)) يعارض بشدة النظرية القائلة بأنه قد حدث تغير في الأراضي المقدسة خلال الأزمنة التاريخية المعروفة، كما يعتقد أن الجفاف قد نتج عن سوء استخدام الإنسان للأرض، وفشله في استخدام وسائل المحافظة عليها، التي جعلت- فيما مضي- من المناطق شبه الجافة، مناطق إنتاج غزير. ويشير "جلوك" إلي النبطيين الذين استطاعوا التغلب علي الجفاف في أدوم والنقب، ممتدحًا عملهم الجبار في خلق حقول منزرعة في الأودية. وقد أدت قدرتهم وتمكنهم من علم التربة والحفاظ علي الماء، إلي تحويل الأودية إلي مناطق خضراء، وإلي ازدهار الزراعة في العديد من القري. ولعل أهل موآب في القديم، تمكنوا- بمثل هذه الأساليب- من استمرار الإنتاج، وقت أن تسبب الجفاف في مغادرة أليمالك ونعمي امرأته وابنيه لمدينتهم بيت لحم، ليتغربوا في موآب (راعوث 1: 1- 5). وفي المناطق الأشد جفافًا حول دمشق وأريحا لم تعتمد الزراعة المتخصصة (كزراعة البساتين) علي المطر، بل كانت هذه المناطق تزرع بكثافة اعتمادًا علي الري من ماء الينابيع (في أريحا)، أو من المياه السطحية المنسابة من المنحدرات المطيرة لجبال لبنان الشرقية. وهناك مقولة قديمة مشهورة، وهي أن دمشق هي هبة جبل حرمون للصحراء. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 57905 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
 الطبوغرافيا في الزراعة: الأرض المقدسة بصفة عامة أرض جبلية مع وجود مساحات كبيرة من المنحدرات شديدة الميل علي طول أخدود وادي الأردن، مما يجعل الزراعة قاصرة علي أرض الوادي الضيقة، أو حيث يمكن الزراعة علي مصاطب. ومع أن وادي الأردن يصل عرضة إلي بضعة أميال، وهو مستو نسبيًا، إلا أنه سهل جاف يعلو سهلًا ضيقًا يفيض عليه النهر. ولم يكن الري ممكنًا بالأساليب المستخدمة في مصر أو في بلاد ما بين النهرين. وكانت أريحا وغيرها تحصل علي احتياجاتها من الماء من الينابيع والعيون المتفجرة من المرتفعات المجاورة، وليس من نهر الأردن. وتتميز المرتفعات الشمالية غربي وادي الأردن بالتلال التي تتخللها أودية عديدة تضم مساحات كافية لقيام الزراعة. وإلي الجنوب في تلال يهوذا، فإن الأرض منحدرة إلي حد كبير، إلا أن المصاطب الموجودة هناك، وقمم الجبال المتموجة في الإقليم الواقع بين أورشليم وبير سبع، تسمح بقيام زراعة حقلية. أما السهل إلي الغرب من جبال يهوذا، فهو - إلي حد كبير -عبارة عن سفوح متقطعة، إلا أنه توجد أودية قليلة تتجه من الشرق إلي الغرب يمكن زراعتها. أما سهل شارون الواقع غربي أفرايم (السامرة) فصالح للزراعة، لكنه ينتهي غربًا بمنطقة مستنقعات لا فائدة منها. أما وادي اسدرالون المستوي الواقع إلي الجنوب الشرقي من سلسلة جبال الكرمل، فقد كانت تحده في القديم مستنقعات كمنطقة الحولة شمالي بحر الجليل. وإلي الجنوب من تلال يهوذا تنحدر الأرض تدريجيًا حتي النقب حيث يحد الجفاف من الزراعة. وتبدأ هضبة شرقي الأردن في الأرتفاع بشدة عن الوادي، إلا ان المنطقة المرتفعة (باشان، جلعاد، عمون، موآب) مناسبة جدًا للزراعة. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 57906 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
 المناخ للزراعة: يتمتع هذا البلد بتنوع مناخي مذهل بالنسبة لمساحته الصغيرة. ويتفاوت سقوط الأمطار بدرجة كبيرة، وذلك تبعًا للارتفاع وخط العرض. وتسقط الأمطار في الشمال بغزارة يمكن الاعتماد عليها، حيث تهطل علي المرتفعات أمطار مقدارها ثلاثون بوصة سنويًا، بينما لا تستقبل منطقة بير سبع في الجنوب إلا نصف هذه الكمية سنويًا مع عدم انتظام سقوطها. وكلما اتجهنا شرقًا نجد ان أمطارًا غزيرة تسقط علي المنحدرات الغربية المرتفعة بسبب العواصف الزوبعية، بينما يغلب الجفاف علي المنحدرات المواجهة للشرق. ويسقط علي غربي اليهودية في المتوسط أكثر من عشرين بوصة سنويًا، ولكن البحر الميت- الواقع علي بعد بضعة أميال إلي الشرق- يتلقي كمية مطر أقل من خمس بوصات سنويًا، وبالاتجاه شرقًا نجد أن مرتفعات عمون وموآب تتلقي كمية مطر مماثلة لما تتلقاه اليهودية، ولكنها تتناقص كلما اتجهنا شرقًا حتي نصل إلي الصحراء العربية. ويبدأ سقوط الأمطار خلال الفصل البارد، "فالمطر المبكر" يبدأ في أكتوبر، بينما يسقط "المطر المتأخر" في مارس وأبريل. وفي الأزمنة الكتابية كانت الدورة الزراعية تتوقف علي موسمي الجفاف والرطوبة، فكان الفلاح يزرع حقوله بكل الحبوب الهامة عند سقوط المطر، ويحصدها عند انتهاء موسم الأمطار. كما أن درجات الحرارة تتوقف علي الارتفاع عن سطح البحر، حيث تقل الحرارة علي المرتفعات طوال العام، مع تعرضها للصقيع في شهور الشتاء. ويقتصر انتشار الأشجار التي لا تتحمل البرودة الشديدة (مثل شجرة الزيتون) علي المنحدرات حيث تجد الحماية من صقيع المرتفعات ومن الرياح الباردة القادمة من الصحراء الشرقية. والثلج نادر إلا في الجبال العالية في شمالي لبنان. والفلاح الإسرائيلي يزرع محاصيله حسب نزول الصقيع وحسب كمية الأمطار. وكانت عمليات الزراعة والتقليم والحصاد وغيرها من العمليات الزراعية، تتم في وقت مبكر في المناطق المنخفضة. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 57907 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
 التربة الزراعية: تأتي خصائص التربة في الأراضي المقدسة- كما في أي مكان آخر- تالية في الأهمية للتضاريس والصخور التي تحت التربة، والغطاء النباتي الطبيعي والمناخ. وهناك تنوع معقول في التربة في هذه المساحة الصغيرة. فالتربة في بعض الأودية الكبري، وفي سهل شارون خصبة تكونت من طبقات سميكة من الطمي، ولكنها في المرتفعات وفي المناطق الجافة عبارة عن طبقة رقيقة حجرية، وقد كانت التربة في القديم في فلسطين ومنطقة بير سبع تربة طفلية خصبة يصل سمكها إلي عدة بوصات، إلا أن الجفاف كان يحد من الإنتاج. وكانت التلال في يهوذا وأفرايم وعمون وموآب ذات تربة حجرية رقيقة ولكنها خصبة حيث أنها تربة جيرية نشأت وتطورت أساسًا من الحجر الجيري. كما أن التربة في الجليل وباشان وجلعاد خصبة ومنتجة لأنها تكونت حديثًا من طبقة البازلت التي تحتها، أما التربة علي المنحدرات شديدة الميل فهي أقل سمكًا. ويزيل الفلاح عادة الكثير من الأحجار من الحقل ليستخدمها كسياج أو كحائط للمصاطب التي يقيمها. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 57908 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
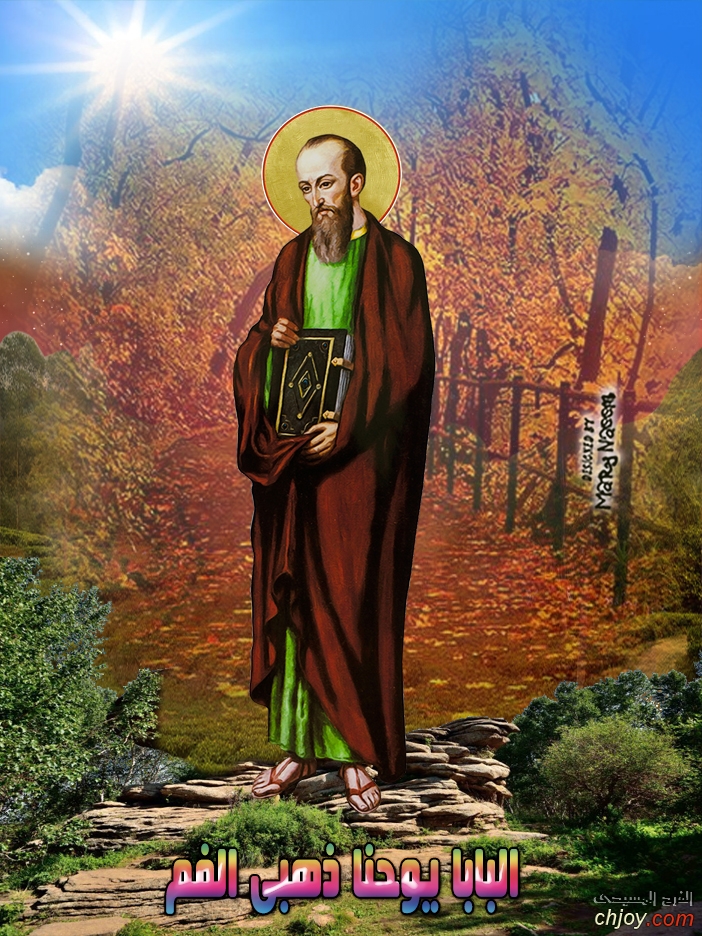 المريمات: ما دمنا نتحدث عن القديسين وقوة صلواتهم عنا وبركتهم يليق بنا أن نشير إلى "المريمات Mariology" لدى القديس يوحنا الذهبي الفم، والذي تتلخص نظرته في النقاط التالية: 1. القديس يوحنا ذهبي كراعي وكارز أكثر منه لاهوتي لم يرد أن يدخل في مناقشات ومجادلات لاهوتية(29)، فلم يذكر قط لقب "qeotokoc ثيؤتوكوس Theotokos" الذي تبنَّته مدرسة الإسكندرية وعارضته أنطاكية في ذلك الحين، بل ولم يذكر لقب والدة المسيح "خريستوتوكوس Christotokos" الذي اعتاده الأنطاكيون، Anthropotokos الذي استخدمه معلمه ديؤدور الطرسوسي. 2. علم بوضوح عن دوام بتولية القديسة مريم، إذ يقول: "نحن نجهل الكثير: كيف يوجد غير المحدود، في رحم، كيف يحمل ذاك الذي يحمل كل شيء وتلده امرأة، كيف تلد البتول وتبقى بتولا؟(30). وفي تفسيره إنجيل القديس متى دافع عن بتوليتها عند تفسيره العبارة: "لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر" ذاكرًا بعض العبارات الكتابية جاءت فيها كلمة "حتى" بطريقة لا تعني المحدودية(31)، نذكر على سبيل المثال "وأرسل الغراب فخرج مترددًا حتى نشفت المياه عن الأرض (تك 5: 7)، فإن كلمة "حتى" لا تعني أن الغراب عاد بعد أن نشفت المياه وجفت الأرض وأيضًا "قال الرب لربي اِجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك" (مز 11: 2)، لا يعني أن الجلوس عن يمين الآب ينتهي بوضع الأعداء موطئًا لقدميه، وأيضًا "يشرق في أيامه الصديق وكثرة السلام حتى يضمحل التمر" (مز 72: 7) لا يفي عدم إشراق الصديق أو نزع السلام بعد اضمحلال القمر، كما دلل القديس على بتوليتها وعدم إنجابها أولادًا آخرين من تسليم السيد لها في أيدي القديس يوحنا الحبيب حين كان معلقًا على الصليب. فلو كان لها أولادًا لما سلمها إليه. 3. إذ يصعب على البشرية قبول الولادة من العذراء، لهذا لم يترك الله البشرية تتخبط، إنما هيأ الأذهان لهذا العمل الفريد بتقديم بعض أعمال رمزية تعين البشرية في قبول هذا الحدث(32). أ. إخراج الله فردوسًا من أرض عدن البكر كرمز لعذراوية القديسة مريم (33). ب. سماح الله لبعض النساء العاقرات أن ينجِبن مثل سارة ورفقة وراحيل وحنة أم صموئيل هؤلاء كن يعلن قدرة الله كتهيئة لعمل أعظم، إذ يقول: "إنجاب العاقر اليصابات يقع في منتصف الطريق بين ولادتنا نحن وولادة السيد. فهي ولادة أقل من ولادة السيد من العذراء، لكنها أسمى من ميلادنا نحن حسب الطبيعة. بهذا الطريق قاد فكر العذراء من الولادة الطبيعية إلى ما يتعداها(34). |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 57909 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
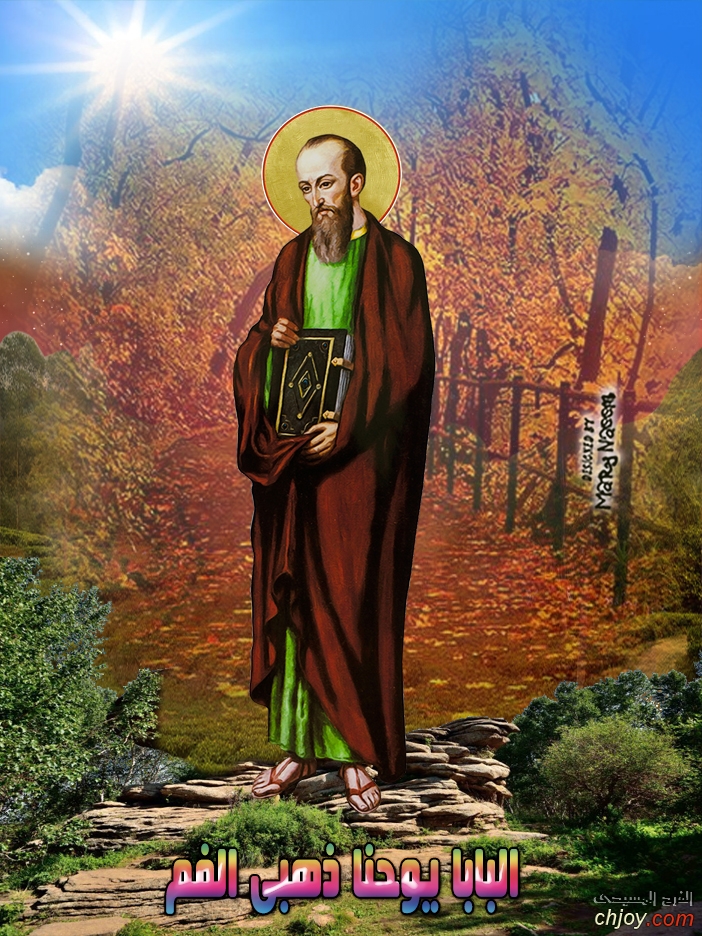 القديس يوحنا ذهبي كراعي وكارز أكثر منه لاهوتي لم يرد أن يدخل في مناقشات ومجادلات لاهوتية(29)، فلم يذكر قط لقب "qeotokoc ثيؤتوكوس Theotokos" الذي تبنَّته مدرسة الإسكندرية وعارضته أنطاكية في ذلك الحين، بل ولم يذكر لقب والدة المسيح "خريستوتوكوس Christotokos" الذي اعتاده الأنطاكيون، Anthropotokos الذي استخدمه معلمه ديؤدور الطرسوسي. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 57910 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
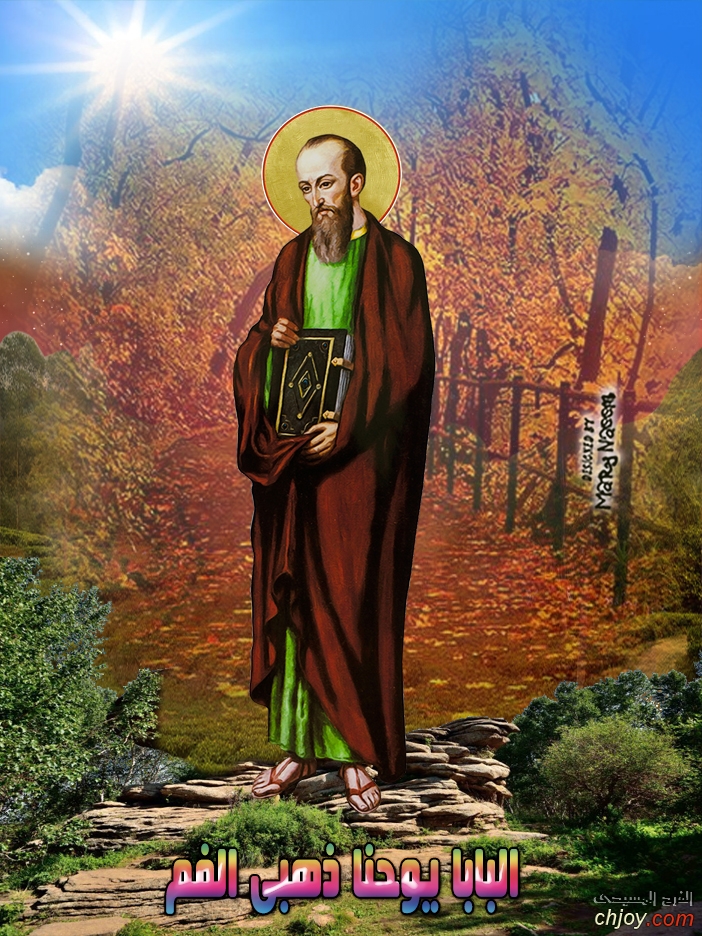 علم بوضوح عن دوام بتولية القديسة مريم، إذ يقول: "نحن نجهل الكثير: كيف يوجد غير المحدود، في رحم، كيف يحمل ذاك الذي يحمل كل شيء وتلده امرأة، كيف تلد البتول وتبقى بتولا؟(30). وفي تفسيره إنجيل القديس متى دافع عن بتوليتها عند تفسيره العبارة: "لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر" ذاكرًا بعض العبارات الكتابية جاءت فيها كلمة "حتى" بطريقة لا تعني المحدودية(31)، نذكر على سبيل المثال "وأرسل الغراب فخرج مترددًا حتى نشفت المياه عن الأرض (تك 5: 7)، فإن كلمة "حتى" لا تعني أن الغراب عاد بعد أن نشفت المياه وجفت الأرض وأيضًا "قال الرب لربي اِجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك" (مز 11: 2)، لا يعني أن الجلوس عن يمين الآب ينتهي بوضع الأعداء موطئًا لقدميه، وأيضًا "يشرق في أيامه الصديق وكثرة السلام حتى يضمحل التمر" (مز 72: 7) لا يفي عدم إشراق الصديق أو نزع السلام بعد اضمحلال القمر، كما دلل القديس على بتوليتها وعدم إنجابها أولادًا آخرين من تسليم السيد لها في أيدي القديس يوحنا الحبيب حين كان معلقًا على الصليب. فلو كان لها أولادًا لما سلمها إليه. |
||||