
 |
 |
 |
 |
|
|
رقم المشاركة : ( 5681 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
ماهية الرجاء  الرجاء هو الفضيلة الإلهية الثانية التي يفيضها الله في نفوسنا لدى قبول سرّ العماد، بها نأمل ونتوقع من الله بثقة، استناداً إلى وعوده الصادقة وإلى استحقاقات سيدنا يسوع المسيح، أن نفوز بعد مماتنا بالسعادة الأبدية وأن ننال من رحمة الله في هذه الحياة كل الوسائل الضرورية لتأمين خلاصنا الأبدي. بالرغم من أن الأعمال التي نقوم بها بدافع المحبة الصافية لله هي لإكمال الأعمال إلا أن تلك التي نقوم بها طمعاً بالمكافأة الأبدية ليست سيئة. أ-براهين كتابية: - »فسابقوا حتى تفوزوا... أما أولئك فلينالوا إكليلاً يفنى وأما نحن فإكليلاً لا يفنى« (1قور 24:9-25). -»فافعلوا للرب عالمين بأنكم ستأخذون من الرب جزاء الميراث« (قو24:3). - »نئن منتظرين التبني، افتداء أجسادنا« (روم 23:8). ب-أدان المجمع التريدنتينيمَن يقول بأن القيام بالعمل الصالح ابتغاء للمكافأة هو عمل شرير. ج-براهين عقلية: - إن جودة وصلاح أي عمل ينبع من موضوعه. وبما أن موضوع الرجاء هو الله فإن الرجاء هو فضيلة ترضي الله. - إذا كنت أحب الله لأنه خيري وكنزي لا يعني أني أنكر صلاحه في ذاته. لا تتنافى المحبة مع الرجاء. ولا تتناقض بين كون الله محبوباً من أجل ذاته ومحبوباً لأنه خيري وعزائي وسبب كمالي وعلة خلاصي. أما إذا أحببت الله فقط من أجل المكافأة وبدونها ما كنت أحببته، فإن ذلك يعني تمسّكي بالخطيئة. قال توما الإكويني: »إن الله هو موضوع إيماننا بصفة كونه الحقيقة القصوى، وموضوع محبتنا لكونه الخير الأسمى، وموضوع رجائنا لكونه المكافأة العظمى«. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 5682 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
علاقة الرجاء بالإيمان والمحبة  الثلاثة معاً تكوّن الفضائل الإلهية التي تنظّم علاقة الخالق بالخليقة وتشكّل الوسيلة التي بها يستطيع الإنسان أن يعيش مع الله حياة اتحاد روحي ومودة كبيرة. ويقف الرجاء بين الإيمان والمحبة كما تتوسط الأخت الصغيرة أختيها الكبيرتين ممسكة أيديهما. »فالإيمان قوام الأمور التي ترجى وبرهان الحقائق التي لا تُرى« (عب 1:11). ودرجة رجائنا تتأثر بدرجة إيماننا بقدرة الله وأمانته ورحمته. الرجاء يوصلنا إلى عتبة المحبة. فالرغبة في امتلاك المحبوب تضاعف قوة المحبة في قلب الإنسان. والمحبوب هو الله، والسعادة الأبدية هي امتلاك الله بالعيان. وبدورها فإن المحبة تقوّي الرجاء: »فمحبتنا الحالية لله الذي لا نراه تزيد فينا الرغبة في رؤيته«. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 5683 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
ضرورة الرجاء 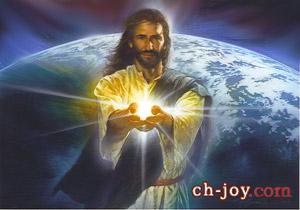 لا يخلص الإنسان بدون الرجاء. فكيف ننال العفو إن لم نرجو العفو؟ وكيف ننال السعادة الأبدية ونتغلّب على الصعوبات التي تعترض سبيلها إن كنا لا نرجوها؟ لذلك أمر الكتاب المقدس بها: »سابقو أنتم حتى تفوزوا. أما أولئك فلينالوا إكليلاً يفنى وأما نحن فإكليلاً لا يفنى« (1كور 25:9-27). »لا تحزنوا كمن لا رجاء لهم« (1تس 12:4). »وصي أغنياء الدهر الحاضر ألا يتكلوا على الغنى الغير ثابت بل على الله الحي الذي يؤتينا كل شيء بكثرة لنتمتع به«(1تيم 17:6). ومن الضروري أن يعلن المسيحي عن رجائه مباشرة في المواقف الهامة، عند التجارب وساعة الموت، وضمناً عندما يعمل الأعمال الصالحة. » لا أحد يذهب إلى الآب، قال الإكويني، ما لم يرجُ شيئاً منه«. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 5684 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
الرجاء من وجهة نظر الفلسفة المعاصرة  ليست الفلسفة المعاصرة في أغلب نظرياتها مشجعة للرجاء المسيحي. بل بالعكس تقاومه وتحقره. ورغم سلبية كل ذلك إلا أن المسيحي يستطيع الإفادة من النقد ليصلح من ذاته حيث لزم الإصلاح. والانتقاد الأول هو أن الرجاء المسيحي وهمي، فردي وأناني، ولذلك لزم البحث عن رجاء عام ملموس وحقيقي. أ-نيتشه:الرجاء المسيحي هو فضيلة الضعفاء. »المسيحي لا يضرّ ولا ينفع وهو متهور على أمره. هو غريب عن شغل الأرض إذ أن سيرته في السماويات. وعندما يضع المسيحي نقطة الاستناد في العالم الآخر فإنه ينزع من الحياة مركز ثقلها فتنتهي الحياة حيث يبدأ ملكوت الله« (نيتشه، إرادة القوة). وقد بلغ نيتشه مبلغ الإلحاد عندما أعلن موت الله وأن الإنسان هو الذي قتله ليأخذ مكانه. فنادى بالإنسان »السوبرمان«. ومن المضحك المبكي أن نيتشه انتهى نهاية غير موافقة لنظرياته. هو الذي نادى بالسوبرمان كان يبكي من الحزن والتأثّر على حيوان يراه في الطريق. ب-الوجودية الملحدة:تدعو الإنسان إلى نبذ الأمل لأنه غير حقيقي ولأنه لا يوجد هدف لأعمالنا وبالتالي لا مكافأة تُنتظر. ومعنى الكلمة في قاموسها هو العبث واللامعقول، فلا مكان لله بين البشر »إذ أن الحياة هي قضية بشر ويجب معالجتها بين البشر أنفسهم« أي بدون تدخّل الله (من أسطورة سيزيف، ألبير كامو). ج-الماركسية:فقد وجدت البديل للرجاء المسيحي وهذا البديل هو مادي محسوس يقوم على بناء مدينة المستقبل وإيقاظ الغضب ضد الظلم (باكونين). فنادت الماركسية بالعلم والتقدّم والمستقبل وبالتحرير الاقتصادي والاجتماعي. وادّعت أن العقبة أمام تحقيق ذلك هي الديانة المسيحية لأنها تعلّق الأمل على مدينة آتية وغير موجودة وتبعد الانتباه عن بناء المدينة الحاضرة. وتريد الطبقة البرجوازية بذلك أن تسحق وتخدّر الطبقة الكادحة (لينين). في الماركسية الإنسان للإنسان هو الله والمسيح المنتصر. د-الجواب:لم تفِ الماركسية بتعهداتها. وبدلاً من دكتاتورية البرجوازية ولدت دكتاتورية الحزب والدولة. ولم تعد الدولة تمثّل الشعب وخير برهان هو ما حدث مؤخراً في المعسكر الشرقي، في روسيا وفي أوروبا الشرقية. وكما في البلاد الرأسمالية فإن الأموال تصرف في التسلّح. ولم يعد الشعب يتمتع بالثروة الموعودة، ومازال يكتفي بالمواعيد. ولا شك أنه تمّ تحسّن ملموس. ولكن أين ذلك من المجتمع المثالي الموعود والحريات المثالية التي تنادي بها الماركسية؟. ماذا ينفع الإنسان إذا حررته من الله وتركته وحيداً ساعة الموت؟ أليس ذلك شبيهاً بمرافقة إنسان محكوم عليه بالموت إلى ساحة الإعدام والترفيه عنه طيلة الطريق ثم تركه وحيداً يعاني حشرجة النزاع؟ وملخص الجواب: إن قتل الله يعني قتل الإنسان وإن الإلحاد واللاإنسانية هما وجهان متكاملان لنفس العملة. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 5685 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
التطلّعات البشرية وموقف المسيحيين منها  هنالك تطلعات بشرية حقة وواجبة على المسيحيين أن يتطلعوا إليها ويساهموا في تحقيقها. وهي الجزء المحسوس والأرضي من الرجاء المسيحي: - تطلعات اقتصادية: تحسين أوضاع الدول النامية والأفراد. - تطلعات ثقافية: محو الأمية. - تطلعات سياسية: استقلال الفئات العرقية والدينية. - تطلعات علمية: غزو الفضاء وحل مشكلات الطاقة. - التطلعات إلى السيطرة على الموارد الموجودة في الأرض لخدمة الإنسان. وهذا مأرب جيد إذ أن الله أورث الإنسان الأرض وطلب إليه أن يخضعها لسلطانه. أما موقف المسيحي منها فهو لا يستطيع أن يقف مكتوف الأيدي بحجة أنه يتطلّع إلى مجيء المسيح في نهاية العالم. فالمسيح في الدينونة سوف يديننا على المحبة وعلى مشاركتنا في بناء حياة كريمة هنيئة لأنفسنا ولإخوتنا البشر. وإطعام الجياع وكسو العراة وزيارة المرضى والسجناء المذكورة في الإنجيل ليست إلا نماذج مبسّطة للأعمال المتنوعة والملّحة المطلوبة من المسيحيين. ويقول قرار المجمع الفاتيكاني الثاني »الكنيسة في عالم اليوم«: » غير أن انتظار الأرض الجديدة بدلاً من أن يخفف من اهتمامنا باستثمار هذه الأرض، يجب بالأحرى أن يوقظها فينا: فجسم العائلة الإنسانية الجديدة ينمو فيها، راسماً الخطوط الأولى للعالم الآتي« (رقم 39). والحاضر الزمني يهم المسيحي كما أنه مهتم بالمستقبل. ويلّح عليه الحاضر بالعمل من أجل قضايا الساعة. وبالإضافة إلى ما ذكر على المسيحي أن يهتم بالدفاع عن حريات الآخرين كلما رأى أنها مكبوتة وأن يعمل ضد الظلم أينما كان ولإحلال المساواة بين الناس. والدافع لذلك هو الأمر الصادر عن المسيح وقوة رجائنا به، هو الذي سيأتي ليسألنا الحساب. وهذا الرجاء يجعلنا نتحرّك للعمل بالرغم من صعوبة الظروف. وهل أقوى من رجاء صاحب الحقل الذي عندما وجد الزؤان بين القمح لم ييأس بل صبر بانتظار الحصاد لينقي بيدره... والمسيحي لا ييأس من قوى الشر العاملة والمتحركة حوله، لأنه يعلم بمن آمن وبمن يعطيه الغلبة على الشر. وكلمة المسيح لا تزال ترن في أذنه: »ثقوا لقد غلبت العالم«. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 5686 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
خطايا ضد الرجاء 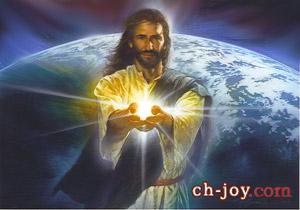 أ- اليأس:هو رفض السعادة الأبدية بسبب الشعور باستحالة البلوغ إليها. وتلك خطيئة يهوذا. وهذا لا يعني حتماً فقدان الإيمان بالرحمة الإلهية إنما التعامي عنها وتجاهلها وعدم طلبها عن كبرياء أو ظناً بأن الإثم أثقل من أن يُغفر. واليائس يضع نفسه في موقف خطير، لأنه يستبدل سعادته الأبدية بالسعادة السهلة المنال فيستسلم للرذيلة تاركاً كل الأعمال الصالحة التي لا تحرّك وتراً فيه. إن اليأس هو فقدان الحافز والزنبرك لكل أعماله الصالحة... وفاقد الرجاء هو فاقد للمحبة أيضاً. وبإمكاننا معالجة خطيئة اليأس من خلال: - التأمل في الإنجيل ولاسيما في أمثال الرحمة الإلهية في إنجيل لوقا (الابن الضال، اللص اليمين...). - التأمل في آلام المسيح والقيام بصلاة "درب الصليب". - التأمل في سعادة السماء. - قراءة حياة الخطأة التائبين. - الصلاة لمريم العذراء ملجأ الخطأة وأم الرجاء. - الاهتمام بتنمية الفرح لأن ذلك أفضل علامة على رجائنا. ولا ينمو الرجاء في جو كآبة وسوداوية. وكيف لا نفرح ونحن نعلم بأن الله الذي سنسعد بمشاهدة وجهه في السماء هو الآن معنا في الإنجيل والقربان وفينا بنعمته وحضوره العجيب؟ ب- الإدّعاء: هو الاعتماد، من جهة، على القوة الذاتية فقط دون الاعتماد على نعمة الله. ومن جهة أخرى أنه الظن بأننا سنحصل على رحمة الرب والسعادة الأبدية بدون الحاجة إلى التوبة. وهذا يعني الإيمان المفرط برحمة الله دون الإيمان بعدله. قال الإكويني: »الاعتقاد بالرحمة وعدم إقامة وزن للعدل الإلهي ليس من باب الفضيلة إنما هو غباء«. ذلك أن الادعاء هو احتقار لعدل الله. أما خير علاج لهذه الخطيئة فهو أن نتذكّر هذه الآية: »أن الله لا يُستهزأ به«. ج- التفاؤل الأعمى: الظن بأن الأمور ستهون وأن المشاكل تجد حلاً بنفسهـا بدون دفع أي ثمن من الجهد والعناء. وقال لهم المتنبي: تريد من لقيان المعالي رخيصة ولابد دون الشهد من إبر النحل د- قلة الثقة: وهذه المرة ليست بقدرة الله عامة وإنما بفعالية الصلاة وبفعالية الالتجاء إليه تعالى في التجارب والكروب. ويحتاج أولئك الأشخاص إلى تعميق إيمانهم بالله وبقدرته، إلى اختبار الصلاة والتذكّر بأن »كل شيء يؤول لخير الذين يحبون الله« وأنه تعالى »يكتب كتابة مستقيمة بأسطر منحرفة«. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 5687 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
لأننا في الرجاء نلنا الخلاص
 رسالة بابوية لمنح العالم الرجاء المطران أنطوان أودو نشر البابا بنديكتس 16 يوم الجمعة 3 ت2 رسالة جديدة حول موضوع الرجاء المسيحي، وفيها يعرض على الإنسانية التي تبدو وكأنها خائبة، الرجاء الذي يحمله إليها المسيح. تبدأ الرسالة بمقطع من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل رومة: " لأننا في الرجاء نلنا الخلاص " (روم 8 / 24) ويشدّد البابا على أنَّ ما يميّز المسيحيين هو كونهم لهم مستقبل، وهم يعرفون أن حياتهم لا تنتهي بالعدم (الفقرة 2) (راجع 1 تس 4 / 13) " ولا نريد أيها الإخوة، أن تجهلوا مصير الأموات لئلا تحزنوا كسائر الناس الذين لا رجاء لهم" الرجاء هو لقاء " أن نصل إلى معرفة الله، الله الحقّ، هذا يعني أنّنا نِلنا الرجاء "، هذا ما يقوله البابا في الفقرة 3 من الرسالة، ولكي يوضّح ذلك، فإنه يلجأ إلى مثل واقعي من حياة الكنيسة وقدّيسيها. فالرجاء المسيحي يتجلّى في حياة عبدة سودانية جوزفين باخيتا المولودة في دارفور سنة 1869 وكانت دوماً تردّد: " إنني محبوبة بشكل نهائي ومهما حصل لي، فإن الحب ينتظرني وهكذا أصبحت حياتي صالحة " ( الفقرة 3 ). فبمعرفة هذا الرجاء " خَلُصَتْ " باخيتا ولم تعد تشعر بأنها مستعبدة بل هي إبنة لله، حرّة. وتعمَّدت ودخلت الحياة الرهبانية في إيطاليا وتحوّلت إلى مُرسَلة. فاللقاء مع الله جعلها تشعر بمسؤولية إعلانه للآخرين. ويتابع البابا في الفقرة الرابعة مُظهراً أن يسوع لم يأتِ لكي يعرض علينا رسالة اجتماعية ثورية لأنّه لم يكن " محارباً في سبيل تحرير سياسي ". لقد حمل لنا يسوع: " اللقاء مع الإله الحيّ، وبالتالي اللقاء مع الرجاء الذي هو أقوى من عذابات العبودية، ولذلك فهو يحوّل من الداخل حياة العالم ". ويختم البابا الفقرة الخامسة قائلاً: " السماء ليست بفارغة. الحياة ليست حصيلة بسيطة لقوانين المادة ونتائجها، ولكن في كل شيء وفي الوقت نفسه، وفوق كل شيء، هناك إرادة شخصية، هناك الروح الذي بيسوع، ظهر لنا على أنّه الحب." فالمسيح هو " الذي يقول لنا في الواقع من هو الإنسان وما عليه أن يعمل ليصبح حقاً إنساناً ". إنّه يدلنا على هذه الطريق، وهذه الطريق هي الحقيقة " ( الفقرة 6 ) نستخلص من ذلك كلّه أنّه بالنسبة للبابا، ليس الرجاء " شيئاً "، ولكن " شخصاً "، فهو لا يعتمد على ما هو عابر، بل على الله الذي يَهِب نفسه وبشكل دائم. اعتباراً من الفقرة 16 يتوقف البابا عند فكر الفيلسوف فرنسيس بيكُن: تحوّل الإيمان الرجاء المسيحي في الأزمنة الحديثة . يقول بيكُن: هناك علاقة جديدة بين العلم والواقع ويُطبّق ذلك على اللاهوت. فهذه العلاقة بين العلم والواقع تعني أن السيطرة على الطبيعة التي أعطاها الله للإنسان، والتي فُقدت بالخطيئة الأصلية، قد أخذت مكانها ثانية، بالعلم طبعاً. ويتابع البابا في الفقرة 17 شرح فكر بيكُن: إلى الآن، كان الإنسان ينتظر استرجاع ما خسر عندما طُرِد من الفردوس، بواسطة الإيمان بيسوع المسيح، وفي ذلك كان يرى الخلاص . أما الآن، فهذا الخلاص الذي هو استرجاع " الفردوس " الضائع، لم يعد الإنسان ينتظره من الإيمان، ولكن من العلاقة المكتشفة بين العلم والوقع. هذا لا يعني أن الإيمان، مع هذه الرؤية الجديدة، قد أصبح منفياً: ولكنه بالأحرى انتقل إلى مستوى آخر إلى مستوى الحياة الخصوصية والأرضية وفي الوقت نفسه، يصبح الإيمان نوعاً ما، من دون معنى، بالنسبة للعالم. هذه الرؤية قد حددت اتجاه الأزمنة الحديثة، وهي تؤثر بالتالي على أزمنة الإيمان الحالية، التي هي في الواقع وخاصة أزمة الرجاء المسيحي. وهكذا يتخذ الرجاء لدى بيكُن شكلاً جديداًَ، لقد أصبح إيماناً في التطور... سوف يقودنا إلى " ملك الإنسان". ويتابع البابا تفسيره في الفقرة 18 قائلاً: لدينا مفهومان مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بفكرة التطور وهما العقل والحرية. فالتطور هو تطور في نمو مُلِك العقل، ويعتبر هذا العقل بوضوح كقوّة خير ومن اجل الخير. فالتطور يتجاوز كل التبعيات إنّه تطوّر نحو الحرية التامة. وفي هذا المجال تعتبر الحرية كوعد فيه يتجّه الإنسان نحو الكمال. أمّا في الفقرة 19 فيتوقف البابا عند شرح الثورة الفرنسية انطلاقاً من مفهوميْ العقل والحرية، قبل أن ينتقل في الفقرة التي تتبع إلى الثورة الماركسية. فالثورة الفرنسية هي محاولة لبسط سلطة العقل والحرية على الحاصر وبأسلوب سياسي واقعي. انطلاقاً من واقع الثورة ونتائجها يفكر " عمانوئيل كانت " حول معنى الأحداث في مرحلتيْها الأولى والثانية وينشر كتاباً في السنة 1792 عنوانه : " انتصار مبدأ الخير على مبدأ الشر وتأسيس مُلْكَ الله على الأرض " ويكتب " كانت " في هذا المجال: " إن العبور المتدرج من إيمان الكنيسة إلى سلطة الإيمان الصافي الوحيدة هي اقتراب ملكوت الله ". ويزيد " كانت " أن باستطاعة الثورات أن تسرع في العبور من إيمان الكنيسة إلى الإيمان العقلاني، إلى الإيمان الديني، أعني بواسطة الإيمان العقلاني. يتابع البابا في الفقرة 20 ملاحظاً أن هيمنة العقل والحرية خلقت في القرن التاسع عشر البروليتاريا الصناعية. فكان لا بدَّ من ثورة بروليتارية بعد الثورة البورجوازية. لقد برز ماركس لكي يحقّق ما سمّاه " كانت " " ملك الله ". فبعد القضاء على حقيقة الماورائيات، لا بدَّ من إقامة حقيقة الأرض. إن انتقاد السماء يتحوّل إلى انتقاد الأرض، وانتقاد اللاهوت يتحوّل إلى انتقاد السياسة. فالتطوّر نحو الأفضل، نحو عالم صالح نهائياً لا يتأصّل في العلم ولكن في السياسة في سياسة قائمة على العلم التي تعرف كيف تكتشف بنية التاريخ والمجتمع والتي توجّه نحو طريق الثورة، نحو تغيير كل شيء. إنّ وعد ماركس، استناداً إلى دقة تحاليله وإلى تحديده الوسائل التي تقود نحو التغيير الجذري، قد بهرت الجماهير ولا زالت. الفقرة 21 : انتصر ماركس في ثورته إلاّ أنّ خطاه ظهر للعيان. لقد أشار إلى تحقيق الثورة إلاّ أنّه لم يقُل كيف على الأمور أن تستمر فيما بعد. إن خطأ ماركس هو المادية، لأنّ الإنسان ليس فقط نتاج الشروط الاقتصادية، ولا يستطاع شفاؤه من الخارج فقط، بواسطة الشروط الاقتصادية المناسبة. يتابع البابا تحليله فكرة التطور والعقل والحرية في الفقرة 23، وفيها يطرح بعض الأسئلة الجوهرية على الفلسفة الحديثة: يقول البابا أجل إن العقل هو عطية الله الكبرى للإنسان، وانتصار العقل على اللاعقل هو أيضاً هدف من أهداف الإيمان المسيحي. ولكن متى يسيطر العقل ؟ أعندما ينفصل عن الله ؟ أم عندما يصبح أعمى أمام الله ؟ هل يبقى العقل عقلاً كاملاً في هذه الحالة ؟ لكي يكون التطوّر تطوّراً، فإنّه يحتاج إلى نمو الإنسانية الأخلاقي، وكذلك على مقدرة العقل أن تنفتح على قوّة الإيمان الخلاصيّة، على موقف التمييز بين الخير والشرّ. بهذه الطريقة فقط يصبح العقل حقاً إنسانياً. يصبح إنسانياً إن استطاع أن يدلّ الإرادة إلى الطريق، ولا يستطيع ذلك إلاّ إذا نظر إلى أبعد من ذاته. فالإنسان بحاجة إلى الله وإلاّ بقي محروماً من الرجاء. وفي الفقرات 24 - 26 يجد البابا أنَّ باستطاعة العلم المساهمة كثيراً في أنْسَنة العالم والإنسانية، إلاّ أنّ باستطاعة العلم أيضاً أن يهدم الإنسان والإنسانية، إن لم يتوجّه بواسطة قوى خارجة عنه. فليس العلم هو الذي يخلّص الإنسان، فالإنسان مُخَلَّص بالحب. ولذلك باستطاعتنا القول إن فرنسيس بيكُن وأتباع التيار الفكري الحديث الذي أسّسه، الذين اعتبروا أنّ الإنسان يخلص بالعلم قد خطئوا. يحتاج الإنسان إلى الحب غير المشروط من اجل الخلاص، يحتاج إلى أن يسمع قول بولس الرسول: ( روم 8 / 38 - 39 ) راجع غل 2/20 ) خاتمة القسم الأول الفقرة 30 - 31 هذا الرجاء العظيم الذي يسعى وراءه الإنسان من خلال رجاءاته الصغيرة والمتعددة لا يستطيع أن يكون إلاّ الله وحده الذي يُشعل العالم والذي يستطيع أن يُقدّم لنا ما لا نستطيع أن نصل إليه وحدنا. الله هو أساس الرجاء، وليس أي إله كان، ولكن الله الذي له وجه بشري والذي أحبنا حتى النهاية كل واحد بمفرده والإنسانية بكاملها. ملكوته ليس بعالم خيالي آخر، وليس موجوداً في مستقبل لا يتحقّق أبداً. ملكوته هو حاضر حيث هو محبوب وحيث حبّه يلتقي بنا. إن حبّه فقط يعطينا إمكانية الثبات بتجرّد يوماً بعد يوم، دون أن نفقد اندفاع الرجاء، في عالم هو في طبيعته غير كامل، ولكن وفي الوقت نفسه، إنّ حبّه لنا هو الضمان لوجود ما نشعر به بغموض ومع ذلك ننتظر في أعماقنا الحياة التي " حقاً " الحياة.  " الأمكنة التي فيها نتعلم الرجاء ونعيشه " 1 - الصلاة ( 32 - 34 ) 2 - العمل ( 35 ) 3 - الألم ( 36 - 40 ) 4 - الدينونة ( 41 - 48 ) يتوقف بنديكتوس 16 عند أربع محطات فيها يتعلم الإنسان الرجاء ويعيشه. 1- وأول محطة هي " الصلاة " : ويقول البابا في الفقرة الأولى الرقم 32: " إن لم يسمعني أحد، فالله يستمر في الإصغاء. وإن لم أستطع بعد الكلام مع أحد ولا أستطيع أن أنادي أيّاً كان، أستطيع أقلّه أن أخاطب الله دوماً ... فالإنسان الذي يصلّي لا يكون أبداً وحيداً كلياً. " بعد هذه المقدمة حول أهمية الصلاة في العلاقة مع الله يتحدث البابا عن شخصية فيتنامية: الكاردينال نكوين فان توان. لقد سُجِن مدة ثلاث عشرة سنة في الفيتنام وفي السجن كتب كتاباً صغيراً عنوانه: " صلوات الرجاء ". وبعد تخْلية سبيله انطلق في العالم كلّه شاهداً للرجاء. ولكي يؤكد على أهمية الصلاة يستشهد البابا بمفكِّره المفضّل أوغسطينس فيما يقول في الصلاة والعلاقة مع الله : " وهكذا فالله، عندما يجعل الإنسان ينتظر يوسّع رغبة الإنسان، وعندما يجعله يرغب فيه، يوسّع روحه، وعندما يوسّع روحَه يزيد في مقدرته على الاستيعاب ". ( راجع فل 3 / 13 ) ويختم البابا تعليقه على كلام أوغسطينس الرائع بقوله: " أن نصلّي لا يعني الخروج من التاريخ والانكفاء في مجال خاص بسعادة فردية. فالطريقة الصحيحة في الصلاة هي عملية تطهير داخلي تجعلنا أهلاً للوقوف أمام الله وبالتالي الوقوف أمام الناس". ويتابع البابا تأمله في تعلّم الصلاة قائلاً: " الصلاة هي تنقية لرغباتنا ورجاءاتنا. فبواسطتها يتحرّر الإنسان من الأكاذيب الباطنية التي بها يغش نفسه: فالله يتمحصها والمقابلة مع الله تحمل الإنسان على أن يعترف بأكاذيبه... فإن كان الله غائباً، فعلي لربما أن أختبئ وراء الأكاذيب، لأنه لا يوجد أحد يستطيع أن يغفر لي ... فاللقاء مع الله يوقظ ضميري، لأنّه لم يعد يقدّم لي التبرير الذاتي، ولم يعد ضميري تأثيراً ذاتياً أو نتيجة لما يحوط بي، بل يصبح الضمير المقدرة على الإصغاء للخير في حد ذاته. 2 - في الفقرة 35 التي تبدأ بالحديث عن " العمل " يقول البابا : كل عمل جدي ومستقيم يقوم به الإنسان هو رجاء فعّال ". ويتابع البابا تفكيره في هذا المجال مشدّداً على معنى الرجاء في المفهوم المسيحي. فالرجاء هو دوماً رجاء من أجل الآخرين، وهو رجاء فعّال، بواسطته نجاهد في سبيل ألاّ تتوجه الأمور نحو " نهاية فاسدة " فهذا الرجاء الفعّال يحافظ على العالم في حالة من الانفتاح على الله. واستناداً إلى هذه الرؤية يبقى الرجاء حقاً رجاءً إنسانياً. 3 - الألم " : يتوقف البابا عند فكرة الألم وعلاقتها بالرجاء مطوّلاً ويخصص لذلك الفقرات 36?40، وهذا مما يشير إلى الأهمية الفكرية والوجودية التي يمنحها اللاهوتي والمسيحي إلى مثل هذه الحقيقة الإنسانية. يقول البابا: " لا بدَّ لنا من أن نعمل كل شيء في سبيل تخفيف الألم ولكن علينا أن ننتبه، ليس بتحاشي العذاب وبالهرب من الألم الذي يشفي الإنسان، ولكن بالمقدرة على قبول الاضطرابات والولوج إلى النضوج من خلالها، وان نجد معنى لها بالاتحاد مع المسيح الذي تألم بحب ليس حدود ". وفي هذا المجال يتوقف البابا مطولاً عند صلاة وشهادة حياة عاشها الشهيد الفيتنامي في السجن بول لورباو- تين ( +1857) تحوَّل الألم بقوّة الرجاء، إلى صلاة شكر وتسبيح. فالألم دون أن يتوقف عن كونه ألماً يتحوّل رغم كل شيء إلى نشيد تسبيح. 4 - الدينونة : وفي الفقرات 41 - 48 يعطي البابا أهمية شديدة لموضوع الدينونة من حيث أنه قِبْلَة الرجاء والحقيقة. يبدو أن هذا الجزء هو مخصص للدينونة في علاقتها مع الرجاء وهو في الوقت نفسه خاتمة لكل الرسالة، فيها يصل البابا إلى النتائج التي يريد ان يستخلصها من كل ما تقدّم. يبدأ البابا بالقول: ينتهي الجزء الذي يتحدّث عن سرّ المسيح في " النؤمن" وأيضاً سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات ". فمنذ البدايات كانت الدينونة بالنسبة للمسيحيين مقياساً لتنظيم حياتهم اليومية، وكدعوة موجّهة إلى ضمائرهم وأيضاً كرجاء في عدل الله ... هذه النظرة نحو المستقبل مُنحت المسيحية اهتماماً كبيراً بالحاضر. (راجع الكاتدرائيات في الفقرة 42 ، يلاحظ البابا أنّه في العصر الحديث الاهتمام بالدينونة النهائية قد اختفى: يصبح الإيمان المسيحي فردياً ويتوجّه نحو خلاص النفس الشخصي. أمّا التفكير في التاريخ العام، على العكس من ذلك، فيسيطر عليه الاهتمام بالتطوّر، واتخّذ الانتظار شكلاً جديداً مختلفاً جذرياً. فالإلحاد في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، هو بحسب جذوره وأهدافه أخلاقية، هو اعتراض على الظلم وعلى التاريخ العام. فالعالم الذي فيه هذا الكم من الظلم، من ألم الأبرياء، ومن تعسّف الحكم لا يستطيع أن يكون من صنع الله. فالله الذي قد يكون مسؤولاً عن عالم كهذا، لا يستطيع أن يكون إلهاً عادلاً ولا حتى بالطبع إلهاً صالحاً. فباسم الأخلاق لا بُدَّ من رفض هذا الإله وبما أنّه ليس هناك إله يخلق العدل، يبدو أنّه على الإنسان نفسه أن يكون مدعواً إلى أن يحقق العدل. إن كنّا نقبل بهذا الاعتراض الذي يحمله العالم ضد الله ونفهمه، إلاّ أنَّ ادّعاء الإنسانية مقدرتها على القيام بما لم يعمله أيّ إله هو ادّعاء خاطئ في أساسه. ومن مثل هذا الادّعاء نصل إلى أوحش التعديات على العدل، لأنَّ مبدأ هذا الادّعاء خاطئ. إنَّ العالم الذي يريد أن يخلق بذاته عدله، هو عالم من دون رجاء. لذلك، بتابع البابا في الفقرة 44: الاعتراض على الله باسم العدل لا يجدينا نفعاً. فالعالم من دون الله هو عالم من دون رجاء ( راجع أف 2/12 ). وحده الله يستطيع أن يخلق العدل. والإيمان يؤكّد لنا بأنَّ الله يحقق ذلك. فصورة الدينونة الأخيرة ليست بالدرجة الأولى صورة مخيفة، ولكنها صورة رجاء ... وهي صورة فيها الخوف، لأنّها تدعو إلى المسؤولية. الله هو العدل ويخلق العدل، هذه هي تعزيتنا ورجاؤنا. ولكن في عدل الله هناك أيضاً في الوقت نفسه النعمة، ونعرف ذلك عندما نرفع نظرنا إلى يسوع المصلوب والقائم من بين الأموات؛ فعلى العدالة والنعمة أن يؤخذا معاً في علاقتهما الباطنية. فالنعمة لا تلغي العدالة، ولا تحوّل الباطل إلى حق. ( راجع مثل الغني ولعازر لو 16/ 19 - 31 ) ( راجع أيضاً 1 قور 3 / 12 - 15 ). في الفقرة 47 يجد بعض اللاهوتيين أن النار هو المسيح، هو النار الذي تحرق وتخلّص، هو الديّان والمخلّص ... فنظرة المسيح، وخفقان قلبه يشفياننا بواسطة التحوّل المؤلم، وكأنّنا نعبر " بالنار". وهذا ألم مفرح، لأنّه بواسطته يخترقنا حبّه كالشعلة، يساعدنا على أن نكون في النهاية " ذواتنا " بشكل كامل وفي الوقت نفسه " من الله " بشكل كامل. هكذا يتوضّح التداخل بين العدالة والنعمة: هذا لا يعني أن طريقة حياتنا هي بدون معنى، ولكن قدراتنا لا تلتصق بنا إلى ما لانهاية، إذا بقينا، أقلّه، مشدودين نحو المسيح، نحو الحقيقة ونحو الحب. فدينونة الله هي رجاء لأنّها في آن عدالة ونعمة ( راجع ص 76 آخر الرقم 47 علاقة العدالة مع النعمة في الله الخاتمة مريم نجمة الرجاء ( الفقرتان الأخيرتان 49 - 50 ) تُحيِّ الكنيسة مريم، أم الله، على أنّها نجمة البحر في نشيد قديم يعود إلى ما بين القرنين السابع والتاسع، أعني منذ أكثر من ألف سنة. يقول قداسة البابا مستوحياً من صورة البحر والنجمة، الحياة البشرية هي طريق، ونحو أيّة نهاية ؟ وكيف نجد الطريق ؟ فالحياة هي رحلة على بحر التاريخ، وغالباً ما يكون معتماً وعبر العواصف، هي رحلة فيها نحدّق بالكواكب التي تدلنا على الطريق. فالكواكب الحقيقية في حياتنا هم الأشخاص الذي عرفوا أن يعيشوا بالاستقامة. هم أنوار الرجاء. لا شكَّ أن يسوع هو النور، هو الشمس الذي يشرق على ظلمات التاريخ كلّها. ولكن للوصول إليه، نحن نحتاج إلى أنوار قريبة منّا، أشخاص يعطوننا النور وهم يستقونه من نوره فيقدمون لنا اتجاهاً في عبورنا. ومَنْ يستطيع أكثر مِنْ مريم أن يكون لنا نجمة الرجاء، هي التي " بالنَّعَم " التي قالتها لله نفسه فتحت باب عالمنا، وأصبحت تابوت العهد الحي الذي فيه صار الله بشراً، وأصبح واحداً منّا، ونصب خيمته في وسطنا ( راجع يو 1 / 14). وفي الفقرة 50 يرفع البابا الصلاة إلى مريم التي قبلت الرجاء وأعطته للعالم، طالباً منها الشفاعة . |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 5688 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
المحبة القديس أفرام السرياني  لأن المحبة تطرح المخافة خارجاً، من حوى المحبة لا يرفض أحداً قط لا صغيراً ولا كبيراً، لا شريفاً ولا وضيعاً، لا فقيراً ولا موسراً، بل يصير موطئاً تحت الكل، يحتمل كافة العوارض، يصبر علي سائر النوائب، من له محبة لا يترفع علي أحد، لا يتشامخ ولا يغتاب أحداً، بل ويعرض عن الثلابين. من له محبة لا يسلك بغش ولا يعرقل أخاه، من حوى المحبة لا يغار حسداً، ولا يحسد ولا ينافس، ولا يفرح بسقطة آخرين، ولا يشجب الخاطئ بل يحزن له ويعضده، لا يعرض عن أخيه في شدته بل يساعده ويموت معه، من فيه المحبة يعمل مشيئة اللـه وهو تلميذ له محق لأن سيدنا الصالح نفسه قال: بِهذا يعلم الكل أنكم تلاميذي إن أحببتم بعضكم بعضاً. من فيه محبة لا يصنع لنفسه شيئاً ولا يقول أن له شئ يملكه خصوصاً لو كان سائر ما له مشاع للكل، من له محبة لا يحتسب أحداً غريباً بل يصنع الكل أهله وانسباءه، من له محبة لا يغتاظ ولا يتشامخ ولا يتحرق غيظاً ولا يسر بالظلم، ولا يلبث في الكذب، لا يحتسب له عدواً إلا المحال وحده، من له محبة يصبر علي سائر المحن يتعطف يتمهل. مغبوط إذاً المقتني المحبة فإن المسافر بِها إلي اللـه يعرف وليه ويقبله في حضنه، ويغتذي نظير الملائكة، ويتملك مع المسيح، بالمحبة ورد الإله الكلمة إلي الأرض وفتح لنا بِها الفردوس وأورى الكل الارتقاء إلي السماء كنا أعداء اللـه فصالحنا بِها، فبواجب قلنا : إن المحبة هي اللـه ومن يثبت في المحبة يثبت في اللـه. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 5689 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
الإيمان العامل بالمحبة (غل5: 6)
 «لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئاً ولا الغرلة بل الإيمان العامل بالمحبة» (غل5: 6) يؤكّد الرسول بولس في قوله هذا الذي وجهه في حينه إلى أهل الإيمان في غلاطية، على أهمية اقتران الأعمال الصالحة بالإيمان في الحياة المسيحية الحقة جاعلاً ذلك حقيقة إيمانية في الدين المسيحي المبين، كاشفاً النقاب عن بطلان شريعة الختان التي كانت علامة عهد بين اللّـه وإبراهيم أبي الآباء وبينه تعالى والنبي موسى وشعبه. وإن شريعة الختان هذه أضحت كالغرلة لا قيمة روحية لها ولا أهمية في المسيحية بل إن من يمارسها دينياً يصبح غريباً عن المسيح، وبهذا الصدد يقول الرسول بولس في موضع آخر «إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئاً»(غل5 : 2) فالأمر المهم في المسيحية هو الإيمان الذي يعلنه الإنسان حالما ينتمي إلى المسيح يسوع ثم الإيمان العامل بالمحبة أي المقترن بالأعمال الصالحة بعد إقامته العهد مع اللّـه بولادته الجديدة من السماء بنيله سر المعمودية المقدس فيتبرر ويتقدس ويصير ابناً للّه بالنعمة. ويبرهن على صدق إيمانه بتحلّيه بالأعمال الصالحة وبخاصة فضيلة المحبة الصادقة التي اعتبرها الرب يسوع علامة واضحة مميزة لتلاميذه بقوله: «بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حبّ بعضاً لبعض»(يو13 : 35) أجل إننا بمحبتنا اللّـه تعالى التي تظهر بمحبتنا القريب نتحلى بالإيمان العامل بالمحبة. ويعرّف الرسول بولس الإيمان بقوله: «أما الإيمان فهو الثقة بما يُرجى والإيقان بأمور لا تُرى»(عب11: 1) وبعبارة أخرى، الإيمان هو التسليم بكل ما أعلنه لنا اللّـه تعالى على ألسنة أنبيائه في أسفار العهد القديم ورسله الأطهار وتلاميذه الأبرار في أسفار العهد الجديد من حقائق إيمانية ولئن لا تدركها عقولنا البشرية، وقبول دساتير الإيمان المسيحي التي حددتها المجامع المسكونية الثلاثة في نيقية سنة 325 وقسطنطينية سنة 381 وأفسس سنة 431 وصار قبولها ملزماً على المؤمنين. كما إن الإيمان هو أيضاً اليقين بالأمور المرجوة فنراها وكأنها قد تمت فعلاً، فالإيمان المسيحي إذن يجمع بذاته التسليم بالعقائد الإيمانية، والثقة بالرب يسوع المسيح ابن اللّـه الوحيد وفادي البشرية. وتنجلي قوة الإيمان المسيحي الحي عندما الإيمان يقترن بالأعمال الصالحة الموازية له، والتي هي ضرورية للخلاص مثله. وبهذا الصدد يقول الرسول يعقوب للذين يدّعون أنهم مؤمنون «ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد أن له إيماناً ولكن ليس له أعمال، هل يقدر الإيمان أن يخلّصه...، أنت تؤمن أن اللّـه واحد حسناً تفعل والشياطين يؤمنون ويقشعرون ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت. ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم اسحق ابنه، ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده»(يع2: 14 ـ 24). أجل قد يبدو كلام الرسول يعقوب هذا مناقضاً لكلام الرسول بولس الذي يقول: «متبررين مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدّمه اللّـه كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله... إذن نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس»(رو3 : 24 ـ 31). ثم يتخذ الرسول بولس من إبراهيم كما فعل الرسول يعقوب مثالاً على ذلك إذ يقول: «آمن إبراهيم باللّـه فحسب له براً... فكيف حُسب أَهو في الختان أم في الغرلة ليس في الختان بل في الغرلة وأخذ علامة الختان ختماً لبر الإيمان الذي كان في الغرلة ليكون أباً لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة كي يحسب لهم أيضاً البر. وأباً للختان للذين ليسوا من الختان فقط بل أيضاً يسلكون في خطوات إيمان أبينا إبراهيم»(رو4: 1 ـ 12). وقد كتب القديس البطريرك مار سويريوس الكبير تاج السريان رسالة إلى يوليان أسقف هاليكارتاس تضمنت التوفيق بين قَوْلَيْ الرسولين في موضوع التبرير بالإيمان والأعمال شارحاً ذلك بما خلاصته أن غير المسيحي ولئن لم يأت أعمالاً صالحةً عندما يؤمن بالمسيح ينال حالاً مغفرة خطاياه الجدية والشخصية بالإيمان وحده وبعد أن يعتمد باسم الثالوث الأقدس ينال الخلاص بناءً على قول الرب يسوع: «من آمن واعتمد خَلَصَ ومن لم يؤمن يدن»(مر16: 16) وبالمعمودية يولد من السماء ويصير ابناً للّه بالنعمة ويبدأ عهداً جديداً مع اللّـه ويصمم أن يسلك كما يحق لإنجيل المسيح مقرناً إيمانه بالأعمال الصالحة وإلاّ حينذاك يصير إيمانه باطلاً ما لم يقترن بالأعمال الصالحة وعلى حد تعبير الرسول يعقوب «الإيمان بدون أعمال ميت»(يع 2: 20). تماماً مثل إبراهيم الذي حسب إيمانه براً وهو في الغرلة أما بعد الختان فقدم أعمالاً صالحةً مقترنةً بالإيمان إذ أطاع أمر اللّـه وقدم ابنه وحيده اسحق للذبح ورأينا أن الرب يسوع يركز على أعمال إبراهيم لما قال لليهود جواباً على قولهم أبونا هو إبراهيم قال لهم: «لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم» (يو 8: 38 و39). فيجب أن يكون إيمانه «الإيمان العامل بالمحبة» (غل 5: 6) على حد تعبير الرسول بولس الذي يقول أيضاً «لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند اللّـه بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون»(رو 2: 13) وهذا القول مبني على تعليم الرب يسوع القائل: «ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات»(مت 7: 21). وقد أيّد له المجد تعليمه هذا عملياً عندما «جاء إليه مرة أمه وإخوته ولم يقدروا أن يصلوا إليه لسبب الجمع فأخبروه قائلين أمك وإخوتك واقفون خارجاً يريدون أن يروك فأجاب وقال لهم أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلمة اللّـه ويعملون بها»(لو 8: 19 ـ 21). ولا غرو من ذلك فقد أعلن رب المجد قانون الحكم في دينونة العالمين في السماء الذي هو قانون «الإيمان العامل بالمحبة» ومن علامة المحبة المميزة خدمة إخوة يسوع الأصاغر ففي يوم الدين سيقول الرب يسوع للمؤمنين الصالحين «تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم لأني جعت فأطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريباً فآويتموني عرياناً فكسوتموني مريضاً فزرتموني محبوساً فأتيتم إليَّ فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب متى رأيناك جائعاً فأطعمناك أو عطشاناً فسقيناك، ومتى رأيناك غريباً فآويناك أو عرياناً فكسوناك ومتى رأيناك مريضاً أو محبوساً فأتينا إليك. فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم»(مت 25: 34 ـ 40). أما الأشرار فسيقول لهم «اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته...» (مت 25: 41) ويعلل الرب إصداره هذا الحكم عليهم لأنهم لم يفعلوا الخير لمن كانوا بحاجة إلى ذلك فكأنهم لم يفعلوا للرب يسوع ذاته، فيمضي الأشرار إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية (مت25: 46) ويقول الرسول بولس بهذا الصدد لأهل كورنثوس: «لأنه لا بد أننا جميعاً نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيراً كان أم شراً»(2كو5: 10) وقال في رسالته إلى العبرانيين «لأن اللّـه ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم»(عب6: 10). أجل، من هنا نعلم أن الرب يسوع يريدنا أن نخدم القديسين وإخوته المعوزين ونشعر معهم فنرعى أمورهم ونمد يد العون للفقير ونتفقد الأرامل والأيتام، معتبرين خدمتنا لهم خدمة للرب يسوع ذاته لأنهم إخوته الأصاغر، وما نفعله معهم ولهم كأننا فعلناه له. ويعتبر هذا العمل من صلب الدين المسيحي كقول الرسول يعقوب: «الديانة الطاهرة النقية عند اللّـه الآب هي هذه افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم»(يع1: 27). كما أن الرحمة هي ابنة المحبة فمن عمر قلبه بمحبة اللّـه تظهر محبة اللّـه بمحبته للقريب. وهذا معلمنا الرسول بولس في الإصحاح الثالث عشر من رسالته الأولى إلى أهل الإيمان في كورنثوس يتغنى بفضيلة المحبة ولذلك يدعى ذلك الإصحاح أنشودة المحبة حيث يفضل أفعالها وثمارها وتضحياتها على الاستشهاد في سبيل الإيمان واجتراح المعجزات الباهرات حتى نقل الجبال والتكلم باللغات العديدة، ويختم الرسول هذا الإصحاح بقوله: «أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة»(1كو13: 13) فالمحبة أعظم الفضائل وهي زبدة الوصايا الإلهية. وما أسمى جواب الرب يسوع للناموسي الذي سأله قائلاً: «يا معلم أية وصية هي العظمى في الناموس فقال له يسوع تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه هي الوصية الأولى والعظمى والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك، بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء»(مت22: 35 ـ 40). فما أروع المحبة التي وصفها الرسول يوحنا بقوله: «اللّـه محبة». أيها الأحباء: يعلمنا الرب يسوع في مثل العذارى العشر الخمس الحكيمات والخمس الجاهلات درساً في الإيمان والرجاء والمحبة فقد كانت جميع العذارى العشر مؤمنات ومنتظرات مجيء الرب ثانية بإيمان متين ورجاء لا يخيب ولكن عندما أبطأ مجيئه نعسن كلهن ونمن ولما جاء العريس دخلت العذارى الخمس الحكيمات معه إلى العرس أما العذارى الخمس الجاهلات اللواتي كان لهن الإيمان والرجاء كصديقاتهن ولم يكن لهن زيت الأعمال الصالحة وخاصة زيت المحبة وابنتها الرحمة فانطفأت سرجهن وذهبن إلى الباعة ليشترين زيتاً وحينذاك جاء العريس فدخلت معه إلى العرس العذارى الخمس الحكيمات المستعدات اللواتي كان لهن إلى جانب الإيمان والرجاء، الأعمال الصالحة أعمال الرحمة والمحبة، أما الجاهلات فطردن إلى الظلمة الخارجية. فالإيمان إذن بدون الأعمال ميت. وكما يعلمنا الرب يسوع أيضاً درساً في ضرورة الأعمال الصالحة إلى جانب الإيمان، في مثل الغني ولعازر (لو16: 19 ـ 31) وقد بنى على هذا المثل ملفان الكنيسة القديس مار يعقوب السروجي موعظة روحية رائعة في ميمر يعتبر من عيون الأدب السرياني الروحي حيث يقول: لم تسجل خطية لهذا الغني ولم يذكر عنه أنه أتى أمراً منكراً قط لا بل كان متمسكاً بالناموس الموسوي تمسكاً شديداً وكان يدعو إبراهيم (أبي إبراهيم) ولما مات رأى نفسه يتعذب في الجحيم والسبب في ذلك لأنه لم يرحم لعازر المسكين الذي كان مطروحاً عند بابه يشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني. أيها الأحباء: إن حلول موعد الصوم الأربعيني المقدس يعد فرصة ذهبية سانحة لنا لنجاهد روحياً ضد إبليس ونغلبه بإيماننا الذي هو علامة النصر، فلنلهج بناموس الرب ليلاً ونهاراً... ونمارس الفضائل السامية ولنقرن إيماننا بالأعمال الصالحة وبخاصة أعمال الرحمة كتوزيع الصدقات ومساعدة الفقراء ورعاية الأيتام والأرامل فيكون إيماننا حقاً عاملاً بالمحبة فننال الغلبة بالإيمان |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 5690 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
محبّة القريب ونقاوة القلب
 ركنا الحياة المسيحيّة: محبّة القريب ونقاوة القلب. لذا قيل: "الديانة الطاهرة النقيّة عند الله الآب هي هذه افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم" (يع 1: 27). محبّة القريب كالنفس تكون أو لا تكون. الحاجز بينك وبين أخيك يجب أن يزول. أحبّ قريبَك كنفسك. كل تحفّظ لديك حيال أخيك من أنانيتك. وحيث الأنانية لا يمكن أن تكون محبّة. لا يمكنها أن تثبت. المحبّة كاملة أو لا تكون. موقف كامل بلا شائبة. المحبّة أن تتحرّر، تماماً، من تمسّكك بما لك. برأيك، بموقفك، بقنيتك. لذلك قريبك مرآة وتحدٍّ. لا يبدأ قريباً لك. تبدأ قريباً لذاتك. ينتهي كذلك إذا رغبتَ وسعيتَ. أنت تدنو من قريبك بمقدار ما تنأى عن أهوائك. أهواؤك هي أناك الذي أنت بحاجة لأن تنبذه، لأن تكفر به. إن فيك أناً وأناً. فيك القويم وفيك المعوجّ. أناك الذي هو في خروجك من نفسك باتّجاه قريبك هذا سليم معافى. هذا لا يأتيك عفواً. تصنعه أنت بقوّة إرادتك وعون الله. أما أناك الذي يجعل نفسك تراكم أهواء ذاتية تتمسّك بها وتسلك فيها سلوك العبودية والعبادة فمعيوب ومعطوب. هذا عليك أن تضعه، أن تخلعه عنك من الداخل. تُهلكه عن إرادة منك وإلاّ تَكَرّس الخلل فيك. هذا الخلل، بالضبط، هو الخطيئة. الخطيئة خطأ في الكيان. مَن يصنع الخطيئة يكون عبداً للخطيئة. قريبك وَجَع طالما أنت قابع في نفسك. كلُّه، والحال هذه، إزعاج لأنّه يَحدّ من تمدّد ذاتيتك، إلاّ في ما يوافق مزاجك. القريب يُمسي قضية مزاج. ولكنْ، ما إن تخرج من نفسك إليه حتى تلقاه، على غير ما توقّعته، جميلاً، وأقول ولا أجمل. هذا، في الحقيقة، لأنّ الجمال ليس في أخيك، في ذاته، في اللحم والدم، في حسن المظهر، في المبنى. هذا عرضة للفساد أبداً. لذا لا يمكنه أن يكون جميلاً. الجمال تستشفّه، بالأحرى، من موقف منك حياله. لا يأتيك الجمال من رؤية العين بل، بالأولى، من معاينة القلب. الجمال من نقاوة القلب. في نقاوة القلب جمال ولا أبهى. أنقياء القلوب يعاينون الله. لِنَقيِّ القلب كلُّ خَلْقِ الله جميل لأنّه "اللابس النور كالثوب". الربّ قد ملك والجمال لبس. البشاعة وجه الخطيئة. الموضوع ليس ما تنظر بل كيف تنظر، إلامَ تنظر. ليس الحُسن في المنظر هو المسألة. الحُسن عابر، انسجام بلاستيكي. بعد حين يبهت ويذبل وييبس. الجمال أن تعاين زرع الله في خلق الله، نورَ الله، من الداخل، أن تعاين الله. الله خَلَقَ كل شيء حسناً. لذلك قريبك تكتشفه اكتشافاً. تكتشف نور الله فيه. تعاينه إيقونة لله. قريبك سرّ. القرابة سرّ تشترك فيه بمقدار ما تتنقّى طويّتك. الحبّ يأتي من نقاوة، من عفّة، ولا يأتي من تأجّج شهوة. الشهوة في الحبّ تعدٍّ على الحبّ، تشويهٌ، مِسْخٌ، تمظهر بالحبّ. أن تساوي ما بين المحبّة وأهواء نفسك هو القول بأن جذر الخطيئة فيك، أي الهوى، هو من الله. إنْ تفعلْ ذلك تؤلِّه هواك وتحسب الله خادماً للخطيئة فلا يعود فيك مكان للحقّ. إذ ذاك تسكن في الباطل. هذا هو الجحيم، الظلمة البرّانية. فيه لا ترتوي. تبقى عَطِشاً إلى الأبد. تقيم في الموت، في العذاب، لأنّك مفطور، أصلاً، على الحياة، وما تأتيه لا يضخّ فيك حياة. والحقّ أنّ المحبّة لا تأتي الإنسان إلاّ من فوق. ما هو تحت، هنا والآن، بات تلفيقاً. لذا قيل "المحبّة هي من الله" (1 يو 4: 7). وينبغي لنا أن يحبّ بعضنا بعضاً كما أحبّنا (1 يو 4: 11). وكيف أحبّنا؟ بوضع نفسه لأجلنا. إذاً بوضع أنفسنا لأجل الإخوة نكون قد أحببنا محبّة حقّانية، على غرار محبّة الله لنا. من هنا القول: "بهذا قد عرفنا المحبّة أنّ ذلك وضع نفسه لأجلنا فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة" (1 يو 3: 16). أن نضع أنفسنا لأجل الإخوة معناه أن نسلك، إرادياً، بإزائهم، وكأنّنا خدّام لهم. ابن الإنسان ما جاء ليُخدَم بل ليَخدُم. لذا مَن يحبّ يستخدم نفسه لأجل الإخوة. الكبير، عند الله، هو مَن يتصاغر. الخدمة، بيننا، هي مجال المحبّة بامتياز. وذروة الخدمة أن تبذل نفسك لأجل الإخوة. "ليس حبّ أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبّته". هذا كلّه لا يتحقّق إلاّ إذا أحببنا الله أولاً وحصراً. لا شريك لله في محبّتك له. لذا تُفرغ نفسك من نفسك ليتسنّى لك أن تتعاطى الله على هذا النحو. في ذلك التماس إرادي للعدم. تفعل ذلك حين تموت عن أناك، عن خطيئتك، عن هواك. خطيئتك، منذ البدء، كانت وجوداً كاذباً، زائفاً، عملاً من أعمال الإرادة الشَرود. لذا مِنْ عَمَلِ الإرادة، أيضاً، والحال هذه، أن تسلك، من جهة الخطيئة، وكأنّها العدم، وجود عدمي، وجود تَذُوق فيه، دائماً، طعم العدم. تَذُوقه ولا أَمَرّ، حيث البكاء وصريف الأسنان، حيث الدود لا يموت. في ذلك، في التماس العدم إرادياً، موتٌ عن الخطيئة ولكنْ حياةٌ لله، عدمٌ من جهة الخطيئة ولكنْ وجودٌ من جهة البرّ. هذا ما يجعل الموت الإرادي ضرورة. يسوع تسمّر، إرادياً، على الصليب، لا لأنّه كان مستأهلاً لأن يموت، بل لأنّه لاق بمَن أحبّنا أن يقدِّم نفسه لنا صورة عما هو لائق بنا أن نكون إيّاه. البار يعلّم الخطأة البرّ حتى إذا ما ارتضَوا، عن إرادة، أن يموتوا، من جهة خطاياهم، جارَوه في مسير البرّ فتبرّروا بالموت إلى حياة أبديّة. المسيح كلمةُ الحقِّ وقد أبان لنا في نفسه الطريق، والطريق يفضي إلى حياة جديدة. "أنا هو الطريق والحقّ والحياة". كلُّ الحياة مسيحٌ حتى يكون كلٌّ، على غرار المسيح، مسيحاً يحدّث عن المسيح. لذا بغير المسيح ما كان ليكون لنا خلاص. لقد أبان الله، قديماً، لموسى نموذج الخيمة وقال له أن يقيم ما هو على مثالها، والمسيح بات الإنسان الجديد، الخيمة الجديدة، آدم الجديد، الذي يقيمُ الروحُ، من صِلبه، إنسانية جديدة، على مثاله. وإذا ما كان قد قيل قديماً إنّ الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، فالأحرى أن من خُلِق الإنسان على صورته ومثاله هو مسيح الربّ. به كنّا في الأصل، بكلمة الله أُبْدِعنا، ثم سقطنا. ولكنْ عاد الله فأقام خيمتنا الساقطة، من جديد، بيسوع المسيح، ليبدعنا، بالروح، على مثاله، من جديد. هكذا كان كلمة الله، ابنُ الله المتجسّد، وارثاً لكل شيء. ألِفُ الناس وياؤهم. "به كان كلُّ شيء وبغيره لم يكن شيء مما كوِّن. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس" (يو 1). زبدة القول أنّ يسوع هو القريب وأصل كل قرابة، ولا قرابة إلاّ بنقاوةٍ تجعل يسوع حاضراً فيك أبداً في الروح |
||||