
 |
 |
 |
 |
|
|
رقم المشاركة : ( 5081 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
الكتاب المقدس
 قداسة البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص تدوين الوحي الإلهي إن الكتاب المقدس، الذي بين أيدينا، هو كلام اللّه الحي، الذي أنزله تعالى على ألسنة أناس قديسين، اختارهم ليكونوا وسطاء بينه وبين البشر، فتلقّنوا الوحي منه، وبلّغوه البشر. كما أمرهم أيضاً بأن يدوّنوه في كتاب، ليكون مناراً للهدى، ليس لجيلهم فقط، بل أيضاً لسائر الأجيال والدهور. وفي هذا الصدد كتب الرسول بولس إلى تلميذه تيموثاوس قائلاً: «وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة... كل الكتاب هو موحى به من اللّه ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البّر»(2تي3: 15و16). ومن المسلَّم به أن أول مَنْ أمره اللّه بتدوين الوحي الإلهي هو النبي موسى الذي عاش قبل الميلاد بنحو ألف وخمسمائة سنة، وكلّمه اللّه فماً لفمٍ (خر19: 14ــ19). وعلى أثر المعجزات الباهرة التي عملها اللّه لخلاص شعب النظام القديم، إذ أطعمهم خبز الملائكة، المنّ النازل من السماء، وأرواهم من ماء فجّره من صخرة، كان تعالى قد أمر موسى قائلاً: «اكتب هذا تذكاراً في الكتاب»(خر17: 14). وجاء في سفر التثنية ما يأتي: «فعندما كمّل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها، أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلاً: خذوا كتاب التوراة هذه ودعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهداً عليكم»(تث21: 24ــ26). وحدة الكتاب المقدس: اشترك بكتابة أسفار الكتاب المقدس، أكثر من أربعين شخصاً، يمثلون نواحي شتى في الحياة، فقد عاشوا في أماكن مختلفة، وفترات زمنية متباينة، فالفترة الزمنية الممتدة ما بين كتابة السفر الأول والسفر الأخير من الكتاب، تقارب الألف وخمسمائة سنة. كما قد تفاوتت درجات ثقافة الكتّاب، ورتبهم الاجتماعية والدينية. وانعكس كل ذلك على أساليب كتاباتهم، ولكنهم خضعوا جميعاً للوحي الإلهي الذي مصدره اللّه تعالى، ولذلك لما جمعت أسفار الكتاب المقدس، بإرشاد الروح القدس، جاءت متكاملة متسلسلة، على الرغم من تعدّدها وتنوع مواضيعها، وكوّنت كتاباً واحداً مقدّساً، بوحدة عجيبة فريدة، وغاية واحدة، هي إعلان اللّه ذاته الإلهية للبشر، وتحديد علاقته بهم ووعده إياهم بإرسال المخلص، وإتمام الوعد الإلهي بتجسد الإله الكلمة الرب يسوع المسيح الذي فدى البشرية بإهراق دمه الثمين، وهو محور الكتاب المقدس من ألفه إلى يائه، ومركز الدائرة فيه، الأمر الذي جعل الرسول يوحنا أن يختم إنجيله بقوله: «وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه»(يو20: 31). الكتاب المقدس ينطوي على كلام الله: يقيم الكتاب المقدس الدليل الناصع على أنه موحى به من الله، فقد صرّح كتّابه بأن ما دوّنوه إنما هو كلام اللّه تعالى الذي أنزله على ألسنتهم وبهذا الصدد جاء في سفر الخروج ما يأتي: «فكتب موسى جميع أقوال الرب»(خر24: 4) ويقول النبي إشعيا: «اسمعي أيتها السموات، واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم»(إش1: 1و2) ويقول النبي إرميا: «كانت كلمة الرب إليّ قائلاً، قال الرب لي»(إر1: 4و7) و «هكذا تكلّم الرب... قائلاً اكتب كل الكلام الذي تكلّمتُ به إليك بسفرٍ»(إر30: 2) وجاء في سفر حزقيال النبي ما يأتي: «وصار كلام الرب إلى حزقيال، وكانت عليه يد الرب»(حز1: 3) والرسول بولس يقول: «نشكر اللّه بلا انقطاع لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من اللّه قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة كلمة اللّه»(1تس2: 13). «وأعرّفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان لأني لم أقبله من عند إنسان ولا عُلِّمتُه، بل بإعلان يسوع المسيح» (غلا1: 11و12). أمانة كتّاب الكتاب: لا بد من أن نذكر ههنا، إن كتّاب الأسفار المقدّسة، لم يتمكنوا أغلب الأحيان من إدراك الحقائق الإلهية والعقائد السمحة التي أوحاها اللّه في قلوبهم، ومع ذلك فقد أودعوها أسفارهم بأمانة تامة، إذ كتبوا ما أمرهم اللّه أن يدوِّنوه، دون أي اعتراض أو احتجاج، وبهذا الموضوع يقول الرسول بطرس: «نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، الخلاص الذي فتّش وبحث عنه أنبياء، الذين تنبّأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أيُّ وقتٍ أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. الذين أُعلِن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أُخبِرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشّروكم في الروح القدس المرسل من السماء»(1بط1: 9ــ12). تحقيق النبوات التي يبرهن على صدق الكتاب: ومما يبرهن على صدق الكتاب المقدس، وأنه موحى به من الله، محتوياته، فهو ينطوي على نبوات صادقة، وحقائق إلهية سامية، لا يمكن أن تكون من إنتاج بشر. فأغلب النبوات المدونة في أسفار العهد القديم قد تحققت بعد مرور قرون عديدة على إعلانها، نذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، النبوات التي قيلت عن مجيء المخلص الرب يسوع المسيح: فمن ميلاده بالجسد من عذراء تنبّأ النبي إشعياء قائلاً: «ولكن يعطيكم السيد نفسه آيةً. ها العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عمانوئيل»(إش7: 14) وتنبّأ النبي ميخا أنه يولد في بيت لحم أفراثة(مي5: 2) كما حدد دانيال زمن مجيئه إلى العالم وأنه يموت في سنة 482 من خروج أمر ملك فارس لبناء المدينة (9: 25و26) وحددت النبوات أن موته يكون صلباً، أي بثقب يديه ورجليه(مز22: 16) وإن صالبيه يقتسمون ثيابه بينهم وعلى لباسه يقترعون(مز22: 18) وإن صلبه يكون بين آثمين(إش53: 12) وإن عظماً لا يُكسَر منه، وإنه يطعن في جنبه(عد9: 12 وزك12: 10) وإنه يقوم من بين الأموات (مز68: 1) في اليوم الثالث (يو1: 17و2: 10ومت12: 10) وأنه يصعد إلى السماء ويجلس عن يمين الله(مز110: 1). وقد تنبّأ الرب يسوع نفسه نبوات عديدة نذكر منها نبوته على خراب المدينة المقدسة سنة 70م. ولأهمية النبوات كبرهان على صدق الكتاب قال الرسول بطرس: «وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلق كوكب الصبح في قلوبكم»(1بط1: 19). فكل هذه النبوات التي ذكرناها، التي تحققت بحذافيرها في أوانها، لدليل ناصع قاطع على أن الكتاب المقدس الذي بين أيدينا هو كتاب الله. سمو تعليم الكتاب المقدس وتأثيره الروحي: يتّضح صدق الكتاب المقدس أيضاً من سمو تعاليمه الأدبية والروحية، وتأثيره الخفي في حياة الأفراد والجماعات. فقد تغيّرت حياة ملايين من البشر ونالوا الخلاص بعد قبولهم إياه دستوراً لهم في الحياة، وإيمانهم بأنه رسالة اللّه تعالى التي أوحاها على لسان عبيده لتكون للبشر دستوراً للإيمان والأعمال. فبعد أن كانوا خطاةً ضالين عادوا إلى اللّه تائبين سالكين الطريق المستقيم، مؤمنين بالرب يسوع صائرين قديسين. كما أن مجتمعات عديدة، اتخذت الكتاب المقدس أساساً لقوانينها وشرائعها ونظمها، فسادت العدالة وتوطّد السلام في جوانبها. فالكتاب المقدس نور لسبيل الأفراد والأمم، وهو خير مرشد إلى الطريق والحق والحياة، وبهذا الصدد كتب لوقا في سفر أعمال الرسل قائلاً: «كانت كلمة اللّه تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جداً، في أورشليم. وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان» (أع6: 7) «وكان اسم الرب يسوع يتعظم، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع... هكذا كانت كلمة اللّه تنمو وتقوى بشدة» (أع19: 17ــ20). أسفار الكتاب المقدس: يتكون الكتاب المقدس من جزئين، يسمى الجزء الأول بالعهد القديم، والجزء الثاني بالعهد الجديد. وتعني كلمة (عهد) الوصية أو الميثاق أو العقد الذي يرتبط به اثنان، وتشير هذه اللفظة هنا إلى العهد الذي قطعه اللّه بينه وبين إبراهيم أبي الشعوب وبينه تعالى وبين كليمه موسى وشعب النظام القديم في سينا، وفي عهده مع إبراهيم وموسى هيأ اللّه للعهد الذي سيعقده فيما بعد بينه وبين البشرية جمعاء بدم ابنه الوحيد يسوع المسيح الذي سفك لأجل خلاص العالم وهذا هو العهد الجديد. وتنقسم أسفار الكتاب المقدس من حيث مواضيعها إلى أسفار الشريعة والأسفار التاريخية والحكمية والنبوية. فأسفار العهد القديم: كُتِبت باللغة العبرية، وعددها ستة وأربعون، تنقسم إلى: أولاً ـ أسفار الشريعة وهي: ــ أسفار موسى الخمسة وتعرف بالتوراة أي الشريعة. وقد كتبها موسى حوالي سنة ألف وخمسمائة قبل الميلاد وهي: 1ــ التكوين. 2ــ الخروج. 3ــ اللاويين. 4ــ العدد. 5ــ التثنية. ثانياً ــ الأسفار التاريخية: وهي: 6ــ يشوع، وكتبه يشوع ابن نون. 7ــ القضاة، وكتبه صموئيل. 8ــ راعوث، وكتبه صموئيل. 9و10ــ صموئيل الأول والثاني، وكتبهما صموئيل وجاد وناثان. 11و12ــ الملوك الأول والثاني، وكتبهما ناثان، وقيل أن جاد وإشعياء النبي ويعدو اشتركوا معه. 13و14ــ الأيام الأول والثاني، كتبهما عزرا الكاهن. 15ــ عزرا، وكتبه عزرا الكاهن. 16ــ نحميا، وكتبه نحميا. 17ــ طوبيا، وكتبه طوبيا. 18ــ يهوديت، وكتبه يواكيم. 19ــ أستير، يقال إن كاتبه عزرا الكاهن أو مردخاي. 20و21ــ المكابين الأول والثاني. ثالثاًــ الأسفار الحكمية: وهي: 22ــ سفر أيوب، نظمه بالعبرية أو العربية أيوب الصدّيق أو موسى النبي، وهو أقدم الأسفار الإلهية كتابةً. 23 ــ المزامير، نظم أكثرها داود والباقي نظمه موسى وهامان وآساف ويدثون وأنبياء آخرون. 24ــ الأمثال. 25ــ الجامعة. 26ــ نشيد الأنشاد. 27ــ حكمة سليمان. وهذه الأسفار الأربعة كتبها سليمان. 28ــ حكمة يشوع ابن سيراخ وهو شبيه بسفري الأمثال والحكمة. رابعاًــ الأسفار النبوية: وكلها بأسماء كاتبيها الذين يسمون بالأنبياء الكبار والأنبياء الصغار بحسب حجم سفر نبوتهم، فأسفار الأنبياء الكبار هي: 29 ــ إشعياء. 30ــ إرميا. 31ــ مراثي إرميا. 32ــ حزقيال. 33ــ دانيال. وقد حذف بعض البروتستانت من سفر دانيال تسبحة الفتية الثلاثة في أتون النار، وقصة سوسنة العفيفة، وقصة بال والتنين. أما أسفار الأنبياء الصغار فهي: 34ــ باروخ. 35ــ هوشع. 36ــ يوئيل. 37ــ عاموس. 38ــ عوبيديا. 39ــ يونان. 40ــ ميخا. 41ــ ناحوم. 42ــ حبقوق. 43ــ صفنيا. 44ــ حجّاي. 45ــ زكريا. 46ــ ملاخي. أما أسفار العهد الجديد فهي سبعة وعشرون سفراً كتبها بعض الرسل الأطهار والتلاميذ الأبرار باللغة اليونانية ماعدا إنجيل متى فقد كتب باللغة الآرامية، ويُظَن أن الرسالة إلى العبرانيين قد كُتِبَت بالآرامية أيضاً، وهذه الأسفار مسماة بأسماء كاتبيها أو بأسماء الأشخاص أو الأماكن المكتوبة والموجهة إليهم، وهي بحسب التقسيم الذي اتبعناه بسرد أسماء الأسفار السابقة كالآتي: أولاًــ أسفار الشريعة: وهي الأناجيل الأربعة، ولفظة إنجيل تعني البشارة السارة. وهي: 1ــ إنجيل متى، كتبه سنة 39م. 2ــ إنجيل مرقس كتبه سنة 61م. 3ــ إنجيل لوقا كتبه سنة 63م. 4ــ إنجيل يوحنا كتبه سنة 98م. وتعتبر الأناجيل الأربعة تاريخية أيضاً لاشتماله على سيرة السيد المسيح وتدابيره الإلهية بالجسد، وقد كتبت بعد صعوده إلى السماء بمدة تتراوح بين أربع إلى ست وستين سنة. ثانياًــ الأسفار التاريخية: 5ــ سفر أعمال الرسل وقد كتبه لوقا البشير سنة 64م. ثالثاًــ الأسفار التعليمية: وهي قسمان: أولهما من 6 ـ 19 تتضمن رسائل الرسول بولس، وقد كتبت بعد صعود الرب إلى السماء بمدة تتراوح من عشرين إلى ثلاث وثلاثين سنة وهي موجهة إلى: 6ــ رومية كتبها الرسول بولس في إفسس سنة 55 أو 57م، وكورنثوس الثانية كتبها الرسول بولس في مكدونية سنة 57 أو 58م. 9ــ غلاطية كتبها الرسول بولس في كورنثوس أو إفسس سنة 55 أو 58م. 10ــ إفسس كتبها الرسول بولس في رومية سنة57م. 11ــ فيليبي كتبها الرسول بولس في رومية سنة 62م. 12ــ كولوسي كتبها الرسول بولس في كورنثوس سنة 52م وتسالونيكي الثانية كتبها الرسول بولس في مكدونية سنة 57 أو 58م. 15و16ــ تيموثاوس الأولى: كتبها الرسول بولس في مكدونية أو رومية سنة 64م، والثانية كتبها الرسول بولس في رومية سنة 65و68م. 17ــ تيطس كتبها الرسول بولس في نيكوبوليس أو إفسس سنة 64م. 18ــ فليمون كتبها الرسول بولس في رومية سنة 61م. 19ــ العبرانيين كاتبها مجهول، إذ لم يصرح باسمه. ويُظَن أنه الرسول بولس. والقسم الثاني من 20ــ26 الرسائل الجامعة وهي: 20ــ رسالة يعقوب، كتبها يعقوب في مدينة أورشليم سنة 61م. 21ــ رسالة بطرس الأولى كتبها بطرس بين سنتي 63و67م. 22ــ رسالة بطرس الثانية، كتبها بطرس بين سنتي 64و68م. 23و24و25ــ رسائل يوحنا الثلاث كتبها يوحنا في إفسس، الأولى سنة 98م، والثانية والثالثة سنة 70م على ما يظن. 26ــ رسالة يهوذا، كتبها بين سنتي 64و66م. ولا بد من أن نذكر أنّ رسائل الرسول بولس والرسائل الجامعة تتضمن علاوة على الأمور التعليمية، بعض الشرائع والحوادث التاريخية وحتى النبوات. رابعاًــ الأسفار النبوية: 27ــ سفر الرؤيا كتبه على الأغلب يوحنا الرسول الذي يوصف أيضاً بالرائي، وذلك بين سنتي 90و100م، ويتضمن النبوات بتدبير الرب الإله عالمنا إلى منتهى الدهر. قانونية الكتاب المقدس القانون لغة، هو مقياس كل شيء، وفي السريانية (قنيو) أي قصبة المساحة التي كانت تستعمل كمقياس، وطولها أربعة أو ستة أو ثمانية أذرع، وأيضاً بالسريانية (قونونو) أي قاعدة، وقانون ومقياس. أما بالعربية فهي (القناة) أي العصاة المستقيمة وفي علم اللاهوت، تعني القواعد والأصول، فقانونية (الأسفار المقدسة) هي الاعتراف بكونها موحى بها من الله، وهي المعتبرة أجزاء من الكتاب المقدس. استمدت اسفار الكتاب المقدس قانونيتها، منذ زمن تدوينها، فهي وحي إلهي، وقد هُيِّئ شعب العهد القديم مثلاً لتقبل أسفار العهد القديم كوحي إلهي وحفظها، وصيانتها. وكان مطلب هذا الوحي حال نزوله واضحاً صريحاً، إنه كلام الله، كما جاء في سفر إرميا، ما يأتي: (فدعا إرميا باروخ بن نيرنا فكتب باروخ عن فم إرميا كل كلام الرب الذي كلمه به، في درج السفر)(إر36: 4). درست الكنيسة المسيحية قانونية أسفار العهد القديم التي كانت بيد اليهود، فقبلتها ككتاب موحى به من الله. وبهذا الصدد يقول الرسول بطرس: «إنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس اللّه القديسون مسوقين من الروح القدس» (2بط1: 21) وقال الرسول بولس: «كل الكتاب موحى به من الله»(2تي3: 16). واقتبس السيد المسيح ورسله الأطهار وتلاميذه الأبرار آيات من أسفار العهد القديم، فقد وردت في أسفار العهد الجديد (465) آية من العهد القديم. ويكفي أن السيد المسيح وحده ذكر عشرين شخصاً من أشخاص العهد القديم. وذكر منه حوادث عديدة وأشار إليها بوضوح، مثل: الطوفان (مت24: 37) وانقلاب سادوم وعامورة واحتراقهما بالنار والكبريت (لو17: 28ــ30و32) والمن والسلوى(يو6: 31و32) ورفع موسى الحية النحاسية في البرية (يو30: 14) وحادثة النبي يونان والحوت، وتوبة أهل نينوى (مت12: 39ــ41). ونذكر أيضاً على سبيل المثال لا الحصر بعض أقوال الرب يسوع التي بها يشير إلى أسفار العهد القديم، فقد قال لابليس المجرب (مكتوب)(مت4: 4و7و10) وقال لليهود: «فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي... لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني. فإن كنتم لا تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامي» (يو5: 39و45ــ47). وفي ذات اليوم الذي قام فيه من بين الأموات ظهر للتلميذين اللذين كانا ذاهبين إلى قرية عمواس، وقال لهما: «أيها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده، ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب»(لو24: 25ــ27) ولما ظهر لتلاميذه في العلية قال لهم: «هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم أنه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذٍ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب» (لو24: 44و45). مكانة الأسفار المقدسة في العهد القديم: كانت أسفار موسى الخمسة التي تدعى التوراة تقرأ سنوياً أمام الشعب كله، في عيد المظال(تث31: 9ــ11) وكلمة توراة العبرية تعني الناموس أو الشريعة. وكان اللّه تعالى قد أمر كل من يتوج ملكاً فيهم، أن يستكتب له نسخة من أسفار الشريعة لتكون معه دائماً، ويقرأ فيها كل أيام حياته، لكي يتعلّم ان يتقي الرب إلهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض ليعمل بها(تث17: 18ــ20) وكان القارئ أيّاً كان لا يجرؤ على أن يلمس الكتاب بإصبعه لرهبته من قدسية الكتاب المقدس. وعندما سبي الشعب، وتشرد وتشتت، كان من الطبيعي أن يصطحب معه نسخاً من الأسفار المقدسة أينما رحل، وحيثما حل، وإذ كان قد فقد هيكله، وتوقف عن تقديم الذبائح والمحرقات وغيرها، اقتصرت عبادته للّه على تلاوة الأسفار المقدسة، موجهاً عنايته إليها، بل قد تطرف بعضهم في تكريمها إلى درجة عبادتها. أما العقلاء الأتقياء المعتدلون، فقد ركزوا اهتمامهم على دراسة النبوات، وغدوا ينتظرون إتمامها بفارغ الصبر، وقوي بذلك إيمانهم بعناية الله، ورجاؤهم بإتمام وعوده تعالى بمجيء المخلص. ولكي يفهم الجيل الصاعد شريعة الله، نقلت الأسفار المقدسة إلى اللغات المحلية، وهكذا صار السبي وسيلة لنشر تعاليم الله، فعرفت الشعوب الوثنية الشيء الكثير عن نبوات أنبياء اليهود عن مجيء المخلص الذي سيأتي لفداء العالم أجمع. وكانت الأسفار المقدسة تُقرأ في مجامع اليهود، أثناء العبادة، كل يوم ست خلال السبي البابلي، واستمر الحال على هذا المنوال، بعد العودة من السبي في القرن الخامس قبل الميلاد، حيث كانت المجامع قد انتشرت في الأرض المقدسة، كما نوه بذلك القديس يعقوب بقوله: «لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يُقرأ في المجامع كل سبت» (أع15: 21). وقال البشير لوقا عن الرب يسوع ما يأتي: «وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت، وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر إشعيا النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوباً به...» (لو4: 16و17). وكلام البشير لوقا هذا يدل على أن الأسفار المقدسة كانت تتلى على مسامع الشعب في المجامع حتى ذلك العهد. وكانت لها المكانة الأولى في قلوبهم. وكانت أسفار العهد القديم، المكتوبة باللغة العبرية، قد جُمِعت ونُظِّمت لتكون مجموعة واحدة مؤلفة من تسعة وثلاثين سفراً قانونياً وذلك سنة 534ق.م بهمة عزرا الكاهن وبمساعدة النبيين حجي وملاخي. أما الأسفار المكتوبة بالآرامية فاستثنيت من تلك المجموعة. وسنة 285ق.م عندمت ترجمت أسفار العهد القديم إلى اليونانية بأمر بطليموس فيلادلفوس في الاسكندرية أضيفت إلى هذه الأسفار رسمياً الأسفار السبعة التي كتبت باليونانية والآرامية ما عدا سفر المكابيين الذي كتب بعد ذلك التاريخ وترجم بعدئذ وضمّ إليها أيضاً. وكان هناك خلاف بين يهود الاسكندرية ويهود فلسطين حول هذه الأسفار التي دعيت بعدئذ، من بعض الكنائس، بالأسفار القانونية الثانية، فالاسكندريون دون الفلسطينيين كانوا يقبلونها كلها. وقد تسلمت المسيحية أسفار العهد القديم من اليهود ومعها تسلمت الخلاف حول بعضها، وظلّ الحال على هذا المنوال، حتى القرن الخامس للميلاد حيث قبلت الكنائس كافة، مجموعة الأسفار كاملة. حذف بعض الأسفار: وجدد الجدل حول قانونية بعض أسفار العهد القديم، مع ظهور الكنيسة البروتستانتية، إذ رفض بعض فرقها أسفاراً من العهد القديم دعتها (أبوكريفا) وهذه الأسفار هي: 1ــ طوبيا. 2ــ يهوديث. 3ــ حكمة سليمان. 4ــ حكمة يشوع بن سيراخ. 5و6ــ المكابيين الأول والثاني. 7ــ بعض أجزاء من سفر أستير. 8ــ بعض أجزاء من سفر دانيال كتسبحة الفتية الثلاثة القديسين وقصة سوسنة وغيرها. 9ــ باروخ. وحجة رافضي هذه الأسفار هي أنها لم تكن في تعداد الأسفار القانونية التي جمعها عزرا الكاهن سنة 534ق.م. وإن الإعلانات الإلهية، حسب عقيدة شعب العهد القديم، قد توقفت بعد نبوة ملاخي الذي كان معاصراً لنحميا سنة 433ق.م وإن هذه الأسفار كتبت سنة 200ق.م وما بعدها وإن الأسفار القانونية كلها كتبت بلغتهم العبرية. وإن السيد المسيح ورسله الأطهار لم يستشهدوا بعباراتٍ منها. ورداً على اعتراضاتهم هذه نقول: إن الوحي الإلهي لا يقتصر على لغة واحدة، وإن عزرا الكاهن وحجي وملاخي لم ينظموا في قانون الأسفار المقدسة سنة 534ق.م إلا ما كان مكتوباً بلغتهم العبرية إذ جمعوها معاً كأسفارٍ قانونية، أما ما كان مكتوباً بالآرامية، أو ما كتب بعد ذلك التاريخ، فلئن كان مكرماً لديهم، ومصدقاً منهم، ولكنهم لم يضعوه ضمن كتبهم القانونية، لعدم ظهور أنبياء لديهم بعد ذلك التاريخ، يخلف أحدهم الآخر، لكي يعترف الخلف بما كتبه السلف، وبهذا الصدد يقول مؤرخهم يوسيفوس فلافيوس: «لدينا فقط اثنان وعشرون سفراً. ومن أيام أرتحشستا إلى يومنا هذا دونت كل الحوادث، ولكننا لا نستطيع أن نضع فيما دُوِّن نفس الثقة التي نضعها في التواريخ السابقة لأنه لم تكن هناك سلسلة متعاقبة من الانبياء اثناء هذه الفترة». أما عدم استشهاد السيد المسيح ورسله الأطهار بعبارات من هذه الاسفار فليس دليلاً على عدم اعترافهم بقانونيتها، فهم لم يستشهدوا بعبارات من العديد من الأسفار التي يعترف البروتستانت بقانونيتها أيضاً. علماً بأن آباء الكنيسة الأولى قد استشهدوا بآيات منها في كتاباتهم كما أن فصولاً منها تقرأ في الكنائس أثناء الصلاة ضمن القراءات التي نظم جدولها آباء الكنيسة. كما أن هذه الاسفار كانت قد ضمت إلى الأسفار التي نقلت إلى اليونانية في الإسكندرية عام 285ق.م كما يتضح ذلك من مخطوطة المتحف البريطاني في لندن. ولا بد من أن نذكر أيضاً أن شعب العهد القديم التزم بما جاء فيها من توجيهات فعيَّد عيد تجديد الهيكل (يو10: 22) مثلاً، بناءً على ما رسمه يهوذا المكابي حين طهّر الهيكل من نجاسات الأمم الوثنية، وجدد مذبحه كما هو وارد في سفر المكابيين الأول (4: 59). أما قانونية أسفار العهد الجديد التي بين أيدينا اليوم وهي سبعة وعشرون سفراً فقد أقرتها الكنيسة الأولى في أوائل القرن الثاني وأجمعت على قبولها كأسفارٍ موحى بها من اللّه كتبها الرسل والتلاميذ الذين اختارهم الرب يسوع وحلّ عليهم الروح القدس فأرشدهم إلى استعمال العبارات اللائقة، وصانهم من الخطل والزلل فكتبوا ما كتبوه بعباراتٍ واضحة، ومما يبرهن على صدقهم، بساطتهم في سرد شهادتهم عن السيد المسيح، فقد كتبوا ما رأوه بأم العين، وما سمعوه بالأذن، ولمسوه بالأيدي. وأتموا بذلك وصية الرب إذ قال: «فتكونون لي شهوداً في أورشليم وجميع اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض»(أع1: 8) وقد قدموا شهاداتهم عن أمورٍ عرفها عدد كبير من معاصريهم، فلو كذبوا لكذّبوهم حينذاك. كما أثبتوا صدق كلامهم بالمعجزات الباهرات التي اجترحوها، وبسيرتهم الفاضلة، وإيمانهم حتى الموت بصدق ما بشّروا به وكتبوه. قال الرسول بولس: «إنه إن بشّرناكم نحن أو ملاكٌ من السماء بغير ما بشّرناكم فليكن أناثيما»(غلا1: 9) فلا عجب إن كان لرسالتهم تأثير على عقول الناس وقلوبهم فأذعنت للمسيح وآمنت به. وبعد أن أخذت أسفار العهد الجديد الصفة القانونية، كما ذكرنا، صار قبولها إلزاماً على المؤمنين كأسفارٍ موحىً بها من الله. لا يُزاد عليها حرفٌ، ولا يُحذف منها حرفٌ كقول الرسول يوحنا في سفر الرؤيا: «لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحدٌ يزيد على هذا يزيد اللّه عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحدٌ يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة، يحذف اللّه نصيبه من سفر الحياة، ومن المدينة المقدسة، ومن المكتوب في هذا الكتاب»(رؤ22: 18و19). سلامة الكتاب المقدس: صان اللّه تعالى كتابه المقدس سالماً من أي تحريفٍ أو تبديل أو تناقض أو ناسخ أو منسوخ، فلم يعتره خلل منذ كتب وإلى الآن ولن يعتريه أبداً. ومن البديهي أن يحافظ المؤمنون على سلامته، طالما يؤمنون بأنه كتاب اللّه الذي كتبه الأنبياء الصادقون، والرسل القديسون، مسوقين من الروح القدس وهو يحتوي على كل ما قصد اللّه تعالى أن يودعه فيه من معانٍ لخلاص الإنسان. ومما يدل على حرص شعب العهد القديم مثلاً على الحفاظ على الأسفار المقدسة سليمةً من أية زيادة أو نقصان أسلوب نسخ الأسفار. فقد كان النساخ يعنون العناية التامة بكتابتها، وكانوا يعرفون عدد كل حرفٍ في كل سطرٍ أو صفحة، ويخافون العقاب من زيادة حرفٍ أو نقطة أو حذفهما. وعلى الرغم من انقسام اليهود إلى شيع وفرق عديدة واختلافاتهم في أمورٍ كثيرة، كانوا مجمعين على أن الأسفار المقدسة موحى بها من الله. وكذلك المسيحيون بالنسبة إلى نصوص العهدين قد أجمعوا على أنها كلام اللّه الحي «كل الكتاب موحى به من الله»(2تي3: 16) و«كلامك هو حقٌ»(يو17: 17) وقد اؤتمن شعب العهد القديم على حفظ أسفار الناموس والنبوات كقول الرسول بولس: «فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله»(رو3: 1و2). فالكتاب المقدس الذي بين أيدينا اليوم بلغاته الأصلية، هو هو كما دوّنه الأنبياء والرسل، وتسلّمه آباؤنا الميامين، وسلّمونا إيّاه، سليماً صحيحاً. وقد تُرجم إلى كل لغةٍ ذات شأنٍ في العالم، ومع هذا مهما اختلفت الترجمات في الألفاظ، والأساليب في التعبير فهي جميعها تتطابق كل المطابقة بعضها لبعضٍ في الجوهر ولا خلاف بالمعنى. ويرجع تاريخ أقدم مخطوطاته العديدة بلغاتٍ شتى، إلى القرن الأول قبل الميلاد لأسفار العهد القديم. أما الكتاب المقدس بعهديه فإلى القرون: الثاني والرابع والسادس والسابع للميلاد. وهي محفوظة في شتى متاحف العالم وخزانات الكتب الشهيرة. وكان الكتاب المقدس أول كتاب نشر بالطبع بعد اختراع صناعة الطباعة في القرن الخامس عشر. وقد فحص العلماء هذه المخطوطات، وكذلك ما طبع من أسفار الكتاب حتى اليوم بلغاتها الأصلية وترجماتها وقابلوا نصوصها، بتدقيقٍ، فرأوها، رغم قدمها وتباعد البلدان التي جُمعت منها المخطوطات، مطابقة كل المطابقة بعضها لبعض. ولا خلاف فيها بالمعنى أبداً. ولئن اختلفت الترجمات في الألفاظ والأساليب في التعبير. وكلما اكتُشفت مخطوطة قديمة أضافت برهاناً جديداً على سلامة الكتاب المقدس لتطابقها كل التطابق مع النسخ التي بين أيدينا. لم يجسر اليهود على تبديل أو حذف آية واحدة من نبوات الأنبياء التي تعلن حقيقة مجيء المسيح المخلص وموته وقيامته. فعلى الرغم من عدم إيمانهم بالمسيح يسوع وقد اعتبروه عدواً لدوداً لهم، حافظوا على مئات النبوات التي تنبّأ بها أنبياؤهم عن مجيئه قبل مجيئه بمئات السنين مفصلين مراحل تدبيره الإلهي على الأرض بوضوح، وكأنهم يكتبون تاريخ حياته بالجسد، وبقيت هذه النبوات برهاناً ناصعاً، وشهادة صادقة على أن يسوع الناصري هو المسيح المنتظر، وأن اليهود لم يعرفوا زمن افتقادهم فرفضوا المسيح فرفضهم الله. ولو حاولوا حذف شيء من الأسفار المقدسة أيضاً لحذفوا ما دوّنه أنبياؤهم من الحقائق التي تسيء إلى سمعتهم وسمعة آبائهم بقساوة قلوبهم وتمردهم على اللّه وأعمالهم الهمجية التي يُندى لها جبين الإنسانية خجلاً. ولكنهم لم يجرؤوا على حذف نقطة واحدة أو كلمة واحدة من الأسفار المقدسة أو زيادة ذلك عليها. وكذلك الحال بالنسبة إلى المسيحيين بحفاظهم على أسفار العهدين. كما إن اليهود والمسيحيين ينقسمون إلى فرقٍ عديدة، وشيعٍ لا يُحصى لها عددٌ، فلو فكرت فرقةٌ من الديانتين أن تحرّف أسفار العهدين لشنّعت بها سائر الفرق. ولكن ذلك لم يحصل ولن يحصل أبداً. ولا ننسى أن نذكر إن قبول الرسل الأطهار الحقائق الإلهية ولئن فاقت إدراكهم، لهو دلالة واضحة على أمانتهم في حفظ الكتاب سليماً من أي تبديل. فعقيدة صلب السيد المسيح مثلاً لم يكن من الهيّن قبولها، حتى إن سمعان بطرس لما سمعها من الرب قال له: «حاشاك يا رب. لا يكن لك هذا»(مت16: 22) ورغم صعوبة الفكرة، كانوا يبشّرون بها لأنها حقيقةٌ إلهية. مما يدل على أن الإنجيل صحيح. وقد كرزوا أولاً بالإنجيل المكتوب في قلوبهم لمدة ثلاثين سنةً، ثم بعد ذلك كتبوا الأناجيل الأربعة من مناطق بعيدة عن بعضها وأماكن متفرقة وبدون سابق اتفاق أو تواطؤ على كتابتها. وقد جاءت أناجيلهم مختلفة النصوص ولكنها واحدة في الجوهر. مما يدل على أن الإنجيل صحيح وصادق. وقد أجمعوا بالشهادة التي قدّموها بالإنجيل على صلب المسيح، وموته، وقيامته رغم أن التبشير (بالمسيح المصلوب) كان وما يزال عثرة لليهود وجهالة لدى الأمم (1كو1: 18) فهذا أقوى دليل على صدق جميع أسفار الكتاب، وسلامتها. كما إنه قد كُتب من الأناجيل آلاف النسخ وانتشرت في العالم بلغاتٍ مختلفة ولم توجد نسختان تختلف الواحدة عن الأخرى من الإنجيل الواحد، أو تختلف عن سائر النسخ. فهل يعقل أن تجمع هذه النسخ من أنحاء العالم وتُحرَّف وتُباد النسخ الأصلية وتبقى المحرفة! لغات الكتاب المقدس: كُتِب معظم أسفار العهد القديم باللغة العبرية، ويُظن أن سفر أيوب كُتِب أولاً بالعربية شعراً ثم نُقِل إلى العبرية نظماً أيضاً. ومنذ القرن الخامس قبل الميلاد أخذت اللغة الآرامية مكان اللغة العبرية في شؤون الحياة اليومية لدى اليهود، إذ كان الشعب قد نسي اللغة العبرية أثناء السبي البابلي، وأخذ يتكلّم اللغة الآرامية، فكتبت بالآرامية أسفار: طوبيا ويهوديث وبعض أجزاء من سفري عزرا ودانيال. وكُتِبت باليونانية (الدارجة) أسفار الحكمة والمكابيين الثاني. علماً بأن اللغة العبرية بقيت اللغة الدينية لدى اليهود. أما أسفار العهد الجديد فكُتِب أغلبها باللغة اليونانية (الدارجة) وكان هؤلاء الكتّاب ذوي ثقافة آرامية، ومطبوعين في تفكيرهم بالطابع الآرامي السرياني. وقد تكلّم السيد المسيح ورسله باللغة الآرامية السريانية وبها كتب الرسول متى الإنجيل المقدس ويقول أوسابيوس القيصري(263ــ339) بهذا الصدد: «لأن متى كرز أولاً للعبرانيين، كتب إنجيله بلغته الوطنية». أما الرسالة إلى العبرانيين فقد كتبت أصلاً باليونانية الفصحى، وقيل بل بالآرامية أو العبرية ونقلت إلى اليونانية. أهم ترجمات الكتاب المقدس: ترجم الكتاب المقدس من لغاته الأصلية إلى لغات عديدة بلغت اليوم ما ينوف على ألف ومئتي لغة ولهجة، وأهم هذه الترجمات القديمة هي: وللترجمة السبعينية أهمية كبرى، فمنها نقلت أسفار العهد القديم إلى اللغة اللاتينية في منتصف القرن الثاني للميلاد، وكذلك عنها نقلت الترجمات القبطية بين القرنين الثالث والخامس للميلاد، وغيرها. روى مار يعقوب الرهاوي (+708) أن أبجر الخامس ملك الرها (+50) بعدما آمن بالرب يسوع على يد البشير أدى الذي أوفده إلى الرها أخوه الرسول توما، أرسل ابجر من الرها إلى فلسطين عدة علماء تفرّغوا لنقل أسفار الكتاب المقدس إلى اللغة السريانية وعادوا بها إليه. وهذه الترجمة مفقودة. أما الترجمة السريانية التي أطلق عليها في القرن التاسع اسم فشيطةا (فشيطتا) أي البسيطة، فقد جرت على مرحلتين: المرحلة الأولى وقد تمت في أواخر القرن الأول للميلاد حيث نقل جماعة من العلماء اليهود المتنصرين أسفار العهد القديم عن العبرية إلى السريانية، في الرها على الأغلب، وسميت أورة كةب (صورات أكثوب) أي متن الكتاب المقدس ونصه. أما المرحلة الثانية فقد تمت في أوائل القرن الثاني للميلاد حيث نقل العلماء السريان أسفار العهد الجديد من اليونانية إلى السريانية ودعيت هذه الترجمة أيضاً بـ (صورات أكثوب) أي متن الكاب المقدس ونصه. وقد حوت كل أسفار العهد الجديد ما عدا رسالتي مار يوحنا الثانية والثالثة ورسالة مار بطرس الثانية ورسالة مار يهوذا ورؤيا يوحنا الرسول. وقد أجمع العلماء على أنها ترجمة صحيحة وأمينة بدون أن تكون حرفية، وسميت بالبسيطة لبساطتها ووضوحها وترك أفانين البلاغة وتعقيداتها في نقلها واستعملتها الكنيسة السريانية لبساطتها، دون الترجمة السبعينية، وذكرها آباؤها الأولون مقتبسين منها في كتاباتهم وكانت في أواسط القرن الرابع قد قوبلت على النص اليوناني الذائع يومئذ في كنائس الجالية اليونانية في أنطاكية. وما تزال الكنيسة السريانية تستعمل هذه الترجمة بنصها وفصها وما تزال هذه الترجمة ذات أهمية كبرى، وتعد من المراجع المهمة جداً في دراسة الكتاب المقدس. وأقدم مخطوطة لها، محفوظة في المتحف البريطاني في لندن وترقى إلى القرن الرابع للميلاد. وقد أحصى بعضهم خمساً وخمسين مخطوطة سريانية بالقلم الاسطرنجيلي من الترجمة البسيطة، مكتوبة في القرون الخامس والسادس والسابع، محفوظة إلى اليوم في مكتبات الشرق والغرب، يقابلها اثنتان وعشرون نسخة لاتينية وعشر نسخ فقط يونانية. وفي السريانية ترجمات أخرى منها: الترجمة الأنطاكية: المعروفة اليوم بـ (السينائية) لاكتشاف نسختها في دير طور سينا عام 1892 وقد كتبت بخط يوحنا العمودي في دير مار قانون في معرة مصرين سنة 698م أو 789م ونشرتها السيدة لويز عام 1910. وعلى الأغلب أن ططيانس قد اعتمدها في جمع الدياطسرون أي «من خلال الأربعة» وهو الإنجيل الموحد أو المختلط كما يسميه آباؤنا السريان. الترجمة الفلكسينية: التي تمت على يد الخورفسقفوس فوليقربوس بعناية مار فيلكسنوس مطران منبج عام 505م واقتصرت على ترجمة أسفار العهد الجديد ويظن أنه نقل بعض أسفار العهد القديم أيضاً ولم تصل إلينا هذه الترجمة. الترجمة الحرقلية: وهي مشهورة جداً كتب عنها المؤرخ السرياني الشهير البطريرك مار ميخائيل الكبير (1199+) ما تعريبه بتصرف «في عهد البطريرك أثناسيوس الأول (595ــ631) اشتهر توما الحرقلي من دير ترعيل وهو أسقف منبج، الذي درس اللغة اليونانية منذ نعومة أظفاره في قنسرين. ولما صار أسقفاً، ونفي من كرسيه بدسائس دوميطان أسقف ملاطية في عهد موريقي الملك كان توما المغبوط في جملة الأساقفة الذين هربوا بسبب الاضطهاد إلى بلاد مصر. وانكفأ في الدير المسمى أنطون بجوار الاسكندرية، حيث نقح بدقة فائقة الترجمة السريانية لكتاب الإنجيل المقدس وسائر كتب العهد الجديد وهذه الترجمة كانت قد جرت بهمة مار فيلكسينوس أسقف منبج وفي زمانه». وفي هذا الزمن أيضاً نقل إلى السريانية مار بولس مطران تلا بين سنتي 615ــ617 بأمر البطريرك الأنطاكي مار أثناسيوس الأول 595ــ631. الترجمة السبعينية لأسفار العهد القديم بحسب هكسلا أوريجانس وسميت هذه الترجمة بالسبعينية السريانية، واعتمدها العديد من علماء السريان في دراساتهم، منهم العلامة مار غريغوريوس يوحنا ابن العبري (1286+) في كتابه (أوصار روزي) أي مخزن الأسرار، وقد ذكر ابن العبر ي ذاته في كتابه أمحا (صمحي) (في نحو اللغة السريانية) أن هذه الترجمة هي أفضل من الترجمة البسيطة لبلاغة عباراتها. ومما هو جدير بالذكر أن بولس بن عرقا الرهاوي الأديب السرياني الشهير في أوائل القرن الثالث للميلاد، استنبط الخط الاسطرنجيلي لكتابة الإنجيل المقدس بالسريانية. فقد اهتم الخطاطون السريان على مرّ الدهور والأجيال بإجادة نسخ أسفار الكتاب المقدس. يذكر التاريخ أن ورقة بن نوفل نقل أجزاء من الإنجيل المقدس إلى العربية. أما أشهر ترجمة عربية للإنجيل يذكرها تاريخنا السرياني فهي الترجمة التي تمت على أيدي علماء الكنيسة السريانية الأرثوذكسية العرب من بني طي وتنوخ وعاقولا (الكوفة) وقد قاموا بذلك بأمر البطريرك يوحنا الثالث أبي السذرات (+648) استجابة لرغبة عمرو بن سعد بن أبي وقاص الأنصاري أمير الجزيرة. قال فيها البطريرك مار ميخائيل الكبير (+1199) في تاريخه الشهير ما يأتي: «في هذا الزمان استقدم عمرو بن سعد بن أبي وقاص الأنصاري أمير الجزيرة، البطريرك يوحنا الثالث أبي السذرات (631ــ649) فلما مثل بين يديه ابتدأ يناقشه ويجادله بقضايا لا تتفق والكتاب المقدس ويوجه إليه أسئلة ملتوية، ففند البطريرك اعتراضاته بحجج دامغة اقتبسها من أسفار العهدين القديم والجديد، ومن بينات طبيعية، فأعجب الأمير بشجاعته وغزارة علمه، وطلب إليه قائلاً: «ترجم لي إنجيلكم إلى اللغة العربية على أن لا تدخل فيه اسم المسيح اللّه أو المعمودية أو الصليب، فأجابه البطريرك المغبوط بجرأة قائلاً: «حاشا لي أن أنقص حرفاً واحداً أو سطراً واحداً من الإنجيل مهما سامني جندك من صنوف العذاب بالسيوف والرماح. فلما رأى شجاعته وصموده قال له: اذهب واكتب بحسب إرادتك. فجمع البطريرك العلماء العرب والأساقفة من بني تنوخ وعاقولا (الكوفة) وطي، المتبحرين في اللغتين العربية والسريانية، وأوعز إليهم لينقلوا الإنجيل إلى اللغة العربية، وأوصاهم بأن تتلى عبارة عبارة من الترجمة على مسامع شارحي (الكتاب المقدس) كافةً. وبعد أن ترجموه ونقّحوا عباراته أخذوه إلى الملك». وهذه الترجمة مفقودة. وقد اكتشف في دير كاترينا بشبه جزيرة سينا عام 1950 أقدم ترجمة عربية للتوراة عرفت في التاريخ وهي من القرن السابع للميلاد. وإن يوحنا أسقف أشبيلية في إسبانيا قام بترجمة أجزاء من الكتاب المقدس إلى العربية سنة 750 معتمداً على الترجمة اللاتينية لهيرونيموس. وظهرت ترجمات عديدة لأسفار الكتاب المقدس بالعربية بعد ذلك التاريخ نقلت عن اليونانية أو السريانية. وفي القرن التاسع عشر نقلت أسفار الكتاب من العبرية واليونانية القديمة إلى العربية وطبعت سنة 1864 في لبنان وقد أسهم بهذا العمل الدكتور كورنيليوس فانديك بمؤازرة الشيخ ناصيف اليازجي والمعلم بطرس البستاني والشيخ يوسف الأسير. وفي عام 1876 صدرت الترجمة العربية المعروفة باليسوعية لأسفار الكتاب المقدس كاملة مترجمة عن العبرية واليونانية. كما ظهرت ترجمات عربية عن السريانية. الترجمة المليالمية: وهذه الترجمة يستعملها أبناء كنيستنا السريانية الهنود في كيرالا في جنوب الهند وفي الهند وخارجها. وقد قام بها الربان فيلبس السرياني الملباري الهندي ناقلاً الكتاب المقدس برمته من السريانية إلى المليالم لغة جنوب الهند، وذلك في القرن التاسع عشر. ولابد من أن نذكر الترجمة الأرمنية لأسفار الكتاب المقدس التي تعاون على إنجازها الملفان دانيال السرياني ومسروب الأرمني سنة 404م والترجمة الفارسية التي تمت سنة 1221 على يد يوحنا ابن القس يوسف السرياني التفليسي. في حدود سنة 172 للميلاد جمع ططيانس السرياني (ت180) الأناجيل الأربعة وصاغها كتاباً واحداً، مبتدئاً من الآية الأولى من الإنجيل بحسب يوحنا: «في البدء كان الكلمة» ومتتبعاً بإنشاء سهل ممتنع ما انفرد به كل من الأناجيل الأربعة للموضوع الواحد ودعا هذا الكتاب بـ (الدياطسرون) وهذه كلمة يونانية معناها: (من خلال الأربعة) وسماه السريان الإنجيل المختلط أو الموحد محلطا تمييزاً له عن الأناجيل المفردة، ويضم خمسة وخمسين فصلاً. وقد وضعه بالسريانية معتمداً فيه، كما ارتأى بعض العلماء، على الترجمة التي تعرف اليوم بالسينائية لاكتشاف مخطوطاتها في دير كاترينا في شبه جزيرة سيناء، أو على الترجمة البسيطة على رأي غيرهم من العلماء. ونقله إلى اليونانية. وقد أحب السريان (الدياطسرون) وقرؤوه في كنائسهم خاصة في الرها وولايتي الفرات وما بين النهرين حتى ألغى استعماله رابولا مطران الرها في القرن الخامس حرصاً على سلامة الكتاب المنزَّل، وأحلّ محله الأناجيل الأربعة المفردة. ولا وجود اليوم لمخطوطة كاملة منه. وقد فسّر مار أفرام السرياني (373+) (الدياطسرون) ونقل بعضهم هذا التفسير إلى الأرمنية وله مخطوطة بالأرمنية كتبت عام 1195 نشرت بالطبع مع ترجمتها اللاتينية سنة 1876 كما نقل في القرن الحادي عشر إلى العربية. وفي عام 1888 نشر النص العربي مترجماً إلى اللاتينية، ثم نقل إلى الإنكليزية فالألمانية سنة 1896ــ1926. وقد اكتشفت المخطوطة السريانية الفريدة لتفسير مار أفرام للدياطسرون ونشرت بالطبع في أوكسفورد سنة 1963 مترجمة إلى اللاتينية. بعض مخطوطات الكتاب المقدس الباقية: اكتشفت عبر الأجيال مخطوطات لأسفار الكتاب المقدس، مجموعة أو متفرقة بلغاته الأصلية أو ترجماته. من ذلك مخطوطات البحر الميت في فلسطين، التي اكتشفت عام 1947 وهي ملفات من الرق، أهمها نص كامل، باللغة العبرية، لسفر النبي إشعيا الذي عاش في القرن الثامن ق.م وتنبّأ عن ميلاد السيد المسيح من عذراء، وعن صلبه وموته. ويعود تاريخ نسخ هذه المخطوطة إلى القرن الأول للميلاد، وتظهر أهميتها لعدم وجود مخطوطات كاملة بالعبرية يرجع تاريخها إلى ما قبل القرن التاسع للميلاد. والمخطوطة الفاتيكانية الكاملة: وتضم أسفار العهد القديم مع الجزء الأكبر من الأسفار القانونية الثانية وأسفار العهد الجديد ما عدا رسالتي تيموثيؤس الأولى والثانية ورسالة تيطس وسفر الرؤيا. وقد عني الملك قسطنطين بنسخها باليونانية سنة 328م. المخطوطة السينائية: باليونانية وتتضمن ثلثي أسفار العهد القديم، ويرتقي تاريخ نسخها إلى القرن الرابع للميلاد، وقد اكتشفت هذه المخطوطة النفيسة في دير سانت كاترين عند سفح جبل سينا، وأهديت إلى القيصر نيقولا الثاني امبراطور روسيا وقد طبعها ونشرها سنة 1862 وظلت النسخة الأصلية في مكتبة ليننغراد ثم بيعت إلى المتحف البريطاني عام 1933 وتحتوي على أسفار العهد القديم بكاملها وعلى القسم الأكبر من الأسفار القانونية الثانية واسفار العهد الجديد. واكتشفت أيضاً في الدير نفسه (دير كاترينا) سنة 1844 نسخة يونانية للعهدين خُطَّت في القرن الرابع، وهي محفوظة الآن في المكتبة الملوكية في بطرسبرج. ويرتقي عهد نسخها إلى القرن الخامس للميلاد، وهي تضم أسفار العهدين كاملة، وبعض الأسفار القانونية الثانية وهي المكابيين وطوبيا ويهوديث وعزرا الأول والثاني والحكمة وحكمة سليمان. وكانت هذه المخطوطة ضمن مخطوطات بطريركية الاسكندرية حتى سنة 1628 حيث أهديت إلى شارلس الأول ملك انكلترا وهي الآن محفوظة في المتحف البريطاني في لندن. وقد كتبت باليونانية بالحرف الاسفيني الذي كان مستعملاً حتى القرن التاسع للميلاد. وهي محفوظة في مكتبة السلطانية بباريس، وسميت بالأفرامية لأن أحدهم اقتناها باعتبارها أسفار الكتاب المقدس، ولكن إذ بهت لون كتابتها، كتب عليها ميامر أفرام السرياني(+373) فوق كتابة الأسفار المقدسة. واستطاع أحد العلماء أن يمحو منها ميامر مار أفرام فظهرت الكتابة الأصلية للكتاب المقدس باليونانية وهي قديمة جداً إذ تعود كتابتها إلى القرن الرابع للميلاد. مخطوطة الإنجيل بحسب يوحنا باليونانية: اكتشفها عام 1956 السيد مرتان بودمير أحد أساتذة اللاهوت في جنيف، وهو القسم الأكبر من إنجيل يوحنا (من الفصل الأول وإلى الفصل الرابع عشر) وقد كتب على ورق البُردي ويرجع تاريخ كتابته إلى القرن الثاني للميلاد أي بعد وفاة الرسول يوحنا بمدة وجيزة جداً. وهو مطابق كل المطابقة لنص الإنجيل اليوناني الذي بين أيدينا ولسائر المخطوطات، كمخطوطة الفاتيكان التي نسخت سنة 328م والسينائية التي يرقى تاريخ نسخها إلى القرن الرابع أيضاً والاسكندرية التي يرجع تاريخها إلى القرن الخامس. مخطوطات بالسريانية: ومن المخطوطات المهمة جداً، والقديمة جداً، نسخة للأناجيل الأربعة المقدسة بالسريانية بخط الكاتب يعقوب في الرها كتبها عام 411م وهي محفوظة اليوم في المتحف البريطاني في لندن. والمخطوطة السريانية للكتاب المقدس كتبت سنة 548م ومحفوظة في مكتبة الفاتيكان. ومخطوطة مكتبة فلورنسا التي كتبها بالسريانية سنة 586م الربان رابولا ولذلك تدعى بـ (إنجيل رابولا) وتنطوي على ست وعشرين صورة ملونة وفضلاً عن امتياز هذه المصاحف بجودة الخط وحسنه، فقد تميّزت أيضاً بالنقوش والصور التي جاءت آية في الفن والإبداع. ومن النسخ المحفوظة في مكتبات الكنائس والأديرة السريانية والمتاحف وخزانات الكتب العالمية نذكر على سبيل المثال لا الحصر نسخة قديمة للعهد الجديد مكتوبة بالسريانية ومنقولة إلى العبرية نُسخت سنة 1189 ومحفوظة في دير مار متى في الموصل ــ العراق. إلى جانب هذه المخطوطات، هناك آيات مقدسة وعبارات كريمة لا يحصى لها عدد اقتبسها آباء الكنيسة الأولون من أسفار الكتاب المقدس منذ فجر المسيحية. وهي محفوظة ضمن كتاباتهم بمخطوطات قديمة العهد. وهي أقوى برهان وأدمغ حجة على سلامة الكتاب المقدس لأن نصوصها مطابقة كل المطابقة لنصوص الكتاب المقدس. وقد قيل عن مار أفرام السرياني مثلاً: «لو نفدت ترجمة الكتاب المقدس السريانية الأصلية لتيسر جمع نصوصها من تصانيف مار أفرام». في أواسط القرن السادس عشر للميلاد أرسل البطريرك الأنطاكي السرياني مار إغناطيوس عبدالله اسطيفان (1520ــ1557+) القس موسى ابن القس اسحق الصوري إلى النمسا، وبوساطة أستاذ القانون الكنسي المستشرق العلامة يوحنا بدمانستاديوس الذي كان يجيد اللغة السريانية اهتم بطبع أسفار العهد الجديد من الكتاب المقدس لأول مرة باللغة السريانية طبقاً لنص الترجمة البسيطة (فشيطتا) وذلك في فيينا سنة 1555م على نفقة فرديناندرس (1503ــ1564م) ملك رومانيا وجرمانيا وهنغاريا وبوهيميا ورئيس رؤساء النمسا الشرقية والغربية يومذاك. وقد طبع الكتاب بالقلم السرياني الغربي الذي وضع في القرن التاسع للميلاد. أما العناوين فقد كتبت بالخط الاسطرنجيلي. ويحتوي الكتاب على أسفار العهد الجديد ما عدا رسالتي يوحنا الثانية والثالثة ورسالة يهوذا وسفر رؤيا يوحنا الرسول. ذلك أن بعض الآباء لم يكن قد تبين لهم قانونية هذه الأسفار وبعض أسفار العهد القديم. أما اليوم فقد زالت الشكوك التي كانت تثار حولها وهي في الكنيسة السريانية تعتبر كسائر الأسفار القانونية. وقسمت أسفار الكتاب المذكور إلى فصول تتلى عادة في الكنيسة السريانية في بدء القداس أيام الآحاد والأعياد. ويعتبر الكتاب تحفة من تحف فن الطباعة وهو أول كتاب سرياني ينشر بالطبع. كان كل سفر من أسفار الكتاب المقدس في أول الأمر فصلاً واحداً من أوله إلى آخره ما عدا سفري المزامير ونشيد الأنشاد. وقيل أن أسفار العهد القديم تم تقسيمها إلى ستمائة وتسعة وتسعين فصلاً على يد عزرا الكاتب أو موسى النبي. أما تقسيم سائر الأسفار إلى فصول، المعوَّل عليه لدينا نحن السريان فقد جرى على يد العلامة مار يعقوب الرهاوي الذي قسّم الترجمة السريانية البسيطة (فشيطتا) إلى فصول واضعاً في مقدمة كل فصل ملخصاً لمحتوياته وفي الهامش شرحاً للكلمات الصعبة كما ضبط اللفظ الصحيح. عيّن السريان فصولاً خاصة من أسفار الكتاب يتلونها أيام الآحاد والأعياد في الكنيسة ضمن الطقس البيعي. فقد عينوا لكل أحد وعيد ثلاث قراءات من العهد القديم على أن تكون الثالثة من أسفار النبوات، وثلاثاً من العهد الجديد أي من سفر أعمال الرسل أو إحدى الرسائل الجامعة ومن الرسائل البولسية والإنجيل المقدس. وتزيد هذه القراءات وتنقص بالنسبة إلى المناسبة في ممارسة أسرار الكنيسة والأصوام والمواسم. ومما يلاحظ أن السريان استثنوا من الكتاب المقدس قراءة سفري نشيد الأنشاد ورؤيا يوحنا وأكثر سفري المكابيين. وقد وضع آباء الكنيسة صلوات خاصة يتلوها المؤمنون قبل البدء بقراءة الكتاب المقدس في تأملاتهم الفردية والعائلية والطقسية، وهي أدعية فيها يطلبون من الرب أن ينير أذهانهم لفهم معاني كلمة الحياة ذلك أن للكتاب المقدس مكانة سامية في الكنيسة. وبموجب طقسنا السرياني يُنصب في وسط باب المذبح المتوسط في كل كنيسة منبر صغير من الخشب يقال له بالسريانية (جوغولتو) أي الجلجلة. ويُصمد عليه الإنجيل المقدس ويكون ظاهر الإنجيل مغشى بصفيحة من الذهب أو الفضة المذهبة موسوماً عليها صور الإنجيليين الأربعة والصليب المقدس ليقبِّله المؤمنون تبركاً عند دخولهم الكنيسة ومغادرتهم إياها. كما خصصت الكنيسة مناداة يرتلها الشماس قبل قراءة الإنجيل المقدس في الكنيسة خلال الخدمات الطقسية، يدعو بها المؤمنين أن يقفوا منتصبين، ويصغوا بخوفٍ وحكمة لسماع كلام بشارة الخلاص، ويعبق البخور أثناء ذلك. وقارئ الإنجيل في الطقس السرياني عندنا هو مقرِّب الذبيحة الإلهية بطريركاً كان أو مطراناً أو كاهنا |
||||
|
|
|||||
|
|
رقم المشاركة : ( 5082 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
الخطيئة  الأب د./ رمزي نعمة 1)طبيعة الخطيئة: أ-الخطيئة مخالفة إرادية: الخطيئة إساءة إلى الله، ومخالفة إرادية لشريعته. وحتى المخالفة الطوعية للقانون البشري تُعتبر خطيئة، لأن شريعة الله هي أساس التشريع البشري. وليس من الضروري للإنسان لارتكاب خطيئة أن يكون شاعراً بالإساءة إلى الله. وعلى الكائنات العقلانية واجب التصرف بطريقة تتلائم مع طبيعتها. فإذا تصرّف الإنسان بخلاف طبيعته فإنه يخطئ، بصرف النظر إذا كان الفرد يفكر في الله أو لا. ومن هنا فقد رفضت الكنيسة الخطيئة الفلسفية. وبعبارة أخرى فلا يوجد فعل يخالف الطبيعة البشرية والتفكير السليم دون أن يكون إساءة لله- حتى عند شخص يجهل الله. إن العنصر الذي يجعل ذلك العمل خاطئاً، هو صفة البُعد عن الله الكامنة في هذا العمل. فالخطيئة هي ثورة على الله. ويرغب المخلوق البشري الخاطئ أن يكون مستقلاً عن الله- وأن يقرر لنفسه ما هو الخير والشر. وفي ضوء هذا فاصطلاح: الخطيئة، يشير مبدئياً إلى الخطيئة المميتة قياساً إلى الخطيئة العرضية. ب-الأقل كمالاً: وليس طبيعياً اعتبار النقص أو عدم الكمال شيئاً مساوياً للخطيئة. ويعتبر النقص أحياناً بأنه إهمال عمل غير مجبر القيام به إنما أمر محبذ. وإذا فهمنا الأمر على هذا النحو فالنقص بالتأكيد ليس خطيئة، إذ إن ما ينصح به يترك للخيار الحر للشخص الذي يقوم به. كما أنه لا يجوز معادلة النقص بالخطيئة العرضية. واعتبار الخطيئة العرضية "غير المقصودة" نقصاً هو بلبلة في الاصطلاحات، إذ إن الفعل غير المقصود تماماً خارج عن ميدان الأخلاق: وفي الواقع فالنقص إهمال لفعل حسن أو أحسن، كالتخلف مثلاً عن حضور القداس في يوم من أيام الأسبوع أو إعطاء خمسة جنيهات للفقراء عندما يستطيع إنسان أن يدفع عشرة. إن مثل هذا النقص ليس خطيئة، لأن الإنسان ليس ملزماً دائماً بعمل الشيء الأحسن. وبناء على المبدأ القائل إن كل فعل إما أن يكون حسناً أو شريراً، على الإنسان أن يعتقد أن الفعل الذي يدعي بالناقص أو الأقل كمالاً هو جيد. فالفارق هو نفسه بين الحسن والأحسن لا بين الحسن والأسوأ. ج-الشروط لاعتبار عمل ما خاطئاً: 1-إذا كان الفعل نفسه مغلوطاً (أي بعيداً عن النظام الخلقي)، بحيث يخفق في الانسجام من ناحية ما مع مقاييس السلوك البشري. 2-إذا كان القائم بعمل يدرك أن ذلك الفعل مغلوطاً أو ناقصاً. وهذا الإدراك عقلي. 3-وإذا وافق الفرد أن يتصرف بهذه الطريقة المغلوطة. فالموافقة هي فعل الإرادة. وإن لم تستوف واحدة من هذه الشروط، يفقد الفعل طبيعته الخاطئة. د-الخطيئة الأصلية والشخصية: 1-الخطيئة الأصلية: وهي حالة الابتعاد عن الله، وهي التي ولد فيها الجميع نتيجة لخطأ آدم. 2-الخطيئة الشخصية: وهي فعل إرادي لفرد يخالف شريعة الله. وقد تكون الخطيئة الشخصية: - فعلية (actual) أو حالية (habitual): والخطيئة الفعلية هي الفعل البشري الخاطئ نفسه. وهي خطيئة الارتكاب بمخالفة أمر سلبي، كالأمر الإلهي ضد السرقة. إن الخطيئة الفعلية هي خطيئة الإهمال إذا خالفت أمراً إيجابياً كالأمر الكنسي بالصوم في أوقات معينة ويمكن ارتكاب الإنسان خطيئة بالفكر أو بالقول أو بالفعل أو بالإهمال. والخطيئة الحالية هي الحالة الخاطئة التي هي نتيجة الفعل. - مادية (material) وحقيقة (fomal) مادية عندما يقوم شخص بارتكاب شيء خاطئ موضوعياً بدون أن يدرك ذلك. وحقيقة وهي تتحقق عندما يتوافر الوعي والإرادة. - مميتة وعرضية: مميتة عندما تسبب موتاً روحياً بتجريد الفرد من الحياة الإلهية. عرضية عندما تقلل من حماسة الحب. وسنعود فيما بعد للفروق بين الخطيئة المميتة والخطيئة العرضية. إن القديسين في السماء يشاهدون الله ويحبونه كما هو، وتدفعهم قوة طبيعتهم إلى الاتحاد به. أما البشر على الأرض فإنهم لا يشاهدون الخير المطلق لكي يرتبطوا به. فهم لا يشاهدون سوى انعكاسه في الفضائل الخاصة التي يستطيعون عدم الاكتراث بها. فهم يستطيعون الانتقاء والاختيار من بين هذه الفضائل الخاصة، ويقومون أحياناً باختيارات خاطئة تتعارض مع دعوة الله. ومن هنا تأتي إمكانية الخطيئة. 2)أنواع الخطايا: يمكن تمييز الخطايا من الناحية النوعية والناحية العددية. ولهذا التمييز علاقة هامة بسر التوبة إذ إن الشريعة تُلزم الخطاة على الاعتراف بخطاياهم المميتة بحسب نوعها وعددها. أ- الناحية النوعية: حسب تعليم توما الإكويني تتميز الخطايا من ناحية أنواعها تبعاً للموضوع الذي تميل إليه بحكم طبيعتها. هذا الميل بالذات هو الذي يحدد الأخلاق الموضوعية للخطايا ويجعلها في أنواع مختلفة. وهكذا فالقتل يتميز بصورة خاصة عن السرقة، ذلك لأن القتل يقضي على حياة الإنسان، بينما السرقة تأخذ منه ممتلكاته. ويعتمد نوع الخطيئة على الهدف المنشود وليس على رفض الله الموجود في كل خطيئة. ويعتقد علماء لاهوت آخرون، مثل سكوت، أن الخطايا تتميز بصورة معينة بقدر ما تعارض الفضائل المختلفة. وهكذا فإن خطيئة التمرد تختلف بصورة خاصة عن خطيئة الإفراط. ومع هذا يميز علماء لاهوت آخرون، مثل جبرائيل فاسكويز، الخطايا على أساس مخالفتها للشرائع المختلفة. وهكذا فإن خطيئة ضد الوصية الرابعة من الوصايا العشر تختلف قطعاً عن الخطيئة ضد السادسة. إن هذه المعايير لتمييز الخطايا لا تبدو قطعاً أنها تتعارض مع بعضها بعضاً. ويبدو معيار الإكويني أكثر أصالة بينما تظهر المعايير الأخرى تقريبية. ب- الناحية العددية: تتحكم مبادئ أخرى بالتمييز العددي للخطايا. وتتضاعف الخطايا عددياً كلما تميزت نوعياً. فالزاني يرتكب خطيئتين متميزتين قطعيتين واثنتين من حيث العدد عن طريق فعل زنا واحد لأنه يناقض العفة والعدالة كلتيهما. تتضاعف الخطايا عددياً كلما تكرر فعل الخاطئ. ففي كل مرة يسطو لص على مصرف فإنه يرتكب خطيئة متميزة عددياً. ولا يوافق المؤلفون على الإجابة عن السؤال حول ما إذا كانت الخطايا تتضاعف عددياً إذا وجه فعل واحد نحو أهداف متعددة. ويبدو أنه إذا كان كل من هذه الأهداف واحدة من تلقاء نفسها، وإذا مثلاً تسببت جريمة واحدة في جرح عدة أشخاص، فمعظم المؤلفين يعتبرون هذا قضية تضاعف عددي. وحتى إذا كان هدف واحد خاضعاً لآخر، إذ يعتبر معظم المؤلفين العمل الذي تم بأجمعه عملاً واحداً خاطئاً. وهكذا فالترتيبات جميعها التي قام بها اللص الذي يخطط لسرقة مصرف تكون خطيئة واحدة مع السرقة الحقيقية. 3)الخطايا الداخلية: الخطايا الداخلية هي تلك التي يرتكبها الإنسان في قلبه ولا تظهر في الخارج. وكان يسوع يتحدث عن الخطيئة الداخلية عندما علمنا أن كل من ينظر باشتهاء لامرأة قد ارتكب زنا معها في قلبه (مت 28:5). وقد اعتاد علماء اللاهوت في تمييزهم بين الخطايا الداخلية أن يتحدثوا عن: أ-اللذة المتوقف عليها Delectatio morose: إن اللذة المتوقف عليها، وهي معنية بالحاضر، ترضي رضى خاطئاً إذا ما فكرت وتخيلت الشر بدون الرغبة فيه حقيقة. فيعتبر مذنباً مثلاً ذلك الشخص الذي يفكر في إيذاء الآخرين. ب-الابتهاج المحرم Gaudium peccaminosum: ويعني الابتهاج المحرم الموافقة على فعل خاطئ ارتكبه الشخص نفسه أو غيره في الماضي. فمثلاً إذا قال الإنسان لنفسه "جرح فلان فلاناً في الماضي وأنا مسرور لأنه فعل ذلك"، يعتبر ذلك الشخص مذنباً في فعل الشر. ج-الرغبة القبيحة Desiderium pravum: هي الرغبة والقصد لعمل شيء شرير في المستقبل. فكما يلاحظ فالأولى معنية بالحاضر، والثانية بالماضي والثالثة بالمستقبل. وتجب الملاحظة أن الفعل الإرادي فقط يمكن أن يخطئ وليس فعل العقل. وبعبارة أخرى، التفكير في شيء شرير ليس خاطئاً بحد ذاته فالتفكير في الشر قد يكون ضرورياً في بعض الحالات عندما يفحص الإنسان ضميره مثلاً. غير أن التفكير في الشر ربما كان مناسبة للخطيئة عندما، على سبيل المثال، يستغرق الإنسان في أفكار حية. وتدخل الخطيئة عندما يوافق الشخص بالحقيقة على الشر المعتزم. وقد تحدّث يسوع عن خبث الشهوة الشريرة (مت 28:5). فالمجرم الذي يقصد سرقة أحد المصارف ولكنه يتراجع عند مشاهدته أحد الحراس يكون مذنباً بالسرقة في عيني الله حتى ولو أنه لم يمض في الجريمة. وفي الحالات الثلاث جميعها لا يختلف الفكر ولا العمل في الأساس فيما يتعلق بالخبث. إن غياب العمل لا يزيل خطيئة الإرادة الفاسدة. وقد يشعر الفرد بالرضى نتيجة التأثير الجيد الذي يلحق بشيء شرير. وهكذا فالزوجة قد تشعر بالرضى تجاه الحقيقة كونها غير معرضة للإيذاء الجسمي من قبل زوج مدمن على المسكرات. 4)الخطيئة المميتة والعرضية: الفارق بين الخطيئة المميتة والعرضية له علاقة "بالنوع اللاهوتي" للخطيئة. ونعالج هنا ثقل الخطايا. ولا تشير فكرة كون الخطايا غير متساوية في ثقلها إلى الفارق بين الخطيئة المميتة والعرضية وحسب بل أيضاً إلى الفارق في الثقل بين الخطايا المميتة. أ-الخطيئة العرضية: لا تدمر الخطيئة العرضية حياة النعمة، ولكنها تستوجب العقاب المؤقت. وعندما يرتكب الإنسان خطيئة عرضية فهو لا يبتعد عن الله، إذ يبقى الله هدفه، إلا أنه ينعطف في الطريق عن الله. ب-الخطيئة المميتة: أما الخطيئة المميتة فإنه تدمر حياة النعمة، وهي موت روحي، وتعاقب بالهلاك الأبدي في الجحيم. وعندما يرتكب الإنسان خطيئة مميتة فإنه يبتعد عن الله، ولا يعود الله هدف حياته. وهناك تعارض أساسي بين الفعل الخاطئ المميت ومحبة الله. الخطيئة المميتة هي الخطيئة بالمعنى الكامل للكلمة. وما الخطيئة العرضية سوى خطيئة بالمعنى التشابهيanalogical sense. قبل الوقوع في خطيئة مميتة، يجب أن تتحقق ثلاثة شروط: 1-يجب أن تكون المادة ثقيلة. ويمكن التعرّف على ثقل المادة من الكتاب المقدس، وتعليم الكنيسة والإدراك السليم. فعلى سبيل المثال، تؤكد لنا هذه المصادر الثلاثة أن قتل الإنسان مادة ثقيلة جداً. 2-يجب أن يكون هناك تفكير كاف من جانب العقل، أي أن القائم على العمل يجب أن يعي بوضوح العمل الشرير الخطير الذي يفكر في القيام به. 3-يجب أن تكون هناك موافقة تامة للإرادة للعمل الشرير في مادة ثقيلة. وإذا كان الأمر المقصود ليس خاطئاً إلى درجة ثقيلة إذن فالعمل الخاطئ لا يمكنه أن يكون إلا عرضياً. وإذا كان التفكير والموافقة غير كاملين، حتى ولو كان المر المقصود ثقيلاً، تكون الخطيئة عرضية بحكم الضرورة. إن الخطر الرئيسي للخطيئة العرضية، على كل حال، هو في انه يضعف حماسنا في خدمة الله، ويميل بنا إلى الخطيئة المميتة. 5)أسباب الخطيئة: الله ليس سبب الخطيئة بل الضعف البشري مسؤول عن الفعل الخاطئ: أ-العقل والإرادة: يستذكر الإكويني في نقاشه حول أسباب الخطيئة أن الإرادة هي الموهبة الرئيسية في أداء أي عمل بشري، حسن أو رديء، وأن العقل يوجه الإرادة، وأن العواطف تؤثر في الأفعال البشرية ولكنها لا تسيطر عليها. إن إرادة الخاطئ وحدها هي سبب الخطيئة، إلا أن الإرادة معرضة للإغراء من الخارج والداخل. ب-القوة الشيطانية: يُفهمنا الكتاب المقدس كيف أن عمل الفداء هو انتصار على قوة الشيطان. وبالفعل فإن الشيطان يحاول توجيه الناس نحو الخطيئة. وإن كان باستطاعته إغراء المخلوقات البشرية، إلا أنه لا يستطيع إرغام أي شخص على ارتكاب الخطيئة. ولا يستطيع الاعتداء على الحرية الإنسانية. وعلينا أن نقرّ أيضاً بأن التجارب والإغراءات ليست جميعها من الشيطان. ج-العالم: "العالم"، هو أيضاً، ليس سبباً للخطيئة لأنه لا يستطيع إجبار الإرادة بأن تتصرف خطأ. إلا أن العالم يستطيع إغراءنا بارتكاب الخطيئة، ويستطيع أن يكون مناسبة للخطيئة. ونفكر هنا في أولئك الأشخاص، والأماكن والأشياء التي تستطيع أن تقودنا إلى الخطيئة. ونحن ملتزمون بتجنب المناسبات القريبة من الخطيئة، وعندئذ يجب أن تقوم بخطوات تقلل من الخطر. إن المناسبات الأكثر بعداً للخطيئة لا يمكن أبداً تجنبها، فهي جزء من الحياة. د-الشهوة: إن الشيطان كالعالم يجربنا من الخارج، غير أن الشهوة تجربنا من الداخل. وتعني الشهوة ميلاً إلى الشر في داخل الشخص البشري. وهي "شهوة الجسد وشهوة العين وكبرياء الغنى" (1يو 16:2). والشهوة تتعلق بالرغبات الجسدية، والطموحات الدنيوية، والأغراض الأنانية، وروح التملك، وجاذبية القيم المادية، وحب الظهور الدنيوي، وبإمكان هذه الأشياء جميعها أن تشتعل في داخل القلب البشري وتعرض الإنسان لإغراء ارتكاب الخطيئة. الخاتمة: أحياناً ييأس الناس من مقاومة بعض التجارب لارتكاب الخطيئة. ولكنهم يجب ان يتذكروا أن الله لا يسمح للإنسان أن يتعرض للتجربة إلى درجة تتخطى قدرته على المقاومة. إن الطريقة الممتازة لتجنب الخطيئة هي تجنب أولئك الأشخاص، والأماكن والأشياء التي تقودنا نحو الخطيئة. وللجوء المنتظم لسر التوبة مساعدة عظيمة. ولا يقصد من وراء التجارب تدميرنا، إذ أنها في صالحنا. والمقصود بها تقوية أعصاب وعضلات عقولنا وقلوبنا ونفوسنا. فهي المحك الذي يمكننا من الانطلاق للمعركة ونحن في حالة أقوى. إن الله يدعو الخطاة إلى الارتداد. والارتداد معناه الابتعاد عن الخطيئة والرجوع إلى الله. وتعني الانسجام الكلي لإرادة الأب السماوي، والتوقف عن فعل الخطيئة، والثورة على وجهة نظر الإنسان ورغباته كي يصبح الإنسان مخلوقاً جديداً. وعلى كل حال فإن موضوع الارتداد سيعالج بإسهاب أكبر مع سر التوبة |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 5083 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
النشاط الخارجي للصلاة 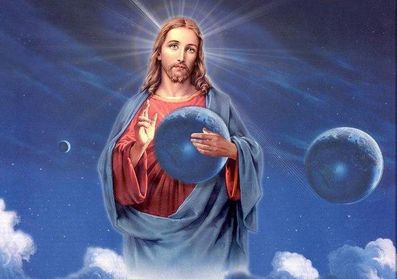 الصليب المقدس تكريم ورشم الصليب الإنسان بكل طاقاته يشترك في عبادة الله: إذا كانت أجسادنا هي أعضاء المسيح، وهي هيكل الله والروح القدس يسكن فيها (1كو 6: 15؛ 1كو 3: 16)؛ فأجسادنا مع أرواحنا ونفوسنا سوف تتمجَّد معاً في الأبدية. ولذلك، فإن عبادتنا لله لابد أن تشترك فيها أجسادنا مع أرواحنا ونفوسنا، بما فيها العقل والأحاسيس والمشاعر؛ وإلاَّ فكيف تكون أعمال عبادتنا متكاملة؟ فنحن في عبادتنا نستخدم أولاً الكلمات، وهذه الكلمات المنطوقة منا تحمل أول ما تحمل المعنى الحرفي لها، ويستوعبها عقلنا بمعناها في أذهاننا. ولكن هناك ما هو أبعد من المعنى الحرفي في أعمال عبادتنا. ففوق ووراء المعنى الحرفي للكلمات، هناك بعض المقاطع والجُمَل ذات ترابُط وتداعيات، وتحمل في طيَّاتها قوة خاصة، مخفية، وشاعرية. لذلك فنحن في صلواتنا نستخدم كلمات، ليست فقط بحروفها، بل وبجمالها أيضاً من خلال التصوُّر الشعري، حتى ولو كانت بعض التسبحات والصلوات مكتوبة على هيئة إيقاع شعري أكثر من كونها شعراً مُقفًّى، وبذلك نُضفي على الكلمات بُعداً ومعنىً جديدين. لذلك، فنحن حينما نؤدِّي عبادتنا، نؤدِّيها ليس فقط بكلمات منطوقة بحرفيتها فقط، بل وبتنوُّع كبير وبطرق أخرى في إلقائها: من خلال الألحان، ومن خلال جمال الملابس الكهنوتية داخل الهيكل أثناء خدمة الليتورجيا (القداس)، ومن خلال الخطوط والألوان في الأيقونات المقدسة، ومن خلال تصميم البناء المقدس للكنيسة، ومن خلال الحركات الرمزية مثل رشم علامة الصليب، وتقديم البخور، وإيقاد الشموع، وأخيراً من خلال المواد المستعملة في جوانب الحياة البشرية: مثل الماء، وعصير الكرمة، والخبز، والزيت، والنار. فمن خلال استخدام الكلمات حرفياً نحن نصل إلى تعقُّل الذهن البشري؛ فعن طريق الشعر واللحن والفن والأفعال والرموز الطقسية، فإننا نصل إلى كل جوانب الشخصية الإنسانية الأخرى.وكل أسلوب وطريقة نستخدمها في العبادة هي أساسية مثلها مثل باقي الأساليب والطرق. ولنفرض مثلاً أننا جعلنا كلماتنا التي نتلوها في العبادة أو نُرتِّلها بالألحان بلا معنى حرفي أو بلا غرض مفهوم؛ فنكون كأننا نرطن أو كنحاس يطنُّ أو كصنج يرنُّ، ويتحول السر حينئذ إلى سحر لا يليق بخراف المسيح العاقلة الناطقة (كما يُسميهم كتاب: الدسقولية - تعاليم الرسل). وبالتالي فإن اقتصرنا في عبادتنا على الكلمات فقط، وننطقها حرفياً فقط، فستكون عبادتنا عبادة بالذهن فقط، دون أن تكون عبادة بالقلب أيضاً. وفي هذه الحالة ستكون عبادة منطقية فقط تستخدم العقل فقط، وتستبعد كل طاقات الإنسان غير العقلية الأخرى. وهذا ما فعله المُصلحون للكنيسة الغربية حينما أغفلوا قيمة ومعنى السر في عبادتهم لله؛ فبدون معنى السر في العبادة، فنحن لا نكون بشراً عابدين الله بالروح والحق. فالعبادة هي أكثر من مجرد كلمات تُقال، وأكثر من مجرد اجتماع المؤمنين حول منبر وواعظ يعظ، إنها سرٌّ. هل رموز ومحسوسات العبادة، ليست معاصرة؟ وكثيراً ما يُقال بأن الرموز والمحسوسات المستخدمة في عبادتنا التقليدية، ولمسة الجمال التي تُصوِّرها؛ أصبحت وقد عفا عليها الزمن، ولم تَعُد مناسبة لعالمنا المعاصر. وكما يدَّعي أصحاب هذا الادِّعاء أن هذه الرموز والمحسوسات مقتبسة من نمط الحياة في البيئة الزراعية الريفية التي كانت سائدة قديماً، ولم تَعُدْ من جوانب كثيرة صالحة للبيئة الصناعية المعاصرة. ويتساءلون: لماذا يجب أن نعبد الله وفي يدنا شمعة أو مبخرة (شورية)، وليس في يدنا مثلاً سمَّاعة طبيب أو إزميل نجَّار!! وهما غير مناسبَيْن للعبادة. ولهؤلاء نردُّ أن الأفعال والرموز التي نستخدمها في عبادتنا لها مغزى عام لا يتغيَّر بالضرورة مع تغيُّر الأزمان. فبالرغم من أن الليتورجية الإلهية (القداس) قد ترتَّبت بحسب التقاليد الغنية التي كانت سائدة في عصر معيَّن، ولكنها في جوهرها الداخلي تتجاوز هذه الحدود، وتُخاطب الوضع والجوهر الداخلي للإنسان، سواء قديماً أو حديثاً، شرقاً أو غرباً. فالكنيسة الأرثوذكسية تستخدم في صلواتها المواد الأولية التي يستخدمها الإنسان على مر العصور. فالخبز والماء والزيت والنور والنار يستخدمها الناس قديماً وحديثاً، ولا يُغيِّرونها بتوالي الأزمنة. فإن لم يجد الناس في بيئة متحضِّرة تكنولوجية معنىً لهذه المواد، أفليس يعني هذا بأن أصابع الاتهام يجب أن توجَّه للمدنية المعاصرة الموصومة بالتزييف وعدم الواقعية؟ إن ما يحتاج إليه هؤلاء، ليس تغيير هذه الرموز، بل تغيير أنفسهم هم وتنظيف مداخل أذهانهم! + وفي هذا السياق، نجد بادرة أمل وتشجيع من التقدير الذي يُقدِّمه الغرب الآن للأيقونات الكنسية. فهناك أعداد كبيرة مثيرة للدهشة، من مؤيِّدي الحداثة والعصرية، رجالاً ونساءً، الذين بالرغم من عدم انضمامهم لعضوية أي كنيسة في بلادهم؛ أصبحوا مهتمين ومنجذبين بشدة للأيقونات الأرثوذكسية عندنا في الكنيسة القبطية وسائر الكنائس الأرثوذكسية. فلا نتسرَّع ونتهم مثل هؤلاء بأن تقديرهم هذا عاطفي ومصطنع. ألسنا نجد في تصرُّفهم، ونحن في عصر التكنولوجيا والترويج للعلمانية secularism شيئاً من التضاد، إذ كيف يحسُّون بالانجذاب لهذا النوع من الفن الذي هو بلا شك فن روحي ولاهوتي بآنٍ واحد؟ وهل كانوا ينجذبون لو أن فن الأيقونة كان مُعاصراً ومتجدِّداً بحسب مدارس الفن الحديث؟ العبادة تعبير عن فرح وجمال ملكوت الله: والمسيحي الأرثوذكسي يرى أنه من الأهمية بمكان أن تُعبِّر العبادة عن الفرح والجمال اللذين لملكوت السموات. فبدون عامل الجمال، لن يتحقَّق في عبادتنا أن تكون العبادة صلاة، بكل ما في الكلمة من معنى، أي صلاة من القلب كما هي صلاة من العقل. فالجمال والفرح في ملكوت الله لا يمكن التعبير عنهما ببراهين مجرَّدة ولا بشرحٍ منطقي، فهما عنصران يُختبران أو يُعاشان، وليس يُناقشان. لذلك فإنه من خلال أفعال العبادة بالرمز والفعل: بالبخور الذي تتصاعد حلقاته في الهواء، بإشعال الشمعة أو حتى المصابيح أمام أيقونة في الكنيسة؛ فإن اختبار الفرح والجمال يتحقَّقان بالفعل. المسيحي القبطي أو الشرقي يحسُّ جيداً ويمارس هذا الاختبار في كنائسنا بطُرق واضحة للجميع. هذه اللمسات البسيطة تُعبِّر، أفضل ألف مرة من الكلمات، عن أحاسيسنا تجاه الله، وكل محبتنا وتكريمنا وإيماننا بالله. وبدون ذلك تفتقر العبادة إلى الكثير من المقوِّمات. العبادة بالطقوس أمر حتمي للتعبير عن كل أحاسيسنا: وإلاَّ فلماذا نُقدِّم البخور ونُشعل الشموع؟ لماذا نؤدِّي السجود أو الميطانيا أمام الهيكل في الكنيسة؟ ولماذا نرشم علامة الصليب على جباهنا وصدورنا؟ فإن حاولنا أن نُقدِّم شرحاً شفوياً أو مكتوباً، فإن ذلك يُمثِّل فقط جانباً قليلاً من الحق. وهذا بالتأكيد وبالتحديد هو السبب في أداء الأفعال الرمزية في عبادتنا، لأنه إن كان الشاعر يستطيع أن يُعبِّر بكلامه المُرسَل عمَّا قاله بالشعر، وإذا كان الفنان أو الموسيقي يقدر أن يُعبِّر بالكلمات العادية عمَّا يريد أن يقوله بالرسم أو باللحن؛ حينئذٍ لن تكون هناك حاجة لقصيدة أو لوحة فنية أو سيمفونية موسيقية. ولكن كل هذه وُجدت لأنها تُعبِّر عمَّا لم يكن ممكناً التعبير عنه بوسيلة أخرى. هكذا الأمر في العبادة، فإنه لو كان من الممكن أن نقول بالكلمات: لماذا نُشعل الشمعة ونحرق البخور، لكنَّا بقينا مستريحين مكتفين بالشرح بالكلام، ونستغني عن العمل الطقسي بجملته. لكن القيمة المتكاملة للرمز في العبادة هي أنها تُعبِّر عمَّا ليس في إمكاننا أن نقوله بالكلمات المنطوقة وحدها، التي تستخدم جانباً واحداً فقط من كياننا الإنساني لا يمكنه أن يُعبِّر تماماً عن كل ما يعتمل في نفوسنا. والواقع والحقيقة أن الرمز هو الأبسط والأسرع في التعبير من الشرح الكلامي، وفي الوقت نفسه يتغلغل عميقاً في كبد الحقيقة. إن الرمز يستخدمه ويفهمه الفلاح والأُمِّي، الصغير وغير الفاهم، كما المتعلِّم والمثقف، وكلهم يُشبِعون به اشتياقاتهم لعبادة الله بكل كيانهم. هل الطقوس لا منفعة منها، وهل هي غير ضرورية؟ ثم نأتي إلى المستوى النفعي، الذي بـه قد ينظر البعض إلى العبادة الطقسية برموزها ومحسوساتها، فيعتبرون أن كل الجمال والحيوية فيها غير ضرورية وبلا نفع، وأن الله لا يطلبها ولا يُريدها. ولكن الكائن الإنساني ليس بمنتهى البساطة، نفعياً، فيرفض الجمال وحشد طاقاته الإنسانية في عبادة الله، مدَّعياً أنه ليس في حاجة إليها ليعبد الله، وأنه تكفي الكلمات الخارجة من فمه. ولكن هذا غير متحقِّق في عالم الواقع الإنساني اليومي. هل يدَّعي أي إنسان أنه ليس محتاجاً إلى الجمال في حياته اليومية، لأنه غير ضروري فإذا كان أيٌّ منَّا وهو منتظر زيارة مَن يحبه، أفلا يضع على المائدة غطاءً جديداً، ويُحيطه بالورود والزهور وربما بشموع وإكسسوارات أخرى، ليس عن ضرورة ولا عن نفعية؛ بل عن محبة وفرح بالزائر المحبوب؟ أما نحن فحينما نجتمع في الكنيسة، فإنما ندخل إليها بالفرح والتهليل، لأننا ننتظر حلول عمانوئيل إلهنا في وسطنا، إنه المسيح الذي قام من بين الأموات، فكيف لا نفرح به، وندخل إليه كعروس وهي داخلة إلى مخدع عريسها؟ إنه فرح الرجاء، ورجاء الفرح، الذي نُعبِّر عنه باللحن: يا ملك السلام، أعطِنْا سلامك، قرِّر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، ندخل إليه ونحن لابسون أثواب البر، ونحرق البخور أمامه، ونُشعل الشموع والمصابيح، لتستضيء الكنيسة كلها بنوره الذي تُعبِّر عنه هذه الشموع والمصابيح. هذا هوالجمال الذي كثيراً ما جحده وأنكره علينا البعض أنه غير ضروري وبلا منفعة؛ بل كثيراً ما اتُّهم بأنه خطية! إن القداس الإلهي، كثيراً ما سُمِّي السماء على الأرض، لأننا في بدء القداس، نصرخ ردّاً على سؤال الكاهن خادم المذبح: أين هي قلوبكم أو ارفعوا قلوبكم؛ هي عند الرب. فنحن في الكنيسة واقفون في السماء حول العرش الإلهي وفي وسطه الحَمَل القائم كأنه مذبوح (رؤ 5: 6)، لنأكل فصحنا الذي لا ينفد ولا يتلاشى على مدى الدهور. ويا للفرح حينما نُعبِّر عنه بعد تناولنا من الأسرار بقولنا (على فم الكاهن الخديم): فمنا امتلأ فرحاً، ولساننا تهليلاً، من جهة تناولنا من أسرارك غير المائتة، يا رب. هذه هي طبيعة عبادتنا لله: فأنْ نُصلِّي ونعبد، يعني أن ننظر الجمال الروحي لملكوت السموات؛ وأن نُعبِّر عن هذا الجمال بالكلمات والترتيل واللحن والأيقونة،+ + + ومن خلال حركات أجسادنا: رفع اليدين، النظر إلى فوق، تقبيل اليدين وجهاً وظهراً، رشم الصليب، السجود مراراً وتكراراً حسب نداء الشماس، إحناء الرأس لسماع صلاة الحلِّ ومغفرة الخطايا، إشعال الشموع، حرق البخور، التمسُّح بالأيقونة وتقبيلها، تقبيل سِتر الهيكل... إلخ؛ كل هذا يعني أننا نستخدم كل طاقات كياننا الإنساني، حتى إذا ما خرجنا من الكنيسة يرتسم نور وجهك يا رب على وجوهنا (مز 4: 6). وبهذه الطريقة نمتد بالجمال الإلهي للعالم الذي حولنا، وللأشخاص الذين نقابلهم؛ فينتقل سلام الرب ومحبته للجميع، فنكون حقّاً وإحقاقاً كارزين بإنجيل المسيح. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 5084 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
عيد الرسل وإيمان الكنيسة  الأب متى المسكين يا كنيسة الرسل يا جليلة القدر، يا جالسة على الاثني عشر كرسيًّا محيطاً بالعرش، يستمدون المجد من صاحب المجد، أينما وُجد الرب حتماً توجدون، لازمتموه في التجارب ولازمتموه في التجديد وتلازمونه في التمجيد، حُكم عليكم بالجلد من رؤساء الختانة ـ فخرجت كلمة القضاء الذي لا يُرَد أن تحكموا وتدينوا الاثني عشر سبطاً الذين عبدوا الختانة ورفضوا رب الختان. موسى النبي استُؤمن على شبه السموات وظلها، وأنتم استؤمنتم على تجسيد نور السموات بلمعانها، ووضعتم أساس كنيسة الدهور التي أساسها في السماء وبناؤها على الأرض، المدينة التي لها الأساسات الحاملة ربوات القديسين وملايين أهل بيت الله، التي تلبس البز وتحملها تبررات القديسين، التي ستُستعلن يوم يُستعلَن عريسها وهي مزيَّنة كعروس تُزفُّ لعريسها، هابطة من فوق أعلى السموات وعليها اسمها القديم أورشليم، وقد استُعلن البرّ والسلام الحقيقي على وجوه كل مواطنيها. أول من نطق باسم الكنيسة هو الرب يسوع، وكان ذلك بمناسبة اعتراف بطرس الرسول بالإيمان المسيحي: «أنت هو المسيح ابن الله الحي» (مت 16:16). فكان هذا الاعتراف هو أول تعريف لاهوتي للمسيح والكنيسة. وهذا بحد ذاته يُفرِّح قلوبنا ويُبهج أرواحنا أن الإيمان المسيحي أول ما جاء جاء على لسان رسول دون إملاء. وبهذا يُحسب الإيمان المسيحي أنه استعلان وليس تلقيناً، والاستعلان ليس بجهد بشري أو بتسليم ولكنه استعلان من الآب السماوي حينما كشفه الرب وأعطى معه صورة كاملة بديعة لما هي الكنيسة، ومَنْ هو مصدرها، وما هو سلطانها، وما هي قوتها السمائية المؤمَّن عليها ضد الشيطان وسلطانه، شيء يملأ القلب بالإيمان والرجاء الحي. + «وأنتم مَنْ تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان بن يونا. إن لحماً ودماً لم يُعلن لك لكن أبي الذي في السموات، وأنا أقول لك أيضاً أنت بطرس (صخر) وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً في السموات، وكل ما تحلُّه على الأرض يكون محلولاً في السموات.» (مت 15:16-19) وهكذا، ما ضيَّعه آدم من مفاتيح الفردوس بسبب عدم إيمانه بالله الذي ألهمه به الشيطان، استردَّه بطرس بإيمانه الذي ألهمه به الله. وهذا ليس مجالاً لوصف الكنيسة وشرح لاهوتها، ولكن المجال هو الإيمان الذي ألهمه الله لبطرس الرسول برضى ومسرة ليصبح إيمان الكنيسة كلها. وإكراماً لموقف الرسل النبيل دُعيت الكنيسة كلها باسم الكنيسة الرسولية أو كنيسة الرسل، وعبَّر عن هذه اللفتة الإلهية الكريمة القديس بولس الرسول بالإلهام أيضاً، لأنه لم يكن حاضراً هذا الحدث الكبير، وذلك في رسالته إلى أفسس، وذلك لما كان يخاطب الأمم الذين فتح لهم الرب باب الإيمان قائلاً: «فلستم إذن بعد غرباء ونُزلاء، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، الذي فيه كل البناء مركباً معاً ينمو هيكلاً مقدساً في الرب الذي فيه أنتم أيضاً مبنيون معاً مسكناً لله في الروح.» (أف 19:2-22) ويُلاحِظ القارىء هنا أن بولس الرسول لا يركز على المستويات الروحية في ذكره الرسل والأنبياء قبل يسوع المسيح، ولكنه يركز على الإيمان الذي تأسس فعلاً على الرسل أولاً واستلمه الأنبياء. ولكن إن كان هؤلاء أو أولئك، فهم مجرد أساس في بناء كنيسة الله الروحية المبنية ليس من حجر وأعمدة وقِبَاب بل من صَخْر حيٍّ وحجارة كريمة يقع فيها المسيح موقع حجر الزاوية، وهو تاج المبنى الذي لولاه لانفرط المبنى كله. فحجر الزاوية هو التاج الذي يربط البناء كله: «الذي فيه كل البناء مركباً معاً ينمو (في الروح والإيمان) هيكلاً مقدساً في الرب.» (أف 21:2) الأساس عمل حسابه المهندس العظيم ليحمل كنيسة الدهور الأبدية بكل إيمانها وأضعف مؤمنيها وأخطر تجاربها وجيوش أعدائها الخفيين والظاهرين، لكي تكون حصناً يحمل الدهور كلها دون أن يُفلَّ. ليس بها منفذ واحد يتسرب منه شيطان الجحيم. وقد سلَّحها ربها بوجوده في القمة، يرعى من بُعدٍ وعن قُربٍ، يسوع المسيح الذي تجرَّب في كل شيء مثلنا وأشبه إخوته في كل شيء ما عدا الخطية. فهو القدوس الباقي قدوساً ملء كل السماء والأرض. مَنْ يقترب إليه يتقدس به. وإيمان بطرس أَعْجَبَ المسيح ليكون المسيح هو الأساس الصخري الذي يدعى عليه اسم الرسل. وأما المتصرِّفون فيها على مدى السنين فهم المؤمنون على مستوى بطرس للفتح والغلق. فلا يدخلها ذئب ولا يخرج منها حمل. هو أصلاً وفي ترتيب الأزل ملكوت الابن الوحيد الوريث، ولكن الابن رأى أن يكون له من بني الإنسان أهل على مستوى إبراهيم حبيبه وموسى قديسه، فانتسب لداود واختار منه عذراء هي أقدس قديسيه، وقدَّسها هو بالأكثر وملأها بروح الله وقوته وحلَّ فيها مدة لتكون له سماء ثانية بجنودها وملائكتها، وبنى فيها أول ما بنى رَحِمَها الذي يولد منه كمن يخرج من سماء إلى سماء. فكل من اختاره يسوع جعله ابناً للسماء. واختار التلاميذ أطهاراً، وطهَّرهم ليكونوا أدوات بيته الأول، ولكن اندسَّ في وسطهم واحد مندوب مخفي للشيطان، لم يحتمل أن يكون واحداً بين إخوة، فخرج مفضوحاً. أما يسوع فطرح نفسه على تلاميذه وقال لهم: ماذا ترون فيَّ فرأوه بعين بطرس ابن الله منذ الأزل، ورآه يوحنا الحياة الأبدية المخفية كسرٍّ مغلق لا يفتحه إلا رسول في لحظة استعلان سماوي، ورآه بولس أخيراً أكثر لمعاناً من الشمس وقت الظهر، ورآه لوقا وقد اصطُفَّت كل ملائكة الله حول بيت لحم سجوداً وجمهور جند السماء يهنِّىء الأرض بالسلام بعد اللعنة وبني آدم بالمسرة عوض أحزان الموت، واستطاعوا أن يفسروا رؤيا إشعياء النبي أنه الملك الجالس على كرسيه وأذياله تملأ كل الهيكل، والسرافيم يصرخون الواحد قُبالة الآخر بأعلى صوتهم: قدوس قدوس قدوس قد امتلأت كل الأرض بكل المجد. واجتمعت قوات السلاطين والرؤساء والسيادات والأرباب وعملوا وليمة استعداد لاستقبال ابن الله الآتي في جسم آدمي بكل خضوع، وأفسحوا السماء لخلائق جديدة سماوية أحضرها وراءه، كلها تعكس بهاء مجده ــ فأجلسوه عن يمين عرش العظمة في السموات عن يمين الله. أما وُجهاء أهل بيت الله الذين تعبوا معه في التجديد فأجلَسوهم من حوله على اثني عشر كرسيًّا. واحتفظت الكنيسة على الأرض بسرِّ إيمان الرسل. فلماذا يكون الإيمان الرسولي المسيحي هو الأصح لاهوتياً؟ لأنه الإيمان الذي لم يُفرض عليهم فرضاً، ولا تلقَّنوه تلقيناً، ولا تعلَّموه تعليماً، أي أن الفكر البشري والذكاء البشري والعلم البشري لم يشترك فيه! ولكنه كما يقول السيد المسيح وهو يركِّز جداً على ما يقول لأهميته القصوى، ثم جعل هذا الإيمان هو أساس الكنيسة المزمعة أن تكون أو التي صارت من لحظتها: «فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع: طوبى لك يا سمعان بن يونا. إن لحماً ودماً لم يُعلن لك، لكن أبي الذي في السموات. وأنا أقول لك أيضاً أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي.» (مت 16:16-17) قول المسيح لبطرس: طوبى لك هو عائد الإيمان السماوي. فبطرس تلقَّاه من الآب السماوي دون كافة التلاميذ لأمور كثيرة، أهمها انفتاح الذهن، وقبوله الاستعلان السماوي، مع جرأة وشجاعة أن يصف المسيح بأوصاف إلهية لم ينطقها أحد قبله. فاعتُبر القديس بطرس الرسول أول وعاء كنسي تقبَّل أول وأهم مقولة إلهية في لاهوت الكنيسة حُسبت أنها بناء على صخر روحي. وكون المسيح نفسه ينفي نفياً قاطعاً أن لحماً ودماً تدخَّل في هذا الإعلان اللاهوتي فهذا معناه أنه ينفي أن يكون القديس بطرس قد تلقَّاه بالمعرفة، لا بمعرفته ولا بمعرفة مخلوق بشري من دم ولحم. ثم بعد النفي القاطع بأن بطرس لم يتلقَّ إيمانه من بشر بأية وسيلة كانت، أعلن المسيح المصدر السري الوحيد للإيمان الحق والسماوي والوحيد الذي تلقاه بطرس من الآب السماوي!!! وهل حافظت الكنيسة على هذا الإيمان الرسولي؟ هذا يؤكده بولس الرسول تأكيداً قاطعاً أن: «وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس» (1 كو 3:12)، بمعنى أن أية صورة للإيمان بالمسيح يسوع إن لم تكن بدافع وبقوة الروح القدس تكون صورة إيمانية ناقصة ليست لها الطوبى، بمعنى أنه يكون إيمان بلا نتيجة ولا جزاء. لهذا أكَّد المسيح: «ومتى جاء المعزِّي الذي سأُرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معي من الابتداء» (يو 26:15-27)، وصحتها: ?وأنتم كنتم معي من البدء.? فالأُولى: «تشهدون أنتم أيضاً» شهادة؛ والثانية ?كنتم معي من البدء? معاينة، وهي أكثر من الشهادة: + «بل قد كنَّا معاينين عظمته. لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجداً، إذ أَقـْبَـل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى: هذا هو ابني الحبيب الذي أنا سررتُ به. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلاً من السماء، إذ كنا معه في الجبل المقدس.» (2بط 16:1-18) على أن الرب منذ أن اختار الاثني عشر، اختارهم: «ليكونوا معه» (مر 14:3) أي لينظروا مجده (يو 14:1). والقصد من الكلام أن المسيح أرسل الروح القدس الذي من عند الآب ينبثق ليشهد للمسيح لأنه روح المسيح وروح الآب. فشهادة الروح القدس أعظم شهادة وأعظم من الرؤيا. أما الإيمان الرسولي فهو من شهود معاينين والروح القدس المتكلم فيهم، لذلك كان الإيمان الرسولي إيمان شهادة بالروح القدس ومعاينة أيضاً. لذلك أصبح إيمان الرسل لا يضاهيه إيمان مهما كان، والكنيسة فخورة بأنها كنيسة مبنية على أساس الرسل والمسيح نفسه حجر الزاوية. فحلول الروح القدس على الرسل حتى الملء يوم الخمسين، وهم أصلاً كانوا معاينين المسيح ومعاينين عظمته على الجبل المقدس، جعلهم أساساً للإيمان المسيحي بالدرجة الأولى. ومن أجل هذه الشهادة أعطى الرب الرسل الاثني عشر أن يتكلموا بلغة الروح القدس التي يفهمها كل لسان وشعب وأمة على الأرض. فهي لغة الإنسان الجديد أو الخليقة الجديدة الناطقة بروح الله. + «تلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق.» (أف 24:4) + «ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه مجده تعالى |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 5085 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
العالم صديق خائن الراهـب كاراس المحرقي 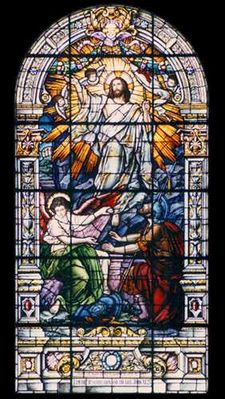 قد يكون العالم تعمَّق داخلك ولذاته تملَّكت على قلبك، وقد ظهر لك بمظهر الصديق المُحب الذي يريد إسعادك، وأنت لا تدرى أن العالم عدو شرير يريد إهلاكك، وصديق خائن يسعى لإذلالك، وإن أردت أن تتحقق من هذا، فعليك أن تسأل الذين أحبّوا العالم وأفنوا حياتهم فى ملذاته، سلهم وهم على فراش الموت: أحقاً أخلص العالم لكم؟ هل أوفاكم بوعوده؟ ستجد إجابتهم مكتوبة على جبينهم بأحرف بارزة: العالم صديق خائن قضى على حياتنا! وأضاع أبديتنا!  وأعتقد أنَّ هذا هو السبب فى أننا لا نري الخطاة يبكون على العالم عند موتهم، إذ كيف يبكون على من أذلهم واستعبدهم! قد يبكون على أنفسهم وجهلهم، ولكنهم لا يبكون على العالم الخائن الذي قد غدر بهم! يجب أن تعلم أنَّ العالم اخترع لنفسه ينابيع كثيرة، للهو والمسرات لكي يجذب الناس إليه، ولكنَّ الحقيقة إنَّ ينابيع العالم كلّها جافة، وأفضل تشبيه لها هو السراب الخادع، الذي يراه السائر فى الصحراء ماءً، وبعد أن يركض نحوه يتحقق أن ما راءه إنَّما هو وهم وخيال! هلم نتساءل: ما الذي يجذبك في عالم الشهوات؟! وما الذي يغريك في دنيا اللذات؟ ربَّما تكون شهوات الجسد! لكنى أقول: إنَّ كل الذين سعوا وراء شهوة جسدية عادوا فارغين، ولم يجنوا سوى وجع القلب ومرارة النفس وأمراض الجسد.. بالإضافة إلى ما يجنيه البنين من سمعه ردية نتيجة خطايا الوالدين وسلوكهم المنحرف! وربّما يُغريك العالم بصنمه الذهبيّ، الذي سجد ولايزال حتى الآن يسجد له ويخر أمامه الكثيرون، الذين أصبحت الثروة هى نقطة ارتكاز آمالهم، ولأجل المال فعلوا الشرور، وضحوا بسمعتهم وشرفهم ومبادئهم، ولهذا أسألك: ما هو الشبع الروحيّ الذي ستناله من جمع المال؟ وما هى السعادة التي تجنيها إذا اقتنيت ثروة؟ على هذا السؤال أجاب سليمان الحكيم قائلاً: " مَنْ يُحِبُّ الْفِضَّةَ لاَ يَشْبَعُ مِنَ الْفِضَّةِ وَمَنْ يُحِبُّ الثَّرْوَةَ لاَ يَشْبَعُ مِنْ دَخْلٍ " (جا10:5). هناك أيضاً التسالي والأفراح العالمية التي ينجذب إليها الناس، كمحاولة لإدخال السرور إلى قلوبهم، وهم لا يدرون أنَّ مسرات العالم وأفراحه ما هى إلاَّ ينبوعاً جافاً ليس فيه ما يُسعد، سعى إليه سليمان من قبل، إذ بنى لنفسه بيوتاً وغرس كروماً وعمل جنّات وفراديس فيها أشجار من كل نوع.. في النهاية إذ أدرك الحقيقة قال: " فإذا فَإِذَا الْكُلُّ بَاطِلٌ وَقَبْضُ الرِّيحِ وَلاَ مَنْفَعَةَ تَحْتَ الشَّمْسِ! " (جا11:2) إنَّ أفضل ما قيل عن شهوات العالم وملذاته أنَّها: " لا تشبع ولا تُشبع آلاماً تسبقها وآلاماً تلحقها " ! لا أظن أنَّ من أحب العالم وتمرّغ في شهواته، قضى فى وقت ما لذة لم يصحبها ألم، أو راحة لم يتخللها تعب، أو تمتع بصحة جيدة دون أن يضعفها مرض، أو فرح لم يعقبه حزن.. هذه طبيعة الدنيا: تعد براحة وسرور وتُعطي كداً وتعباً، تعد بأفراح وتُعطى أحزاناً وبلايا، تعد بالشرف والكرامة وتُعطي الذل والإهانة، وهذا ليس واضحاً من خلال معاملات العالم القاسية مع كافة البشر. ولهذا السبب قال أحد الفلاسفة عند موت إسكندر الأكبر: " هذا الذي كان بالأمس يدوس الأرض بقدميه، الآن داسته الأرض بقدميها، بالأمس لم تكن الأرض كافية لتحقيق رغباته والآن يكفيه ثلاثة أشبار ليُدفن فيها "، وقد أشار فيلسوف آخر إلى التابوت الذهبيّ الذي وضع فيه قائلاً: " بالأمس كان إسكندر يكنز الذهب والآن قد صار مكنوزاً في الذهب "، فالمجد زال، والمُلك بطُل، والذهب قد صار له تابوتاً. مَن مِن الناس لم تمتد يد الدنيا إليه بالأذى، ومن لم يحيا فيها قلقاً من غدرها وخيانتها، فكثيراً ما قدمت لمحبيها طعاماً لذيذاً فى الغذاء، وفى العشاء كان المر طعامهم والعلقم شرابهم، وفى الوقت الذي نجد فيه أهل العالم يعيشون فى سلام تفاجئهم البراكين والحوادث فيهلكون وتنتهي حياتهم... هذا هو العالم وهذه هى حقيقته المرّة، والحكيم هو من يحيا في العالم دون أن يحيا العالم فيه، فيصير مثل السفينة، لا يغرقها وجودها فى الماء، وإنَّما يغرقها دخول الماء فيها. نستطيع أن نقول: إنَّ العالم سفينتنا وليس مسكننا! فاجعل من العالم وسيلة تستطيع من خلالها أن تصل إلى الأبدية وليس غاية، لأننا أردنا أو لم نُرد سنموت، تاركين ممتلكاتنا وأموالنا، والآن ماذا تُريد؟ أن تتمسّك بعالم فانٍ وتحدّق في تراب زائل؟! أم ترفع عينيك إلى فوق وتتأمل مجد الله وما أعده لك في السماء؟ |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 5086 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
 ما معنى قول الكتاب: "اعداء الانسان اهل بيته"؟ هل ننظر إلى آبائنا وأمهاتنا وأقاربنا كأعداء؟! سؤال آخر: أنا عنيد، ولا أعرف كيف أتخلص من هذا الأمر، الذي سبب لي مشاكل كثيرة؟! الإجابة: هذه العبارة قيلت في مناسبة معينة، ولا تؤخذ بالمعنى المطلق. قيلت في مناسبة هذا الإيمان الجديد الذي ينشره السيد المسيح، فيقبله بعض أفراد الأسرة، ويرفضه البعض الآخر. ويكون الإبن ضد أبيه، والابنة ضد أمها، والكنة ضد حماتها.. و"أعداء الإنسان أهل بيته" (إنجيل متى 34:10-36) يكون آعداء الأنسان آهل بيتة، إذا أبعدوه عن الإيمان. باعتبار أنهم يرون أنفسهم مسئولين عن حفظه في إيمان أجداده. فإن كان أصلاً يهودياً أو أممياً، وقبل الأيمان بالمسيح، يقف أهله ضده، ليحولون عن هذا الايمان. ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. ولا يُقصَد بهذه العبارة المعنى المُطلَق، بدليل أن الكتاب يوصينا بأهل بيتنا. وهكذا يقول الرسول: "إن كان أحد لا يعتني بخاصته، ولا سيما أهل بيته؛ فقد أنكر الإيمان. وهو أشرّ من غير المؤمن" (رسالة تيموثاوس الأولى 8:5). ما هي المعاني الأخرى لهذه العبارة؟ يكون أعداء الإنسان أهل بيته، إن أحبهم أكثر من الرب. وهكذا يقول الرب بعد هذه العبارة مباشرة: "مَنْ أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب إبنا أو إبنة اكثر منى فلا يستحقنى.." (انجيل متي 37:10) إذن، نحب أهل بيتنا ونعتني بهم. ولكن لا نحبهم أكثر من الله، ولا نطيعهم أكثر منه، وإلا يكونون بهذا أعداءٌ لنا. ومع أن الله أمرنا بإكرام وطاعة الوالدين، إلا أن الكتاب يقول محدداً هذه الطاعة: "أيها الأولاد: أطيعوا والديكم في الرب" (رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 1:6) وعبارة "فى الرب" تعني داخل وصية الله.. فإن أخرجتك الطاعة للوالدين عن طاعة الرب، فإن هذا يدخل في عبارة "اعداء الانسان اهل بيته". على أن هذه العبارة قد تنطبق في مجالات كثيرة منها: وقوفهم ضد تكريس الإنسان لله. قد يُدعى خادم إلى الكهنوت، ويفرح الكل بذلك ويزكونه. أو يقبل على حياة الرهبنة، ويفرح الكل ويهنئونه. ووسط كل ذلك الفرح يقف ضده أهل بيته. تبكي الأم في حزن وتمرض، ويصرخ الأب في غضب ويهدد.. وقد يستخدمون معه العنف، ويضعون أمامه كل ما يستطيعون من عراقيل. وكل مَنْ يرى هذه المأساة يقول في أسى: حقاً، أعداء الإنسان أهل بيته. وبالمثل ما يتبع أحياناً من إرغام على الزواج. وكثيراً ما تقاسي الفتيات من هذا الوضع. فإن أتى عريس اقتنع به الأب والأم، فيجب أن تقبله الفتاة، مهما كانت لا تميل إليه!! وربما بعد ممارسة ضغوط شديدة عليها، تقبله مرغمة. وتعيش بعد ذلك تعيسة في حياتها. وقد تنتهي العلاقة الزوجية بخلافات شديدة أو بالطلاق. ويكتب على قسيمة الطلاق: "أعداء الإنسان أهل بيته". كذلك يدخل في ذلك تدخلات الحياة الشخصية، منها: التدخل في الحياة الروحية بحكم السلطة العائلية. كأن يُمنَع الابن عن الصوم، حرصاً على صحته!! مع الاتصال بأب اعترافه لإرغامه على عدم الصوم. وكل ذلك بمشاعر من الشفقة الخاطئة. أو منعه عن الخدمة أو اجتماعات الكنيسة، بحجة أنها تأخذ الكثير من وقته. وكذلك المنع عن الافتقاد إن كان خادماً. أو منعه عن زيارة الأديرة وعن الخلوات الروحية، خوفاً عليه من الاشتياق إلى حياه الرهبنه. وأحياناً تمنعه الأسرة عن التدين عموماً، خوفاً عليه من التطرف!! وقد تفرض عليه صنوفاً من اللهو لا يقبلها ضميره أو تُضْعِف روحياته. وتظن الأسرة بهذا أنها تسعده.. وأحياناً تطلب الأسرة منه أن يدافع عنها ولو بالكذب مهما أخطأت. ولابد أن يبرر تصرفاتها مهما كانت واضحة الخطأ. وقد يعتبر الأبن عاقاً، وتعتبر الزوجة غير مخلصة، ويعتبر الأخ غير وفي!! أو تطلب الأسرة أن يُعادي مَنْ تعاديهم. ولابد أن يتكلم عليهم بالسوء. ولا يزور من تفرض الأسرة عدم زيارته، وهكذا بالضرورة يقاطع من تقاطعه الأسره، ويخاصم من تخاصمه.. ويجد أنه بذلك قد فقد بعض الفضائل الروحية. ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. وقد يكون أعداء الإنسان أهل بيته بالقيادة الخاطئة والقدوة السيئة. وهذا ما يتعرض له كل ابن نشأ في أسرة غير متدينة، حاولت أن ينشأ على نفس طباعها وأسلوبها في الحياة.. ولعل من أمثلة المشورة الخاطئة في محيط أهل البيت، مشورة رفقة لابنها يعقوب في خداع أبيه لينال البركة منه (سفر التكوين 27). وما جره هذا الخداع من تعب له في حياته.. ولكن، لماذا يخص "أهل البيت"؟ لأن لهم التأثير العاطفي، وكذلك السلطة العائلية، والقدرة على ممارسة الضغوط المعنوية والمادية. وكذلك شعورهم بكل الحق في التدخل في صميم حياته، وفرض رأيهم عليه! هذا ما لا يدعيه الغرباء عنه، الذين ليسوا من أهل بيته. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 5087 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
خلاّق بين الخالق و المخلوق 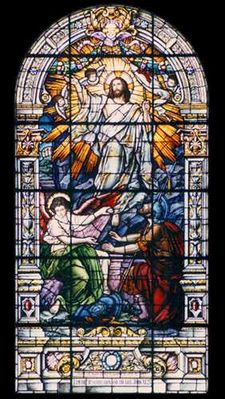 المطران بولس يازجي من كتاب "السّائحان بين الأرض والسماء" الله والإنسان الجزء الثاني. لابدَّ من تعريف هذه الكلمات بسرعة لندرك علاقة كلّواحدة منها بالأخرى. الخالق هو الله، وهو الذي أوجد، من اللا وجود، كلَّ ما هو موجود، وهذا يدعى المخلوق أو الخليقة. الخلاّق هو الإنسان، وهو مخلوقٌ من الخالق الوحيد الواحد ذاته، لكنه جُبل على صورة الله ومثاله، وهو الوحيد بين كلّ الكائنات المخلوقة القادر على معرفة الله وبناء علاقةٍ معه. الإنسان هو الوحيد من بين كلّ الخلائق الذي يستطيع أن يتصل بالله. هذا الخلاّق يتفنّن ويبدع في صياغة ظروف حياته وتطويرها مستخدماً الخليقة، فيحوِّل اللون الجامد إلى صورةٍ ناطقة، والتربة إلى عمارة، والخشبُ يصيِّرُه قارباً ويفكِّك طاقة الذرة ذاتها... لكن هل ينتهي فنُّه عند هذه الحدود؟ إنّ أعظم فنٍّ يمارسه الإنسان ليس في تجميل وتركيب عناصر الطبيعة بل في تقديمها قرباناً لله، وفي أن يبني منها بطرقه الرّوحية علاقةً مع الله الخالق. لهذا الصلاة هي فنُّ الفنون. عندما يتعامل الإنسان الخلاّق مع الخليقة دون تذكّر الخالق فإنه يســتخدمها كفنّــــان، لكن عندما يتذكّـر منـهاواهبَها تختلف نظرتُه إليها. ولا تعود مجرَّد مادةٍ مفيدة بل هديةً مؤثِّرة! نعرف الخليقة بواسطة الحواس ونحلّلها ونسيطر عليها بواسطة العقل. أما الله الخالق فلا نعرفه بالحواس، لأنه غير مخلوقٍ وغير منظور، وإنما بالعقل الذي يقرأ من وجود الخليقة حكمةَ خالقها. نعرف الله إذاً من أعماله وليس بحواسنا. الخليقة هي أحد أعماله، وتاريخ التدبير الإلهي والوعد والتجسد والقيامة والعنصرة... كلُّها أعمال الله التي تُعرِّف الإنسان على خالقه. إدراك الخليقة ومعرفتها أمرٌ سهل ومفروض لأنّ الحواس تُدرِك المخلوق. أما معرفة الله فلا تحتاج إلى بصرٍ فقط بل إلى بصيرة، ليس إلى حواسٍ فقط بل إلى عقلٍ وحكمة. ولطالما انغمس الإنسان في استخدام الخليقة والتفنّن بها، لدرجة أنه نسي أن يقرأ فيها حضرة خالقها. "فعَبدَ الخليقة دون الخالق". ولمّا كانت الخليقة "إشارة" إلى الله، توقّفَ البعض عند قراءتها دون النظر إلى المشار إليه. معرفة الله، من خلال الخليقة وتدبيره وأعماله، تحتاج إلى إنسانٍ حرّ غير مستعبدٍ من عناصر الخليقة بل سيّدٍ عليها. لذلك تتطلب هذه المعرفة التحرّر من المبالغات وتتطلب قراءةً حكيمة للخليقة. هذه القراءة تتم في "الهدوء" لأنّ الارتباك بالدنيا يحرمنا قراءة معناها. الهدوء لا يعني مجرّد العزلة أو الوحدة، رغم أنه يحتاجها في البداية. الهدوء يعني "التأمل" من خلال الخليقة بالخالق. الهدوء ليس هروباً من العالم إلاّ بمقدار ما يكون سجوداً لله والتصاقاً به. الهدوء هو فنُّ قراءة حضور اللاّ مخلوق في المخلوق، فنُّ الاتصال بالخالق من خلال الخليقة. الهدوء ممارسةٌ تتم بالصلاة، المطالعة، الاعتدال في تناول العالم، التحرر من الدنيويات، عَتْق الذهن من مخاوف الحياة والحواس من عبودية اللّذات. دون هذه الممارسة، مصير الإنسان أن يعبدَ الخليقة وينسى الخالق. عندما يكتشف الإنسانُ اللهَ غير المخلوق في الهدوء، عندها يدرك المعنى الحقيقي للخليقة. الله محبّة، وقد وهب الخليقة للخلاّق فعلَ محبّة، عندها يقف الإنسان أمام كلّ ما في الخليقة وقفة "رعشة". الخليقة هديةٌ ثمينة من المحبّة الإلهية، ثمينةٌ لدى الله لأنها من أجل الإنسان. حضرة الله غير المخلوق تدفع الإنسان إلى احترام المخلوق برهبة. يتحسس الإنسان الحكيم لكلّ عناصر الخليقة، وفي مقدمتها الإنسان، بحسٍّ مرهفٍ روحيٍّ مسـؤول. لولا حضرة الله المحِبّ لصارت الخليقة بما فيها البشر بالنسبة للإنسان مادةً للاستهلاك والمتعة، والأمثلة على ذلك عديدةٌ في دهرنا. حضرة الله في حياة الإنسان تجعل للخلائق معنىً اعتبارياً، فهي ليست مجرّد مادةٍ جامدة للإبداع بل هي رسالة محبةٍ إلهية تولّد في مستخدِمها "رعشة" سجود، وتغدو الخليقة للإنسان مادةً محبوبة بدل ضرورية. هكذا يسحبنا الهدوء في البداية من العالم ولكن ليعيدنا إليه إنما بقراءةٍ جديدة له، يسحبنا ونحن مستخدميه ويُعيدنا إليه ونحن نحبّه! فأية روعةٍ هي ممارسة الهدوء. ملاقاة الخليقة بهذا الحبّ تقودنا إلى "عذوبةٍ مؤلمة"! من يحبّ، مصيره أن يُعاني. الخليقة المادية تتنهّد بحسب تعبير بولس الرسول، والإنسان فيها خليقةٌ في حياته الكثير من أوجه الألم والعديد من الحاجات. من يحبّ يعاني! الحبّ مقابل الألم يملؤنا خشوعاً. هذا الخشوع يتبنىّ كلّ آلام الناس وكلّ تنهّد الخليقة. إذاً هذه القراءة الرّوحية للخليقة بعين الحبّ تجعل الإنسان مسـؤولاً متخشِّـعاً، تجعله يواجه الدنيا والقريب وفي عينيه دوماً دموع! يعطي الحبُّ سعادةً، ولكن عندما تُحبُّ متألماً يتسلّل إلى عذوبة الحبّ ألم، ألمٌ ضروري جداً ليجعل الحبّ عملياً ومسـؤولاً. الحبّ أب الدموع، المحبّة أم المسؤولية. الدموع هي عزم المحبّ، خاصةً عندما يذرفها في الصلاة أمام الله الخالق فيعصر فيها كلّ الكون أمامه، ويبرهن أنه ابنٌ له وليس مجرد عبدٍ أو أجيرٍ مستخدَم. خلاّقٌ وخالقٌ ومخلوق، ثلاثةٌ تجدّد العلاقة بينهم حكمة الخلاّق، والحكمة تقرأ في الخليقة حبّ الخالق فتقدِّس المخلوق وتحبّه. احترام المخلوق في الهدوء يولّد رعشة الحبّ ومن ثَمَّ دموع الرجاء. هدوءٌ فرعشةٌ ومن ثَمَّ دموع، آمين. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 5088 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
شرح العقيدة - لنيافة الأنبا رافائيل
همسات روحية لنيافة الأنبا رافائيل  شرح العقيدة أولاً: ما هي العقيدة؟ العقيدة هي ما نؤمن به، أو هي "ما انعقدت عليه الحياة".. لأن ما نؤمن به لا بد أن يؤثر على حياتنا وسلوكنا وتعاملاتنا، ثم على مستقبلنا الأبدي. والعقائد المسيحية العظمى هي: V الإيمان بوجود الله. V الإيمان بالثالوث القدوس. V الإيمان بألوهية السيد المسيح. V الإيمان بالتجسد الإلهي. V الإيمان بالفداء بدم المسيح على الصليب. V الإيمان بقيامة السيد المسيح من الموت، ثم قيامتنا نحن معه في المجيء الثاني. V الإيمان بالأسرار الكنسية السبعة ? بكل تفاصيلها. V الإيمان بشركة القديسين والملائكة وشفاعتهم عنَّا في السموات. V الإيمان بأن العذراء مريم هي والدة الإله وأنها دائمة البتولية. ثانيًا: أهمية تدريس العقيدة: (1) أن السيد المسيح هو واضعها، فلا بد من أن نعرف فكره ومطاليبه لنا. (2) أن الآباء الرسل تعبوا وكرزوا بهذه العقائد في العالم كله، ونالوا أكاليل الجهاد والشهادة، من أجل نشر هذه التعاليم المقدسة. (3) أن آباء البيعة المقدسة تعبوا في حفظها وشرحها والمحافظة عليها، وبذلوا من أجل ذلك دماءهم وأعراقهم الطاهرة. (4) أن ليتورجيات الكنيسة تشرح العقيدة وتهتم بإبرازها، وهذه الليتورجيات المقدسة تعكس لنا مدى اهتمام الكنيسة في كل عصورها بهذه الأمور الإيمانية.. بل وتعلمنا كيف نصلي بهذه الإيمانيات. (5) من أجل العقيدة عُقدت مجامع مسكونية لتقنين الإيمان وشرح ما استعصى على الناس فهمه، أو ما عوّج الهراطقة معناه. وأول مجمع عُقد في تاريخ المسيحية ورد ذكره في سفر أعمال الرسل لمناقشة بدعة التهود.. "فاجتَمَعَ الرُّسُلُ والمَشايخُ ليَنظُروا في هذا الأمرِ" (أع15: 6). (6) هناك بُعد خلاصي لعقائدنا المسيحية.. فليست العقيدة مجرد فلسفات كلام ولكنها عقيدة خلاصية. فلا يمكن لإنسان أن يخلُص دون أن يؤمن بعقائدنا ويمارسها عمليًا (على سبيل المثال): V الإيمان بألوهية السيد المسيح: "الذي يؤمِنُ بالاِبنِ لهُ حياةٌ أبديَّةٌ، والذي لا يؤمِنُ بالاِبنِ لن يَرَى حياةً بل يَمكُثُ علَيهِ غَضَبُ اللهِ" (يو3: 36). V المعمودية: "الحَقَّ الحَقَّ أقولُ لكَ: إنْ كانَ أحَدٌ لا يولَدُ مِنَ الماءِ والرّوحِ لا يَقدِرُ أنْ يَدخُلَ ملكوتَ اللهِ" (يو3: 5). V التناول من جسد الرب ودمه: "الحَقَّ الحَقَّ أقولُ لكُمْ: إنْ لم تأكُلوا جَسَدَ ابنِ الإنسانِ وتشرَبوا دَمَهُ، فليس لكُمْ حياةٌ فيكُم" (يو6: 53). V التوبة: "إنْ لم تتوبوا فجميعُكُمْ كذلكَ تهلِكونَ" (لو13: 3). V الحِل من فم الكاهن: "كُلُّ ما تربِطونَهُ علَى الأرضِ يكونُ مَربوطًا في السماءِ، وكُلُّ ما تحُلّونَهُ علَى الأرضِ يكونُ مَحلولاً في السماءِ" (مت18: 18)، "مَنْ غَفَرتُمْ خطاياهُ تُغفَرُ لهُ، ومَنْ أمسَكتُمْ خطاياهُ أُمسِكَتْ" (يو20: 23). هذه عقائد خلاصية، لا يمكن أن نستغنى عنها في موضوع خلاصنا الأبدي. ماذا إذًا؟ ما هو المطلوب منَّا كخدام أرثوذكسيين، غيورين على كنيستهم، ومُحبين للمسيح، ويشتهون خلاص كل نفس على وجه الأرض؟ إن المطلوب منَّا هو: (1) الإيمان بأهمية العقيدة.. كمثل فكر السيد المسيح، ورسله الأطهار، وكما أعلن الكتاب المقدس.. باعتبار العقيدة هي طريق الخلاص، وهي مُوجّه السلوك الروحي والسلوك اليومي، بل وهي سبب الحكمة والفهم "بالإيمانِ نَفهَمُ" (عب11: 3). (2) مُعايشة هذا الفكر العقيدي.. عمليًا وتطبيقيًا في حياتنا.. حتى لا تظل العقيدة مجرد منطوق نظريات فلسفية يختلف حولها الناس، ويتشاجرون بسببها.. بل تكون هي المُحرك الحقيقي لسلوكنا اليومي.. "لأنَّنا لم نَتبَعْ خُرافاتٍ مُصَنَّعَةً، إذ عَرَّفناكُمْ بقوَّةِ رَبنا يَسوعَ المَسيحِ ومَجيئهِ، بل قد كُنّا مُعايِنينَ عَظَمَتَهُ" (2بط1: 16)، "أرِني إيمانَكَ بدونِ أعمالِكَ، وأنا أُريكَ بأعمالي إيماني" (يع2: 18). (3) نقل هذه الخبرة الإيمانية الحياتية إلى أبنائنا ومخدومينا.. "الذي رأيناهُ وسمِعناهُ نُخبِرُكُمْ بهِ، لكَيْ يكونَ لكُمْ أيضًا شَرِكَةٌ معنا. وأمّا شَرِكَتُنا نَحنُ فهي مع الآبِ ومع ابنِهِ يَسوعَ المَسيحِ" (1يو1: 3). فتكون هذه الخبرة هي أيضًا مُحرك سلوكياتهم، ويُدرك الجميع أهمية الإيمان والعقيدة لحياتهم، فيكتشفون تزييف الإدعاء الباطل باللاطائفية واللاعقيدة. (4) شرح البُعد الروحي والخلاصي في كل عقيدة أرثوذكسية.. وأن يتربى عند الخدام الأرثوذكس الاختبار الروحي الليتورجي.. بحيث لا يكون الخادم منعزلاً عن الكنيسة، واتجاهاتها وإيمانها. (5) التنبيه للانحرافات الإيمانية المنتشرة، وتفنيد الفكر الغريب.. لئلا يسقط في براثينها أحد البُسطاء، دون إدراك خطورتها أو انحرافاتها. لابد أن تكشف الثغرات الإيمانية لكل الشعب "لأنَّهُ باطِلاً تُنصَبُ الشَّبَكَةُ في عَينَيْ كُلِّ ذي جَناحٍ" (أم1: 17).. ولا يجب الاكتفاء بالبناء الإيجابي فقط، بل يجب أيضًا تفنيد الآراء الهرطوقية. (6) نشر الفكر العقيدي الأرثوذكسي.. بممارسة الليتورجيا بحماس، وروحانية، وجمال روحي يخلب الوجدان، وكذلك بتأليف ترانيم على المستوى الشعبي، وبحفظ الآيات، وبتكثيف التعليم الكنسي العقيدي. (7) ترسيخ فكرة أن الكتاب المقدس هو المرجع الأساسي الأول لكل عقيدة أرثوذكسية، وكذلك فكرة أن الليتورجيا في الكنيسة هي مصدر معتمد وموثق للفكر العقيدي. (8) عدم الانخداع بالإدعاء الكاذب أننا متعصبون لأننا نتكلم في العقيدة.. فليس تقييم الناس لنا هو مُحرك خدمتنا، بل ما يُرضي الله.. "لأنَّ وعظَنا ليس عن ضَلالٍ، ولا عن دَنَسٍ، ولا بمَكرٍ، بل كما استُحسِنّا مِنَ اللهِ أنْ نؤتَمَنَ علَى الإنجيلِ، هكذا نتكلَّمُ، لا كأنَّنا نُرضي الناسَ بل اللهَ الذي يَختَبِرُ قُلوبَنا. فإنَّنا لم نَكُنْ قَطُّ في كلامِ تمَلُّقٍ كما تعلَمونَ، ولا في عِلَّةِ طَمَعٍ. اللهُ شاهِدٌ" (1تس2: 3-5). فلا يليق يا إخوتي.. أننا نتوقف أمام كل رأي باطل يُوجهه لنا الناس، ونتعطل عن طريقنا المستقيم، خوفًا من آرائهم الباطلة.. بل يجب أن نكون أقوياء، ونفرح بهذه الأقاويل الكاذبة، ونقبلها بكل صبر.. "طوبَى لكُمْ إذا عَيَّروكُمْ وطَرَدوكُمْ وقالوا علَيكُمْ كُلَّ كلِمَةٍ شِريرَةٍ، مِنْ أجلي، كاذِبينَ. اِفرَحوا وتهَلَّلوا، لأنَّ أجرَكُمْ عظيمٌ في السماواتِ، فإنَّهُمْ هكذا طَرَدوا الأنبياءَ الذينَ قَبلكُمْ" (مت5: 11-12). (9) في كل هذا يجب أن نتبع المبدأ الكتابي.. "نَطلُبُ إلَيكُمْ أيُّها الإخوَةُ: أنذِروا الذينَ بلا ترتيبٍ. شَجعوا صِغارَ النُّفوسِ. أسنِدوا الضُّعَفاءَ. تأنَّوْا علَى الجميعِ" (1تس5: 14). ففيما نتمسك بإيماننا بكل قوة.. يجب أن نتعامل مع الناس بكل محبة، فنحن لا نختلف مع الناس بل مع الفكر المُنحرف. فالكتاب المقدس نفسه يأمرنا.. كونوا "مُستَعِدينَ دائمًا لمُجاوَبَةِ كُل مَنْ يَسألُكُمْ عن سبَبِ الرَّجاءِ الذي فيكُم، بوَداعَةٍ وخَوْفٍ" (1بط3: 15). ثالثًا: لمَنْ نشرح العقيدة؟ يجب شرح العقيدة لكل فئات الشعب من الأطفال إلى الكبار، والبسطاء، والعلماء.. لأن الكتاب المقدس يعلمنا: "هَلكَ شَعبي مِنْ عَدَمِ المَعرِفَةِ" (هو4: 6). وطالما عرفنا أن للعقيدة بُعد خلاصي فلا يجب أن نحجب معرفة الإيمان عن أي من الشعب المؤمن بالمسيح، ونحتاج أن نشرح الإيمان بطرق مبسطة تتناسب مع المستمع والمتلقي. رابعًا: طرق التدريس: (1) اللحن والترنيمة: ألحان كنيستنا تحمل أبعادًا عقيدية تثبِّت الإيمان في أذهان الناس، وهناك ترانيم تشرح أمورًا عقيدية (نحتاج المزيد منها).. وهذه الطريقة تناسب الأطفال والكبار بحسب مستوى الترنيمة أو اللحن. (2) الممارسة العملية: هي دخول عملي اختباري في مواضيع عقيدتنا المسيحية مثل: V رشم الصليب. Vالتناول من الأسرار المقدسة. V المشاركة في الصلاة بالأجبية والصلوات العامة الكنسية. v المشاركة في الصيامات والأعياد السيدية. V المشاركة في أعياد القديسين وتماجيدهم وتكريم أجسادهم. V دراسة الكتاب المقدس وقراءته بانتظام. V المشاركة في صلوات التسبحة اليومية. V حضور صلوات أسرار الكنيسة (القنديل، الإكليل، السيامات....). V ممارسة سر الاعتراف. (3) الشرح المبسط عن طريق القصص، والتمثيل، والرموز، ووسائل الإيضاح، والوسائط السمعية والبصرية والكمبيوترية. (4) التنويه للمعاني الروحية واللاهوتية والخلاصية للممارسة الكنسية أثناء الممارسة أو قبلها، خصوصًا الممارسات الموسمية أو غير المتكررة (المعمودية وجحد الشيطان، وأنواع الزيوت، ومعنى الإشبين، والاتجاه للشرق، والإكليل، والقنديل، وتبريك المنازل....الخ). (5) شرح العقيدة من خلال الدروس الروحية، وعظات القداسات، واجتماعات دراسة الكتاب المقدس. (6) عمل اجتماعات خاصة بشرح العقيدة بطرق مبسطة. (7) تشجيع الشباب والخدام على عمل أبحاث ودراسات لاهوتية، والالتحاق بكليات ومعاهد اللاهوت |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 5089 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
الكتاب المقدَّس في حياة الكنيسة
المطران بطرس مراياتي  الكتاب المقدَّس في حياة الكنيسة الكتاب المقدَّس في حياة الكنيسةلمنـاسبة مرور 40 سنة على صدور الدستور العقائديّ في الوحي الإلهـيّ "DEI VERBUM" في 18/11/1965، وهو من أهمّ وثائق المجمع الفاتيكانيّ الثاني، عُقد مؤتمر عالَميّ حول موضوع "الكتاب المقدَّس في حياة الكنيسة"، وذلك في مدينة روما في الفترة 14-18 أيلول 2005، بحضور أكثر من 200 مشارِك من مختلف بلدان العالَم. كان وراء تنظيم هذا المؤتمر "الرابطة البيبليَّة الكاثوليكيَّة العالَميَّة" بمؤازرة "المجلس البابويّ لتعزيز وحدة المسيحيّين". وقد شارَك فيه ممثّلو الكنائس الكاثوليكيَّة ومندوبون عن سائر الكنائس الأرثوذكسيَّة والإنجيليَّة ومسؤولون عن مختلف الجمعيّات الكتابيَّة في العالَم، ما أعطى اللقاء بُعداً مسكونيّاً مميّزاً. فالكتاب المقدَّس يشكّل أرضيَّة مشترَكة للحِوار بين المسيحيّين مهما تنوّعت انتماءاتهم. أعرض لكم في هذا الحديث المحاور الرئيسة التي جاءت في الفصل السادس من الوثيقة المجمعيَّة، وما أكّدته أعمال المؤتمر بما يخصّ كلمة الله في حياة الكنيسة، وقد وضعتُها في خمسة أقسام. 1- قدسيَّة كلمة الله في الكنيسة "إنّ الكنيسة قد أحاطت دوماً الكُتُب الإلهيَّة بالإجلال" (في الوحي الإلهيّ، 21). هذا ما يؤكّده المجمع الفاتيكانيّ الثاني وهذا هو الواقع في كنائسنا الشرقيَّة. فالكتاب المقدَّس يوضع على المذبح الرئيسيّ في غلاف أنيق من الفضّة، ويُحمَل في تَطواف داخل الكنيسة، ويُكرَّم بالبخور والتراتيل... وتضيف الوثيقة المجمعيَّة أنّ الكنيسة تحيط الكُتُب المقدَّسة بالإجلال الذي تحيط به جسد المسيح. "وهي تتناول دوماً خبز الحياة على المائدة نَفْسها التي حملتْ، معاً، جسد الربّ وكلمة الله. إنّها تتناوله وتوزّعه على المؤمنين، لا سيّما عندما تقوم بخدمة الليتُرجيّا الإلهيَّة" (الرقم 21). فإذا ما تأمّلنا في تكوين القدّاس نجد فيه قسمين: ليتُرجيّا الكلمة، وليتُرجيّا الإفخارستيّا. وكلاهما مترابطان متكاملان، فالمسيح حاضر بكلامه وبجسده كما كان حاضراً بين تلميذَي عمّاوس اللذين عرفاه عند كسر الخبز بعد أن رافقهما في الطريق وشرح لهما الكُتُب (راجع لوقا 24/13- 35). ولم تكتفِ الكنيسة بتكريم الكُتُب المقدَّسة وإدراجها في صلواتها وطقوسها الليتُرجيَّة، بل جعلتها موضوع كرازتها. "وما فتئت يوماً تعتبر الأسفار المقدَّسة، ومعها التقليد المقدَّس، دستوراً أساسيّاً لإيمانها، لأنّ الكُتُب المقدَّسة هي من وحي الله، وهي مثبّتة تثبيتاً نهائيّاً. ولذلك، فهي توصل كلمة الله كما هي، من غير تحريف، وتُمكّن الأنبياء والرُسُل أن يُسمعوا صوت الروح القُدُس بأقوالهم" (الرقم 21). ومنذ القرون الأُولى للمسيحيَّة جاءت عظات آباء الكنيسة وكتاباتهم مشبَعةً بالنصوص الكتابيَّة، ملتزمةً بهديها، حتّى قيل: "لو فُقدت الأناجيل لوجدنا نصوصها في كتابات آباء الكنيسة". ويشتمل الأدب الآبائيّ على شروح وتفسيرات، جزئيَّة أو كاملة، للأسفار المقدَّسة. فقد كانوا يحفظون عن ظهر قلب الآيات الكتابيَّة ويستشهدون بها في زمن لم تكن وسائل الطباعة والنشر معروفة. وأذكر على سبيل المثال أنّ القدِّيس كريكور ناريكاتسي (غريغوريوس الناريكيّ، 1003) استشهد في كتاب صلواته "المراثي" بألفين ومائة وتسعين آية كتابيَّة. وكان أوّل مؤلَّفاته "شرح نشيد الأناشيد". فأين نحن من إجلالنا للكتاب المقدَّس بعد أن أصبح في متناول الجميع؟! لقد فقدنا قدسيَّة الكتاب الملهَم، وتلاشى الاحترام تجاه الكلمة الموحى بها المدوّنة في كتاب قدسيّ، وأصبح شأنه شأن سائر الكُتُب العاديَّة. أسوأ ما رأيت لمّا كنت أعلّم في المدرسة، أنّ أحد الطُلاّب جاء بكتاب مقدَّس لم يجد كتاباً أضخم منه ليجعله مسنداً يرفع عليه آلة عرض الشرائح الضوئيَّة..! وماذا لو حدّثتكم عن مصير الإنجيل في المخيّمات.. فهذا يضعه تحت رأسه ليجعل منه وسادة، وذاك يلقيه بين ثيابه القذرة، وآخَر يأخذه إلى المطبخ حيث السمن والزيوت.. وأشنع من ذلك كلّه أنّ أحدهم جاء بنسخة من الإنجيل ليؤجّج بها النار!! أمّا عن كيفيَّة قراءة الرسائل وتشكيل الحركات النحويَّة فحدّثْ ولا حرج... كيف نطلب من الآخَرين أن يحترموا كتابنا إذا كنّا نحن لا نعطيه حقّه من الاحترام والإكرام (راجع كتاب: "هل أنت معي؟"، الصفحة 9-14). ومن جهة أُخرى، أين نحن من العظات المشبَعة بالنصوص الكتابيَّة؟ حدّثنا رئيس المؤتمر المذكور عن أسقف جمع عظاته في كتاب. وقبل أن يرسله إلى الطبع نادى أمين سرّه وقال له: "خُذْ هذا النصّ وضعْ في كلّ صفحة آية مناسبة من الكتاب المقدَّس"! وكأنّ كلمة الله جُعلت للترصيع والتزيين وحسب. على العظة، أيّاً كان نوعها، أن تكون نابعة من التأمّل في النصّ الكتابيّ لا أن تأتي الآية لتُقحَم في ما نريد أن نقوله نحن. في مكتبتي مجلّدان فيهما مجموعة عظات وخطابات لأحد الكهنة طوال سنوات رعايته. وعبثاً حاولت أن أجد فيهما آية واحدة من الكتاب المقدَّس، فلم أُفلح! جميل أن نتكلّم ونكتب بمنطق وعِلم وبلاغة، ولكنّ الأجمل أن نتكلّم بفم الله، وأن نغرف في كتاباتنا من مَعين كتاب الله. 2- أهمّيَّة مطالعة الكتاب المقدَّس "يحرّض المجمع المقدَّس تحريضاً ملحاحاً جميع المسيحيّين، ولا سيّما مَن كان منهم عضواً في الجمعيّات الرهبانيَّة، أن يدركوا "معرفة المسيح السامية" (فيلبّي 3/8)، بالمواظبة على قراءة الكُتُب الإلهيَّة، "لأنّ مَن جهل الكُتُب المقدَّسة، جهل المسيح" (الرقم 25)، كما يقول القدِّيس إيرونيمُس. بالرغم من انتشار ملايين النسخ المطبوعة من الكتاب المقدَّس بمختلف اللغات والأحجام فإنّ عدد الذين يقرؤونه قليل جدّاً. بحسب إحصاء أجرته الرابطة البيبليَّة في ثلاثة بلدان أورُبّـيَّة تُعتبر كاثوليكيَّة وهي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، تبيّن أنّ 3٪ من المؤمنين الملتزمين الكاثوليك يقرؤون الإنجيل يوميّاً، والباقي يكتفي بالاستماع إلى مقاطع منه في الكنيسة. و40٪ منهم يعتقد أنّ بولس هو من بين كتبة الأناجيل و 26٪ يعتقد أنّ بطرس هو أيضاً من بين كتبة الأناجيل! سُئل أحدهم: "عدّدْ أسماء الإنجيليّين الأربعة". فكان الجواب: "هم اثنان: بطرس وبولس". والغريب في الأمر أنّ الكنيسة التي تطالب اليوم مؤمنيها بقراءة الكتاب المقدَّس بعهديه القديم والجديد كانت، في ما مضى، تمنعهم من ذلك! كان العهد القديم ممنوعاً لعامّة الشعب. وحتّى العهد الجديد لم يكن في متناول الجميع. كان يكفيهم ما يُتلى عليهم في الكنيسة. وكذلك كانت حال الأديار. فلم يكن الكتاب المقدَّس في متناول أيدي الرهبان والراهبات. كانت ثمّة عمليَّة انتقاء لبعض النصوص تساعدهم على التأمّل والصلاة. والحقّ يُقال إنّ أحد أسباب نشوء الحركة الإصلاحيَّة والتيّار البروتستانتيّ هو تأكيد أهمّيَّة الكتاب المقدَّس ومرجعيّته المطلَقة SOLA SCRIPTURA ، وضرورة مطالعته المتواترة. وهكذا كانت بداية الكنيسة البروتستانتيَّة الإنجيليَّة بين الأرمن العامَ 1850 في إستنبول. والسبب يعود إلى ممانعة السُلطة الكنسيَّة الأرمنيَّة الأرثوذكسيَّة آنذاك بعض شبّانها المثقّفين من مطالعة الكتاب المقدَّس وطبعه ونشره بلغة الشعب وتوزيعه على البيوت والأفراد. حينئذٍ قرّروا ترك حضن الكنيسة الأرثوذكسيَّة وإنشاء جماعة كنسيَّة بروتستانتيَّة أرمنيَّة مستقلّة. في القرن الماضي، وحتّى اليوم، عُرف البروتستانت في بلادنا بتعلّقهم بالكتاب المقدَّس وحفظـه والتبشير به. ويُعرف المؤمن البروتستانتيّ ممّا يحمل معه: الكتاب المقدَّس وكتاب التراتيل. أمّا بالنسبة إلينا، نحن الكاثوليك، فقد أهملنا الكتاب المقدَّس ولجأنا إلى الرتب التقويَّة كدرب الصليب، وتلاوة السُبحة، وإكرام القدِّيسين، والزيّاحات، وساعات السجود، والأخويّات التعبّديَّة... وكذلك شأن الأرثوذكس في إكرام الإيقونات وإقامة القداديس الاحتفاليَّة وصلوات الفرض مع استعمال البخور والشموع والحفاظ على الصوم... كان علينا أن ننتظر منتصف القرن العشرين وقرارات المجمع الفاتيكانيّ الثاني لتبدأ نهضة جديدة بين الكاثوليك، وبين الأرثوذكس أيضاً، للعودة إلى الجذور الإيمانيَّة البيبليَّة ونشر الكتاب المقدَّس والانكباب على دراسته. لا يزال الكتاب المقدَّس حتّى يومنا هذا أكثر الكُتُب الموزّعة في العالَم. وقد أخبرني أحد المسؤولين في "جمعيَّة الكتاب المقدَّس" أنّ الكتاب المقدَّس هو أكثر الكُتُب المرغوبة في معارض الكُتُب العامّة. كما أنّه دخل عالَم الاتّصالات الحديثة فنجده في أقراص ليزريَّة وفي مواقع إلكترونيَّة وفي مختلف برامج الاتّصال الدوليَّة. ولكن هل يكفي أن يكون في بيتنا كتاب مقدَّس؟ علينا أن نقرأه كلّ يوم، في الصباح أو قبل النوم.. ونجعل منه كتاب الكُتُب. وإنّه لِمَن التحدّي أن يلتزم كلّ مسيحيّ بأن يقرأ الكتاب المقدَّس من أوّله إلى آخِره ولو مرّة في العمر. فهل في إمكاننا التغلّب على هذا التحدّي؟ 3- اللاهوت الكتابيّ في حياة الكنيسة إليكم ما يقوله المجمع الفاتيكانيّ الثاني في هذا الموضوع: "إنّ عِلم اللاهوت يرتكز على كلام الله المدوّن، ومعه على التقليد المقدَّس، كأنّما على أساسٍ ثابت. بكلام الله يتعزّز عِلم اللاهوت تعزيزاً متيناً، وبه يتجدّد تجدّداً دائماً، إذ إنّه لا يفتأ يستقصي، في ضوء الإيمان. الحقائق الكاملة المخفيَّة في سرّ المسيح. إنّ الأسفار المقدَّسة تحتوي على كلام الله. ولكونها ملهمةً، تُصبح هي كلام الله في الحقيقة. فمن المفروض إذن أن تصبح دراسة الكُتُب المقدَّسة بمثابة روح عِلم اللاهوت. ومن المفروض أيضاً أن تعتمد رسالةُ الكرازة على كلام الأسفار، لتغذيتها السليمة، وإنعاشها الروحيّ المقدَّس، في كلّ مظاهرها: أكانت موعظةً رعويَّة، أم تعليماً دِينيّاً منتظماً، أم وجهاً من أوجه التثقيف المسيحيّ". (في الوحي الإلهيّ، الرقم 24). كان عِلم اللاهوت في ما مضى يرتكز على عِلم الفلسفة والمنطق، وأسلوب المجادلة والمرافعة والدفاع. وما كان على الكنيسة بعد المجمع الفاتيكانيّ الثاني إلاّ أن تعود إلى سابق عهدها في أيّام الآباء القدِّيسين فتبني لاهوتها على المعطيات الكتابيَّة مع ما يرافقها من تقليد كنسيّ. وهكذا فتحت الأبواب لدراسة الكُتُب المقدَّسة دراسةً نقديَّةً من جميع جوانبها: الأدبيَّة والتاريخيَّة والاجتماعيَّة والنفسانيَّة والعِلميَّة... وليس هناك كتاب وُضع على مشرحة النقد العِلميّ مثل الكتاب المقدَّس! فالكنيسة لا تخشى الحقيقة لأنّ الله هو الحقّ. ومن خلال هذه القراءة العِلميَّة النقديَّة، وما رافقها من تفاسير وشروح، ظهرت تيّارات عديدة تراوح بين التيّار المتحرّر الذي ينفي القدسيَّة والبُعد الإلهيّ عن أقسام عديدة من الكتاب المقدَّس ويردّها إلى عالَم الميتولوجيا والأساطير، والتيّار المتشدّد الذي يقول بحرفيَّة الكلمة (كما أُنزلت)، ما أدّى إلى نشوء بدع وشيع، اليوم كما في الماضي (راجع ما قيل عن "النيقولاويّين" في سفر الرؤيا 2/6 و15)، وإلى ظهور حركات متطرّفة منحرفة. ومن هنا المسؤوليَّة الكُبرى المُلقاة على عاتق مَن يفسّر الكتاب المقدَّس ويشرحه. وإذا كان "الروح يهبّ حيث يشاء" (يوحنّا 3/8)، فلا يعني ذلك أنّ كلّ مؤمن يستطيع أن يفسّر كلام الله على هواه. إنّ تفسير كلمة الله له مرجعيَّة: الكتاب نَفْسه، والتقليد، والسُلطة الكنسيَّة. وكلّها تتمّ بإرشاد الروح القُدُس الذي هو ضمان الحقيقة إلى منتهى الدهر (يوحنّا 14/26). وإذا كانت الكنيسة الكاثوليكيَّة انفتحت أكثر ممّا مضى على اللاهوت البيبليّ فإنّ بعض الكنائس البروتستانتيَّة المُصلحة راحت، بدَورها، تقبل بمرجعيَّة السُلطة الكنسيَّة في شرح الكتاب المقدَّس وتفسيره بحسب تقاليد آباء الكنيسة الأوّلين الذين كانوا الأقرب إلى عصر المسيح وبدايات البشارة الإنجيليَّة. وبناءً على ذلك كان سعي الكنائس الإنجيليَّة المستمرّ في تمييز ذاتها عن سائر البدع والشيع التي نشأت منها بسبب عدم وجود مرجعيَّة ضابطة. 4- الكتاب المقدَّس محور الحركة المسكونيَّة بعد أن كان الكتاب المقدَّس نقطة خلاف بين الكاثوليك وسائر المسيحيّين، وخاصّة الإنجيليّين، من حيث عدد الأسفار والترجمات والتفاسير والشروح، أصبحت البيبليا بعد المجمع الفاتيكانيّ الثاني محطّة لقاء بين جميع الكنائس. ومن ثمار المجمع أيضاً أنّ المجلس البابويّ لتعزيز وحدة المسيحيّين أنشأ العامَ 1969 "الرابطة البيبليَّة الكاثوليكيَّة العالَميَّة" لتطبيق قرارات المجمع المتعلّقة بالتعاون مع سائر الكنائس والجماعات الكنسيَّة لوضع ترجمة موحّدة ودراسة الأسفار الكتابيَّة معاً. وهذا ما تحقّق في السنوات الأربعين الأخيرة. فكانت الترجمات المشترَكة في مختلف اللغات وكانت الدراسات والمنشورات والأبحاث التي اكتشفت الكنائس من خلالها أنّ كلمة الله جُعلت لتوحّدنا لا لتفرّقنا. إليكم ما جاء في وثيقة "دليل لتطبيق مبادئ الحركة المسكونيَّة وقواعدها" الصادرة العامَ 1993 عن حاضرة الفاتيكان: "كلام الله المدوَّن في الكُتُب المقدَّسة يغذّي حياة الكنيسة بطرق مختلفة، وهو "أداة ممتازة بيد الله القدير للحصول على هذه الوحدة التي يدعو المخلّص جميع الناس إليها". إجلال الكُتُب المقدَّسة هو رباط أساسيّ للوحدة بين المسيحيّين، وهذا الرباط يظلّ قائماً حتّى وإن لم تكن الكنائس والجماعات الكنسيَّة التي ينتمون إليها على ملء الوحدة بعضها مع بعض. كلّ ما من شأنه أن يشجّع أعضاء الكنائس والجماعات الكنسيَّة على أن يقرؤوا كلام الله، ويقرؤوه معاً، إذا أمكن، كلّ هذا يقوّي رباط الوحدة التي تجمعهم ويفتح قلبهم لنعمة الله الموحّدة، ويعزّز ما يؤدّونه للعالَم من شهادة مشترَكة لكلمة الله المخلّصة. إنّ ما يقوم به المسيحيّون من نشر الكتاب المقدَّس وتعميمه في طبعات ملائمة، هو شرط لا بدّ منه لسماع كلام الله. إنّ الكنيسة الكاثوليكيَّة، مع استمرارها في نشر الكتاب المقدَّس في طبعات تراعي قوانينها ومقتضياتها، تساهم أيضاً، وبطيبة خاطر، مع كنائس وجماعات كنسيَّة أُخرى، في وضع ترجمات ونشر طبعات مشترَكة، وفقاً لما لحظه المجمع الفاتيكانيّ الثاني وما ورد في الشرع الكنسيّ، وتعتبر التعاون المسكونيّ، في هذا المضمار، شكلاً هامّاً من أشكال الخدمة والشهادة المشترَكتَين في الكنيسة ولأجل العالَم" (الرقم 183). "هذه العلاقات وهذا التعاون مع مؤسَّسات متفرّغة لنشر الكتاب وتعميم استعماله، تلقى تشجيعاً على كلّ مستويات حياة الكنيسة، وبإمكانها أن تسهّل التعاون بين الكنائس والجماعات الكنسيَّة، للعمل الرساليّ والتعليم المسيحيّ والتفقيه الدِينيّ والصلاة والبحث المشترَك. وقد تُفضي غالباً إلى المشارَكة في إصدار طبعة من الكتاب المقدَّس يمكن الاستعانة بها في كثير من الكنائس والجماعات الكنسيَّة، القائمة في منطقة ثقافيَّة ما، أو استعمالها في أغراض محدّدة كالدراسة والحياة الليتُرجيَّة. مثل هذا التعاون يمكن أن يكون ترياقاً يتصدّى لاستعمال الكتاب المقدَّس في اتّجاه أصوليّ أو لأهداف منحازة" (الرقم 185). إذا كان هذا التعاون المسكونيّ فتح آفاقاً جديدة لإبراز دَور الكتاب المقدَّس وأهمّيّته في حياة المؤمنين فإنّه طرح، في المقابل، مشكلةً أُخرى ألا وهي مشكلة تعدّد الترجمات باللغة العربيَّة والتنوّع في الطبعات ودُور النشر. فثمّة ترجمات مسكونيَّة وكاثوليكيَّة وبروتستانتيَّة ورعويَّة ويسوعيَّة وبولسيَّة ومارونيَّة ولاتينيَّة وغيرها كثير... حتّى ليحار المؤمن قارئ العربيَّة أيّ ترجمة يعتمد! أضفْ إلى ذلك الارتباك الذي يحصل عندما نطلب من المؤمنين أن يجلبوا معهم كتابهم المقدَّس أو إنجيلهم للتأمّل والدراسة. فإذا بنصوص متباينة من حيث الترجمة لا تساعد على التركيز ووضوح الرؤية وفهم كلمة الله كما يجب. فلا عجبَ إذا عمدت بعض الأخويّات إلى تبنّي طبعة معيّنة وتوزيعها على أعضائها لتوحيد النصوص في ما بينهم. وفي هذا الصدد أيضاً يأخذ علينا بعضهم أنّ ثمّة اختلافاً بين ترجمة عربيَّة وأُخرى وبين تعبير وتعبير في كتابنا المقدَّس. نقول: إنّ المسيحيَّة قبل أن تكون دِين كتاب هي دِين شخص هو يسوع المسيح ابن الله. وما الكتاب الذي بين أيدينا سوى شهادة لهذا الشخص. هو الكلمة الحيَّة التي نزلت من السماء. وهذه الكلمة لا تقيّدها لغات البَشَر مهما تنوّعت، بل تزيدها ألقاً وانتشاراً ليتغذّى بها جميع الناس. 5- الكتاب المقدَّس: كلمة وصلاة وحياة كلّ ما تحدّثنا عنه مهمّ: قدسيَّة كلمة الله، وضرورة مطالعة الكتاب المقدَّس، وأولويَّة اللاهوت الكتابيّ والبُعد المسكونيّ، ولكنّ الأهمّ أن تتحوّل هذه الكلمة إلى "روح وحياة" (يوحنّا 6/63)، وأن يصبح الكتاب المقدَّس، وعلى الأخصّ الإنجيل، مناجاةً روحيَّة وهدياً لدرب كلّ مؤمن في واقعه اليوميّ. يقول القدِّيس أمبروسيوس: "إنّنا نتحدّث إلى الله عندما نصلّي، ولكنّنا نستمع إليه عندما نقرأ آيات الوحي الإلهيّ". ويقول يسوع: "ليس مَن يقول لي "يا ربّ، يا ربّ" يدخل ملكوت السموات، بل مَن يعمل بمشيئة أبي الذي في السموات... فمَثَل مَن يسمع كلامي هذا ويعمل به كمَثَل رجل عاقل بنى بيته على الصخر..." (متّى 7/21-27). فالكنيسة التي اؤتمنت على كلام الربّ لم تضعه في متحف ولم تودعه الخزائن، بل جعلته على منارة، كما يقول صاحب المزامير "كلمتك مصباح لخطاي ونُور لسبيلي" (119/105). وجاء يسوع ليؤكّد: "أنا نُور العالَم مَن يتبعني لا يمشِ في الظلام بل يكون له نُور الحياة" (يوحنّا 8/12). وهذا ما دعا إليه المجمع الفاتيكانيّ الثاني لكي لا يكتفي المسيحيّ بالقراءة، بل يعيش بحسب المبادئ الإنجيليَّة ويطبّق عمليّاً ما يقول له الروح. "فبواسطة الكُتُب المقدَّسة يبادر الآب الذي في السموات، بحنوّ عظيم، إلى لقاء أبنائه والتحادث معهم. إنّ كلام الله هذا يحمل قوّة وعزماً عظيمَين حتّى إنّه يصبح ركناً للكنيسة وعزّة، ولأبناء الكنيسة منعة إيمان، ولنفوس المؤمنين غذاء، ولحياتهم الروحيَّة مَعيناً دائم الجريان. وهكذا صحّ ما قيل في الكُتُب المقدَّسة من "أنّ كلمة الله حيَّة فعّالـة" (إلى العبرانيّين 4/12)، "لأنّها قادرة أن تبني وتُؤتي الميراث مع جميع المقدَّسين" (رسل 20/32، 1تسالونيقي 2/13). (في الوحي الإلهيّ، الرقم 21). "للكتاب المقدَّس علاقة عميقة مع العناصر الثلاثة الأساسيَّة في حياة الإنسان: الكلمة والصلاة والحياة. وهي عناصر متشابكة. فالصلاة ليست عملاً خارجيّاً عند الإنسان، لأنّها تنبع من داخله، تحييه وتجعله واعياً لعلاقته الجوهريَّة بالله. الصلاة لقاء واتّصال وحِوار يأخذ فيه لقاء الله شكل كلمة تنير الحياة. لهذا يجب أن تتغذّى الصلاة بكلمة الإيمان، كما يجب أن تنطلق من قراءة نصّ من الكتاب المقدَّس الذي يحتاج دوماً إلى أن يتجسّد في الحياة. يجب أن تدخل كلمة الله إلى عمق حياة الإنسان وتتفاعل معه بحيث تكوّن حركة مستمرّة بين كلمة الله وحياة الإنسان. وهذا يفترض بالضرورة استعداداً داخليّاً عند الشخص الذي يتعامل مع كلمة الله حتّى يدع الكلمة تعمل فيه وتكشف له معناها الحقيقيّ" (راجع كتاب: الصلاة الربّانيَّة، المكتبة البولسيَّة، جونية - لبنان 2005). إنّ هذا النوع من الصلاة الكتابيَّة الروحيَّة يُسمّى، بحسب التقليد الرهبانيّ، "الصلاة الربّانيَّـة" LECTIO DIVINA. وتعود الكنيسة إلى اكتشافها مجدَّداً وحثّ الرهبان والمؤمنين الملتزمين، أفراداً وجماعات، على المواظبة عليها. يختصر الكَردينال مارتيني MARTINI هذا النوع من الصلاة الكتابيَّة في ثلاث مراحل تقابلها ثلاث كلمات باللاتينيَّة: 1- القراءة LECTIO: ماذا يقول النصّ أو ماذا تقول كلمة الله في حدّ ذاتها. 2- التأمّل (التفكير) MEDITATIO: ماذا يقول لي النصّ أو ماذا تقول لي كلمة الله. 3- الصلاة ORATIO: ماذا أقول أنا للربّ بواسطة كلمته. ويكون ثمر هذه الصلاة توجيه الحياة بحسب مشيئة الله. فنميّز الأمور بإرشاد الروح، ونتّخذ القرار، ونعمل بحسب الكلمة متشبّهين بالمسيح في المحبّة لتصبح حياتنا كلّها شهادة وبشرى. الخاتمة نختم حديثنا من حيث بدأتْ الوثيقة المجمعيَّة "كلمة الله DEI VERBUM" بالقول إنّ الكنيسة "تُصغي إلى كلمة الله بورع وتعلنها إعلاناً ثابتـاً" (الرقم 1). وهذا شأن كلّ مسيحيّ ملتزم: أن يُصغي إلى كلمة الله بالقراءة والصلاة، وأن يكون بشيراً لها بشهادة الحياة قولاً وفعلاً. يقول القدِّيس يوحنّا الذهبيّ الفم في عظته في الكتاب المقدَّس: "فَلْنطالع الكتابة المقدَّسة جيّداً في أثناء الصلاة. ليس عند وجودنا في الكنيسة وحسب، بل عند الرجوع إلى البيت... فإنّ الشجرة المغروسة على مجاري المياه لا تتّصل بالماء ساعتين أو ثلاثاً في النهار، بل اتّصالها دائم ليلاً ونهاراً، ولذلك تزدان بالأوراق وتعطي الثمار الجيّدة في حينها... الكُتُب المقدَّسة تعطينا المنفعة العظيمة، لا بكثرة كلامها، بل بالقوّة الكائنة فيها. إنّ الطيب فوّاح ذكيّ بطبيعته، لكن وبطرحه في النار تزداد رائحته ذكاء. هكذا الكتابة الإلهيَّة فإنّها جميلة جدّاً بنَفْسها ولكنّها إذا دخلت أعماق النَفْس تصبح كالبخور المطروح في المبخرة، يملأ البيت شذاه الذكيّ". (راجع كتاب: "خطيب الكنيسة الأعظم" في سلسلة "الفكر المسيحيّ في الأمس واليوم"، الرقم 11، المكتبة البولسيَّة، جونية - لبنان 1988). |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 5090 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
أَيـُّها المُرَتِّلُون... 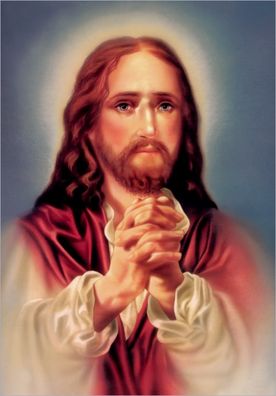 الأب/ نقولا مالك - لبنان إِنَّهُ لَحَسَنٌ أَن يَشعُرَ الإنسانُ بِرَغبَةٍ في تمجيدِ اللهِ بِالحَناجِرِ الّتي خَلَقَها. فَإذا اشتَهَيتُمْ أَن تَكُونُوا مُرَتِّلِينَ، فَنِعْمَ الشَّهْوَةُ. لكِنْ تَذَكَّرُوا أَنَّ التَّرتيلَ وَزْنَةٌ تجعلُكُم خُدّامًا لا أَسيادًا، غَسَلَةَ أَرْجُلٍ لا آنِيَةً لِمَجْدٍ باطِل. فَمَتى رَتَّلْتُم، قُولُوا إِنَّنا عَبيدٌ بَطّالُون، لأَنَّنا عَمِلْنا ما كانَ يَجِبُ عَلينا (لو 10:17). أَيـُّها المُرَتِّلُون... لا تُسارِعُوا لاقتِحامِ مَنابِرِ التَّرتيل (القَرّايات)، وَكَأَنَّكُمْ تَتَلَهَّفُونَ لاغتِصابِ مَنصِبٍ ما، خِشْيَةَ أن يَسبِقَكُمْ آخَرُ إلَيه، بَلْ إِذا وُجِدَ مَنْ يَقُومُ بِهذِهِ الخِدمَة، دُونَ حاجَةٍ إلَيكُم، فَقِفُوا جانِبًا، وَاغْتَنِمُوها فُرصةً للصَّلاةِ بِتَركِيزٍ أَكْبَر. أَيـُّها المُرَتِّلُون... لا تَحْجُبُوا وَزَناتِكُمْ عِندَ الضَّرُورة، وَلا تُضْرِبُوا عَنِ التَّرتِيلِ بِداعِي العُجْبِ وَالأَنَفة -فَمَلعُونَةٌ التِّينَةُ الكَثِيرَةُ الأوراقِ والعَدِيمَةُ الثَّمَر- بَلْ رَتِّلُوا مَتى دَعَتِ الحاجَةُ، أَو مَتى طُلِبَ إِلَيكُم ذلك وَكُنتُم قادِرِينَ على القِيامِ به. وَتَقَدَّمُوا مِنَ المنبر بِرُوحِ الخِدمةِ وَالوَداعَة، وَنَسِّقُوا مَعَ مَنْ يَكُونُ هُناكَ بِلِياقَةٍ وَتَرتيبٍ، وَبِرُوحِ الغيرةِ على جَمالِ الخدمةِ الإلهيّة. وَلا تَكُونُوا طالبِينَ رِئاسَةً -فَما هكذا عَلَّمَنا الرَّبّ- لكنْ إِذا وُجِدَ أَحَدُكُم مسؤولاً عن مجموعةِ مُرَتِّلِين، فَلْيَكُنْ مِثالاً لَهُمْ بالرَّصانَةِ وَالخُشُوعِ واحتِرامِ أَجواءِ الصَّلاة. وَلا تَنتَظِرُوا مَدْحًا وَإِطراءً مِنَ النّاس، بَل قَدِّمُوا أَصواتَكُم قَرابِينَ تَشْفَعُ بِكُم أَمامَ عَرشِ الحَمَل. أَيـُّها المُرَتِّلُون... إِنَّ التَّرتِيلَ فَنٌّ لَهُ أُصُولُه، وَأنتُم تُمارِسُونَ هذا الفَنَّ. لكنْ تَذَكَّرُوا أَنَّ التَّرتِيلَ صَلاةٌ قَبْلَ أَن يَكُونَ فَنًّا، وَتَوبَةٌ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ جَمالاً. وَتَذَكَّرُوا أَنَّ الغايَةَ مِنْ إِلْباسِ الكَلِمَةِ ثَوبَ النَّغَمِ هِيَ أَنْ تُرْفَعَ القُلُوبُ خُشُوعًا، وَأَنْ تُزْهِرَ الشِّفاهُ تَسابِيحَ. فَيَجدُرُ بِكُمْ أَنْ تُسائِلُوا أَنفُسَكُم: هل نحنُ في الكنيسةِ مُرَتِّلُونَ أم مُطْرِبُون؟! هَل نُرَتِّلُ لِنُصَلِّيَ وَنُساعِدَ النّاسَ على الصَّلاة، أَم نَتَّخِذُ التَّرتِيلَ "فَنًّا" مَحْضًا؟! أَيـُّها المُرَتِّلُون... انْتَبِهُوا، لِئَلاّ تَخْرُجُوا بِفَنِّ التَّرتيلِ عَنِ الجادَّةِ الصَّحيحة؛ وَتَذَكَّرُوا أَنَّكُمْ دائمًا بِحاجَةٍ إلى السَّهَرِ الرُّوحيّ، وَبِحاجَةٍ إلى كَمٍّ كَبيرٍ مِنَ التَّواضُع، وَإِلاّ فَالجُنُوحُ سَهْل. إنتَبِهُوا، لِئَلاّ تَنحَرِفُوا بِالتَّرتِيلِ عَن هَدَفِهِ السّامي فَيُصبِحَ تَمجيدًا لِلذّاتِ بَدَلاً مِنَ أن يَكُونَ تَسبيحًا للّهِ. فَإِذا كُنتَ تَبْحَثُ عَنِ المَجْدِ الباطِل، لا تَتَّخِذْ كَنيسةَ اللهِ مَسْرَحًا لَك، "لأنَّ الوُقُوعَ في يَدَيِ اللهِ الحَيِّ أَمْرٌ هائِلٌ" (عب 31:10) |
||||