
 |
 |
 |
 |
|
|
رقم المشاركة : ( 41 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
التشتُّت الكرازي حينما سأل الإسكندر الأكبر أحد الفلاسفة: “إلى متى يحرص الإنسان على حياته؟” أجابه: “إلى أن يشعر بأنّ الموت أفضل من الحياة”، فالموت لن يتقدّم على الحياة إلاّ إذا كان مَعبَرًا لحياةٍ أسمَى وأبهج، كانت تلك قناعة المسيحيين الأُوَّل. كانت رماح الاضطهاد تُسنّ في وجه الكنيسة لا لشيء إلاّ أنّها تبشّر بقيامة الربّ يسوع. فالقيامة هي رحمٌ جديدٌ انطلقت منه أشعّة الرجاء لمستوطني الظلمة وظلال الموت. لقد كتب القديس بطرس في رسالته: «مُبَارَكٌ اللهُ أَبُو رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، الَّذِي حَسَبَ رَحْمَتِهِ الْكَثِيرَةِ وَلَدَنَا ثانِيَةً لِرَجَاءٍ حَيٍّ، بِقِيَامَةِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ مِنَ الأَمْوَاتِ» (1بط 1: 3). تلك كانت بشارة الرجاء التي يطلقها الرسل ليل نهار. لم يكن الاضطهاد بسبب ممارسات لاأخلاقيّة، ولا طموحات سياسيّة، ولا تنظيمات تستهدف استقرار البلاد، ولا بسبب محاولات انقلابيّة ثوريّة تطمح في الحُكم، فقط لأنّ إعلان الكلمة هو جزءٌ أصيل في صميم الإيمان المسيحي، ونشر البشارة هو وصيّة إلهيّة، ولأنّ اسم المخلِّص لا يتوقّف عن الانبعاث من شفاه المسيحيين الأوائل. “لاسم يسوع نرى أناسًا قبلوا ويقبلون أن يُعذّبوا بدلاً من أن يجحدوه، لأنّ كلمة حقّه وحكمته أكثر اضطرامًا وضياءً من قوّات الشمس، ويتسرّب إلى أعماق القلب والروح”(1) إنّ تلك الكلمات هي ليوستين الذي مات شهيدًا على اسم المسيح (165- 166). لقد بدأت أعاصير الاضطهاد تحيط بسفينة الكنيسة؛ «.. وَحَدَثَ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ اضْطِهَادٌ عَظِيمٌ عَلَى الْكَنِيسَةِ الَّتِي فِي أُورُشَلِيمَ، فَتَشَتَّتَ الْجَمِيعُ فِي كُوَرِ الْيَهُودِيَّةِ وَالسَّامِرَةِ، مَا عَدَا الرُّسُلَ» (أع8: 1). التشتُّت هو أحد صيغ التعامل مع الاضطهاد الذي أصبح يمثِّل تيارًا في أورشليم. هنا ونلحظ أن الرسل لم يبرحوا أورشليم ولم يتركوا حلبة الصراع؛ فالحقّ يجب أن يعلن، والجموع متمركزة في أورشليم حيث الهيكل، فالكرازة التي تنطلق من أورشليم ستجد لها مكانًا في كلّ ربوع المسكونة مع الحجيج القافلين إلى ديارهم. لم يكن التشتُّت فعلاً سلبيًّا للجماعة المسيحيّة الأولى، فهو لم يقترن بالاختباء من لهب الاضطهاد ولكنه كان مقرونًا بمدّ رقعة البشارة بالملكوت إلى التخوم المجاورة؛ «فَالَّذِينَ تَشَتَّتُوا جَالُوا مُبَشِّرِينَ بِالْكَلِمَةِ» (أع8: 4). هنا ونلحظ أنّ مجابهة الاضطهاد إمّا يكون بقبول الألم والموت في يقينيّة الرجاء بملكوت الله، وإمّا بالخروج من بؤرة الأحداث مع الحفاظ على العمل الإيجابي وهو هنا الكرازة بقيامة السيّد. لذا فإنّ الهروب الخامل لم يكن أحد خيارات الكنيسة الأولى بأي شكل من الأشكال. كانت ضربة استشهاد استفانوس بمثابة قوّة دافعة للكنيسة لتطلقها إلى مدىً بعيد. فلم تكن اليهوديّة والسامرة فقط هي محطّ رحال الكنيسة الأولى ولكنها امتدّت إلى فينيقيّة وقبرس وأنطاكيه؛ «أَمَّا الَّذِينَ تَشَتَّتُوا مِنْ جَرَّاءِ الضِّيقِ الَّذِي حَصَلَ بِسَبَبِ اسْتِفَانُوسَ فَاجْتَازُوا إِلَى فِينِيقِيَةَ وَقُبْرُسَ وَأَنْطَاكِيَةَ» (أع11: 19). ونتوقّف قليلاً عند تلك المدن الثلاث. فينيقيّة، وهي لبنان الحاليّة،إنّها منطقة ساحليّة تقع على الساحل الشمالي لليهوديّة وبها موانئ تجاريّة مثل صيدون. أمّا قبرس فهي ثالث أكبر جزيرة في البحر المتوسّط بعد صقليّة وسردينيا وتقع على بعد حوالي ستين ميلاً على الساحل الغربي لسوريا. ولكن تبقى أنطاكية هي النقطة الأكثر إشراقًا في رداء الكرازة، فهناك ولدت كلمة “مسيحيين” وظلّت إلى يومنا هذا. كانت هناك ست عشرة مدينة تسمّى أنطاكية ولكن تلك التي استقبلت البشارة الجديدة كانت أعظمهم على الإطلاق. إنّها كما أطلقوا عليها “المملكة الذهبيّة التي للشرق”.(2) كانت أنطاكيّة من أعظم ثلاث مدن في العالم بعد روما والإسكندريّة وكانت من المدن التي تُسمّى “عالميّة” cosmopolitan وكان يصفها شيشرون بأنّها مكان الرجال المتعلّمين والدراسات الليبراليّة(3) إلاّ أنّها كانت ترزح تحت ثقل ممارسات وثنيّة لا أخلاقيّة؛ فقد كانت تشتهر بعبادة دافني(4) والذي كان هيكلها يبتعد حوالي خمسة أميال عن المدينة وسط بستان من أشجار الغار. كانت دافني فتاة تحوّلت إلى شجرة الغار إثر ملاحقة أبوللو لها بحسب الميثولوجيا الإغريقيّة القديمة. كانت كاهنات دافني مكرّسات لممارسة الخطيّة كنوع من التعبُّد لها. انتقلت الكنيسة من مجتمع متحفِّظ دينيًّا إلى مجتمع يعاني من الانحلال الخلقي. الأوّل أصولي النزعة يركن إلى الحرف ويتحرّك وفقًا لضوابط تقليدٍ، بنَى برجه العاجي قادة اليهود، والثاني لا يُقيِّده ضابطٌ خلقيٌّ؛ فالانحلال عنده عبادةٌ وفقًا لتقليد عبادة دافني الوثنيّة. هنا وتقف البشارة أمام الأوّل لتبعث له بنسائم التحرير من الحرف، وتبعث للأخير بنسائم التحرُّر من قيد الخطيّة والفساد. كانت البشارة في تلك المدن لليهود فقط في أوّل الأمر إذ كانوا «لاَ يُكَلِّمُونَ أَحَدًا بِالْكَلِمَةِ إِلاَّ الْيَهُودَ فَقَطْ» (أع11: 19). ولعلّ هذا يرجع إلى أنّ المكان الذي كانت تنطلق منه الكرازة هو المجمع اليهودي وخاصّة أيام السبوت حيث يهود المدينة مجتمعين. ويروي لنا يوسيفوس أنّ أنطاكية كان بها حوالي 25000 يهودي في وقته.(5) ولسبب الانفتاح الأنطاكي على العالم كانت الفرصة مهيّأة لنقل البشارة لا لليهود المتحدّثين بالآراميّة فقط ولكن لليهود المتحدثين باليونانيّة أيضًا، وكانت الوسيلة هي بعض المسيحيين من الأصول القبرسيّة والقيروانيّة؛ «وَلكِنْ كَانَ مِنْهُمْ قَوْمٌ، وَهُمْ رِجَالٌ قُبْرُسِيُّونَ وَقَيْرَوَانِيُّونَ، الَّذِينَ لَمَّا دَخَلُوا أَنْطَاكِيَةَ كَانُوا يُخَاطِبُونَ الْيُونَانِيِّينَ مُبَشِّرِينَ بِالرَّبِّ يَسُوعَ» (أع11: 90). إنّ كلمة «اليونانيين» التي وردت بالآية السابقة جاءت في اليونانيّة Ἑλληνιστὰς وقد تباينت آراء المفسرين واللُّغويين، هل المقصود بها اليونانيين أو اليهود المتحدثين باليونانيّة، وهل هم من الدخلاء proselytes الذين آمنوا بيهوه وهو الرأي الذي يرجّحه Wordsworth. وفي المقابل نجد أنّ Meyer يرى أنهم من اليونانيين غير المختونين ولكن الأتقياء على شاكلة كورنيليوس وكان يسمح لهم بالحضور للمجمع.(6) في كلّ الأحوال نجد أن الكنيسة كانت تنمو وتمتد وتتّسع وتعاين يدَ الله وتتمتّع بالعمل الإلهي الفائق للتصوُّر؛ «وَكَانَتْ يَدُ الرَّبِّ مَعَهُمْ، فَآمَنَ عَدَدٌ كَثِيرٌ وَرَجَعُوا إِلَى الرَّبِّ» (أع11: 21). _____ الحواشي والمراجع لهذه الصفحة هنا في موقع الأنبا تكلاهيمانوت:(1) القديس يوستينوس، الحوار مع تريفون، تعريب الأب جورج نصور (الكسليك: جامعة الروح القدس، 2007)، 345. (2) Wiersbe, Warren W. The Bible Exposition Commentary. Wheaton, Ill.: Victor Books, 1996, c1989, Acts 11: 9. (3) MacArthur, John. Acts. Chicago: Moody Press, 1994, c1996, p.311. (4) The Acts of the Apostles. Ed. William Barclay, lecturer in the University of Glasgow. The Daily study Bible series, Rev. ed. Philadelphia: The Westminster Press, 2000, c1976, p.88. (5) Boice, James Montgomery. Acts: An Expositional Commentary. Grand Rapids, Mich.: Baker Books, 1997, p. 197. (6) The Pulpit Commentary: Acts of the Apostles Vol. I. Ed. H. D. M. Spence-Jones. Bellingham, 2004, p.358. |
||||
|
|
|||||

|
|
|
رقم المشاركة : ( 42 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
هيرودس والاضطهاد السياسي في ذلك الوقت ظهر على المسرح شاول الطرسوسي كأحد اليهود الغيورين الذين أخذوا على عاتقهم مهمّة إبادة المسيحيّة وترويع المسيحيين. وقد حدثت في تلك الفترة نهضة كرازيّة للأمم كما هيّأت السماء إناءً لإعلان الكلمة للأمم، ولكن قبل الخوض في تفاصيل تلك القفزة من على أسوار أورشليم واليهوديّة إلى رواق الأمم (موضوع مقالنا القادم)، لابدّ لنا من ذكر حدث في غاية الأهميّة ألا وهو محاولات هيرودس أغريبا الأوّل إيقاف النمو في الجسد المسيحي، إذ نقرأ في سفر الأعمال (12: 1): «وَفِي ذلِكَ الْوَقْتِ مَدَّ هِيرُودُسُ الْمَلِكُ يَدَيْهِ لِيُسِيْء إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْكَنِيسَةِ، فَقَتَلَ يَعْقُوبَ أَخَا يُوحَنَّا بِالسَّيْفِ». إنّ هيرودس الذي ذكره القديس لوقا في هذا النصّ هو هيرودس أغريبا الأوّل (10 ق.م. - 44 م) ابن أرسطوبولس Aristobulus وبِرينيس Berenice وحفيد هيرودس الكبير. نال تعليمه في روما، وقد هرب منها في شبابه إلى فلسطين نتيجة تراكم الديون عليه هناك بعد أن عاش هناك حياة انحلال كاملة. سُجن في عهد طيباريوس قيصر نتيجة بعض تصريحاته المسيئة التي تمنّى فيها تولّي كاليجولا بدلاً من طيباريوس، وقد أُفرج عنه بعد موت طيباريوس قيصر بل وتم تعيينه حاكمًا على شمال فلسطين في عهد الإمبراطور كاليجولا وكذلك حظى بلقب “ملك”. وقد أُضيفت إليه اليهوديّة والسامرة عام 41 م. كنتيجة لدعمه لتولّي كلاوديوس قيصر سدّة الإمبراطوريّة بعد موت كاليجولا. ونتيجة علاقته المتقلّبة بروما كان يحاول تقوية علاقاته باليهود على حساب الجماعة المسيحيّة الجديدة.(1) كان هيرودس أغريبا الأوّل مناورًا سياسيًّا حاذقًا استطاع أن يدرس النفسيّة اليهوديّة جيّدًا ووجد أن المدخل الملوكي إلى قلوب شعبه هو الدين. كان يعلن على الملأ أنّه يستمتع بالإقامة في أورشليم، وكان يراعي الناموس والتقاليد اليهوديّة وكان يُقدّم ذبائح في الهيكل يوميًّا، بل إنه قرأ فقرة من الناموس في عيد المظال كتكريم من قادة اليهود لخدماته الدينيّة، وهكذا ملك زمام الأمور فرسّخ دعائم حكمه.(2) كما ذكرت المشناه، أثناء القيام بالدورة السنويّة لحمل البكور إلى الهيكل، أنّه “حينما وصلوا إلى جبل الهيكل حمل الملك أغريبا [هيرودس] سلّته على كتفيه ودخل بها إلى باحة الهيكل”.(3) ويعلّق ماسون Mason على التقرُّب المُغرض من الديانة اليهوديّة والذي كان يحرص عليه هيرودس، فيقول: “إنّه استراتيجيّة حكم، وطريقة للحفاظ على دعم الجموع، أكثر من كونه التزامًا قلبيًّا تجاه التقليد اليهودي”(4). ما الذي يرسّي دعائم الحاكم في مجتمع أصولي أكثر من قتل واضطهاد وتعقُّب من تراهم الجموع أنّهم أعداء الدين!! هنا ويبقى الحاكم هو حامي حمى الدين وبالتالي يحصد المغانم السياسيّة على طبق من ذهب ودون عناء. على الجانب الآخر يرى بعض المفسّرين أنّ تلك الهجمة الشرسة من هيرودس على المسيحيين كانت بسبب المجاعة الحادثة آنذاك؛ «وَقَامَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ اسْمُهُ أَغَابُوسُ، وَأَشَارَ بِالرُّوحِ أَنَّ جُوعًا عَظِيمًا كَانَ عَتِيدًا أَنْ يَصِيرَ عَلَى جَمِيعِ الْمَسْكُونَةِ، الَّذِي صَارَ أَيْضًا فِي أَيَّامِ كُلُودِيُوسَ قَيْصَرَ». وكأنّ المجاعة هي غضب إلهي بسبب الدعوة المسيحيّة، كما حاول أن يصوّر بعض المناهضين للدعوة المسيحيّة من قادة اليهود. ولأنّ هيرودس أغريبا كان يهوديًّا غيورًا كما أورد يوسيفوس. يمكن أن يكون لهذا الرأي موقعه ولكن بجانب دعم موقفه السياسي كما أسلفنا.(5) لقد كان موت إستفانوس كما تحدّثنا في المقال السابق بأيدي الغوغاء من اليهود الذين تمّ تحريضهم في المجمع، إلاّ إننا ههنا أمام أمْرٍ جديد، فالعقوبة هنا صادرة عن الملك هيرودس، وهو يعني أنّ الصدام مع المسيحيّة أصبح علنًا وبمباركة الملك وإرادته وهو الذي يمثّل قيصر في تلك البلاد. يكتب القديس يوحنّا الذهبي الفم عن تلك الحادثة فيقول: “يا له من شكل جديد للتجارب. لاحظوا ما قلته منذ البداية، كيف اختلطت الأشياء معًا، كيف تناوبت الراحة مع الضيقة في النسيج الكلّي للتاريخ. ليس فقط اليهود، ولا السنهدرين، ولكن الملك. إنّ القوّة تشتد والحرب تستعر، كلّما حاولت استرضاء اليهود”.(6) بدأ هيرودس حملته المحمومة ضدّ المسيحيّة بقتل القديس يعقوب. لم يسترسل القديس لوقا في ذكر حادثة استشهاد القديس يعقوب إلاّ أنّ يوسابيوس القيصري يروي لنا عن ملابسات استشهاده، نقلاً عن أحد الأعمال المفقودة لكليمندس السكندري وهو “وصف المناظر” Ὑποτυπώσεις إذ يقول إنّ كليمندس تسلّم هذا التقليد من سابقيه، ومفاده أنّ من كان منوطًا به قيادة يعقوب إلى مكان الحُكم، حينما رأى يعقوب حاملاً شهادته، تحرّك قلبه، واعترف أنه أيضًا مسيحي، فاقتيدا معًا. وفي الطريق، توسَّل إلى يعقوب لكي يسامحه، وبعد برهة من التفكير، أجابه: “سلامٌ لك” وقبّله، وقد استشهدا معًا.(7) ويروي لايتفوت Lightfoot قصّة أخرى نقلاً عن Rabanus Maurus وهي أنّ القديس يعقوب في ذلك الوقت قد أتمّ صياغة قانون إيمان الرسل والتي تنتهي كلّ فقرة منها بعبارة “وفي يسوع المسيح، ابنه الوحيد، ربّنا” وقد كان هذا سببًا كافيًا لقتله.(8) كان القديس يعقوب أوّل من استشهد من الُرسُل وهو الوحيد منهم الذي دوّن العهد الجديد شهادته. كان من الثلاثة المُقرّبين من المسيح، الذين عاينوا مجده على جبل التجلّي (انظر مت17: 1) والذين كانوا بجواره إبّان إقامة ابنة يايرس (انظر مر5: 37)، حتّى إنه كان أحد الذين رافقوه في ليلة الجسثيمانيّة (انظر مت26: 37). يكتب القديس جيروم: “إنّ كنيسة المسيح تأسسّت بسفك دمائها، لا [دماء] الآخرين. باحتمال الاعتداءات لا بافتعالها. وبينما كانت الكنيسة تنمو بالاضطهاد، كانت تُتوّج بالاستشهاد”.(9) وبنفس المنطق الإسخاطولوجي يقول القديس يوحنّا الذهبي الفم: “حياة المسيحي يجب أن تكون مُخضّبة بالدماء، بالطبع ليس أن يريق دماء الآخرين، بل أن يكون مستعدًّا أن يراق دمه هو. إذًا لنُرِقْ دماءنا، عندما يكون هذا لأجل المسيح”.(10) هكذا صارت دماء يعقوب حجرًا لبناء صرح الكنيسة الأبدي وتاجًا على هامتها أبد الدهور. لقد استشهد القديس يعقوب بالسيف في إشارة إلى أنّ جريمته كانت قيادة الجموع لعبادة آلهة غريبة، وهو ما نقرأه في نصّ التثنية؛ «إِنْ سَمِعْتَ عَنْ إِحْدَى مُدُنِكَ التِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ لِتَسْكُنَ فِيهَا قَوْلاً: قَدْ خَرَجَ أُنَاسٌ بَنُو لئِيمٍ مِنْ وَسَطِكَ وَطَوَّحُوا سُكَّانَ مَدِينَتِهِمْ قَائِلِينَ: نَذْهَبُ وَنَعْبُدُ آلِهَةً أُخْرَى لمْ تَعْرِفُوهَا. وَفَحَصْتَ وَفَتَّشْتَ وَسَأَلتَ جَيِّداً وَإِذَا الأَمْرُ صَحِيحٌ وَأَكِيدٌ قَدْ عُمِل ذَلِكَ الرِّجْسُ فِي وَسَطِكَ. فَضَرْباً تَضْرِبُ سُكَّانَ تِلكَ المَدِينَةِ بِحَدِّ السَّيْفِ وَتُحَرِّمُهَا بِكُلِّ مَا فِيهَا مَعَ بَهَائِمِهَا بِحَدِّ السَّيْفِ» (تث13: 12-15). _____ الحواشي والمراجع :(1) MacArthur, John Jr. The MacArthur Study Bible. Nashville: Word Pub., 1997, c1997, Acts 12:1. (2) Kistemaker, Simon J. and William Hendriksen. New Testament Commentary: Exposition of the Acts of the Apostles. New Testament Commentary. Grand Rapids: Baker Book House, 1953-2001, p.432. (3) Herbert Danby, trans., The Mishnah, M Bikkurim 3:4 (London: Oxford University Press, 1933), p. 97. Cited by; Hughes, R. Kent. Acts: The Church A fire. Preaching the Word. Wheaton, Ill.: Crossway Books, 1996, p.164. (4) Mason, Steve. Josephus and the New Testament. Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 1992, ch 4. (5) Mills, M.S. The Acts of the Apostles. Dallas: 3E Ministries, 1997, c1987, Acts 12:3 (6) The Nicene and Post-Nicene Fathers, edit. by: Schaff, Philip,, First Series Vol. XI. (Oak Harbor: 1997), Homilies on the Acts, xxvi, p. 168 (7) The Nicene and Post-Nicene Fathers, op.cit., Eccl. Hist., ii. 9, p. 110 (8) Lightfoot ‘Works,’ vol. viii. p. 282, cited by; The Pulpit Commentary: Acts of the Apostles Vol. I. Ed. H. D. M. Spence-Jones. Bellingham, p.378 (9) Water, Mark. The New Encyclopedia of Christian Quotations. Alresford, Hampshire: John Hunt Publishers Ltd, 2000, p.724 (10) تفسير رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين، القديس يوحنا الذهبي الفم، ترجمة: د. سعيد حكيم يعقوب (المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائيّة: 2010)، ص107. |
||||

|
|
|
رقم المشاركة : ( 43 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
ممارسة الترتيل بالمزامير في الجزء الثاني من كتاب المعاهد، يُبرّر كاسيان التسبيح باثني عشر مزمورًا في الخدمتيْن الرئيسيتيْن (الغروب والسهر)، مستشهدًا، ليس فقط بالتقليد المُقدّس، ولكن بتوضيحٍ إلهيٍّ لتلك الممارسة، وتلك القصة قد تكون مرتبطة بقصّة القديس باخوميوس التي يظهر فيها تسليم الملاك لتلك الممارسة الرهبانيّة.(1) وفي النسخة الخاصّة بكاسيان، نجد أنّه قد اجتمع جمعٌ من رؤساء الرهبنة لمناقشة العدد الأمثل من المزامير التي يمكن ترتيلها في الخدمات العامّة، ولكنّهم لم يتوصّلوا لاتفاقٍ، فقرّروا أن يُصلّوا الغروب معًا. “وبينما الجميع جالسون (كما هو معتادٌ وشائعٌ في أرض مصر)، مُثبّتين كلّ تركيز قلوبهم على كلمات المزامير التي تُرتل. رتل [الملاك] إحدى عشر مزمورًا يتخلّلها صلواتٌ: مُرتلاً كلّ آية لاحقة مع تعديلٍ(2) مساوٍ لها، وأكمل الاثني عشر بالاستجابة بـ‘هلّلويا’، وبانصرافه المُفاجئ عن أعين الجميع، وضع نهاية لاختلافهم وخدمتهم [الليتورجيّة]”(3) كانت لكاسيان عدّة أهدافٌ من الفقرة السابقة؛ أولاً: أراد أن يشير إلى أنّ الاستماع إلى الترتيل بالمزامير كان أثناء جلوس الجميع كما كان شائعًا، كعادةٍ، في مصر آنذاك (حسب قوله). ثانيًا: المزامير الفرديّة كانت تُرتل مع الصلوات وليس بالمردِّ “هلّلويا” بعد كلّ منها. ثالثًا: أنّ المزامير كانت تُرتل بوضوحٍ وتمييزٍ، مع إمكانيّة “التعديل”، الأمر الذي يُشجِّع الجميع على التركيز الكامل بكلّ قلوبهم على الآيات التي تُرتل. وفي النهاية تخلُص تلك القصّة إلى أنّ اثني عشر مزمورًا كانت كافية. كما يظهر أيضًا من خلال النصّ أنّه في الاجتماع اللّيتورجي، كان ترتيل المزامير قاصرًا على مُرتل أو اثنين بينما الباقي جالسون. تلك النقطة يسترسل فيها كاسيان في موضعٍ آخر من كتاب المعاهد، كما يلي: “إنّ الاثني عشر مزمورًا المذكورة أعلاه مُقسّمة كالتالي: لو كان هناك أخوان، يُرتل كلّ منهما ستّة مزامير، وإن كان هناك ثلاثة، يرتل كلّ منهما أربعة مزامير، وإن كانوا أربعة يرتل كلّ منهما ثلاثة مزامير، ولا يُرتل بأقل من هذا العدد في المجمع، لذا فمهما كان حجم الجمع، لا يُرتل أكثر من أربعة في الاجتماع”(4) وتشير تلك النصوص إلى أنّه على عكس نظام التناوب في الترتيل antiphonal(5) حيث تتبادل جوقتان من المرتلين، التسبيح، نجد الممارسة الرهبانيّة المبكّرة للسهر اللّيلي وكذلك خدمة الغروب كانتا تعتمدان على الإنصات أكثر من الترتيل.(6) كان مَنْ يُرتل هو المُنشِد وليس الجماعة(7)، ولكي يتسنَّى للرهبان أن ينصتوا بانتباهٍ أكبرٍ كان مسموحًا لهم بالجلوس أثناء ترتيل الإبصلموديّة: “إنّ عدد المزامير القانوني السابق ذكره، يسهُل على الجماعة، عن طريق الراحة الجسديّة. إذ كان يجلس كلّ المجتمعين على أرائكٍ مُنخفضةٍ (باستثناء ذاك الذي يقف في المنتصف ليرتل المزمور)، ويتابعون صوت المُرتل بتركيز قلوبهم الكامل، وذلك لأن الصوم والعمل ليل نهار مُجهِد للغاية، لذا فلو لم يكن مجالاً كهذا [للراحة]، لن يكون في مقدورهم أن يكملوا هذا العدد من المزامير وهم وقوف”(8). وبحسب كاسيان، فإنّ هذا الوضع الظاهري للجسد كان يُساعد الرهبان في الإبقاء على تركيز القلب أثناء الترتيل وكانت هناك فترات لإنعاش refreshment انتباههم أثناء الإنصات للترتيل عن طريق فترة من الصلاة الصامتة والتي كانت تُختتم بالختام الذي كان يُنشِده المُرتل. هذا كان هامًا لتغيير وجهة تركيزهم من الإنصات، إلى حالة أكثر نشاطًا من الصلاة الذاتيّة. وبعد فترة الصلاة، وقد انتعش تركيز القلب يمكن للمرتل (المرتلين) أن يكملوا وينتقلوا إلى المزمور الثاني: “لذا لم يحاولوا عن طريق الترديد المتواصل للمزامير أن ينهوا تلك الخدمة الجماعيّة؛ بل كانوا يقسّمون الآيات إلى قسميْن أو ثلاث، ويكملونها منفصلة، قسمٌ وراء الآخر، ويرصّعونها بصلواتٍ فيما بينها. لأنّه ليس بكثرة الآيات ولكن بانتباه ومعرفة الذهن كانوا يبتهجون مُشدّدين على ذلك بكلّ قلوبهم؛ أُصلّي بالروح وأُصلّي بالذهن أيضًا (اكو14: 15)”(9). ويرى جيمس ماكينون James McKinnon أنّ عبارة “يكملونها منفصلة، قسمٌ وراء الآخر”separately, section by section، تشير إلى الإيقاع الهادئ في الترتيل من قِبَل المُرتلين، لتسهيل فهم الجزء الذي يُرتل.(10) على الجانب الآخر، نجد أنّه كانت هناك فرصةٌ أخرى لتدعيم المفهوم الروحي للمزمور من خلال الوقفات الخاصّة بالصلاة والتي كانت تتخلّل ترتيل المزامير بشكلٍ منتظم. كانت تلك الوقفات ترتبط بثلاثة أفعال مُتتاليّة؛ لكلٍّ منهم وضعٌ خاص. أولاً: يقف الرهبان للصلاة، يعقبها سجود قصير وأخيرًا ينتصبون مُجدّدًا للصلاة بأيادٍ منبسطة ومرتفعة إلى العلاء، بينما “يختتم” المُنشِد تلك الصلاة الجماعيّة. ويُحذّر كاسيان من أن وقفات الصلاة يجب أن تكون متأنيّة وليست مُسرعة، إلاّ أنّه يؤكّد أنّ السجود لا ينبغي أن يطول. ويضيف كاسيان تلك الممارسة المصريّة مفسرًا إياها كما يتذكّرها قائلاً: “.. قبل أن يحنوا ركبهم، يُصلّون لفترةٍ قصيرةٍ، واقفين لكيما يقضوا الجزء الأكبر من الوقت في التضرُّع. بعد ذلك، ولبرهة قصيرة، ينحنون إلى الأرضِ مُتعبّدين لرحمة الله، ثم يقفون بسرعة، وينتصبون رافعين أياديهم، كما كانوا واقفين للصلاة من قبل، متريّثين في التضرُّع، لأن إطالة السجود على الأرض يجعلك عُرضة -كما يقولون- ليس فقط لهجوم الأفكار الشريرة، ولكن أيضًا للنوم.. ولكن حينما يقوم مُترئِّسُ الصلاة، يقف الجميع، لا يحني أحدٌ ركبتيه قبل سجوده أو يُطيل سجوده بعد قيامه من على الأرض..”(11). تلك الفقرة تُميِّز لنا بين الصلاة المُقدّمة أثناء الوقفات ما بين المزامير؛ فالأولى تسبق السجود ويشير إليها كاسيان بكلمة (12)oratio، والثانية تعقب السجود، حيث ينتصب الرهبان في وضع الصلاة رافعين أياديهم (كعلامة تضرُّع) ويُقدّمون ابتهالاتهم والتي تنتهي بالترتيل الذي يُرتله المُنشِد نيابة عن الجمع كلّه.(13) لوقا ديسينجر Luke Dysinger _____ الحواشي والمراجع :(1) يؤكّد Owen Chadwick أن رواية كاسيان مشابهة لما ورد في التقليد الباخومي عن “قانون الملاك”، ولكنه يصف بتفصيل أيضًا الاختلافات الأساسيّة، ويشك أن هذا الأمر يثبت وجود علاقة مباشرة بين كاسيان والقديس باخوميوس. Chadwick, John Cassian, pp. 60-2. (2) [يقصد بالتعديل] نغمة أو نظام لكلّ آيتين معًا. (3) Cassian, Institutes 2.5.5, SC 109, p. 68 (4) Cassian, Institutes 2.11.3, SC 109, p. 78. (5) مصطلح أنديفونا antiphonal يستخدم هنا في نطاق ضيق للتعبير عن الترتيل التبادلي للخوارس. بينما يستخدم كاسيان هذه الكلمة antiphona للتعبير عن ممارسات مختلفة تمامًا؛ فأحيانًا يشير بها إلى ترتيل ضمني responsorial (كمرد لقراءة) لآية أو لمزمور بأكمله (Institutes 2.2.1, SC 109, p. 58). بينما في مواضع أخرى يستخدمه للتعبير عن ترتيل كلّ المزامير المتعلّقة بالخدمة (Institutes 2.8, SC 109, p. 72). وفي استخدام ثالث للمصطلح يبدو أنه يعني الترتيل المتناغم للمزمور أو مرد (لازمة) يرتله المجمع كله. (Institutes 3.8.4, SC 109, p. 112). (6) يؤكّد Bunge على تلك النقطة وذلك في Geistgebet, pp. 13-14، إذ أنه يرى، بشكل غير مفهوم، أن الترتيل للمزامير كان يؤدّى على أقصى تقدير من قبل ثلاثة منشدين “hِchstens drei Sنngern”، وذلك بالرغم من الوصف الذي أورده كاسيان عن أربعة منشدين. (7) تلك كانت الممارسة المبكرة للخدمة في مصر والتي يصفها كاسيان في الكثير من فقرات كتابه الثاني من المعاهد Institutes. بينما نجد في مجمع كاسيان في بلاد الغال وضعًا مختلفًا. ويشير في كتاب المعاهد3، 3، 1 إلى الممارسة في فلسطين وبلاد ما بين النهرين التي سبقت الممارسة في مجمعه، فبالإضافة إلى السواعي الجديدة؛ الثالثة والسادسة والتاسعة (التي استبدلت الممارسة المصرية الأكثر قدمًا “للصلاة الدائمة” أثناء العمل)، كان هناك أيضًا تنوع كبير في طرق ترتيل المزامير. ويستخدم مصطلح antiphona tria ليشير إلى ذلك التنوع، وقد يكون شكل من أشكال الإنشاد الضمني (كمرد لقراءة) (Institutes 3.8.4, SC 109, p. 112)، ولكن من المؤكّد أنه كان ترتيلاً للمزامير بواسطة المجمع كله وليس المنشد فقط. (8) Cassian, Institutes 2.12.1, SC 109, pp. 78-80. (9) Ibid., 2.11.1, p. 76. (10) McKinnon, Music in Early Christian Literature, p. 148. (11) Cassian, Institutes 2.7.2-3, SC 109, p. 70. (12) تعني “عظة”. (المعرّب) (13) إن من يقوم بـ“ختام صلاة المجمع” هو المرتّل وهو ما يظهر بوضوح في تلك القطعة التي يعارض فيها كاسيان بوضوح تلك الممارسة (والتي صارت فيما بعد العادة السائدة في الغرب) لإنشاد المجدلة بعد كلّ مزمور. ويحافظ كاسيان على موضع الذوكصا بعد الانتهاء من ترتيل كلّ المزامير: “إن ما شاهدناه في هذه المدينة، حيث يقف المجمع كلّه بعد نهاية كلّ مزمور ويرتلون بصوت عالٍ ‘المجد للآب والابن والروح القدس’، لم نسمع به قبلاً في أي مكان في الشرق كلّه. فهناك، بينما يسود الصمت والسكون الجميع، يختم المرتل الصلاة. إنّ هذا اللحن لمجد الثالوث يُختتم به، عادة، خدمة ترتيل المزامير”. Institutes 2.8, SC 109, p. 72. |
||||

|
|
|
رقم المشاركة : ( 44 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
الآباء والمعاصرة لقد تميَّز الآباء بسمة غاية في الأهميّة؛ إنّها ما يمكن أن نطلق عليه الآن: “المعاصرة”. فلم يكن الآباء مُتغرِّبين عن عصرهم وما يحدث فيه، كما لم تستهلكهم قضايا العصر ومشاكله لتنحدر بهم إلى أسفل. بل ولقد استبق الكُتّاب المسيحيين الأوائل عصورهم بطرح قضايا لم تكن موضوع بحث في تلك الأزمنة؛ مثل الإجهاض، الذي تناوله أثيناغورس في دفاعه الخامس والثلاثين مؤكِّدًا على حقّ الجنين في الحياة، مؤثًمًا مَنْ يستخدم عقاقير الإجهاض. لقد كتب الآباء عن الزواج، البتوليّة، الحياة المسيحيّة، الأغنياء، المرأة، العدل، الحياة السعيدة، الأخلاقيّات، وحريّة الإرادة.. كما كتب القديس يوحنّا الذهبيّ الفم عن المسارح والأزياء وعلاقتها بالأخلاق المسيحيّة. لذا يمكننا القول إنّ الآباء لم يألُ جهدًا في تناول أي من المواضيع التي مسّت مسيحيي عصورهم. لقد خرج معظم الآباء إلى البراري ليتنقّوا من مجاذبات العالم المادي، وحينها استطاعوا أن يفهموا مأساة الإنسان المعاصر آنذاك، واستطاعوا أن يستشعروا مكمن الخطر وكيفيّة مجابهته. لذا فإنّ من المخاطر التي تحيق بنا اليوم هو انقسامنا إلى قسمين؛ الأوَّل لا يرى في الآباء سوى إرثٍ بالٍ من عصورٍ غابرة يجب أن نعبر عليه كما يعبر الزائر على القطع الفنيّة والأثريّة في المتاحف ليبدي إعجابه ثم ينتقل إلى قطعة أخرى. والثاني يرجع به الحنين إلى الماضي فيصير مُتغرِّبًا عن عصره وقضاياه وإشكالياته، فيصبح حديثه وكأنّه حديث الذكريات التي لا تُعالِج واقع الإنسان المعاصر. لقد كتب القمُّص تادرس يعقوب ملطي في مؤلّفه “المدخل إلى علم الباترولوجي، بدء الأدب المسيحي الآبائي. الآباء الرسوليون” قائلاً: “لم تكن أقوال الآباء وسِّيَرهم ورسائلهم وفكرهم يُمثِّل تُراثًا ثمينًا يُوضَع في بطون الكُتُب أو يُحفَظ في خزائن المتاحف والجامعات ليكون مادّة لدراسات فلسفيّة نظريّة، إنّما كان إنجيلاً عمليًّا حيًّا تخطُّه الأجيال بالروح القدس، شهادة لديمومة عمل الله الخلاصي المُستمر في كلّ جيل. هكذا اعتزّ الآباء بتراث السابقين لهم لا بكونه أدبًا روحيًّا لأجيال ماضية، وإنّما بكونه مُمثِّلاً لحاضرٍ حيّ وحياة واقعيّة صادقة عاملة في الكنيسة”. لذا من الضروري بمكانٍ أنْ نُدرِك أن بحثنا في كنوز الآباء لا ينفصل عن وعينا بواقعنا المعاصر، وما نستلهمه من الآباء نُقَوْلِبه في لُغة العصر لنُصِّدر خطابًا يُعبِّر عن الكنيسة التي تحمل في جعبتها جددًا وعتقاء. يجب علينا أن نجمع ما بين المنظوريْن؛ التراثي والمعاصر، وأن نكون على استعداد للتجدُّد والمغامرة في التلامس مع إشكاليات العصر دون أن نقطع الخيط الذي يصلنا بهوّيتنا الإيمانيّة. ولكن، هل عالج الآباء إشكاليات إنساننا المعاصر مثل؛ ثقافة الاستهلاك، تحديات الثورة الصناعيّة، الإلحاد السلبي، السطوة الإعلاميّة، التغيّرات السياسيّة، القضايا الحقوقيّة، الموازنات بين قيم التسامح والتغيُّر المجتمعي من خلال ثورات سلميّة لتفعيل الديموقراطيّة، عِلم الأجنّة، نقل الأعضاء، قيم الحداثة، التعدديّة الدينيّة والتعايش المشترك في قالب المواطنة، الهجرة، العولمة، عمالة الأطفال، التغيُّرات المناخيّة والاحتباس الحراري.. لا أستطيع الادّعاء بأني قرأت كتابات الآباء جُملةً، لأجيب على هذا التساؤل، ولكني أعتقد أنّ تلك التحديّات هي وليدة ظرف تاريخي ومجتمعي وثقافي معاصر، وبالتالي لم تكن تحديّات في العصور الأولى للمسيحيّة، لذا أستبعد أن يكون الآباء تناولوا تلك الأمور بشكل مباشر. هنا ونستشرف دور الكنيسة المعاصر كامتداد طبيعي للآباء؛ منهم تأخذ خيط الإيمان لتحيك به إجابات لتساؤل الإنسان المسيحي المعاصر؛ إجابات ناتجة عن وعي عام؛ كتابي آبائي ليتورجي مُخلَّط في بوتقة الصلاة والتلامس مع الواقع، مع الأخذ في الاعتبار أن الأجوبة هي نتاج كنيسة ومجامع وصلوات ودراسات. لذا فالآبائي ليس هو المتفقّه في نصوص وتواريخ الآباء، ولكنّه السائر على خُطاهم، المُحاكي سيرتهم، الواعي بدوره المعاصر، المنفتح على قضايا وإشكاليات مجتمعه. ومن التحديات التي تواجه مَنْ هم معنيون بالشأن الآبائي، سؤالٌ يفرض نفسه دائمًا: كيف نُحوِّل كلمات الآباء وتعبيراتهم وأفكارهم إلى لُغة حيّة معاصرة تجري على ألسنة عموم المسيحيين وبالأخص الشباب؟ كما يلوح في الأفق تساؤل أخر؛ كيف نستعيد لُغة التواصل مع الآباء في عصرٍ نحتاج فيه لتنمية وعينا بإعادة قراءة الماضي، وإن كان في التقليد ليس هناك ماضٍ وحاضر، بل إيمان حيّ ممتد فاعل في جسد المسيح؛ الكنيسة؟؟ لعلّ اهتمام بعض الشباب المنقوص بدور آباء الكنيسة قد يرجع إلى عدّة أمور منها؛ أنّ قيم الحداثة والليبراليّة الفكريّة قد طالت عقول البعض في فهمهم للكتاب المُقدَّس وبالتالي في فَهْم الإيمان المسيحي. وتحوَّل البعض إلى تقييم النصّ الكتابي بمقاييس النصّ الأدبي وتخلَّق ما يُسمّى بالنقد الكتابي، ودار الجميع في دائرة النصوص والحرف وتناسوا أنّ الإيمان معني بالروح، وأنّ الحرف في المسيحيّة هو ما دوّنته الكنيسة نتيجة ضرورات وتحديّات واجهتها لنقل خبر الإيمان كما هو. إنّ تلك القيم والأفكار المعاصرة تدفع الإنسان ليكون فكره هو مركز انطلاقه مُخضعًا كلّ شيء للشك حتّى يظهر عكس ذلك، وهو ما يفيد العالم ولكنّه يتيه الروح. من هنا تشكَّك الفكر الليبرالي في الآباء لا لشيء إلاّ لأنّهم قادمون بقناعات الماضي التي يتوجّس منها الفكر اللّيبرالي. ولقد تزامن عصر النهضة مع خروج حركات الإصلاح البروتستانتيّة أدّى إلى ما يمكن أن نطلق عليه “تحالف ضدّ الماضي” ولأنّ الكنيسة الكاثوليكيّة في العصور الوسطَى قد استخدمت بعض النصوص الآبائيّة في سياقات مختلفة لخدمة مصالح زمنيّة، تولّد شعور باطني برفض التقليد الآبائي جُملةً، وظهر هذا الشعور على السطح من تنامي دور حركات الإصلاح في المجتمعات الغربيّة بعد ذلك. إنّ من العوامل التي تخلِّق حراكًا آبائيًّا: الكرازة. فالكرازة تُحفِّز البحث في كنوز التراث الذاتي للكنيسة، وتلك الكنوز بدورها تُثري الكرازة وتعطيها فعاليّة طالما هي موجَّهة بالحكمة الإلهيّة العاملة في قلب الدارس والكارز معًا، وما أحوج العالم الآن إلى مَنْ ينتشله من تضارب الأفكار التي تتقاذفه في بحارٍ دونما ضياء. ومن الجدير بالذكر أنّ القديس إيريناؤس أُرسِل للكرازة في بلاد الغال (فرنسا حاليًا)، وقد تعلّم لغتهم حتّى يستطيع أن ينشر الإنجيل في تلك المناطق الوثنيّة آنذاك. إنّنا لم نأخذ الروح القدس لكي نعيش منكمشين بالجبن، بل لكي نتكلّم بجسارة القديس يوحنّا الذهبي الفم “يستحيل على المرء أن يبدأ في تعلُّم ما يعتقد أنّه على علمٍ به”، تلك هي كلمات إبكتيتوس، والتي يضع بها أهم وأوَّل الخطوات التي يجب أن نخطوها على طريق المعرفة، وهي أنّنا لا نعلم شيئًا بعد. لقد طلب البروفيسور جورج هنري من طلبة معهد برينستون اللاّهوتي أن يذهبوا للمكتبة ويقفوا أمام مجموعة “نصوص آباء ما قبل نيقيه / نيقيه وما بعد نيقيه”، فقط لكي يتّضعوا. إذ وجدوا أنفسهم أمام 38 مجلّدًا من الحجم الكبير من الكتابات المُتخصّصة لنفرٍ قليل من الآباء، ولا أعلم ماذا سيكون شعورهم إذا وقفوا أمام مجموعة مين Migne والمؤلّفة من 382 مجلَّد من النصوص اليونانيّة واللاّتينيّة؟! فلكي نفهم فكر الآباء يجب أن نُنحِّي جانبًا كبرياءنا الذاتي واعتماديتنا على خبراتنا الشخصيّة وفهمنا الأحادي للأمور. فالمسيحيّة كما عاشها الآباء في ملئها، ليست كما يحياها الكثيرون الآن. إنّ المسيحيّة عند الآباء كانت هي الوصول إلى حالة « إنسانٍ كاملٍ » (أف4: 13)، فهي لم تكن نمطًا سلوكيًّا مستقلاًّ عن دعوة عليا وغاية إسخاطولوجيّة تجتذبهم على الدوام. فالاكتمال في الثالوث كان قوّة الجذب العليا لكيانهم الذاتي (الشخصي) والجمعي (الكنسي) على حدٍّ سواء. لذا رأى القديس غريغوريوس النيسي أنّ المسيحيّة هي العودة بالإنسان التائه إلى الفردوس المفقود من خلال تلك الإمكانيّة الهائلة التي تركها الله في دواخلنا؛ وهي الصورة الإلهيّة. إنّ نمو النزعة الماديّة المعاصرة كان له دور كبير في الانصراف عن الآباء الذين كانوا رمزًا للتجرُّد الإنجيلي في أبهَى صوره. ففي العصور الأولى كان الجميع منشغلاً بالإيمان لا بلقمة العيش. وللقديس غريغوريوس النيسي فقرة مشهورة في مقاله عن “لاهوت الابن” يُوضّح فيها مدَى شغف رجل الشارع العادي، في عصره، بمعرفة نتائج السجال اللاّهوتي السائد آنذاك؛ فالخبّاز بدل من أن يطلب منك المال، يتساءل عن طبيعة المولود وغير المولود، وهل الابن مساوٍ للآب، أو أدنى منه، في حين أن ما تحاول أن تعرفه منه، هو فقط ثمن الخبز!! ويرى بونيفاس رمزي Boniface Ramsey في كتابه “البداية لقراءة الآباء” أنّ ذلك كان بسبب “الشغف بالحوارات الفكريّة والتي كانت جزءًا من النسيج الثقافي لمجتمعات البحر المتوسِّط آنذاك، ولكن أولاً وقبل كلّ شيء، كان ذلك نتيجة انشغالهم العميق بالخلاص”. ويضيف: “إنّ كلمات مثل الهوموؤسيوس (المساواة في الجوهر) والفيسيس (الطبيعة) والهيبوستاسيس (الأقنوم) لم تكن كلمات تقنيّة في القرن الرابع فقد كانت بمثابة العُملة اللُّغويّة السائدة آنذاك، ولكنّها وصلت إلينا اليوم في إطار تقني يحتاج للكثير من الشرح والتفصيل”. إنّ هناك علاقة طرديّة دائمًا بين الأدب والحياة؛ فكلّما كانت الحياة عميقة جادّة مُهدّفة مُتحرِّكة كان الأدب المُعبِّر عنها جادًّا عميقًا قوي التأثير، وكلما هزلت الحياة وتسطّحت تسطّح معها الأدب وهزُل وانحطّ. لذا فإنّ كتابات الآباء كانت تعبيرًا عن حياة ديناميكيّة فاعلة في مجتمعات ديناميكيّة متفاعلة، فكانت كلماتهم تحمل بحارًا من المعاني لا تُستنفذ لأنّها مأخوذة من كلمات وحياة المسيح بلامحدوديّتها. ولا سبيل لفهم كلمات الآباء دون العودة إلى الفطريّة الإيمانيّة والروحيّة قبل دخول تيار الأهواء، والمآرب الفرديّة الشخصيّة الضيّقة. ولعلّ ظهور تيار أدبي في عصرٍ ما يقترن بردّة فعل داخلية تُترجَم كلمات وعبارات وصياغات. كانت ردّة فعل الآباء هي نتاج معاينتهم للثالوث وتلامسهم اليومي مع حركة الروح الذي يُفجِّر في دواخلهم جدّة الحياة. لذا لم تكن كتابات الآباء هي أطروحات فكريّة مُجرّدة لتزجية الفراغ، ولكنّها كانت رسالة يدفع بها الروح عبر أفواههم وأقلامهم إلى كلّ العالم. إنّ الأدبيات المعاصرة هي أدبيات قصيرة تذهب مباشرة للحدث المراد إيصاله للقارئ دونما استرسال في الشرح. وهذا الاسترسال هو أحد السمات الأدبيّة لنصوص الآباء في معظمها، كما أظهرت بعض الدراسات التي طرحت تساؤلات على الشباب عن سبب انصرافهم عن الآباء؛ فكان الاسترسال في الشرح أحد العوامل. ولعلّ الاسترسال الذي يلحظه القارئ المعاصر لكتابات الآباء ناتج عن كون معظم تلك النصوص هي نتاج عظات ألقوها من على المنابر، ثم نقلوها مدوَّنة كما هي دونما تعديل. كما أنّ الآباء، كما يقول جون س. هيدلي John C. Hedley: “لم يكتبوا مختصرات، فلقد بحثوا في النصوص الكتابيّة، وقارنوا بين الشهادات المختلفة، واختبروا التقليد، وواجهوا التعاليم الخاطئة”. على صعيدٍ آخر؛ إنّ عامل اللُّغة يمثِّل عائقًا لمَنْ يريد أن ينمّي معارفه الآبائيّة. فحينما كتب الآباء استخدموا اللُّغة اليونانيّة (الآباء الشرقيين) تلك التي كانت أنسب وعاء للتعليم المسيحي، فهي تتفرّد بكونها تحمل اتّزانًا مدهشًا بين الفعل والفكر في مفرداتها وتعبيراتها. إنّ اللُّغات المختلفة وإن كانت تعطي معنىً دقيقًا، إلاّ أنها تفتقر إلى حِسّ الكلمة ووقعها على الآذان وترجمتها إلى معانٍ جزئيّة. من أمثلة ذلك: كلمة لوجوس Λογος المحوريّة في تعليم الكتاب المُقدَّس ومن ثمّ الآباء، عن المسيح، والتي تُتَرجَم في العربيّة إلى “كلمة”، وفي الإنجليزيّة إلى “Word”. إنّ تلك الكلمة لها مخزون في الثقافة اليونانيّة القديمة يبزغ حينما يلفظها المرء، بينما تبقَى كلمة ذات وقعٍ نمطي على الذهن العربي أو الغربي المعاصريْن، وذلك لتوقُّف ذلك الامتداد الثقافي والمعرفي لمدلولات الكلمة قبل المسيحيّة. إنّ اللّهجة اليونانيّة التي كتب بها الآباء هي لهجة الكيني Koine وهي الحلقة الرابعة من حلقات تطوُّر اللُّغة اليونانيّة، إذ أنّ هناك ست حلقات في تطوُّر اللُّغة اليونانيّة وهي؛ اليونانيّة الأوليّة Proto-Greek، الميسينيّة Mycenaean (1600-1100 ق م)، اليونانيّة القديمة Ancient Greek (800-330 ق م)، الكيني Koine (330 ق م - 330 م)، يوناني العصور الوسطى Medieval Greek (330-1453م)، اليوناني الحديث Modern Greek (1453م - وحتّى الآن). ولهجة الكيني هي بحسب معنَى الكلمة؛ اللّهجة العامّة، ومن مسمياتها أيضًا: اللّهجة السكندريّة، الآبائيّة، الهلّلينيّة، المقدونيّة، أو لهجة العهد الجديد. إنّها بمثابة اللّسان العالمي الذي كان يتقنه العالم القديم. ومن الجدير بالذكر أنّها نشأت أول ما نشأت في أروقة جيوش الإسكندر الأكبر، وتحت قيادة مقدونيوس والذي استعمر العالم المعروف آنذاك، ممّا خلّق احتياجًا للّغة عامة لكلّ رعايا الإسكندر في كلّ مكان. لهجة الكيني مُشتقّة من الأتيكيّة attic (نسبة إلى منطقة أتيكا الجنوبيّة في اليونان والتي كانت تضم أثينا) ومُطعَّمة ببعض العناصر من اللّهجة الأيونيّة ionic (نسبة إلى الأيونيين وهم الأربع قبائل الرئيسيّة التي خرج منها اليونان) حسبما أعلن عالم اللُّغويات اليوناني الشهير هاتزيداكس G.N. Hatzidakis. أخيرًا، يمكن أن نُجمِل الأسباب التي دعت قطاعًا كبيرًا من الشباب المعاصر لينصرف عن الآباء في النقاط التالية:
|
||||

|
|
|
رقم المشاركة : ( 45 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
بطرس يتحرر 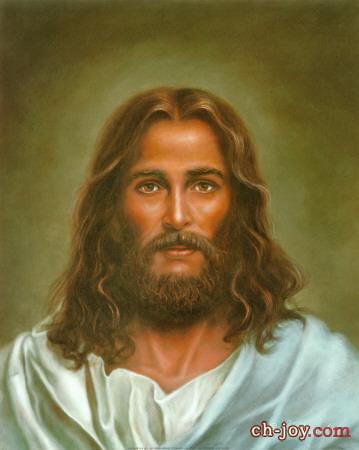 ”لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا“ (أع 4: 20) تلك كانت كلمات القديس بطرس في حديثه لرؤساء اليهود، بعد ليلةٍ قضاها في السجن، ولعلّنا للوهلة الأولى نندهش أن تلك هي كلمات ذاك التلميذ الذي أنكر معرفته بيسوع أمام جارية، منذ عدّة أيام خلت!! ولكننا نعلم أن شيئاً ما قد حدث داخل بطرس لأنّ تلك المجاهرة الجريئة التي قد تكلّفه حياته -حياته التي لم تعد لها قيمة في مقابل الشهادة التي ينبغي أن يؤدّيها عن قيامة الربّ- كان قد سبقها كلمات نارية استطاعت أن تحرّك نحو خمسة آلاف رجل تجاه النور الحقيقي، هنا ونتساءل عن سرّ هذا التحوّل من موقف ردّ الفعل الخائف، إلى موقف الفعل الجريء الذي لا يعبأ بالنتائج، ولا يرى سوى صورة المصلوب / القائم. والإجابة تتلخّص في كلمتين: “الروح القدس”، والذي كان بمثابة النار التي كانت تحتاجها الكنيسة المتحيّرة التي توارت في عُلِّية، في صلاة عميقة من أجل نوال تلك القوّة، لأنّ العمل الموُكل للكنيسة (ومنها بطرس) ليس هيناً؛ إنّه الشهادة للمسيح أمام قاتليه!! لقد كان عمل الروح القدس في بطرس أولاً هو تحريره من الخوف الذي ظلّ ينهش في قلبه في صراعٍ لا يهدأ، صراع بين الحريّة والتقوقع، الأولى لها رصيد يتمثل في معايشته اليوميّة للمخلّص، والثانية هي من تبعات السقوط الآدمي الذي أورثنا الخوف كنتيجة مباشرة للخطيئة التي سكنت بشريّتنا.. ولكن الروح الذي هبَّ على الكنيسة في يوم الخمسين كان يُرجِّح كفّة ما رآه وما سمعه بطرس قرابة الثلاث سنوات وبضعة أشهر، هي تلك الفترة التي قضاها مع المُخلّص، الفترة التي مرّت سريعاً كحلمٍ جميلٍ مُرْسَل من الأبديّة إلى قلبه.. وكان الروح يُذكِّره -كقول المُخلّص- بما رآه وما سمعه.. ما رآه من مجد الربّ الملتمع على جبل طابور ما رآه من معجزاتٍ باهرةٍ مفتتة منطق العقل الإنساني المجرّد ما رآه من سيادة الابن على الطبيعة وعلى البشر وعلى الأرواح الشريرة ما رآه في يسوع من حريّة الروح الطليقة التي كانت تنزعج من شكليّات العبادة الحرفيّة، والطقوس المُفرَّغة من معناها والتي كانت تهدف، بالأساس، إلى إعادة الصّلة بين يهوه وشعبه ما رآه من غفرانٍ مذهلٍ لمَنْ مزّقوا جسده بأيديهم وقلوبهم المتحجّرة.. ما سمعه عن التحرُّر المذخر لبني آدم إن قبلوا رسالة الابن ما سمعه عن وهج ملكوتٍ لن يخبو ولن ينطفئ ضيائه، لأنّه سُكْنَى الحمل مع جمهور المفديّين ما رآه عن المحبّة التي تُعطي حتى الميل الثاني، غير متفكرة في جزاء الميل الأول ومغانمه ما سمعه عن تعاليم تحترم إنسانيّة الإنسان مهما كان وضعه الاجتماعي والمادّي والثقافي ما رآه من رقّة في التعامل مع المرأة التي همّشها المجتمع وشيّئها إلى أن أصبحت خزيًّا ما رآه من اختراق عينا يسوع جوهر وقلب البشر والكون، باحثًا عن فتيلة مدخّنة وإن كان الظاهر صخورًا جرانيتيّة ما سمعه عن قوّة عبادة ترفع إلى الآب بالروح والحقّ ما رآه من بذلٍ منسكبٍ بشهادة الدماء والجروح لأنّه أحبّ حتى المنتهى هذا كان ما رآه وما سمعه بطرس ولكن ما رآه وسمعه بطرس لم يكن محفوراً في قلبه، لذا عند هبوب أوّل زوبعة لم يجد ولو صدىً خافتًا لكلمات المخلّص في قلبه!! لم يرى ولو صورة باهتة لحياة المسيح في كيانه!! لقد تلاشَى كل شيء، ولم يتبقّى سوى الخوف والرعب والتفكير في عواقب القبض على يسوع. فالروح القدس لم يسكن بعد في ذلك القلب المرتعش بحبّ الحياة التي في الجسد!! ولكن نحن الآن بعد حوالي شهريْن من موت الربّ يسوع وقيامته، نرى شخصاً آخر نرى معادلة إنسانيّة جديدة تولّدت من رحم يوم الخمسين، وهي: بطرس (الإنسان في ملء ضعفه) + سكنى الروح = الشهادة بقوّة عظيمة وهذه المعادلة هي عينها البشارة المفرحة التي جاء بها الربّ يسوع إلينا، إنها رسالة لمن فقد الرجاء في إمكانية تغييره، رسالة لمن انحصر في دائرة خوفه من الجسد والعالم والشرّير، رسالة لمَنْ سَقَطَ في هوّة اليأس المظلمة حينما اصطدم برغبات اللّحم والدم القاتلة، رسالة لمن صرخ قائلاً: “لا أستطيع.. مفيش فايده”!! لقد رأى بطرس رسالة الربّ يسوع المرسلة من السماء، في الروح القدس، تعمل في داخله، رأى في ذاته أذيال الخوف تفرُّ من أمام نور الحقّ الذي جاء ليسكن من جديد، رأى في داخله قوّة لم يكن يعيها في بادئ الأمر، ولكنه كان يشعر بتحرُّره.. يشعر أن قيود فمه سقطت مثل القشور التي سقطت من عيني بولس. لقد شعر بكلمات جديدة تخرج من بين شفتيه، كلمات فيها ملء الحقّ والحريّة، تشهد للإله الذي اتّخذ جسداً فلم يدركه أحد، حتى جاء الروح وأنعش ذاكرة المؤمنين في يوم الخمسين ليُعْلِن فيهم وبهم أنّ هذا هو بالحقيقة مُخلّص العالم. بدأ هنا في تلك العليّة الضيّقة فصلٌ جديدٌ من حياة بطرس، فصلُ الشهادة للربّ بالروح بكلّ مجاهرة. كانت الليلة التي قضاها بطرس في السجن قبل نطقه بتلك الكلمات، بمثابة إعادة شحن لحريّته التي لن تُقيّدها أغلال ولن توقفها قضبان، فقد دخل بطرس السجن وهو يضع في حسبانه أنّه سوف يلاقي نفس مصير المُخلّص، لأنهم إن كانوا فعلوا ذلك بالعود الرطب، فكم وكم باليابس؟ إن كانوا تجرأوا على قتل المسيّا المنتظر، فما الذي ينتظره تلاميذه إلا أن يلاقوا نفس المصير.. لقد” أقبل عليهما الكهنة وقائد جند الهيكل والصدوقيون متضجّرين من تعليمهما الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات. فألقوا عليهما الأيادي ووضعوهما في حبسٍ” (أع 4: 1-3)، تماماً كما فعلوا مع يسوع؛” فأخذ يهوذا الجند وخدامًا من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاء إلى هناك بمشاعلَ ومصابيحَ وسلاحٍ” (يو 18: 3) . لقد كتب بطرس في الأصحاح الخامس من رسالته الأولى قائلاً: ”مُلقين كلّ همّكم عليه لأنه هو يعتني بكم“، تلك الكلمات التي تُلْقي بكلّ الحِمْلِ على المُخلّص لتنتظر منه المعونة، كانت ولاشك إحدى فوائد السجن، ففي السجن تتصارع الأفكار ويتسلّل إبليس إلى العقل ليلقي بشكوكه، فما الذي يستطيعه الإنسان وسط إعصار الظلمة إلاّ أن يرفع عيناه إلى العلاء ويلتمس المعونة. لا يستطيع سوى الصلاة بصراخ الغرقَى، والرجاء بفجرٍ قريبٍ يشرق بنور الابن من وسط ظلمة الأفكار والشكوك.. الآن، في هزيع النفس الرابع، يشرق المخلّص بالروح في القلب ليداعب النفس الباكية ويكفكف دموعها المنهمرة، وليرفع رأسها إلى”المجد الأبدي الذي في المسيح يسوع” (بط 5: 10)، لينسيها محاصرة إبليس لها، ويرسل الروح إلى القلب ليعمل على فتح بصيرتها على حقيقة الأشياء التي زيّفها إبليس، ألا وهي حقيقة قصر ضيق الزمان الحاضر، وحقيقة براح الحياة الأبديّة الدائمة غير المنقضية.. لقد وضع بطرس هذا نصب عينيه، واستجمع قواه وتحفّز بالروح ليموت من أجل شهادة حقٍّ، فمن يضع الموت نصب عينيه، ويتجاهله، ما الذي سيخيفه فيما بعد؟!! لقد رأى بطرس بالروح أن الشيطان يعمل في اليهوديّة ليُبْكِم الأفواه الشاهدة للربّ، ولكن رؤيّته لمكائد إبليس ومؤامراته، لم تخيفه ولم ترهبه كالمرّة الأولى، فهو الذي كتب عن إبليس في رسالته الأولى (5: 8) إنه كـ”أسدٍ زائرٍ يجول ملتمساً من يبتلعه”.. الآن بطرس مستعد أن يسير مع المُخلّص على درب الجلجثة.. الآن بطرس حرٌّ بالابن، كما أعلن لهم المُخلّص ذات مرّة ”فإن حرّركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرارًا“ |
||||

|
|
|
رقم المشاركة : ( 46 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
جوهر الصوم 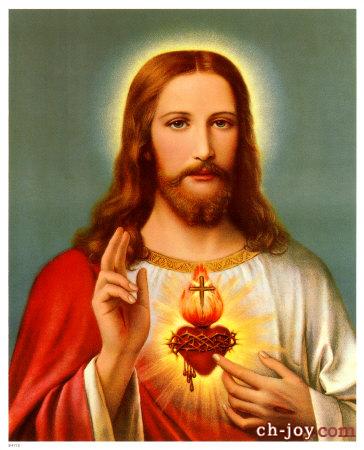 ما ألذُّ وأطيب خبز الصوم لأنه معتوق من خمير الشهوات القديس نيلُس كلمة صوم هي كلمة عبرية الأصل؛ צום (تس وم)، والصوم في معناه اللُّغوي هو الانقطاع عن الطعام، إلاّ أن المعنى الروحي للصوم يترجّى الحواس والقلب والذهن، هو صوم الكيان الإنساني بجملته بحثًا عن الله بعيدًا عن مجاذبات المادة التي تحيط بنا حتى في صميم أجسادنا الترابيّة. وقد يعتقد البعض أن الصوم ينحصر في التوقف عن الطعام أو في تغيير نوع الطعام!! إلا أنه، في جوهره، يبدأ بتوقف حركة الطعام، ليتهيّأ الجسد للدخول في عباءة الروح السابحة نحو الله؛ فالروح لا تنطلق بمعيّة الجسد الممتلِئ والمنغمس في طلب غذاءه، ولكنها تنطلق حينما يُخضِع الروح، الجسد، في رحلة الأبدية. ولقد صام المسيح على الجبل قبل البدء في خدمة الخلاص والفداء العلنيّة، وهذا لكيما يرشدنا إلى نقطة البداءة في أي عمل يتطلّع للأبدية ويسعَى للملكوت، فالمسيح لم يكن في حاجة جسديّة للصوم، وذلك لنقاوة روحه الإلهيّة التي لم تنفصل عن الجوهر الإلهي، وبالتالي لم تتدنّس بالميل للتراب والتلوث بالشهوة.. ولكن كان صوم المسيح، بجانب حمله للبشريّة في جسده الصائم، كما تحدث الكثير من الآباء، هو بمثابة درس تعليمي لمن يريد أن يخطو أولى الخطوات بالروح، ولمن يريد أن يضع يده على المحراث في تلك الرحلة التي تمتد بمدى الحياة في الجسد. ولقد أدركت الكنيسة ذلك الدرس الأولي والبدائي، في الحياة بالروح، وقنّنت الصوم وجعلته موسميًّا، لكي تستحث المسيحيّين لتذوق دسم الصوم بعيدًا عن دسم الغذاء، وأيضًا لكي تحيي حياة الشركة بين أعضاء الكنيسة، حينما يقولون بفمٍ واحد “لا للمادة” و“نعم للروح”، هنا تصبح الشركة في الكنيسة ليست مفهومًا نظريًّا ولكن واقعًا يظهر في التوقُّف الجماعي عن الطعام، واستبداله بالصلاة، غذاء الروح. إنَّ الصوم هو صرخة يطلقها الجسد المتألّم بالخطيئة، حتى تتدخّل الروح، برفع أيديها العقليّة إلى السماء، لينزل سكيب الطهارة والنقاوة ليغمر الجسد والروح معًا.. فالإنسان ليس كيانًا مجزَّئًا، يمكنه أن يتطهّر في الروح بينما يبقَى الجسد متدنسًا خاطئًا مائتًا!! كما لا يمكن للجسد أن يتطهّر بمعزل عن الروح، فالإنسان كيانًا متكاملاً يسعَى بجملته للأبديّة، بالجسد وبالروح. والصوم يمنحنا القدرة على التفطُّن والتيقُّظ لتلك الحرب التي تدور أحداثها على أرض قلوبنا الداخليّة، ذلك الصراع القائم بين روح الله وروح العالم، بين صورة الله وصورة إبليس، بين منطق الزمن ومنطق الأبديّة. هنا ويبقَى الصوم هو الوقت المثالي الذي نستطيع فيه أن نرتحل داخل ذواتنا حاملين مصباح الروح بحثًا عن الزوان الذي بذره الشيطان على أرضيّة قلوبنا ونحن سكارى بالطعام والشراب واللّذة.. ندخل حاملين كلمة الله، لكيما تُنَقِّي ذلك الحقل الداخلي، ونحن في صلاة، تترجّى التطهُّر من رائحة الدنس، التي تفوح من جذور الخطيئة المتعفّنة في تربة قلوبنا. وحينما نصوم فإننا نُفقِد نبتة الشر والخطيئة، الضاربة قلوبنا، قوَّتها، فيسهل على الروح انتزاعها من جذورها، باذرًا عوضًا عنها، بذار السلام السمائي الذي هو عربون ملكوت السموات. الصوم هو رياضة روحيّة لترويض الغرائز قبل أن يكون عمل جسدي يستهدف البطن!! فهو بمثابة السكين الباتر لأجنحة الغرائز والتي تريد أن تتحكّم في مسيرة الإنسان وتصيّره عبدًا لمتطلباتها؛ فالجسد يريد أن يأكل ويشرب ويمرح دون حدود وضوابط، يتعدّى احتياجه الطبيعي في محاولة مستمرّة لاستدامة اللّذة بإعطائها ما تنشده على الدوام.. وهذا يؤول في النهاية إلى ضمور في قوى الإنسان الروحيّة التي تنمو فقط من خلال ضبط الجسد وتقنين حاجته حسب الطبيعة وليس حسب اللّذة. في النهاية يجب أن تدرك أنّ الصوم ليس عملاً بطوليًّا، بل هو نعمة إلهيّة، نقرع باب مراحم الله حتى نتأهّل لها، من أجل كسب جولة هامة وأساسيّة في معاركنا الروحيّة؛ ألا وهي ضبط الجسد كمدخل لضبط الذهن والقلب. ولكن الصوم إن تحوّل إلى جهد ذاتي صرف، فإنه يقود الشخص للكبرياء والشعور بالتفوّق والتميُّز عن الآخرين، وهو شعور يبتعد بالإنسان بعيدًا عن مساكن الروح، ويجعله يحيا خدعة العبادة من خلال الصوم، وهو في واقع الأمر يتعبّد لذاته. لذا فإنّ الصوم والصلاة يجب ألا يفترقا؛ فالصوم مدخل لضبط الحواس والقلب والذهن، والصلاة مدخل لرفع الصوم كذبيحة مقبولة أمام الله، لأنها نابتة من بين وديان التواضع والوادعة والشعور بالاحتياج والمعونة.. دنس قلوبنا، فلنطهره بالمحبة بواسطة الصلاة والصوم والأعمال اللائقة عن إبصالية واطس (للأربعين المقدسة) |
||||

|
|
|
رقم المشاركة : ( 47 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
أزمنة صعبة 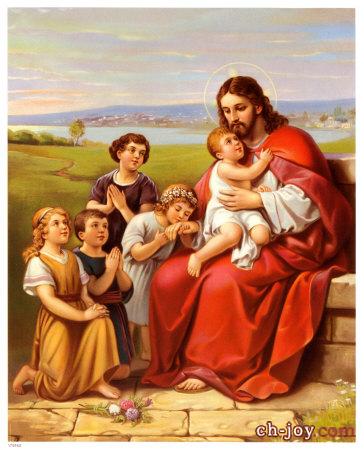 حينما راسل القديس بولس تلميذه تيموثاوس أنبئه بقدوم أزمنة صعبة difficult times مشحونة بالعنف والغضب؛ لم تكن الصعوبة التي يتحدث عنها القديس بولس ضيقة ينفث فيها العالم لملاحقة الكنيسة ولم تكن اضطهادًا يلاحق الإيمان المسيحي محاولاً زعزعته وتجريف أساساته المتأصلّة في المسيح. كانت الأزمنة الصعبة هي أزمنة تحوّل الإنسانيّة نحو صورة العالم مستلهمين أنموذج الموت المليء بالقساوة والكبر والتجديف والعصيان والشراسة والجشع وانعدام النزاهة.. إلخ. أزمة ذاك الزمان تكمن في أزمة الإنسان التي تجعله يعانق فساده من جديد. إنها أزمة تحجُّر في قالب الموت ورفض صبّ مياه الحياة. “وَلَكِنِ اعْلَمْ هَذَا انَّهُ فِي الأَيَّامِ الأَخِيرَةِ سَتَأْتِي أزْمِنَةٌ صَعْبَةٌ. لأَنَّ النَّاسَ يَكُونُونَ مُحِبِّينَ لأَنْفُسِهِمْ، مُحِبِّينَ لِلْمَالِ، مُتَعَظِّمِينَ، مُسْتَكْبِرِينَ، مُجَدِّفِينَ، غَيْرَ طَائِعِينَ لِوَالِدِيهِمْ، غَيْرَ شَاكِرِينَ، دَنِسِينَ. بِلاَ حُنُوٍّ، بِلاَ رِضىً، ثَالِبِينَ، عَدِيمِي النَّزَاهَةِ، شَرِسِينَ، غَيْرَ مُحِبِّينَ لِلصَّلاَحِ. خَائِنِينَ، مُقْتَحِمِينَ، مُتَصَلِّفِينَ، مُحِبِّينَ لِلَّذَّاتِ دُونَ مَحَبَّةٍ لِلَّهِ. لَهُمْ صُورَةُ التَّقْوَى وَلَكِنَّهُمْ مُنْكِرُونَ قُوَّتَهَا” (2تيمو3: 1-5). الأزمنة الصعبة حاضرة طالما أنّ الإنسان خاضع لاستهلاكيّة اللّذة ومؤلِّهًا ذاته فوق كلّ سيادة؛” مُحِبِّينَ لِلَّذَّاتِ دُونَ مَحَبَّةٍ لِلَّه” love pleasure rather than God. أليس العصيان الأوّل كان شهوّة ارتفاع ذاتي بمعزل عن الله؟؟ فالعصيان كان السلوك الظاهر بينما الذاتيّة كانت المرض الدفين. عالم اليوم يحيا في بؤرة الزمان الصعب، إذ يستبدل كلّ ما هو إلهي بما هو إنساني، يعيد تشكيل دائرة الوجود ليضع ذاته في المركز كفاعل أوحد بل وكخالقٍ للعلم ومن ثمّ للعالم إن جاز التعبير!! حتى في دائرة تديّنه يضع ذاته فوق الحقّ الإلهي كمالك أوحد للحقّ وكأنّه صار مُلمًّا بالحقّ كما الله!!! إنها إحدى أشكال أزمة تأليه الذات.. هنا وينقسم العالم إلى دائرتين: الأولى ترى أنّها تماثل الخالق في قدرتها على الابتكار والاكتشاف، وهي تنتج أخلاقيات استعلائيّة كالكبرياء والتجديف؛ ألم يقل أحدهم حينما شفى إحدى مريضاته من مرضٍ عضال بجراحة ناجحة أنه بمثابة إله يميت ويحيي؟!!! وقال آخر حينما بدأ عصر التلقيح الصناعي المعدّل جينيًّا أنّه يملك خيوط الحياة والبشر!!! الدائرة الأخرى هي دائرة الاستهلاك التي تقوم على إلحاح إعلامي لربط الرفاهيّة في الحياة بما يُقدّم من إنتاج، فيسير الإنسان وراء كلّ ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والموضة والمأكل والمشرب والكماليات.. ليظل أبدًا أسير قانون المصانع والاستهلاك. تلك الدائرة مستهلكة لنتاج الدائرة الأولى وهي تدور في دائرة مفرغة من الاحتياجات المُخلَّقة يوميًّا ومن ثمّ تنتج أخلاقيّات استهلاكيّة كالجشع والقساوة وانعدام النزاهة.. إلخ. اتحاد الدائرتين ينتج الزمان الصعب، لأنّه ينتج بالضرورة إنسانًا مشوّهًا يحيا متغرّبًا عن ذاته، تائهًا في فضاء الاحتياج الدائم، لا يشعر بالشبع أو الرضَى أو السكينة إذ لم يهدأ ليكتشف قبس الضياء في تلابيب القلب ومعاريجه الدفينة. لا نتعجّب إذًا إن أعلن العالم عن ذاته من خلال أبنائه الذين يعتنقون عقيدة: “الزمان الحاضر وكفى”!! إيمانهم أنّ “اللّذة هي الإله المتوّج”، يتتبعونها أينما كانت!!! قالها المسيح من قبل: هل يجتنون من الشوك عنبًا؟؟ فمن ذا الذي يطمح في ثمار تنبت من صخرٍ صلد وأرضٍ جافّة وبذار متعفّنة؟؟ لا نلومن عالمًا لم يتجدّد بعد، ولكن ما يجب أن يستوقفنا هو مسيحي تجدّدت طبيعته في معموديّة قابلاً المسيح المائت / الحي، المصلوب / القائم، الإنسان / الإله، ولا يزال ينتج شوكًا؟!! إذ كيف تثمر كرمة إلهيّة شوكًا جافًّا؟؟؟ سلوك المسيحي مظهرًا لجوهر يحرِّك القيم النبيلة باستمرار في داخله. فمن القلب تتولّد الحياة أو يخبو نورها. ولادة الحياة تشكّل السلوك، وهو ما يسمَّى بالولادة الجديدة وما أطلق عليه الآباء تجديد الطبيعة أو خلع أوراق التين لارتداء المسيح. حينما يحاول المسيحي التشبُّث بوريقات التين ليخفي عواره، فإنّه يرجع أسيرًا لفساده ولسقطته. كلّ منّا له بعض وريقات التين التي يحاول أن يختبئ خلفها من أعين من حوله.. يحاول أن يقصي أعين الجموع عن قبحه.. يحاول أن يتجمّل بوريقات الشجر، ولكن أني لجمال لا يأتي من الداخل، هل من جمال يمكن أن ينبع سوى من نبع الجمال المطلق والمشرق من وراء غيمات الزمن الغارب في أفق نهايته. سلوكنا في العالم هو إعلان عن جمال إله تبعناه وأحببناه ولاقيناه عند مياه التجديد فمتنا فيه لنحيا به، مشرقين بضياء ينعكس من سكناه بالروح في قلوبنا. إن لم نعلن عن إلهنا في العالم نخفق في كوننا مسيحيين، بل ويتردّد صدى كلمات التوبيخ الرسوليّة؛ إذ يُجدّف على الله بسبب مسلكنا!! أن نعلن ملكوت النور أو نعلن ملكوت الظلام ذلك هو ما يترتّب على سلوكنا بشكلٍ مباشر. لذا إنّ حديث القديس بولس عن الأزمنة الصعبة كانعكاس لتردّي السلوك هو في جوهره أنين يصدح في قلبه خوفًا من توقُّف الإعلان من خلال المسيحيين. القضيّة ليست في نتاج السلوك ولكن في نبع السلوك؛ فالعَرَض لا يقلق بقدر المرض المتجذِّر في بدن المسيحي غير الخاضع لنداءات الروح. الإشكاليّة ليست أن تخطئ في موقفٍ أو تنحدر في مسلك مشين ولكن أن تحيا في دائرة الخطيئة التي تغذي جسد الموت الصائر إلى العدم. فارق كبير بين خطيئة والخطيئة؛ الأولى انحراف وسقطة وضعف، بينما الأخيرة حالة ولُّباس. إنها كالفارق بين جواد يسقط في مستنقع وحلٍ وبين خنزيرٍ يحيا في مستنقع الوحل. لكي نتحرّر من زمان العالم الصعب علينا أن نتحرّر من التمركز الذاتي الناتج عن الاغتراب الذاتي، وكذلك علينا أن ننضج لننفلت من دائرة الاستهلاك. المسيح يمكنه آنذاك أن يصير لنا مركزًا يُعبّر عن وجودنا الأصيل فيما وراء الزمان وفاعل بقوّة في إطار الزمان. إنْ تمركز المسيح في حياتنا سلكنا بحسب حقّ الإنجيل وصرنا نورًا للعالم مشعًّا بجمالات الثالوث.. |
||||

|
|
|
رقم المشاركة : ( 48 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
العثور على بقايا مصلوب 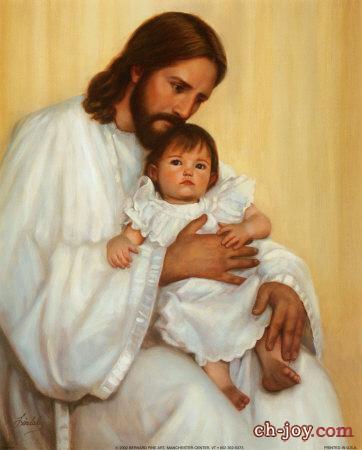 في صيف 1968 اكتشف الباحثون الأثريون الإسرائيليون أولى بقايا يمكن التعرّف عليها لمصلوب في الضواحي الشمالية لأورشليم. ولقد درس العلماء الإسرائيليون البقايا لمدّة تزيد عن العامين قبل الإعلان عنه. وُجدت عظام ذاك المصلوب المدعو يوحنان Jehohanan في قبرٍ يهوديّ داخل مغارة والتي احتوت على تابوت كتب عليه “سمعان، باني الهيكل”. من خلال الكتابة والفخاريات في المقبرة تم تحديد زمن المصلوب ما بين 7 ق. م. إلى 70 ق. م. وهو ما يلقي بالضوء على وجود تلك العقوبة في تلك المنطقة في ذلك العصر. وُجِدَ كذلك مسمار منثني كان يستخدم لتثبيت قدم المصلوب على الصليب مكونًا ما هو أشبه بالعقدة حينما كان يثبّت بمطرقة. بعد موت ذاك المصلوب، حينما حاولوا رفع جسده من فوق الصليب لم يمكنهم انتزاع المسمار. لذا قطعوا أرجله مع المسمار وقطعة الخشب ودفن كلّ هذا معه. |
||||

|
|
|
رقم المشاركة : ( 49 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
عشرة صعوبات نلاقيها في شرح الثالوث لمن هم خارج المسيحيّة 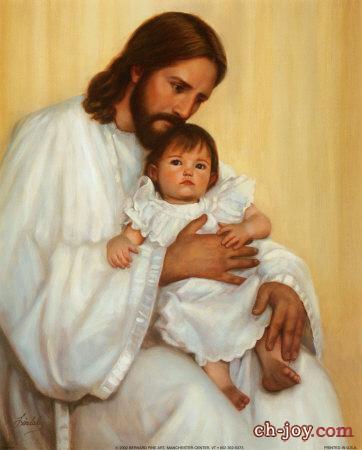 1- محاولة الآخر لتحويل الله إلى معادلة حسابية حالما نتحدث عن ثالوث ووحدانيّة وكأننا بالحديث عن تلك الحقائق نتحدّث عن أرقام مجرّدة يمكن وضعها في قالب المعادلة لنخرج بمنتج يعبِّر عن الله!!! وهنا علينا أن ندرك أن لُّغة الأرقام هي لُّغة تجريدّية بالأساس تعبِّر عن مكونات شموليّة. فمثلاً حينما نجمع 3 برتقالات و5 أصابع لا يكون المجموع 8 على الإطلاق. فالمعادلة الحسابية تخفق في الوصول إلى منتج من تلك المعطيات لأنّ التمييز مختلف ويكون الرقم 8 هنا هو رقم تجريدي وليس موضوعي. 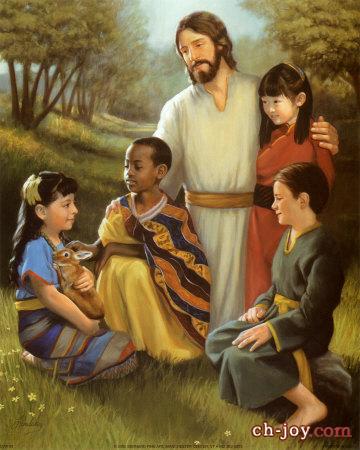 2- التداخل بين مفهوم التناقض الذاتي وبين مفهوم التجاوزيّة؛ فالتناقض الذاتي يعني أن تكون هناك حقيقتان مختلفتان تعبران عن حقيقة كبرى متناغمة، أي أن نقول أن لون قطعة من القماش أبيض وأسود في ذات الوقت، وهو ما يستحيل حدوثه لأن نقيضين لا يشكلان حقيقة. بينما التجاوزية هي أن تكون هناك حقائق تتخطى حسابات العقل وإدراكاته المباشرة ومعادلاته التي كونها من مشاهداته التجريبية واستدلالاته المنطقية. فمثلاً حينما نقول أن ضوء الشمس دخل إلى الغرفة، فإن هذا لا يعني أنه لا يوجد ضوء للشمس خارج الغرفة، وهنا الحقيقة تتجاوز إدراكي المباشر ومشاهدتي المباشرة.  3- حصر الحقيقة في الكثير من الأحيان في إطار عقلي فقط دون الإيمان بوجود روح وحدس ووجدان وشمولية إنسانية تشكل آلية متكاملة لتقبل الحق. ولعلّ تلك الحالة هي من منتجات الحداثة والتي تريد أن يكون لها مكانًا فيما هو روحي. وهنا يحدث الالتباس بين دائرة العقل المعني بشؤون كلّ ما هو مادّي وما بين دائرة الإيمان المعنيّة بمن هو مطلق فائق. 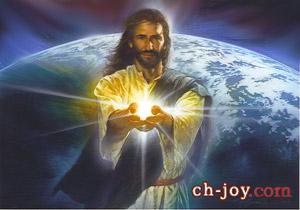 4- تكوين صورة استاتيكية عن الله وكأنه غير قابل لتمديد إعلانه عن ذاته للبشريّة وكأنه قد أتمّ طرح ذاته بالكليّة لنا ومن ثمّ نبدو وكأننا احتويناه وامتلكنا حقّ التعبير عنه حصرًّا!! أي أننا نجعل من ذواتنا مُلاّك للحقّ وبما أنّ الحقّ مطلق نسقط في فخ إسباغ صورة المطلق على ذواتنا!!!  5- الخلل في فهم النصّ الكتابي حينما نخرج به عن سياقه ممّا يؤدي إلى إنتاج صورة مغايرة للحقّ كما أعلنه المسيح. 6- الخلط ما بين تدرُّج الإعلان ووحدانيّة الإعلان. فأن يقدّم الله الحقّ للبشريّة بشكل متدرج لا يعني أن الإعلان قد تغيَّر؛ فالتدرج معني بالكشف في إطار الزمن، ولكن وحدانيّة الإعلان معنية بماهيّته، والزمن والماهيّة موضوعان مختلفان كليًّا ولا يتضادّان. 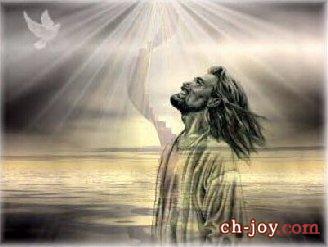 7- هناك فارق دائمًا بين القياسات وبين الحقائق الموضوعيّة؛ فالقياس دائمًا قاصر لأنه نسبي في التعبير عن الحقيقة ولكنه أقرب تعبير إنساني مستخلص من واقع الإنسان ومن محيطه الكوني للتعبير عن الحقيقة الموضوعيّة. فمثلاً حينما تشرح الثالوث مستدلاً بالشمس أو بالإنسان هذا لا يعني أن الثالوث متطابق مع المثل في كلّ تفاصيله ولكنه يبقى أقرب مثال لشرح حقيقة فائقة عن كلّ مثال إنساني مادّي. 8- سقوطنا الدائم في فخ الخلط بين التعبير النسبي والتعبير المطلق حينما يكون المفرد اللُّغوي واحد. كأن نطابق بين كلمة النور في سياقين مختلفين الأول يعبر عن المسيح كنور للعالم والثاني يعبّر عن المؤمنين كأنوار وسط العالم، فالأول تعبير يشير للمطلق بينما الأخير تعبير يشير للنسبي. 9- الانحصار فيما هو شائع من المعاني يجعل من الصعب تبني المعاني المتجاوزة للفظة الظاهرة والمعبرة عمّا هو ليس حسيًّا. فمثلاً الحديث عن بنوّة الابن للآب، يجعل البعض يرى في البنوة مرادف لعملية التناسل لأنها البنوة شائعة الاستخدام في هذا الإطار الحسّي والمباشر، بينما يبقى الاستخدام المجازي والمتجاوز لظاهر اللَّفظ كالحديث عن البنوّة المجازيّة كبنوة الوطن وبنوة الحق صعب، وبالتالي يكون الحديث عن البنوّة المتجاوزة لمدار المنطق الإنساني كحالة من العلاقة الفريدة التي تنطلق من الجوهر الإلهي الواحد والتي لا يوجد لها مثيل إنساني صعبٌ للغاية. 10- عدم شرح الثالوث في إطار خبرة روحيّة شاملة من الصلاة، فالإعلان الإلهي يبقى رهن عمل الروح مهما كانت فطنتنا في شرح ومنطقة إيماننا. تلك نقطة جوهرية وحجر زاوية علينا ألا نغفلها. |
||||

|
|
|
رقم المشاركة : ( 50 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
روح الترتيل بالمزامير 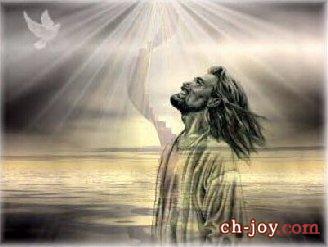 كاسيان يرصد لنا البُعد الداخلي وكذلك الهدف الروحي من المزامير والتأمُّل في النصوص المُقدّسة والتي كان ينخرط فيها الرهبان أثناء ممارستهم للعمل اليدوي. يصف لنا كاسيان في المناظرة العاشرة (المناظرة الثانية لأبّا إسحق) الصلاة التي يُردّدها الراهب مع ذاته بشكلٍ مستمر، ويشرح ذلك من خلال “حدود الآية الواحدة الضيقة” ولكن مع تأمُّل ممتلئ بالاشتياق من نحو الله، إذ يبدأ الذهن بطرد “غنَى وتعدُّد الأفكار”(2) ليصعد كالوعولِ كما في مزمور (103: 18) إلى “أسرارٍ مُقدّسة سامية”(2). وللوهلة الأولى يبدو هذا الرفض لغنَى تعدديّة الأفكار أثناء الصلاة لصالح “الفقر” (يقصد قلّة كلمات الصلاة) والتي هي عينها “الصلاة النقيّة” عند مار أوغريس، تلك التي تتخطّى الصور والأفكار. ومن تلك الصورة للصلاة ينطلق كاسيان ليصف “الأيِّل المُقدّس” الذي يصعد إلى “معرفة الله المتنامية من خلال الاستنارة الإلهيّة”.(3) إنّ الهدف من تلك الصلاة ليس التحرُّر من الكلمات والصور بقدر ما هي القدرة على تقبُّل «حكمة الله المتنوّعة» (انظر: أف3: 10)، لكي نستطيع أن نعي بشكلٍ أفضل ونقبل باطنيًّا الغنَى المتنوِّع في الصور والكلمات التي في كتاب المزامير: “.. حينما يقبل [المرء] في داخله كلّ الحالات الباطنيّة [التي وردت] في المزامير، سيبدأ في الترتيل، لا كأنّها تأليف أحد الأنبياء، ولكن ككلماته الشخصيّة والذاتيّة الخارجة من عمق أعماق القلب: وسيفسِّرها كما لو كانت موجّهه له شخصيًّا، واعيًا أنّ تلك الآيات لم تُستنفذ مسبقًا في حياة أحد الأنبياء، ولكن سيمتد المعنَى ليشمل تحقيقها وفعلها يوميًّا، فيه، بشكلٍ شخصي”(4). يتّضح من خلال هذا النصُّ أنّ ترتيل المزامير عند كاسيان لم يكن بمثابة تهيئة للصلاة التي كانت تُقدّم في الوقفات بين المزامير، بل إنّ المزامير نفسها ينبغي أن تُرتل كصلاةٍ شخصيّةٍ. ومن المُؤكّد أنّ ترتيل المزامير يقود إلى التوبة ونوال التقديس بشكلٍ مستمر ومُتجدِّد من قِبَل الله. تلك الحالة أطلق عليها آباء البريّة: نخس القلب (التخشُّع) κατανυξις((5). في رؤية كاسيان، نجد أنّ ترتيل المزامير ليس استدعاء من الماضي لأحداثٍ من حياة بني إسرائيل، ولكنه فرصة لنوال بصيرة الروح الثاقبة، تلك التي تتّجه نحو الكيان الداخلي من أجل وعي أعمق لمعنَى الجهاد النُسكي في الحياة الشخصيّة. لذا فإنّ ترتيل المزامير ليس هروبًا من العالم الواقعي إلى حالة أخرى من الوعي، كما أنه ليس فرصة للتأمُّل بتقوى في أحداثٍ آمنةٍ بعيدة عنّا كلّ البُعد في الزمن والثقافة. في المقابل، ينصح كاسيان أن يتقبّل الراهب في قلبه المشاعر القلبيّة الباطنيّة التي لكاتب المزامير، وأن يجعل من المزامير فعلهُ الشخصي، فيبدو وكأنّه الناظم الجديد للمزمور(6). ومن خلال تلك الأُلفة مع النصِّ، يتعلّم الراهب أن يرصُد المعنَى العميق للكلمات التي يتهيّأ لترتيلها، ويسمح لها بإنارة خبرته الشخصيّة الحيّة. كما يسترجعُ، أثناء الترتيل، جُملة جهاده اليومي وما لحقه من عثرات وسقطات. “.. نتذكّر ما حدث لنا طيلة اليوم حينما باغتتنا الأفكار، وإذ نُرتل [المزامير]، نسترجع ما نتج عن تهاوننا، وما ربحناه بالجهاد، وكذلك ما وهبته لنا العناية الإلهيّة، وأيضًا كلّ خديعة قد أثارها الشيطان ضدّنا، فضلاً عمّا فقدناه حينما انزلقنا وصِرنا فريسة للنسيان، وكذلك ما جلبه علينا الضعف البشري حينما خُدِعنا بلامبالاة الجهل”(7) حينما تُرتِّل المزامير فإنّ المرء يبدو وكأنّه يُحدِّق في “مرآة النفس” حيث صراعه الروحي والشخصي يظهر جليًّا على خلفيّة التاريخ الخلاصي وتحت ضوء الرحمة الإلهيّة. “إنّنا لنجد في المزامير كلّ تلك الحالات الداخليّة [للنفس]، لذا نرى، كما في مرآة نقيّة، ما يحدث [داخلنا] ونتفهّم تلك الأمور بفاعليّة أكبر، من هنا ندرك أنّ تعلُّمنا ليس من خلال السماع فقط، ولكن بالاختبار الفعلي، في أعماقنا الداخليّة [...]”(8). إنّ المزامير، عند كاسيان، هي مدرسةٌ متكاملةٌ يتعلّم فيها الراهب تكوين عَلاقة مع الله على خلفيّة ذكرياته الشخصيّة. ولعلّ ما نختبره “داخليًّا” حينما نُرتل هو بمثابة “مُعلِّمين”، يُظهِرون لنا أعماق وغاية مسيرتنا الروحيّة وما يصاحبها من نموٍ أو تعثُّر. إنّ خبرة الراهب تنكشف أمامه أثناء ترتيل المزامير، وحينما يُنصت للصوت الصادر عن داخله، مع ما يسمعه خارجيًّا ممّا يُرتِّل، يبدأ في الدخول إلى أعماقٍ جديدةٍ من الفهم لكلا الصوتيْن [الداخلي والخارجي]. لذا فإنّ ترتيل المزامير هو بمثابة نوعٌ من التداريب الروحيّة يتعلّم من خلالها، الراهب، فضيلة الإفراز؛ الأفكار الشخصيّة والذكريات والآمال والطموحات، تُختبر وتُفسّر على ضوء كلمة الله أثناء الترتيل. إنّ هذا الاتجاه، يُلقي بالضوء على الصور والقصص التي تبرز أثناء الترتيل، لتُفسَّر كرموزٍ تشرح المسيرة النُسكيّة للراهب. إنّ تلك الطريقة للفهم الشخصي [الذي يُستعلَن أثناء الترتيل] كانت إحدى أدوات تعليم مار أوغريس الذي يمكن قراءة أعماله التفسيريّة وكأنّها “قواميس” روحيّة أو كتب تطبيقيّة تهدف إلى مساعدة الراهب في ممارساته التعبُّديّة الخاصّة. إنّ شرح كاسيان لترتيل المزامير والصلاة الشخصيّة، بلغ أوجه حينما وصَّف النفس المُتخطيّة الكلمات والصور، أثناء الصلاة، إذ قد أشار إليها بأنّها “صلاة ناريّة”. إنّها حالة لا يمكن بلوغها من خلال تقنيات معيّنة في الصلاة، ولا حتى من خلال ممارسة الصلاة بشكلٍ شخصي والذي يُرجِّحه كاسيان في مناظرته العاشرة. إنّها، في المقابل، نعمة إلهيّة مُجرّدة، تأتي دونما توقُّع مسبق، على فتراتٍ، وخاصّةً (ولكن ليس على سبيل الحصر) أثناء ترتيل المزامير. “.. قد يحدث أحيانًا أن تتسبَّب آية من المزامير في تأجيج صلواتنا أثناء الترتيل، وأحيانًا تُساهِمُ طرق التعبير الموسيقيّة بواسطة الأخوة، في النهوض بالذهن المُظلِم إلى التضرُّع بفاعليّة وتركيز. (2) ونحن نعلم أنّ استقامة النطق وحرارة المُرتِّل يمكنها أن تُشعِل حماسة مَنْ يُنصتون”(9). إنّ “الصلاة النقيّة” الخالية من التصوُّر التي يشيد بها مار أوغريس لها مثيل في كتابات كاسيان، إذ يسمّيها “الصلاة الناريّة” التي ترفع المُصلِّي “فوق الاحتياج للكلمات أو الأصوات”. “وهكذا فإنّ ذهننا سوف يحصل على الصلاة النقيّة [...] والتي لا تنضوي على التخلُّص من المشاهدة الداخليّة للصور فقط، ولكنّها بالأحرى تتميَّز بإسقاط الاحتياج للصوت أو الكلمة: إذ أنّ تركيز الذهن يشتعل عبر الحمية غير الموصوفة للروح والتي تتدفّق من الذهن المُتّجهُ نحو الله، وهي تكون مصحوبة بأنّات وتنهُّدات لا يمكن التعبير عنها، وهذا كلّه يحدث فوق الحسِّ أو التأثيرات الماديّة”(10). وبالرغم من أنّ “الصلاة الناريّة” تشغل مكانًا هامًا في توصيف كاسيان للحياة الروحيّة والتي تماثل “الصلاة النقيّة” عند مار أوغريس، إلاّ أنّ كاسيان لا يُشدِّد عليها، خلافًا لمار أوغريس(11). تلك الصلاة عند كاسيان تُمثِّل حالة من التسامي فوق الكلمات، إنّها بمثابة إكليل وتاج للحياة الروحيّة، ولكنّها ليست هدفًا نسعَى وراءه، إذ هي نعمة وهبة إلهيّة، تظهر على فتراتٍ، أثناء مسيرة الإنسان في الحياة الروحيّة. |
||||

|
 |
|