
 |
 |
 |
 |
|
|
رقم المشاركة : ( 21 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
الشّهادة وعلاقة السلطات بالكنيسة في حياة المسيحيين الأوائل في أورشليم وتخومها وهكذا تحت تأثير القوّة السماويّة، وبعونٍ إلهيّ، أنارت تعاليم المُخلّص كلّ العالم بسرعةٍ كأشعّة الشمس، وللحال خرج صوت الإنجيليّين والرسل المُلهمين إلى كلّ الأرض وإلى أقصى المسكونة كلماتهم تاريخ الكنيسة - يوسابيوس القيصري نقرأ في بداية خدمّة الربّ يسوع أنّه كان عرضة لهجمة شرسة في مجمع الناصرة نتيجة لشرحه النصّ الوارد عند إشعياء وهو الأمر الذي دفع الجموع للهياج المبكِّر على يسوع؛ «فَامْتَلأَ غَضَبًا جَمِيعُ الَّذِينَ فِي الْمَجْمَعِ حِينَ سَمِعُوا هذَا، فَقَامُوا وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ الْمَدِينَةِ، وَجَاءُوا بِهِ إِلَى حَافَّةَ الْجَبَلِ الَّذِي كَانَتْ مَدِينَتُهُمْ مَبْنِيَّةً عَلَيْهِ حَتَّى يَطْرَحُوهُ إِلَى أَسْفَلٍ. أَمَّا هُوَ فَجَازَ فِي وَسْطِهِمْ وَمَضَى.» (لو4: 28-30). ومن وقتها والمجمع اليهودي هو القاسم المشترك في معاناة المسيحيين الأوائل، ومصدر لانطلاق شرارة الاضطهاد على الكنيسة. لم يمر الوقت حتّى بدأت تتحقّق كلمات المسيح؛ «وَقَبْلَ هذَا كُلِّهِ يُلْقُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ، وَيُسَلِّمُونَكُمْ إِلَى مَجَامِعٍ وَسُجُونٍ، وَتُسَاقُونَ أَمَامَ مُلُوكٍ وَوُلاَةٍ لأَجْلِ اسْمِي» (لو 21: 12). 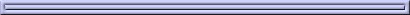 أوّل صدام نرصده بين قادة اليهود والمسيحيّة الناشئة، قدّمه لنا القديس لوقا في سفر الأعمال في الإصحاح الرابع، عقب المعجزة التي أجراها القديس بطرس عند باب الهيكل المدعو بـ“الجميل”، والتي كان من نتائجها التفاف جموع كثيرة في رواق سليمان ليسمعوا ما عزم بطرس على إعلانه. وأثناء الكلمة التي كان يلقيها بطرس؛ « أَقْبَلَ عَلَيْهِمَا الْكَهَنَةُ وَقَائِدُ جُنْدِ الْهَيْكَلِ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ وَالصَّدُّوقِيُّونَ، مُتَضَجِّرِينَ مِنْ تَعْلِيمِهِمَا الشَّعْبَ، وَنِدَائِهِمَا فِي يَسُوعَ بِالْقِيَامَةِ مِنَ الأَمْوَاتِ. فَأَلْقَوْا عَلَيْهِمَا الأَيَادِيَ وَوَضَعُوهُمَا فِي حَبْسٍ(1) τήρησις إِلَى الْغَدِ، لأَنَّهُ كَانَ قَدْ صَارَ الْمَسَاءُ » (أع4: 1-3). هنا ونلاحظ أنّ ثلاث فئات تجمّعت لإلقاء القبض على التلاميذ، وهم يُمثِّلون ثلاثة تيّارات في المجتمع اليهودي آنذاك؛ فالكهنة يُمثِّلون التعصُّب الديني والارتكان إلى التراث والأصوليّة في التفكير، بينما قائد جند الهيكل يمثِّل الجانب الأمني والمرتبط بالضرورة بالجانب السياسي، ومن الجدير بالذكر أنّ حراسة أبواب الهيكل كانت إحدى وظائف اللاّويين لمنع دخول أي شيء نجس، وقد ورد ذكر قائد جند الهيكل في الكتابات اليهوديّة كـ“رجل جبل الهيكل”، وتأتي مكانته في المجتمع اليهودي بعد رئيس الكهنة مباشرة. أمّا الجماعة الثالثة التي كانت حاضرة لإلقاء القبض على التلميذيْن هم الصدوقيون ويمثِّلون الجناح الرأسمالي والطبقة الثريّة والحاكمة في المجتمع اليهودي. ومن الأمور التي يجب أن تستوقفنا؛ أنّ العدو الأوّل للمسيح في المجتمع اليهودي، كان جماعة الفريسيين، إلاّ أنّ ثمّة تغيُّر كبير حدث إذ بات الصدوقيون هم المقاوم الأوَّل للتعليم المسيحي. وذلك لأنّ محور التعليم الذي جاهر به بطرس بل والرسل أيضًا هو القيامة من الأموات، وهو الذي يمسّ التعليم الصدوقي في جوهره، بل ويقوِّض كلّ دعواهم بأنّه ليست هناك قيامة من الأموات. وبالرغم من كون الصدوقيين(2) ليبراليين منفتحين على الثقافات الأخرى دونما تزمُّت، إلاّ أنّهم هبّوا معًا لمقاومة قيامة يسوع. وبعد أن استفسروا منهم عن مصدر القدرة التي جعلتهم يقيمون الرجل الأعرج، أوضح لهم بطرس أنّ القوّة نابعة من يسوع الذي قتلوه منذ أيامٍ ليست بكثيرة. ويضيف سفر الأعمال؛ «فَلَمَّا رَأَوْا مُجَاهَرَةَ بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا، وَوَجَدُوا أَنَّهُمَا إِنْسَانَانِ عَدِيمَا الْعِلْمِ وَعَامِّيَّانِ، تَعَجَّبُوا. فَعَرَفُوهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا مَعَ يَسُوعَ.» (أع4: 13). لقد تعجّب اليهود المجتمعين من قدرّة الرسوليْن على الحديث بالرغم من كونهما «عديما العلم وعاميّان». إنّ “عاميان” وردت في النصّ اليوناني ἰδιώτης وهي تعني الشخص غير المتخصِّص في مجالٍ ما.(3) والعلم المقصود هنا هو الدراسة في المدارس اليهوديّة للتوراة والمشناه وغيرها من نصوص التقليد،(4) والتي تؤهِّل الشخص للحديث في الأمور العقائديّة، إذ كان بطرس يخاطب الناس في رواق سليمان. مَنْ لم ينل ولو قسطًا صغيرًا من التعليم كان في مرتبة متدنّية في المجتمع اليهودي، ومن ثمّ كان يُنظر إليه نظرة دونيّة ولم يكن يُنتظر منه الكثير على أيّة حال. إنّ تلك النظرة كانت هي النظرة إلى المسيح أيضًا، حينما صعد يسوع إلى الهيكل ليُعلِّم؛ «فَتَعَجَّبَ الْيَهُودُ قَائِلِينَ: ‘كَيْفَ هذَا يَعْرِفُ الْكُتُبَ، وَهُوَ لَمْ يَتَعَلَّمْ؟’.» (يو7: 15). كان ردّ يسوع عليهم؛ «تَعْلِيمِي لَيْسَ لِي بَلْ لِلَّذِي أَرْسَلَنِي» (يو7: 16). لذا فقد كتب يوحنّا الذهبي الفم عن بطرس وبولس المُجاهرين بالقيامة أمام اليهود؛ “لم يكن الرسولان هما المتكلّمان ولكن نعمة الروح.”(5) أي أن قياس كلامهما لا يجب أن يُبنَى على معارفهما بل على معارف الروح اللاّمحدودة، المتكلِّم فيهما. إنّ هاتين الكلمتين؛ «عديما العلم وعاميّان»، تلقيان بالضوء على ردّ فعل قادة اليهود تجاههم فقد دعوهما؛ «وَأَوْصَوْهُمَا أَنْ لاَ يَنْطِقَا الْبَتَّةَ، وَلاَ يُعَلِّمَا بِاسْمِ يَسُوعَ.» (أع4: 18). لقد كان السبب الحقيقي لذلك الحُكم أنهم كانوا خائفين من ردود الأفعال تجاه محاكمة الرسل أو قتلهم، لذا فقد رأوا أن القليل من التهديد قد يكفي تلك المرّة؛ «مَاذَا نَفْعَلُ بِهذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ؟ لأَنَّهُ ظَاهِرٌ لِجَمِيعِ سُكَّانِ أُورُشَلِيمَ أَنَّ آيَةً مَعْلُومَةً قَدْ جَرَتْ بِأَيْدِيهِمَا، وَلاَ نَقْدِرُ أَنْ نُنْكِرَ. وَلكِنْ لِئَلاَّ تَشِيعَ أَكْثَرَ فِي الشَّعْبِ، لِنُهَدِّدْهُمَا تَهْدِيدًا أَنْ لاَ يُكَلِّمَا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ فِيمَا بَعْدُ بِهذَا الاسْمِ» (أع4: 16، 17). ولكن كانت الإشكاليّة هي: كيف سيُقدّمون الحُكم أمام النّاس والذي قد يُنظَر إليه بأنّه تساهُل تجاه تلك الحركة الجديدة، كان عليهم أن يحيكوا المؤامرة جيِّدًا كما اعتادوا؛ «وَتَآمَرُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ» (أع4: 15)، ولعلّ ما ساعدهم على ذلك أنه كان هناك قانون يهودي في القرن الأوّل الميلادي يمنع معاقبة غير المتعلِّمين على خطأهم الأوّل الذي يكون عادة نتيجة الجهل. ولعلّ هذا الإطار كان مخرجًا لهم أمام إطلاقهم للرسل دون عقوبةٍ.(6) لقد كانت تلك أوّل محاكمة أو بالأحرى شبه محاكمة للمسيحيين. إنّها أوّل حركة من قادة اليهود تجاه المسيحيّة بعد محاولتهم الفاشلة للقضاء على يسوع. لقد كان ردّ بطرس، بل وردّ الكنيسة على تهديدهم؛ «لأَنَّنَا نَحْنُ لاَ يُمْكِنُنَا أَنْ لاَ نَتَكَلَّمَ بِمَا رَأَيْنَا وَسَمِعْنَا» (أع4: 20). أسباب القبض على بطرس ويوحنّا: شفاء الأعرج والتعليم في رواق سليمان والمناداة بقيامة يسوع مراحل الاستجواب: 1- الاستدعاء الأوَّل (4: 5-12) 2- اجتماع خاص لقادة اليهود (4: 13-17) 3- الاستدعاء الثاني (4: 13-22) 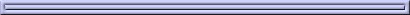 بعد مرور وقت قليل على حادثة القبض الأولى على الرسل نقرأ؛ «فَقَامَ رَئِيسُ الْكَهَنَةِ وَجَمِيعُ الَّذِينَ مَعَهُ، الَّذِينَ هُمْ شِيعَةُ الصَّدُّوقِيِّينَ، وَامْتَلأُوا غَيْرَةً فَأَلْقَوْا أَيْدِيَهُمْ عَلَى الرُّسُلِ وَوَضَعُوهُمْ فِي حَبْسِ الْعَامَّةِ(7)ἐν τηρήσει δημοσίᾳ» (أع5: 17-18) وكان ذلك بعد أن بدأت تنتشر التعاليم بقيامة يسوع، وبدأت الآيات تتزايد وتستقطب الكثيرين من المدن والقرى المتاخمة؛ «وَكَانَ مُؤْمِنُونَ يَنْضَمُّونَ لِلرَّبِّ أَكْثَرَ، جَمَاهِيرُ مِنْ رِجَال وَنِسَاءٍ.. وَاجْتَمَعَ جُمْهُورُ الْمُدُنِ الْمُحِيطَةِ إِلَى أُورُشَلِيمَ حَامِلِينَ مَرْضَى وَمُعَذَّبِينَ مِنْ أَرْوَاحٍ نَجِسَةٍ، وَكَانُوا يُبْرَأُونَ جَمِيعُهُمْ.» (أع5: 14-16)، وهو الأمر الذي استحضر في أذهانهم خدمة يسوع قبل موته؛ ولكن تلك المرّة هناك أكثر من يسوع، وكأنّهم حينما ألقوا بحبّة الحنطة على الأرض لتَمُت، أثمرت أعدادًا متزايدة من ثمارٍ حاملةً آلاف البذار. لم يكن الحبس في حدّ ذاته عقوبة بحسب القانون الروماني الذي يسري على البلاد الخاضعة للحكم الروماني، فقد كان تمهيدًا للعقوبة.(8) وفي السجن حدثت المعجزة الشهيرة التي تفتّحت فيها أبواب السجن على مصراعيها أمام الرسل(9) وكلّمهم الملاك أن عليهم أن يذهبوا لينادوا بكلمة الحياة، وهو ما عملوه في الصباح الباكر. وحينما نما إلى علم رئيس الكهنة وقائد جند الهيكل وكلّ مشيخة بني إسرائيل أنّهم يعلّمون من جديد في الهيكل، ألقوا القبض عليهم مرّة أخرى، ولكنهم لم يستخدموا العنف تلك المرّة خوفًا من الجموع (انظر: أع5: 26). «فَلَمَّا أَحْضَرُوهُمْ أَوْقَفُوهُمْ فِي الْمَجْمَعِ. فَسَأَلَهُمْ رَئِيسُ الْكَهَنَةِ قِائِلاً:‘أَمَا أَوْصَيْنَاكُمْ وَصِيَّةً أَنْ لاَ تُعَلِّمُوا بِهذَا الاسْمِ؟ وَهَا أَنْتُمْ قَدْ مَلأْتُمْ أُورُشَلِيمَ بِتَعْلِيمِكُمْ، وَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْلِبُوا عَلَيْنَا دَمَ هذَا الإِنْسَانِ’. فَأَجَابَ بُطْرُسُ وَالرُّسُلُ وَقَالُوا:‘يَنْبَغِي أَنْ يُطَاعَ اللهُ أَكْثَرَ مِنَ النَّاسِ(10). إِلهُ آبَائِنَا أَقَامَ يَسُوعَ الَّذِي أَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُ مُعَلِّقِينَ إِيَّاهُ عَلَى خَشَبَةٍ. هذَا رَفَّعَهُ اللهُ بِيَمِينِهِ رَئِيسًا وَمُخَلِّصًا، لِيُعْطِيَ إِسْرَائِيلَ التَّوْبَةَ وَغُفْرَانَ الْخَطَايَا. وَنَحْنُ شُهُودٌ لَهُ بِهذِهِ الأُمُورِ، وَالرُّوحُ الْقُدُسُ أَيْضًا، الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ لِلَّذِينَ يُطِيعُونَهُ’. فَلَمَّا سَمِعُوا حَنِقُوا، وَجَعَلُوا يَتَشَاوَرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُمْ.» (أع5: 27-33). من كلمات بطرس والرسل يرتسم أمامنا أساس لعلاقة الكنيسة بالسلطات القائمة آنذاك؛ إذ لا يجب الخلط بين طاعة الله وطاعة البشر، حينما يكون هناك تعارض. فالكرازة بكلمة الحياة كانت وصيّة المسيح قبيل صعوده إلى السماء، كما كانت تعليمات السماء بفم الملاك للرسل، وهنا تتعارض الوصيّة مع مطلب السلطات، ويبقَى القانون الذي سارت عليه الكنيسة وأرادات أن تُقدِّمه لنا في كلّ العصور وتحت مختلف الظروف هو أنّ طاعة الله تتقدّم على طاعة البشر. لقد كتب القديس بطرس في رسالته؛ «فَاخْضَعُوا لِكُلِّ تَرْتِيبٍ بَشَرِيٍّ مِنْ أَجْلِ الرَّبِّ. إِنْ كَانَ لِلْمَلِكِ فَكَمَنْ هُوَ فَوْقَ الْكُلِّ، أَوْ لِلْوُلاَةِ فَكَمُرْسَلِينَ مِنْهُ لِلانْتِقَامِ مِنْ فَاعِلِي الشَّرِّ، وَلِلْمَدْحِ لِفَاعِلِي الْخَيْرِ. لأَنَّ هكَذَا هِيَ مَشِيئَةُ اللهِ: أَنْ تَفْعَلُوا الْخَيْرَ فَتُسَكِّتُوا جَهَالَةَ النَّاسِ الأَغْبِيَاءِ. كَأَحْرَارٍ، وَلَيْسَ كَالَّذِينَ الْحُرِّيَّةُ عِنْدَهُمْ سُتْرَةٌ لِلشَّرِّ، بَلْ كَعَبِيدِ اللهِ. أَكْرِمُوا الْجَمِيعَ. أَحِبُّوا الإِخْوَةَ. خَافُوا اللهَ. أَكْرِمُوا الْمَلِكَ» (1بط2: 13-17). هنا ويبدو أن هناك تناقض بين ما قام به بطرس وصرّح به الرسل أمام المجمع، وبين تعليم بطرس الرسول فيما بعد. ولكن بنظرة أكثر عمقًا نجد أنّ الخضوع والطاعة والإكرام للسلطات الذي يطالب به القديس بطرس، الكنيسة، هو في إطار القوانين المدنيّة والتي لا تتعارض ولا تتداخل مع القانون الإلهي والوصيّة الإلهيّة؛ ولعلّ استشهاد القديس بطرس على يد السلطات لهو أقوى دليل على ضرورة عدم الخلط بين الطاعة الكاملة للوصيّة الإلهيّة وإن نتج عنه غضب السلطات، وبين الخضوع للترتيب البشري والقانون الوضعي الذي يحكم المعاملات بين الناس في إطار شرعيّة قانونيّة وقضائيّة تُظلِّل على الجانب التنفيذي منه. اجتمع المجمع اليهودي والمكوَّن عادةً من 71 عضوًا يشمل رئيس الكهنة ليتباحثوا بخصوص الأزمة التي بدأت تتفاقم في المجتمع. وكانت تتعالى دعاوى بضرورة القضاء عليهم كما يسوع، لئلا يحدث ما لا يُحمد عقباه. إلاّ أنّ صوتًا عاقلاً وجد له مكانًا في جلستهم الصاخبة؛ هو غمالائيل(11) الشيخ الفريسي، والذي أشار على المجمع المنعقد بأن يتركوا القضاء لله لتظهر أحكامه، فإن كان هذا الأمر من الله سيثبت وإن لم يكن فسوف يتلاشى من تلقاء ذاته(12) مدلِّلاً بحركة ثوداس ومن معه، واستجاب الجمع لرأيه و«دَعُوا الرُّسُلَ وَجَلَدُوهُمْ، وَأَوْصَوْهُمْ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمُوا بِاسْمِ يَسُوعَ، ثُمَّ أَطْلَقُوهُمْ»(أع5: 40). وكان الجلد بحسب القانون اليهودي، أربعين جلدة إلاّ واحدة (حتّى تقبل القسمة على ثلاثة كما تقول المشناه). ومن الغريب أنّ عقوبة الجلد لها ضوابط ومصوغات وأحكام لا تنطبق بأي شكل من الأشكال على حالة الرسل؛ فكما جاء في المشناه(13) أن عقوبة الجلد تتضمّن: 1- التعديات الأخلاقيّة مثل أن يضاجع الرجل / المرأة أشخاصًا مُحرَّمين (في النطاق العائلي). 2- التعديات التشريعيّة مثل التنجُّس بكل أشكاله. 3- التعديات السلوكيّة بالتشبّه بالعادات الوثنيّة، مثل حلق الشعر مستديرًا، الوشم، جرح الجسد.. إلخ. إلاّ أن أسباب القبض على الرسل لم تتضمّن أحد تلك الأشكال، ومن ثمّ فإنّ عقوبة الجلد ههنا تفتقر إلى الشرعيّة اللاّزمة من التشريعات اليهوديّة، وهو ما يدلِّل أن القضاء اليهودي لم يكن هو المتحكِّم في الأمر، فقد تُرك بجملته ليد قادة اليهود لاجتثاث الحركة المسيحيّة من جذورها. أمّا طريقة الجلد نفسها فنقرأ عنها في الموسوعة اليهوديّة: “كان السوط يصنع من جلود العجول، وكان المُعاقَب يُجلَد على الجزء العلوي من جسده؛ ثلث عدد الجلدات على صدره، والثلثان الآخران على ظهره. وكان المُعاقب يقف في وضعٍ منحنٍ بينما الجلاّد يقف خلفه على حجرٍ، وكان يصاحب الجلد ترديد بعض العبارات التذكيريّة والإرشاديّة للمُعاقَب من النصوص المُقدَّسة”.(14) كما نقرأ في المشناه: “لا يُجلَد واقفًا ولا جالسًا وإنّما مائلاً، حيث ورد «ويطرحه القاضي» (انظر: تث25: 2). والجلاّد يجلد بيد واحدة وبكلّ قوّته.”(15) كان الجلد هو أوّل عقوبة أو اضطهاد لجمع من المسيحيين (كلّ الرسل)، ولكنّه في المقابل كان سبب فرح غامر للرسل لأنّهم تألمّوا مع المُخلِّص أو بالأحرى اشتركوا في آلام المخلِّص؛ «وَأَمَّا هُمْ فَذَهَبُوا فَرِحِينَ مِنْ أَمَامِ الْمَجْمَعِ، لأَنَّهُمْ حُسِبُوا مُسْتَأْهِلِينَ أَنْ يُهَانُوا مِنْ أَجْلِ اسْمِهِ. وَكَانُوا لاَ يَزَالُونَ كُلَّ يَوْمٍ فِي الْهَيْكَلِ وَفِي الْبُيُوتِ مُعَلِّمِينَ وَمُبَشِّرِينَ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ» (أع5: 41-41). أسباب القبض على الرسل:
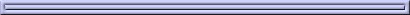 ظهر على ساحة الكنيسة فمٌ جهوري جديد يبشّر بقيامة الربِّ بجرأة وقدرة فائقتين؛ إستفانوس أحد الشمامسة السبع، الذي لم تستطِع أن تصمد أمامه ردود قادة اليهود وهو ما أدّى إلى ثورتهم عليه؛ «فَنَهَضَ قَوْمٌ مِنَ الْمَجْمَعِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مَجْمَعُ اللِّيبَرْتِينِيِّينَ وَالْقَيْرَوَانِيِّينَ وَالإِسْكَنْدَرِيِّينَ، وَمِنَ الَّذِينَ مِنْ كِيلِيكِيَّا وَأَسِيَّا، يُحَاوِرُونَ اسْتِفَانُوسَ. وَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يُقَاوِمُوا الْحِكْمَةَ وَالرُّوحَ الَّذِي كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهِ. حِينَئِذٍ دَسُّوا لِرِجَال يَقُولُونَ:‘إِنَّنَا سَمِعْنَاهُ يَتَكَلَّمُ بِكَلاَمٍ تَجْدِيفٍ عَلَى مُوسَى وَعَلَى اللهِ’. وَهَيَّجُوا الشَّعْبَ وَالشُّيُوخَ وَالْكَتَبَةَ، فَقَامُوا وَخَطَفُوهُ وَأَتَوْا بِهِ إِلَى الْمَجْمَعِ، وَأَقَامُوا شُهُودًا كَذَبَةً يَقُولُونَ:‘هذَا الرَّجُلُ لاَ يَفْتُرُ عَنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ كَلاَّمًا تَجْدِيفًا ضِدَّ هذَا الْمَوْضِعِ الْمُقَدَّسِ وَالنَّامُوسِ، لأَنَّنَا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ: إِنَّ يَسُوعَ النَّاصِرِيَّ هذَا سَيَنْقُضُ هذَا الْمَوْضِعَ(16)، وَيُغَيِّرُ الْعَوَائِدَ الَّتِي سَلَّمَنَا إِيَّاهَا مُوسَى’. فَشَخَصَ إِلَيْهِ جَمِيعُ الْجَالِسِينَ فِي الْمَجْمَعِ، وَرَأَوْا وَجْهَهُ كَأَنَّهُ وَجْهُ مَلاَكٍ» (أع6: 9-15). من المعروف أن مجامع اليهود كانت تعبيرًا عن أصولهم؛ فالسكندريين يُصلُّون معًا وكذلك القيروانيين.. إلخ، إلاّ أن مجمع الليبرتينيين له أهميّة خاصة في فهم موقف اليهود من إستفانوس. والمجمعσυναγωγή قد يُفهَم أنه مكان أو جماعة، ولعلّ الأخيرة أقرب إلى النصّ الذي كتبه القديس لوقا(17). الليبرتينيين هي عن الكلمة اللاّتينيّة libertini وتعني المُحرَّرين، في إشارة إلى اليهود الذي أخذوا إلى روما كعبيد على يد بومبي Pompey 63 ق. م.، وهناك نالوا حرّيتهم فيما بعد وكوّنوا مستعمرة على نهر التيبر في روما(18)، وتمّ ترحيلهم من روما حسب مرسوم طيباريوس(19) عام 19 م. لقد كان هؤلاء هم الأشد عداءً لاستفانوس لأنّ ما يُبشِّر به يعني أنّ ما عانوا من أجله لم يكن يستحق؛ فالأمم سينالون ميراثًا كما اليهود؛ تلك الفكرة كانت تزعجهم حينما يستحضرون في أذهانهم الرومان الذين استعبدوهم ثمّ طردوهم، من هنا كان الصدام مع إستفانوس أكيدًا. ونلحظ هنا أمريْن في غاية الأهميّة:1- الاعتماد على الشهادة الزور للوصول إلى مبتغاهم من النيل من إستفانوس. 2- تهييج الشعب على إستفانوس عن طريق الادّعاء عليه فيما يمسُّ مناطق مقدّسة عند جموع اليهود؛ الموضع المُقدّس، الناموس، موسى. وتلك هي المرّة الأولى التي تتحرّك فيها الجموع ضدّ الكنيسة. وبالفعل تحقَّق لهم ما أرادوا إذ اختطُف إستفانوس بعنفٍ واقتيد إلى المجمع؛ مسرح المؤامرات اليهوديّة. أسباب القبض على إستفانوس:
بعد عظة طويلة استعرض فيها إستفانوس بمهارة ووعي مُجمل التاريخ اليهودي، كانت كلماته الأخيرة بمثابة الوخزة التي دفعتهم إلى الهياج والجنون؛ «يَا قُسَاةَ الرِّقَابِ، وَغَيْرَ الْمَخْتُونِينَ بِالْقُلُوبِ وَالآذَانِ! أَنْتُمْ دَائِمًا تُقَاوِمُونَ(20) ἀντιπίπτετε الرُّوحَ الْقُدُسَ. كَمَا كَانَ آبَاؤُكُمْ كَذلِكَ أَنْتُمْ! أَيُّ الأَنْبِيَاءِ لَمْ يَضْطَهِدْهُ آبَاؤُكُمْ؟ وَقَدْ قَتَلُوا الَّذِينَ سَبَقُوا فَأَنْبَأُوا بِمَجِيءِ الْبَارِّ، الَّذِي أَنْتُمُ الآنَ صِرْتُمْ مُسَلِّمِيهِ وَقَاتِلِيهِ، الَّذِينَ أَخَذْتُمُ النَّامُوسَ بِتَرْتِيبِ مَلاَئِكَةٍ وَلَمْ تَحْفَظُوهُ. فَلَمَّا سَمِعُوا هذَا حَنِقُوا بِقُلُوبِهِمْ وَصَرُّوا بِأَسْنَانِهِمْ عَلَيْهِ. وَأَمَّا هُوَ فَشَخَصَ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ مُمْتَلِئٌ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ، فَرَأَى مَجْدَ اللهِ، وَيَسُوعَ قَائِمًا عَنْ يَمِينِ اللهِ. فَقَالَ: ‘هَا أَنَا أَنْظُرُ السَّمَاوَاتِ مَفْتُوحَةً، وَابْنَ الإِنْسَانِ قَائِمًا عَنْ يَمِينِ اللهِ’. فَصَاحُوا بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَسَدُّوا آذَانَهُمْ، وَهَجَمُوا عَلَيْهِ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ الْمَدِينَةِ وَرَجَمُوهُ.» (أع7: 51-58). لم يذكر لنا القديس لوقا تفاصيل رجم إستفانوس إذ اكتفى بقوله؛ «وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ الْمَدِينَةِ وَرَجَمُوهُ»، ولكي نتعرّف على عملية الرجم عند اليهود، والتي تختلف إلى حدٍّ كبير عن الصورة التي في أذهاننا عن تلك العقوبة، نقرأ: “حسب كلام الرابيين، فإنّ المحكوم عليه بالرجم، كان يُوْثَق اليدان، وكان أحد الشهود يلقيه بقوّة حتى يسقط على ظهره، بعدها يلقي الشاهد الثاني عليه، حجرًا، وإن بقى حيًّا بعد ذلك، تبدأ الجموع في إمطاره بوابلٍ من الحجارة حتى تصرعه، ثم يتركوا الجسد معلَّقًا حتى الغروب.”(21) أمّا في المشناه، نقرأ بالتفصيل عن طريقة الرجم، في باب السنهدرين (الفصل السادس)، إذ تقول: “إذا انتهى الحكم، يخرجونه (المتّهم) لرجمه، ومكان الرجم كان خارج المحكمة، حيث ورد؛ «أَخْرِجِ الَّذِي سَبَّ إِلَى خَارِجِ الْمَحَلَّةِ» (لا24: 14).. يخرج (المتّهم) للرجم ويخرج المنادي أمامه، إنّ [فلان ابن فلان] خارج للرجم لارتكابه الجريمة [الفلانيّة]، و[فلان] و[فلان] شاهدان عليه، فكلّ من يرى أنه برئ يأتي ويشهد له.. وعندما يكون (المتّهم) بعيدًا عن مكان الرجم بأربع أذرع يخلعون ملابسه.. إذ يقول الحاخامات: إنّ الرجل يُرجم عريانًا، أمّا المرأة فلا تُرجم عريانه. وكان مكان الرجم مرتفعًا قدر قامتين (لرجل). يدفع أحد الشهود [المتّهم] على ظهره، فإذا انقلب على قلبه يُقلبه على ظهره فإذا مات بهذا فقد تمّت عمليّة الرجم. وإن لم يحدث فإنّ الشاهد الثاني يلقيه بحجر على قلبه فإذا مات به فقد تمّت عمليّة الرجم. وإن لم يحدث فإنّ كلّ الجماعة ترجمه.. كلّ المرجومين يعلّقون طبقًا لأقوال رابي أليعازر. كيف يعلّقونه؟ يغرسون لوحًا في الأرض، وبالقرب من رأس اللوح تخرج خشبة منه، ثمّ يطوّقون يديه ويعلِّقونه..”(22) ومن الواضح أنّ القديس استفانوس لم يمت في المرحلتيْن الأوليَيْن، ولكنّه أصبح عرضة لوابل من الحجارة، تنهال عليه من الجموع الثائرة عليه، ولكن العجيب أنّنا نقرأ أنّه استجمع كلّ قواه ليجثو على قدميه ليقدِّم صلاته الأخيرة من أجل قاتليه؛ عندها رقد في الربّ، وسطَّر أول كلمة في تاريخ الشهادة الممتد حتى اللحظة الحاضرة. إنّ إستفانوس Στέφανον يعني الإكليل، وهو بالحقيقة صاحب التتويج الأوَّل بين جمع الشهداء، صعد إلى السموات وهو مخضّبٌ بدمائه، لكي يلاقي مسيحًا مخضَّبًا بدماء الحبّ؛ ليقوم معه وفيه إلى الحياة الأبديّة والنصرة الدهريّة، وليجلس فيه عن يمين الآب. كان موت إستفانوس نقطة تحوُّل في الكنيسة الأولى، إذ بعد موته مباشرة بدأت موجة من الاضطهاد تلاحق الكنيسة، وصفها يوسابيوس القيصري بأنّها “الأعظم من اليهود على كنيسة أورشليم”(23)، حتى بدأ التشتُّت لساكني أورشليم، ما عدا الرسل؛ «وَحَدَثَ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ اضْطِهَادٌ عَظِيمٌ عَلَى الْكَنِيسَةِ الَّتِي فِي أُورُشَلِيمَ، فَتَشَتَّتَ الْجَمِيعُ فِي كُوَرِ الْيَهُودِيَّةِ وَالسَّامِرَةِ، مَا عَدَا الرُّسُلَ. وَحَمَلَ رِجَالٌ أَتْقِيَاءُ اسْتِفَانُوسَ وَعَمِلُوا عَلَيْهِ مَنَاحَةً عَظِيمَةً(24)» (أع8: 1-2). لقد بدأت الجموع تشترك مع القادة في مواجهة المسيحيّة؛ من خلال ملاحقة المسيحيين بالإهانة والسرقة والضرب والقبض.. إلخ. لقد بدأت الأوجاع وبدأت معها الأكاليل تُعدّ لمن يصبر إلى المنتهى. ولكن هل كان في التشتت والاضطهاد إضعاف للكنيسة؟ نجد القديس لوقا يوضِّح لنا الأمر جليًّا لئلا تلتبس علينا الأمور؛ «فَالَّذِينَ تَشَتَّتُوا جَالُوا مُبَشِّرِينَ بِالْكَلِمَةِ» (أع8: 4) فالكرازة كانت تتحرَّك على وقع خطى الاضطهاد، لم يفترقا. وكأن الكلمة كانت تصدح من بين رياح الضيقة ولهيب الاضطهاد. 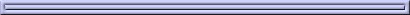 الشّهيد المكرّم الذي لربّنا يسوع المسيح القديس إستفانوس الذي تأويله الإكليل الذي كشف له الله، أسرارًا عظيمةً واستنار وجهه مثل وجه ملاكٍ الذي رأى السموات مفتوحة وربنا يسوع المسيح عن يمين الآب والذين يرجمونه كان يطلب عن خلاصهم صارخًا قائلاً: يا ربّي يسوع المسيح اقبل روحي ولا تحسب هذه الخطيّة على هؤلاء النّاس لأنهم لا يدرون ماذا يصنعون من أجل عمى قلوبهم يا ربّ لا تبكتهم أكمل سعيه ومات على الحقّ ولبس إكليل الشهادة غير المضمحل السلام لك أيها المجاهد الذي لربّنا يسوع المسيح القديس استفانوس الذي تأويله الإكليل اطلب من الربّ عنّا يا رئيس الشمامسة المبارك الشهيد الأوَّل ليغفر لنا خطايانا. (ذكصولوجيّة القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأوّل الشهداء) _____ الحواشي والمراجع :(1) جاءت تلك الكلمة عند يوسيفوس بمعنى رهن الاعتقال. Josephus Ant. 16.321 (2) يرى يوسيفوس أنّ الصدوقيين يستميلون الأغنياء فقط بينما الفريسيين يحظون بتأييد جمهور الجموع. Josephus, Jewish Antiquities 13.298 (3) Abbott, Thomas Kingsmill: A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles to the Ephesians and to the Colossians. New York: C. Scribner’s sons, 1909, 234 (4) Stern, David H.: Jewish New Testament Commentary: A Companion Volume to the Jewish New Testament. electronic ed. Clarksville: Jewish New Testament Publications, 1996, c1992, Acts 4:13 (5) The Nicene and Post-Nicene Fathers, edit. by: Schaff, Philip,, First Series Vol. XI. (Oak Harbor: 1997), Homilies on the Acts, 65 (6) Richards, Lawrence O.: The Bible Readers Companion. Wheaton: Victor Books, 1991; 712 (7) الكلمة في اليونانيّة تعني رهن الاعتقال، أو بحسب المصطلح الأمني المعاصر؛ على ذمّة التحقيق. ومن الجدير بالذكر أن هناك ثلاث كلمات مستخدمة في هذا الإطار؛ الأولى Τήρησιςوتعني رهن الاعتقال كما أشرنا، أمّا الثانية Φυλακή وتعني تحت الحراسة، بينما الثالثة δεσμωτήριον وهي تعني موضوعًا في قيود. Vincent, Marvin Richardson: Word Studies in the New Testament. Bellingham, Vol. 1, 470 (8) Gary L. Knapp, “Prison,” International Standard Bible Encyclopedia, vol. 3, 975. (9) نقرأ في سفر الأعمال عن ثلاث مرّات يتمّ فيها الخروج من السجن بشكلٍ معجزي (انظر: أع12: 6-10؛ 16: 26-27) (10) لقد وردت نفس العبارة على لسان سقراط أثناء دفاعه عن نفسه أمام القضاة الأثينيين، إذ قال: “ينبغي أن أطيع الله أكثر من البشر” Plato Apology 29D (11) معروف في التاريخ اليهودي بـ“غمّالائيل الكبير” وهو أوَّل من اُطلق عليه لقب “رابان Rabban” بدلاً من “رابي Rabbi”، وهو الأوَّل من بين ستّه دعوا باسم غمّالائيل، كان أشهرهم حفيده غمّالائيل الثاني. غمالائيل هو حفيد الرابي الشهير هلِّل، كما أنّه قائد مدرسة بيت هلِّل Beit-Hillel. وهناك فقره في المشناه بخصوصه تقول: “حينما مات رابان غمّالائيل الكبير، خبا مجد التوراة، حينها توقفت الطهارة والقداسة” Sotah 9:15 Stern, David H.: Jewish New Testament Commentary: A Companion Volume to the Jewish New Testament. electronic ed. Clarksville: Jewish New Testament Publications, 1996, c1992, Acts 5:34 (12) هناك فقرة في المشناه تقول: “أي تجمُّع من أجل السماء سيثبت في النهاية، ولكن أي تجمُّع ليس من أجل السماء لن يثبت في نهاية الأمر.” Pirqe Aboth 4.11 (13) انظر: الباب الثالث من مبحث مكوت (الجلدات)، نزيقين الأضرار، المشناه، ترجمة د. مصطفى عبد المعبود (مكتبة النافذة: 2007)، ص 203-206 (14) H. Cohn, “Flogging,” Encyclopaedia Judaica, vol. 6, p. 1350. (15) الباب الثالث من مبحث مكوت (الجلدات)، المشناه، مرجع سابق، ص 207 (16) إنّ الادّعاء على يسوع بأنّه سيهدم الهيكل وجد له مكانًا في إنجيل توماس الأبوكريفي، أحد مخطوطات نجع حمادي، إذ تقول المخطوطة: “قال يسوع: ‘سوف أدمِّر هذا المنزل ولن يستطيع أحد أن يبنيه’.” Robinson, James McConkey ; Smith, Richard ; Coptic Gnostic Library Project: The Nag Hammadi Library in English. 4th rev. ed. Leiden; New York: E.J. Brill, 1996 , 134 (17) Conzelmann, Hans ; Epp, Eldon Jay ; Matthews, Christopher R.: Acts of the Apostles: A Commentary on the Acts of the Apostles. Philadelphia: Fortress Press, 1987, 47 (18) لقد تحدّث عنهم القديس يوحنّا الذهبي الفم، مطلقًا عليهم “المُحرّرين من الرومان οἱ Ῥωμαίων ἀπελεύτεροι” (العظة 15 على سفر الأعمال. انظر: PG 60.120) (19) Vincent, Marvin Richardson: Word Studies in the New Testament. Bellingham, Vol. 1, 476; Kistemaker, Simon J. ; Hendriksen, William: New Testament Commentary: Exposition of the Acts of the Apostles. Grand Rapids: Baker Book House, 1953-2001 (New Testament Commentary 17), 227. (20) تحمل الكلمة مفهوم المقاومة الإيجابيّة والتي تتضمّن “الهجوم على”. Vincent, Marvin Richardson: Word Studies in the New Testament. Bellingham, Vol. 1, 484 (21) Vincent, Marvin Richardson: Word Studies in the New Testament. Bellingham, Vol. 1, 485 (22) مبحث السنهدرين، الفصل السادس (أ-د)، مرجع سابق، ص 165-166؛ Freedman, David Noel: The Anchor Bible Dictionary. New York: Doubleday, 1996, c1992; Vol. 6, Page 209 (23) The Nicene and Post-Nicene Fathers, edit. by: Schaff, Philip,, Second Series Vol. I. (Oak Harbor: 1997), The Church History of Eusebius, Book I, Chapter I, 8, 104 (24) حسب المشناه فإنّ المحكوم عليه بالموت رجمًا لا يجوز أن تعمل له مناحة. انظر: Sanhedrin 6.6 |
||||
|
|
|||||

|
|
|
رقم المشاركة : ( 22 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
يا قليلي الإيمان وأمّا الإيمان فهو الثقة بما يُرجَى والإيقان بأمورٍ لا تُرى عب 11: 1 من وحي المعجزة التي وردت في (مر 4: 37 -41) .. بعد يومٍ طويلٍ مُمتلِئ بالمعجزات، في قرية كفرناحوم، دلف الربّ يسوع إلى القارب مع تلاميذه، متوجّهين صوب قريةٍ أخرى، ليُنادي باقتراب ملكوت الله، وليشفي أي مرضٍ وأي وجعٍ في الشعب؛ فقد كان، ليل نهار، يجولُ يصنع خيراً. دخلوا السفينة معاً كالمعتاد. بدأوا في رفع الشراع وتوجيهه إلى قرية الجرجسيّين التي في بيرّيه على الشاطِئ الشرقي من نهر الأردن. جلسوا معاً يستعرضون اليوم الحافل الذي شهدوه مع الربّ يسوع بينما تركهم يسوع ليتّكئ في مؤخِّرة السفينة. كان التلاميذُ يتباحثون حول المعجزات التي أجراها المُعلِّم في ذلك اليوم، وعيونهم تلمعُ من فرط الذهول لما عاينوه من عجائب. فتارةً يتحدّثون عن الأرواح التي كانت تخرجُ بكلمةٍ من فيه، وتارةً يتحدّثون عن شفاء حماة بطرس، ولكن ما استوقفهم، كانت كلمات المسيح لقائد المئة بأنّ له إيماناً أكثر من كلّ الإسرائيليّين، لأنّه آمن أنّ كلمةً واحدةً تكفي لشفاء غلامه المفلوج. كانت كلمات المُعلِّم لقائد المئة مسار جدلٍ بينهم؛ فقد رأى البعض أنّ لهم إيماناً يفوقُ إيمان قائد المئة الأممي، الذي أثنَى عليه يسوع. وبينما هم يتحدّثون، بدأت أمواج البحر تتعالَى، وألقى صفير الرياح بصداه على مسامع التلاميذ. قاموا على الفور للإمساك بالشراع حتى لا ينكسر ولا تتغيّر وجهته، بيد أن الطبيعة كانت قد تعهّدت في تلك اللّيلة أنْ تُهَاجِم قاربهم الصغير، وكأنّها مُكلَّفةً بتلقينهم خبرةً إيمانيّةً جديدةً. تعالت الأمواج، حتى وطأت بقطراتها أرض القارب.. اشتدّت الرياح العاصفة، حتى بدأ القارب في التأرجح وكأنّه دُميةٌ في يدّ أحد الأطفال، يتلهَّى به بتحريكه يميناً ويساراً .. تدافع التلاميذ؛ منهم مَنْ امسك بدلوٍ لإخراج المياه من السفينة. ومنهم مَنْ تشبّث بالشِراع. ومنهم مَنْ وقف في ذهولٍ من تلك الثورة الفجائيّة للبحرِ. ومنهم مَنْ كان يتحرّك دون أن يعمل شيئاً!!.. ولكن، بقدر ما كانوا يحاولون النجاة، بقدر ما كانت الأمواج تتعالَى، والعواصف تتشدّد، والطبيعة تزأر .. وفجأةً، حينما أدركوا أنّهم، لا محالة هالكون، وأنّ محاولاتهم للنجاة، لا تتعدَّى محاولات رضيعٍ أمام مقاتلٍ شديد القوة والبأس.. تذكّروا يسوع!! بدأوا يتساءلون: أين المُعلِّم؟؟.. وجدوه نائماً!! هرول إليه التلاميذ، وأيقظوه في تلهُّفِ واستنكارٍ!! وقال له أحدهم: يا مُعلِّم، أما تبالي أنّنا نهلك؟!! نظر إليهم يسوع بحزنٍ، متذكِّراً إيمانَ قائد المئة الأممي، بكلمته!! قام ووقف في مقدّمة القارب. تلاقت عيناه بالأفق، ثم نظر إلى البحر والموج والعاصفة، وانتهرهم بكلمات سلطانٍ، فهدأت العواصف وسكنت الأمواج، وكأنّها جروٌ صغيرٌ تطيع سيّدها. ساد صمتٌ مطبقٌ بين جنبات الطبيعة وعلى القارب!! ثم التفت إليهم، ورمقهم بنظرة تحمل من المعاني أقسَى ممّا تحمله كلمات التوبيخ، وقال لهم، بنبرة يمتزج فيها الحزن بالعتاب: “ما بالكم خائفينَ هكذا، كيف لا إيمان لكم؟؟“ أما هم فأطرقوا برؤوسهم إلى أسفل، في خجلٍ من عدم إيمانهم، وهم الذين تعجّبوا من الثناءِ الذي لقيه قائد المئة من يسوع، على إيمانه، متوهّمين أنَّ لهم إيماناً.. تركهم يسوعُ وعاد إلى مؤخّرة السفينة مرّة أخرى، بينما بدأت، في تلك اللّحظة، خيوط الإيمان الأولَى تتكَّون في قلوبهم، حينما أدركوا هشاشة إيمانهم، وتيقّنوا من سلطان يسوع الكامل، حتى على الطبيعة.. الإيمان لا يبدأ في ولوج القلب قبل أن يتيقّن الإنسان من هشاشته، بقدر يقينه من قدرة الله وسلطانه |
||||

|
|
|
رقم المشاركة : ( 23 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
القلق من الغد فلا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره (مت 6: 34) لقد أصبح القلق سِمة نفسيّة للعصر الحالي، والغد هو الرُّعب الأكبر الذي يرهبه الجميع!! يلتقيه البعض بنظرة تشاؤميّة تعكس آلامه الداخليّة، ويستقبله آخرون وهم مذعورون من نَسَمَات هبوبه على الحاضر، ويحاول الكثيرون الهرب من الغد بالانغماس في لذّة اللّحظة الحاضرة؛ إذ” يحسبون تنعُّم يومٍ، لذّة..” (2بط 2: 13)، وكأنَّ اللّذة هي دواء القلب المريض والذهن المُنجرِح بخوف الغدّ!! بيد أن القلق من الغد هو في جوهره بمثابة فقدان للثقة فيمَنْ يبعث لنا بالغدِ، في رسالة الحياة المتجدِّدة كلّ صباح. الخوف من الغد هو يعني خوفٌ من الله الذي يَدفَع لنا بالغد، وكأنّه عطيِّة مُفخَّخة، حالما تَصِلنا، تنفجر في وجوهنا!! هذا لأننا لا نسأل السؤال الصحيح في أغلب الأحيان، إذ نتساءل: ما الذي سيحدث؟؟ ولكن السؤال ينبغي أن يكون: مَنْ الذي سيُحْدِث؟؟ ولعلّ هذا الخوف غير المُبرَّر من الله!! ينبع من شعورنا بالخوف من عواقب يومنا.. شعورنا بالألم من نتائج أخطائنا، وكأنَّ الله يدفع بالغد ليؤدِّبنا ويعاقبنا على يومٍ تلوّث بالخطيئة!! إن لطف الله وإمهاله إنما يقتادنا للتوبة، بحسب ما أكّد لنا القديس بولس، لذا فالغد هو تعبير عن لطف الله ومحبّته المتأنيّة، إنه فرصة مُتجدِّدة لتصحيح أخطاء اليوم، ولتعديل مسار الحياة، ولقبول الله من جديد، ولتحويل الزمن الحاضر إلى ميراث أبدي. بل إنّ الغد هو فرصة ثمينة لنا لتحويل العالم الشاحب، من خلال إطلاق نور الثالوث، ليصير عَالمًا مُضيِئًا وهّاجًا بضياء الأبديّة. والله لم يكن يومًا جلاّدًا قاسيًا يبعث لنا ببرقيّات تهديد ووعيد على أجنحة الغد، فهو إله تُحرِّكه على الدوام، قوى الحبّ الذاتيّة في طبيعته، الحبّ الذي لا يتوقّف من نحونا، حبُّ يصفح عن كلّ أخطاء اليوم المنقضي، ويغفر كل تعديّات الحاضر الساقط في آبار الظلمة. ولنتذكّر كلمات القديس بولس الذي قال:” ونحن أعداء قد صولحنا مع الله، بموت ابنه” (رو 5: 10). فعداوة البشرية لله بالسُكْنَى في أودية الشرّ، لم تمنع الله من التجسُّد وقبول الموت من أجل أولئك الذين أرادهم بنينًا أحرارًا من قيد الخوفِ والقلق والمستقبل. فبالتجسُّد أصبح المستقبل يعني حركة إيجابيّة نحو الأبديّة. وقد يتساءل البعض، عن النصوص المليئة بالتحذيرات الإلهيّة، إنْ لم نرجع عن طرق الشرّ؟؟ إن تلك البرقيات الإلهيّة، هي تحذير بأنّ عاقبة الخطيئة من داخلها، ونتائجها من داخلها. الخطيئة تمامًا كالنّار التي تظل تضطرم من ذاتها وتحرق كلّ ما يمّسها. ومن يضرم النار، بالخطيئة، لا ينبغي أن يصرخ في الله لماذا الألم؟؟ وكأنّ الله مصدر للألم فـ”لاَ يَقُلْ أَحَدٌ إِذَا جُرِّبَ إِنِّي أُجَرَّبُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ، لأَنَّ اللَّهَ غَيْرُ مُجَرَّبٍ بِالشُّرُورِ وَهُوَ لاَ يُجَرِّبُ أَحَداً “(يع 1: 13). إذ أنّ الألم والقلق والاضطراب يستدعيه الإنسان بذاته حينما يستدعي طيف الخطيئة ويستظلّ به.. فالخطيئة مصدر كلّ قبحٍ وتشوُّشٍ وقلقٍ في الكون. إنّ أعظم تأديبٍ قد يصيبنا من الله هو أن يتركنا لنتائج خطيئتنا داخليًّا وخارجيًّا؛ ولكنّه إذ يعاملنا بعين الأبوّة ينتهج معنا منهج الجرح والعصب، السحق والشفاء. فما من ضربة تصيب أولاد الله إلاّ ويصاحبها ضمادة إلهيّة وحضن دافئ ليؤكِّد، في خضمّ ألمنا، أنّه محبّة. لذا فإنّ مَنْ يرفض الله يرفض عونًا ونعمةً ومعيّة ترافقه على درب الحياة فيكون عرضة أكثر من غيره للألم جرّاء ما يلاقيه من أحداث، بينما معيّة الله، لمن يقبله كلّ يومٍ بتجديد عهد العلاقة معه، قلبيًّا وذهنيًّا وإفخارستيًّا.. تجعله أكثر صمودًا وقوّة على مواجهة الحياة، بل وتجعله ينعم بسلامٍ وإن كان الأتون متصاعد اللّهب؛ فالسلام والراحة هي موقف داخلي لا يعني ورديّة الحياة الخارجيّة، ولكن بالأحرى، تلقِّي آلام الحياة على” أيدي النعمة” التي تمتص الصدمة عن الإنسان وترشده لكيفيّة التعامل معها للخروج دون خسائر تلمس روحه. إنَّ القلق من الغد لو استولَى على إنسانٍ ما، قد يتحوّل إلى مرضٍ يمنعه من اتّخاذ أيّ قرارٍ في حياته. وقد يمنعه من العمل بإيجابيّة من أجل مستقبله؛ لذا فهناك فرقٌ كبيرٌ بين التفكير في الغد والقلق من الغد. التفكير في الغد أمرٌ إنسانيٌّ طبيعي بل وضروري، فيجب على الإنسان أنْ يُخطِّط لحياتِه بشكلٍ مُنظَّم، ويَحْلُم بغدٍ يحمل له بركات اليوم المغمور في العمل. ولكنَّ القلق من الغد هو التحوُّل المَرَضي من التفكير السوي إلى التفكير المريض.. من التفكير الإيجابي إلى التفكير السلبي.. هذا ويجب علينا أن ندرك: إننا لا نستطيع أن نغيِّر الغد بالقلق، ولكنك تستطيع أن نغيِّره بالعمل الجّاد، والطموح الصادق المرتكز على الأعمال لا نتائجها. ولعلّ كلمات المسيح هي أبلغ ردٍّ على الذين يُكبِّلهم القلق بقيوده الحديدية. ها هو يقول: ” ومن منكم إذا اهتمّ، يقدر أن يزيد على قامته ذراعًا واحدةً” مت 6: 27 وكأنّه يقول لنا اليوم:
إنَّ الغد دائمًا هو وليد اليوم؛ فعمل اليوم نحصد ثماره في الغد، وكسل اليوم نجني ثماره أيضًا في الغد. فلو كان يومك يفوح منه شذى العمل الجاد المُخْلِص (في أيّ مجالٍ، وفي كلّ مجالٍ) الحالِم بغدٍ أفضل، سيحمل لك الغد بالفعل؛ البركة والبهجة والسلام والأمان، داخليًّا، وإن كانت براكين العالم تقذف حممها من الأحداث المُضْطَرِبة والمُقلقة، ولكن إنْ كان يومك أسيرُ الرقاد واليأس واللّهو سيحمل لك الغد، القلق والخوف والشكوك.. ولكنه في جميع الأحوال فرصة ثمينة، للتنعُّم ببركات اليوم المثمر أو لتعديل نتائج اليوم العاقر.. إنّه فرصة لا تتكرّر كثيرًا.. وما يعبر لن يعود من جديد.. فليكن لنا الغد تلاقٍ مع الثالوث، ولقاءَ مع الإنسان، في ثوب الحبّ الفاعل والنابض بالحياة.. |
||||

|
|
|
رقم المشاركة : ( 24 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
المسيحية المعاصرة هناك مَنْ ينظر للماضي وكأنّه قممٌ من جليدٍ متجمِّدٍ لم تعبر عليه شمس التجربة الإنسانيّة.. وكأنّه خيوطٌ أسطوريّةٌ في رداء التاريخ الوهمي الذي نسجته قريحة الشعوب القديمة. وفي المقابل، هناك مَنْ يرَى في الماضي رمادًا ذُرَّ في فضاء التاريخ.. رمادًا لا قيمة له في الحاضر، فاليوم هو الحياة، وكلّ وافدٍ من الأمس، هو ابن قبور الماضي التي لا يجب أن تُفْتَح من جديد. ولعلّ مسيحنا الذي نرَى فيه الله حيًّا مُتحرِّكًا متلامسًا معنا، قد طاله، من قِبَل العالم، ما طال التاريخ من الإسقاط الأسطوري، أو من التهميش التاريخي، وكلاهما كانا بمثابة محاولة مغرضة لعزلنا عن مسيحنا، ومن ثمّ مسيحيّتنا، لإغراقنا في مياه الحيرة أمام دعوتنا الإلهيّة. يحاول العالم الآن أن ينال من المسيح من خلال البحث في التاريخ الممتد عبر إحدى وعشرين قرنًا. لم يستطيعوا أن يصمدوا أمام بهاء الربّ يسوع وشريعته، فبحثوا عمّن دُعوا على اسمه لعلّهم يجدوا في تاريخهم ما يلقون بأضواء ظلمتهم عليه!! ولكن هل كلّ مَنْ يُدعَى مسيحيًّا يحيا حسبما أوصَى الربّ يسوع، وحسبما يُرشِد الروح؟ بالطبع لا. لذا فإنّ مَنْ يريد أن يواجه المسيحيّة يتوجّب عليه مواجهة المُخلِّص، لا مَنْ تسمّوا باسمه، فهناك مسيحيّون اسمًا بينما قلوبهم لم تتشكَّل على تعاليمه بعد. فاسم الله يُجدَّف عليه بين الأمم بسبب أفعال البعض، تلك كانت كلمات القديس بولس في رسالته إلى الرومان. “كيف أصبح مسيحيًّا؟” كان هو السؤال الذي ردَّده الفيلسوف الدنماركي كيركجارد في كتابه “وجهة نظر” الذي أصدره عام 1849، بل وذهب إلى أن نتاجه الفكري كلّه ليس إلاّ محاولة لفهم كيف يصبح مسيحيًّا. ولعلّ هذا السؤال يراود الكثيرين الآن وخاصة في زمن اختلاط القيم والمبادئ والثقافات.. زمن عولمة الذهن والقلب.. إذ تمّ الخلط عند البعض بين المسيحيّة من حيث هي عَلاقة شخصيّة / ليتورجيّة مع الله، وبين المسيحيّة من حيث هي ديانة بعض الشعوب وميراثهم الفكري والثقافي والحضاري. ذلك الخلط بين المسيحيّة / العَلاقة وبين المسيحيّة / الأيديولوجيّة جعل من الواقع لونًا رماديًّا لا نلمح فيه الخطوط البيضاء أو السوداء بسهولة، وبالوعي المُجرَّد. ولعلّ المسيحيّة / الأيديولوجيّة كانت السبب المباشر في العزوف عن الدين الذي مازالت تعاني منه المجتمعات الأوروبيّة حتّى الآن، حتّى إن البعض يرى أن أوروبا الآن تعيش في مرحلة “ما بعد المسيحيّة” أو مرحلة “عولمة الدين”. كانت محاولة الفصل ما بين المسيحيّة والمجتمع هي ما دعت إليه أستاذة الفلسفة مارجريت نايت في محاضراتها الشهيرة التي قدّمتها بالإذاعة البريطانيّة في خمسينيّات القرن الماضي والتي حملت عنوان: “أخلاق بغير دين”. وقد دعت فيها إلى إمكانيّة قيام أخلاق وضعيّة تحكم السلوك وتوجِّه سير الحياة دون الحاجة إلى الاسترشاد بالمبادِئ والقواعد الدينيّة أو الخضوع لتعاليم الكنيسة!! من هنا ظهر الشعار الذي رفعه دعاة مذهب الحداثة القائل: “إذا أردت أن تكون معاصرًا للحداثة فعليك أن تقول وداعًا للدين”. وقد نشأ في الكنيسة الكاثوليكيّة، كرد فعل، ما يُسمّى بـ“يمين الحداثة” وهو قَسَمٌ يؤدّيه الإكليروس على مختلف فئاتهم، فضلاً عن أساتذة اللاّهوت، وفيه يدينون كلّ ما يتعلّق بالحداثة، وقد كان هذا القَسَمُ معمولاً به حتّى المجمع الفاتيكاني الثاني. مذهب “الحداثة” قائمٌ على الإيمان بكلّ ما هو قابل للاختبار والمُشاهدة.. قائمٌ على العِلم الذي تفجّرت ينابيعه بالثورة الصناعيّة. والحداثة ترى أنّ الكون محدود لذا من الممكن معرفته؛ فالنظريات العلميّة وحدها هي مصدر الحقيقة، لا وجود لما لا يخضع للنظريّات العلميّة.. لذا لا وجود لعالمٍ آخر!! وقد انسحب هذا الفكر على المجال المسيحي والذي كان الألماني شليرماخرSchleiermacher (1768-1834) رائدًا فيه. فقد رأى أن فكرة الخلق من العدم، والأعمال المعجزيّة الواردة في الكتاب المُقدَّس فضلاً عن الميلاد البتولي للعذراء، هي أمور غير مقبولة علميًّا ومن ثمّ يجب أن تُرفَض!! ودعا إلى إعادة هيكلة الوعي والفهم الديني استنادًا إلى العلم!! ظهر بعده الألماني ألبرخت رتشيلAlbrecht Ritschl (1822-1889) والذي نادَى بالحفاظ على البذرة المسيحيّة والتخلُّص من القشرة. والقشرة، في رأيه، كانت أنّ المسيح إله!!! وفي القرن العشرين هاجم الأمريكي هاري إمرسون فوسديك Harry Emerson Fosdick، الميلاد البتولي، في كلمته التي بعنوان “خطر التعبُّد ليسوع”، وقدَّم وثيقة وقَّع عليها ألف ومائتي راعٍ معمداني، مفادها أنّ الميلاد البتولي والمسحة والقيامة ليست من ضروريات المسيحيّة!! لقد ظهرت الحداثة كردّة فعل عنيفة على كلّ الثوابت التي طالبت بها الكنيسة الغربيّة، المجتمع، عبر عِدّة قرون ممّا حال دون التقدُّم والبحث. ولعلّ الشعور بأنّ الإيمان المسيحي ضِدّ العلم كان نتاج بعض الحوادث التاريخيّة التي جرت في أوروبا في العصور الوسطَى نتيجة ارتباط السلطة الدينيّة بالسلطة المدنيّة. ظهر تيار جديد بعد “الحداثة” هو “ما بعد الحداثة” وهو التيار الذي يرفض كلّ تحديد؛ فالحقيقة ليست كونيّة وليست مطلقة وليست قابلة للفهم، كما أنّ اللُّغة لا تُعبِّر عن الحقيقة لأنّها جزئيّة.. ولأوَّل وهلة تبدو تلك الأفكار مقبولة عن التحديدات التي فرضتها الحداثة من خلال رفضها الإيمان بكلّ خيط لا يعبر على التجربة والمشاهدة، إلاّ أنّ “ما بعد الحداثة” أنتجت ما يمكن أن نطلق عليه “ميوعة فكريّة”، وهو الذي تبنّته بعض الكنائس اللّيبراليّة في الغرب، متنصّلة من كلّ تحديد عقائدي أو حتّى أخلاقي!! هنا ونجد أنّها كانت بمثابة محاولة لرأب الصدع بين الأفكار والعقائد والمذاهب المتباينة ولكن من خلال تجريد الإنسان من أيّة قناعة ذهنيّة وفكريّة وروحيّة وهنا الخلط بين ضرورة أن يكون للإنسان عقيدة، وبين الصراع مع مَنْ يخالفون العقيدة.. لقد أجرت مجلّة التايمز حوارًا مع أحد هؤلاء الذين آمنوا بـ“ما بعد الحداثة” ويُدعَى برايان ماكليرين والذي طبّق مفاهيم ما بعد الحداثة على الإيمان والحياة المسيحيّة، وحينما كان السؤال عن موقفه من المثليّة الجنسيّة كان ردّه “أنا لا أستطيع أن أجيب لأنّ أيّة إجابة ستجرح فردًا ما”!! وفي موضعٍ آخر أجاب: “يمكننا أن نكتشف الأمر بصورة أوضح بعد خمس سنوات”!! إيمان ما بعد الحداثة هو إيمان لا يُفرّق بين الصواب والخطأ، بل ويرفض كلّ تحديد وتصنيف أخلاقي للصواب والخطأ تاركًا إياه للمجتمع المدني. وهو بمثابة تنصُّل من المسؤوليّة المسيحيّة والشجاعة المسيحيّة في الإعلان عمّا نؤمن به وإن لم يلق استحسان البعض. ولعلّ خطورة الأخلاق المجتمعيّة تكمن في أن المجتمع يُجدِّد قيمه بين الآن والآخر تبعًا لقانون الإنتاج والاستهلاك المُتحكِّم في أيديولوجيّات الشعوب الآن والخاضعة لرغبة الحكومات في تجنيد الأخلاق لصالح الإنتاجيّة؛ فمثلاً الزنا ليس إشكاليّة ولكن الكذب إشكاليّة في تلك المجتمعات، لأنّ الكذب يُهدِّد منظومة الإنتاج. لذا لن تكون هناك ثوابت أخلاقيّة وهو ما يُنبـِئ بسقوط وانهيار تلك المجتمعات عينها. تلك بعضٌ من الأفكار التي تتحكّم في العقليّة المعاصرة، وهي تتأرجح أو قل تترنّح ما بين الأخلاق اللاّدينيّة، والحداثة الآمنة في أحضان النظريات العلميّة، والميوعة الفكرية والعقائديّة الناتجة عمّا بعد الحداثة، وهو ما دفع ألبير كامو ليقول: “إنّ العقل الحديث يعاني من تشوُّش، لقد امتدّت المعارف إلى مدى أصبح فيه من الصعب على العالم أو الذهن أن يجد موطئًا لقدم، إنها لحقيقة أننا نعاني من العدميّة!!” كان مُحصِّلة هذا التشوُّش أنْ ابتعدت العقليّة المعاصرة عن الله لأنّه غير خاضع للقياس العلمي.. كما توجّست من إقامة عَلاقة معه لئلا تقع أسيرةً لقيود أخلاقيّة تستلزمها تلك العَلاقة.. لذا فإنّ العقليّة المعاصرة يبدو وكأنّها تائهة في آفاقٍ بلا عودة.. المشكلة المعاصرة تكمن في الخلط بين الحياة داخليًّا والحياة خارجيًّا.. الخلط بين الإيمان بالأبديّة والعمل في دائرة الزمن.. بين الروح والجسد.. إنها من جديد مشكلة الخلط بين المسيحيّة / العَلاقة والمسيحيّة / الأيديولوجيّة.. ومن اللاّفت للنظر أنّ المسيح لم يستخدم كلمة “ديانة” مُطلقًا في الأناجيل الأربعة. في المقابل كان مطلبه هو الإيمان به حتى يستطيع البشر أن يخطو أولى خطوات نوال الخلاص؛ « مَنْ يؤمن بي ولو مات فسيحيا ». هنا ويتساءل البعض: هل جاء المسيح ليؤسِّس دينًا وضعيًّا يُعنَى بالنُظُم الأرضيّة تفصيلاً، وهل جاء المسيح ليضع بعض القواعد الأخلاقيّة التي تحكم العَلاقات؟ هل جاء ليوصِد أبواب المعرفة والانطلاق العلمي لصالح الأبديّة؟ هل كان الإيمان يتعارض مع الثورة العلميّة المعاصرة؟؟ وقال له واحدٌ من الجمع: يا مُعلِّمُ، قل لأخي أن يقاسمني الميراث فقال له: يا إنسان، مَنْ أقامني عليكما قاضيًا أو مُقسِّمًا؟ وقال لهم: انظروا وتحفَّظوا من الطَّمع فإنَّه متى كان لأحدٍ كثيرٌ فليست حياته من أمواله (لو 12: 13-15) لقد جاء المسيح ليُحرِّر الإنسان من ربقة الفساد الذي يحيله إلى ترابٍ يومًا بعد يوم. والحريّة هي الغذاء لإعادة البعث الباطني (المتولِّد من فطرة الإنسان الجديد) لتلك الأخلاق الظاهريّة (الاجتماعيّة)، تلك التي لا تنبت من أرضٍ ارتوت بالفداء الإلهي. لذا فإنّ الكتاب المُقدَّس غير معني بحركة العلم صعودًا وهبوطًا.. لا يدينها ولا يُكبِّلها.. فالكلمة الإلهيّة معنيّة فقط بروح الإنسان ونقاوتها. |
||||

|
|
|
رقم المشاركة : ( 25 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
مصطلح "آباء الكنيسة".. هل من أصول؟؟ كانت هناك قاعدة في المجامع التي تلت مجمع نيقيه وهي: “إن قانون إيمان مجمع نيقيه كافٍ للحُكْمِ على أرثوذكسيّة أي تعليم”. كما كان القديس كيرلس الكبير كثيرًا ما يستهلّ كلماته بالعبارة الآتية: “آباؤنا المغبوطون علّمونا”. لقد أراد بهذه العبارة التأكيد على أنّه لم يأتِ بجديد، وأنّ ما يعيد صياغته وفقًا لمتغيّرات عصره لم يخالف ما تسلّمه، ولكنه يبني عليه. فالبناء الآبائي قائم على أساس واحد هو المسيح؛ رأس الزاوية. ولكن مَنْ هو المسيح؟ فَهْمُ المسيح هو ما كان يحميه الآباء من تشويهات الهراطقة وادعاءات الجهَّال، « كي لا نكُون فيما بعد أطفالاً مُضطربينَ ومحمولينَ بكلّ ريح تعليمٍ، بحيلة النّاس، بمَكْرٍ إلى مَكيدة الضَّلال » (أفسس 4: 14). لم يكن تعبير “الآباء” وليد الصدفة؛ فلقد أسميناهم آباء لأنهم ولدونا من الروح في المسيح من خلال كرازتهم وتعاليمهم، وبذلك صرنا أبناء شرعيين لآباء شرعيين أجمعت عليهم الكنيسة، لا كالهراطقة الذين وَلَدوا لهم بنينًا من رحمٍ آخر غير كلمة الله الحيّة والباقية إلى الأبد. كثيرًا ما نقرأ في كتابات الآباء العبارات التالية: نحن نؤمن.. كما قال المسيح.. كما تسلّمنا من الرُسُل.. كما تؤمن الكنيسة.. كما تُعلِّم الكنيسة.. إلخ، وهي كلّها عبارات تؤكِّد على أنّ الآباء لم يكونوا أفرادًا منعزلين يُخلِّقون إيمانًا ولاهوتًا، ولكنهم كانوا امتدادًا حيًّا لمَنْ سبقوهم، كما أنّهم بذارٌ حيّة لنا نحن الذين جئنا من بعدهم. لذا فقد كان لآبائنا، آباءٌ، تتلمذوا عليهم وقبلوا الروح من أفواههم. لم يبزغوا فجأة في سماء الكنيسة، ولكنّهم عرفوا كيف يتتلمذوا، لذا صاروا فيما بعد مُعلِّمين. إنّ الأمور التي نتعلّمها في الصبا تنمو مع النفس وتصبح معها واحدًا. فأستطيع هكذا أن أقول في أي مكان كان الطوباوي بوليكاربوس يجلس للتحدُّث. كما أذكر كيف كان يدخل ويخرج ويعيش، وأيًّا كان منظره الطبيعي ومحادثاته إلى الجماعة، وكيف كان يتكلّم على علاقاته بيوحنّا وبالآخرين الذين رأوا الربّ، وكيف كان يُذكِّر بأقوالهم، وما هي الأمور التي سمعها منهم بشأن الربّ ومعجزاته وتعليمه، وكيف حصل بوليكاربوس على كلّ ذلك من شهود عيان على كلمة الحياة، وكان يرويها وفقًا للأسفار المُقدّسة، وتلك الأمور أيضًا بالرحمة الإلهيّة التي صُنعت إليّ، أصغيت إليها بعناية، محافظًا على ذكرها، لا في الورقة، بل في قلبي. (القديس إيريناؤس) كانت عادة قديمة أن يكون المُعلِّم أبًا لتلاميذه، لذا فقد خاطب القديس بولس أهل كورنثوس في رسالته الأولى قائلاً: « لأنّه وإن كان لكم ربواتٌ من المرشدين في المسيح، لكن ليس آباءٌ كثيرون. لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل » (1كو4: 15). من يتعلَّم من فمٍ آخر، فإنّه يُدعَى له ابنًا، كما يُدعَى الأخير له أبًا (القديس إيريناؤس) والآباء هم الأقرب زمنيًّا لعصر المسيح، يفصلهم عنه بضعة أجيال. منهم مَنْ تتلمذ على تلاميذه المباشرين وذهب ينقل الخبر والخبرة إلى الكنيسة، ومَنْ صار منهم مُكرَّس القلب والذهن تسلَّم من التلاميذ عصا الرعاية، لتبقَى الخبرة منقولة فمًا لأذن، لتشرح وتُفسِّر ما يختلط على البعض من نصوص دوّنها التلاميذ الأوائل. الكلمات وليدة النفس. لذا ندعو أولئك الذين علّمونا، آباء.. وكلّ من تعلَّم هو بمثابة ابن لمعلِّمه (كليمندس السكندري) إنّ البعض يتردَّد في قبول مصطلح الآباء استنادًا إلى كلمات الإنجيل القائلة: « ولا تَدْعُوا لكم أبًا على الأرْضِ، لأنّ أباكم واحدٌ الذي في السّماوات » (مت23: 9). وهذا يدفعنا للتساؤل عن مخاطبة الآباء الجسدانيين بهذا اللّقب؛ فمَنْ منّا لم يدعُ أباه الجسدي: أبي!! هل في هذا النداء الحميمي والذي يُوصِّف العلاقة بين الابن والوالد ما يُناقِض تعاليم المسيح؟؟ إنّ هذا الأمر يلقي بظلاله على إشكاليّة الفهم الحرفي للنصوص الكتابيّة والذي يُصدِّر وجهًا للمسيحيّة به سمات الأصوليّة. ومَنْ يقرأ السياق الذي وردت فيه كلمات المسيح يُدرِك تمامًا أنّ الخطاب كان موجّهًا للكتبة والفريسيين نقدًا وإدانةً لممارساتهم الزائفة؛ فهُم يُحبّون أن يظهروا في الطرقات بملابسهم الفخمة وأهدابهم الطويلة وعصائبهم العريضة على جباههم، ليدعوهم الناس: سيّدي سيّدي “رابي رابي”، إرضاءً لغرورهم الزائف. لذا كانت كلمات المسيح واضحة وقاطعة أنّ المُعلِّم والسيِّد هو المسيح الواحد مع الآب، ومن الآب تستمد كلّ أبوّه قيمتها. كما يُوجد فارقٌ كبيرٌ بين مَنْ يمشي بصولجان العظمة ليستقطب مديح وإعجاب وتكريم الآخرين، وبين مَنْ نالوا التكريم بعد نياحتهم. فتقنين مُصطلح “آباء الكنيسة” جاء في مرحلة لاحقة بعدما انتقل هؤلاء الآباء إلى الأقداس العُليا، وتمّ تقييم تعاليمهم على ضوء الإجماع الكنسي ونقاوة الحياة. هناك دائمًا خلط يحدث حينما يُستخدم التعبير بمعنَى مزدوج؛ فمثلاً نجد أن المسيح أعلن عن نفسه كـ“نور العالم”، ولكنّه دعَى المسيحيين أيضًا “نور العالم” هل هذا يعني أنّ المسيحيين متطابقين مع المسيح؟ بالطبع لا. كذلك نجد أنّ المسيح هو “الكرمة الحقيقيّة”، والعذراء تُلقِّبها الكنيسة بـ“الكرمة الحقيقيّة”، فهل العذراء مساوية للمسيح؟ بالطبع لا. لذا من الضروري أن نُفرِّق بين التعبير النسبي والتعبير المطلق لنفس الكلمة، لنستطيع أنْ نتعرّف إلى فكر المسيح المُدوَّن في الكتاب المُقدَّس. يروي لنا جان بوتي في كتابه “الله أبونا” أنّ الرابيين أرسلوا إلى رابي حنّان حفيد رابي هوني، لكيما يُصلِّي من أجل الأمطار، فلما جاءه التلاميذ أمسكوه من أهداب ثوبه قائلين: “أبَّا أبَّا، أعطنا المطر!” فما كان منه إلاّ أن صلَّى قائلاً: “يا سيّد الكون، افعل هذا لهؤلاء الذين لا يعرفون أن يميِّزوا ‘الأبَّا’ الذي يستطيع أن يمنح المطر، و‘الأبَّا’ الذي لا يستطيع.” فالاثنان آباء؛ ولكنّ ما بين أبوّة الله وأبوّة البشر بونٌ شاسع. وفي التقليد اليهودي نجد أنّ مُصطلح “الآباء” نعني به، بالدرجة الأولى، الآباء الأُوَّل؛ إبراهيم واسحق ويعقوب، فضلاً عن الآباء القدامَى الذي جاء ذكرهم في المشناه اليهوديّة تحت عنوان أقوال الآباء Pirqe Aboth. وفي العهد الجديد نجد أنّ داود هو « رئيس آباء » (انظر: أع2: 29). كما كان كلّ الشعب الفار من مركبات فرعون هم أيضًا « آباء » (انظر: 1كو10: 1). وفي المشناه اليهوديّة، كان اللَّقب الذي يُدعَى به كلّ من شمَّاي وهلِّل صاحبي المدرستيْن الأشهر في التأثير على المجتمع اليهودي قبل ولادة المسيح هو: “آباء العالم”، وهو نفس اللَّقب الذي أُطلق على رابي عقيبا ورابي إسماعيل فيما بعد. وقد كان لقب “أب” يُعطَى لمؤسّسي المدارس اليهوديّة من الرابيين الكبار حسبما جاء في تفسير Pulpit على إنجيل متّى. وبحسب الموسوعة اليهوديّة، كتب سولومون شختر Solomon Schechter وكاسبر ليفياس Caspar Levias أنّ موسَى يُدعَى “أبو الحكمة / أبو الأنبياء” كما كان رابي هوشعيا “يُدعَى أبو المشناه”. لذا فالأبوّة التي رفضها المسيح هي الأبوّة المذهبيّة والتي تنتمي لأحد المدارس اليهوديّة القديمة، تلك التي كانت تستقطب اليهود لتعيد صياغة فهمهم لنصوص العهد القديم وأوامره ونواهيه. لذا فرّق المسيح بين ما هو من موسَى وما هو من الآباء؛ « لهذا أعطاكم موسَى الختان، ليس أنّه من موسَى بل من الآباء، ففي السبت تختنون الإنسان » (يو 7: 22). وفي الخطبة التي ألقاها الشهيد إستفانوس قبيل استشهاده، دعى الحاضرين: « الأخوة والآباء » (انظر: أع 7: 2)، وهو نفس التعبير الذي استخدمه القديس بولس (انظر: أع 22: 1). كما ذكر القديس بولس والقديس يوحنّا، «الآباء»، في سياق الحديث عن العَلاقة بين الأب وبنيه (انظر: أف 6: 4؛ 1يو 2: 13-14). ومن الشهادت المُبكِّرة، نقرأ في وثيقة “شهادة بوليكاربوس” (70 م. - 166 م.) أنّ بوليكاربوس دُعي “أبو المسيحيين”؛ كما كان يُخاطِب أوريجانوس، بعض الأساقفة بكلمة “بابا”، في حوراه مع هيراقليدس، وهو التعبير الذي أصبح يُعبِّر عن البطريرك السكندري أولاً، ومن بعده الروماني، حسبما جاء في “موسوعة المسيحيّة” The Encyclopedia of Christianity في جزئها الأوَّل. ويُحدِّث كليمندس الروماني، الكورنثيين، داعيًا إياهم للعيش في وئامٍ؛ “متناسين الإهانات، سالكين في المحبّة والسلام، ثابتين على الرصانة، في كلّ ظرفٍ، نظير آبائنا (يقصد الرسل) الذين أظهرنا لكم مَثَلَهم”. ومن الجدير بالذكر أنّ تلك الكلمة كانت مُستخدمة في دوائر تعليم الفلاسفة مثل؛ فيثاغورث وسينيكا. يُطالِعنا ديفيد ل. هولمز David L. Holmes بعنوان لمقالٍ مثير للدهشة: “هل لقب الأب / الأم يصلح للقادة البروتستانت؟” وهو المقال الذي نشره في عدد ديسمبر من دوريّة “القرن المسيحي” The Christian Century. ومن اللاّفت للنظر أنّه أكّد، في المقال، أنّ بعض الكنائس البروتستانتيّة في بداياتها التكوينيّة أطلقت على مؤسِّسيها لقب “أب” ومنهم جون ويسلي مؤسِّس الميثوديست والذي أطلقوا عليه لقب “الأب ويسلي”. ويكمل في مقالاته أنّ لفظة “أب” قد تلاشت من القاموس البروتستانتي الحديث كنتيجة لحصول القادة البروتستانت على درجات علميّة فصار لقب من حصل على الدرحة العلميّة؛ “دكتور” وجاءت كلمة “راعٍ” لتتماشَى مع السند الكتابي الذي يبحثون عنه في مواقفهم وقناعتهم الإيمانيّة، حسبما كتب. وفي بحثنا عن استخدام الكلمة بين الجماعات البروتستانتيّة يجب أن نُراعي أنّ المواقف البروتستانتيّة مختلفة من طائفةٍ لأخرى ومتباينة من مجتمعٍ لآخر، فاللّفظة تبقَى خيار الجماعة وليست قانونًا يسري على الجميع. من هنا يمكننا أن نلمح أن الرفض المعاصر لكلمة “أب” لم يكن موقفًا أيديولوجيًّا بروتستانتيًا منذ عهد التأسيس ولكنّه تحوُّلٌ حديثٌ نسبيًّا، ممّا يغلق الجدل حول إمكانيّة استخدام الكلمة من عدمه. فالإشكاليّة البروتستانتيّة مع الآباء هي في دور الأب في الكنيسة ومدى “سلطة” كلماته في التعبير عن الإيمان والحياة. |
||||

|
|
|
رقم المشاركة : ( 26 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
هل لصلاتك قوة مغيِّرة؟؟ صلاة الإيمان بها قوّة هائلة كفيلة بأن تَدْفع العالم كله باتجاه الله إن الكثيرين حينما يصلون، يرددون كلماتَ من أجل إراحة الضمير المُثقَّل بالخطيئة، والذي لا يهدأ حتى يُكمِّل الجسد فريضته الغائبة؛ الصلاة!! وهذا التعوُّد على الصلاة، الخارج من عباءة نخس الضمير له فائدة في البدايّات الروحيّة، حينما يحاول الإنسان تكوين عادة الصلاة بشكل يومي، لتسير بالتوازي مع متطلّبات الإنسان الأوليّة، من طعام وشراب وعمل وراحة. ويصبح غذاء الروح ضرورة يوميّة، نستشعر بغيابه حينما تتوقّف الصلاة، ونستشعر بتأثيره حينما نُتمّم الصلاة، هذا هو مفهوم التغصُّب الروحي أو مجاهدة النفس.. ولكن الصلاة أعمق من هذا بكثير.. إنها حوارٌ شخصيٌّ للغاية مع كائنٍ آخر، حاضرٌ في العالم، ومُحرِّك للعالم بشكل غير منظور، ولكنّه ملموس، ومُدرَك بالحدس الإنساني الفطري. وهذا الكائن الإلهي الذي نخاطبه، الله الثالوث، يتميّز بخاصيتيْن في منتهى الأهميّة وهما: الإنصات والاستجابة لذا فإن كل صلواتنا التي يصعدها الروح إلى السماء، هي صلوات مسموعة من الله، لا يطالها النسيان، لأن ذاكرة الله لا تمتلئ ولا تُجهَد ولا تَشيخ. كما أن أية صلاة نُصْعِدها إلى السماء، بأشواق محبّتنا، وصرخات احتياجنا، واتضاع أرواحنا، يختم الله عليها بخاتم الاستجابة لا محالة ؛ أي أن أية صلاة نرفعها إلى العُلا تُولِّد ردّ فعل إلهي، إمّا بالموافقة أو الرفض أو التأجيل، ولكن دائمًا بالحب. لذا فمن الضروري أن نتيقّن أن صلواتنا ليست بخاراً يرتفع قليلاً ثم يتلاشَى في العدم الكوني، دون أن تصل إلى مسامع الله. وهذا اليقين، الذي يجب أن نحرص عليه قبل أن نرفع أية صلاة، يُدعَى الإيمان. وبدون إيمان، لا يمكن إرضاء الله، كما يؤكِّد القديس بولس في غير موضعٍ، ولا يمكن فهم وإدراك الاستجابة التي تحملها إلينا أيدي ملائكة مُرْسَلين لخدمة خلاصنا. وهذا الإيمان الذي يجب أن نتسربل به قبل الترائي أمام الله في الصلاة، هو الثقة أن صلاتنا، إن كانت صادقة، قادرة أن تُغيِّر الأمور. ولنا في ذلك مَثَلْ، وهو طلبة لوط من أجل قرية صوغر.. ” فقال لهما (للملاكيْن) لوط: لا يا سيّد هوذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك وعظّمت لطفك الذي صنعت إليّ باستبقاء نفسي وأنا لا أقدر أن أهرب إلى الجبل، لعلّ الشرّ يدركني فأموت هوذا المدينة هذه قريبة للهرب إليها، وهي صغيرة، اهرب إلى هناك. أليست هي صغيرة فتحيا نفسي فقال له: “إني قد رفعت وجهك في هذا الأمر أيضًا أن لا أقلب المدينة التي تكلمت عنها” (تك 19: 18-21) لقد طلب لوط من أجل مدينة صوغر ألاَّ يطولها نيران الغضب الإلهي كما كان مزمعًا أن يفعل مع سدوم وعمورة، فرفع الله وجهه، أي استجاب الله لطلبته، وعدَّل من خطّته من أجل طلبة لوط، ولم يُهْلِك تلك المدينة!!! وقد يقول البعض، أن تغيير خطّة الله لهو أمرٌ مستحيل لأن في ذلك انتقاص من إدراكه الكلِّي للأمور وكأنه يرهن مواقفه بالبشر!!! ولكن ما يعنيه الكتاب المُقدَّس بتعبيرات مثل رجع الله عن حمو غضبه، ندم الله عن الشرّ.. إلخ، أنّه أرجع الأمور إلى نصابها الصحيح بحسب مشيئته الصالحة، فالله لا يفرح بإيلام البشر وإبادتهم، ولكن ذلك يأتي في سياق تلاقٍ بين ما يعرف بالكوارث الطبيعية وخطيئة شعبٍ. فالله لا يتغيّر إذ أن المخطط الأصلي هو الخلاص، وحينما نصلي من أجل العالم، يستغل الله صلاتنا لكيما يعود إلى إطالة مساحة الأناة والصبر على البشريّة، حتى يرجعوا إلى منابع النور. من هنا يمكننا القول بأنَّ الله يترقب صلواتنا ولجاجتنا في الصلاة لكي ما يُغيّر العالم، الله يترقّب صلاة مدفوعة بقوة إيمان، حتى يرفع وجه قائلها، بل ويبتهج بمثل تلك الصلاة التي تترجّى خلاص الآخرين، وتتوسّل من أجلهم، تمامًا كما فعل إبراهيم مع الله حينما بدأ” يُفاصِل “!! (بحسب تعبيرنا الدارج) مع الله من أجل خلاص سدوم وعمورة، حتى وصل مع الله إلى اتفاقية، مَفادها أن وجود عشرة أبرار في المدينة سيكون كفيلاً بخلاصها من الهلاك المترصد إبادتها، إلا أن ذاك الزمان لم يكن زمان أبرار!! لأن الخطيئة تسلّلت إلى كلّ بيت وشوّهت كل جسدٍ، وأماتت روح الحياة في كل قلب. فكانت أمطار النار والكبريت، لتغسل الأرض من الخطيئة التي تعمّقت في تربة البشرية المخلوقة على صورة الله!!! وأيضًا نقرأ في قصة أبيمالك مع إبراهيم والتي وردت في الأصحاح العشرين من سفر التكوين ؛ أنَّ الله أرشد أبيمالك إلى الرجوع لإبراهيم لكيما يُصلّى من أجله”.. إنه نبيٌّ فيصلّي من أجلك، فتحيا“، ويخبرنا سفر التكوين في نفس الأصحاح عن تأثير صلاة إبراهيم:” فصلَّى إبراهيم إلى الله، فشفى الله أبيمالك وامرأته وجواريه، فولدن..”. الإنسان يصلي بينما الله يشفي، تلك هي المعادلة السليمة في فعل الصلاة واستحضار فعل الله في صميم العالم، ومن أجل العالم. إن للصلاة قوة عظيمة لإحياء العالم المحتضر على شفى الهاوية، فصلاتك من أجل العالم لن تعود فارغة، قد يكون لها صدى في مكانٍ ما من الأرض، وفي زمنٍ ما من الأزمنة، إلاّ أنها لن تعود فارغة. لو أدركنا كمسيحيّين أهميّة الصلاة من أجل العالم، وصلَّينا بالفعل من أجله كما ينبغي، لكانت تغيّرت خريطة العالم، ولكانت تغيّرت خريطة الخير والشر في العالم. إلاّ أن بعضنا تعوّد السلبيّة في علاقته بالعالم، إذ يدينه على أخطائه ولا يصلّي من أجله!! ونحن بذلك نكون قد أغفلنا أنّه هو العالم (البشريّة) الذي بذل من أجله، الله، ابنه الحبيب، لكي لا يهلك..” لأنه هكذا أحبّ الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبديّة” (يو 3:16) فهل تستطيع أن تترجم محبّة المسيح للعالم إلى صلاة وأنين لكيما يتذوّق معرفة النور الحقيقي عوضًا عن الظلمة التي يرتديها كعباءة. وهل لك إيمانَ أن صلاتك ستكون فارقة في حياة الآخرين، أم تكتفي بترديد العبارة التي تجعلنا نتلذّذ بسلبيّتنا تجاه العالم:” أنا خاطئ، فكيف تكون لصلاتي تأثير!! “ دعني أقول لك أن صلاتك من أجل خلاص الآخرين وصلاتك من أجل خلاصك هما في كفّة واحدة في ميزان محبّتك لله، مرتبطان بعضهم البعض ارتباطًا وثيقًا. فالذي يترجّى الخلاص لا يستطيع إلاّ أن يطلب من أجل العالم لكيما يخلص معه.. في كل عبادتنا الليتورجيّة نصلي من أجل نقاوتنا وتطهرنا ونصلي من أجل العالم أجمع، فما من انسكاب لروح الله للتطهير ومن ثمّ الإنارة، على قلبٍ انعزل في أنانيّة من دون العالم المتألم في ظلمته. صلاتنا من أجل العالم هي فعل حبّ متكامل الأركان. قد لا نرى نتائجها، ولكن لا يجب أن يحرك تحسس النتائج، صلواتنا، بل المبادئ الكتابية التي يحييها فينا روح الله بالفعل. وكما قال أحدهم: إننا سنترائى أمام الله، في السماء، كجمعٍ متشابك الأيدي، كلنا مرتبطون بعضنا البعض بالصلاة والحب فمَنْ يُحب الله ويتطلَّع للأبدية، سيُحب الآخرين ويتطلَّع أن يشاركوه نفس المصير المبهج. فالحب لا يعرف الـ(أنا) بل يعرف فقط الـ(نحن). صلِّ من أجل خلاصك وتوبتك كما تشاء، ولكن لا تنسْ أن تطلب من أجل خلاص العالم بإيمانٍ، أن صلاتك ستتجسّد توبةً في حياة شخصٍ ما على سطح هذا الكوكب. فقط صلِّ واترك النعمة لتعمل عملها فيك وفي الآخرين. |
||||

|
|
|
رقم المشاركة : ( 27 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
في ذلك الإنسان من وحي المعجزة الواردة في (متى 12: 10)، (مرقس 3: 1)، (لوقا 6: 6).. في السبت، يوم الراحة العظيم هناك في المجمع، حيث الجماعة منتبهة ومنصتة إلى التوراة والأنبياء حيث التسابيح وصلوات الشكر مرتفعة بمنتهى التدقيق هناك وفي زاوية مظلمة، كان يجلس رجلٌ قد جاء وسط الجمعُ التقي ليُصلِّي ويبارك الله و لكن يداه لم تكن قادرة أن ترتفع إلى العلاء فهي يابسةٌ فكانت صرخات قلبه يدين، تلامس ثوب السماء و كانت عيناه عصفورين، يهيمان في العلاء بحثاً عن شفاء كان يستمع بملء الإيمان إلى البحر الذي انشق و الأرض المبلّلة التي حملت الشعب الهارب على جناحيها حتى أفلتوا من أنياب فرعون الثائر و كان يُصلِّي: مَنْ لي بموسى آخر، يضرب بحار اليأس والألم من حولي؟ هل لي نجاة من فرعون المرض الذي يلاحقني؟؟ و دخل إلى المجمع رجلٌ، أشبه بملاك مُضيء و التقت فيه الأعين بينما الجميع في أماكنهم بلا حراك وقف على المنبر و كأنه قادمٌ للتو، بلوحي الشريعة من الجبل المقدس بدأ الكلام، فكانت كلماته أشبه بنارٍ هادئةٍ تذيب برودة الخطيئة من القلب، و تخيف ذئاب الألم واليأس التي تحيط بالنفس فتجري مهرولة إلى غابات الظلمة، لتختبئ من أعينه النارية كانت كلماته عن الحب والدفء كان يلامس أعماق الإنسان الثائرة.. الحائرة فيروّضها كان يزرع باقة من رجاءٍ حول القلب المنهك بالحزن كانت كلماته حيّة وفعّالة وخارقة للنفس كان الجميع هائمين في سماء كلماته لا يريدون النزول إلى أرض الناموس المُتشدّد الذي اختلقه فريسيو ذاك الزمان لا يريدون أن يتركوا ذلك العالم الجميل فدفء الحب فيه، هو السعادة المطلقة التي يبحث عنها الإنسان في سعيه على الأرض. بينما كان يسوع يعزف أنشودة الحب المختبئة في الكتب المقدسة كانت عيناه تجولان تصنع خيراً كانت نظراته ترياقًا لكسيري القلب ومنسحقي الروح و فجاءةً، توقفت عيناه على تلك البقعة المجهولة من الجميع نحو ذلك الإنسان، الذي لم يدرك أحد إنسانيته من قبل فقد كانوا منشغلين عن الإنسان بالحرف!! هناك، توقفت عينا يسوع و شاهد القلب الذي يدمي في وحدةٍ قاسيةٍ و كأنه في جزيرةٍ، لم تشرق عليها شمسٌ هناك، توقفت عينا يسوع وإلى هناك، التفت الفريسيون والكتبة تحوّلت أعين الجميع عن المنبر و التفتت نحو الإنسان هناك، في ذلك الإنسان الذي يلتمس معونة فلا يجد سوى همهمات يستجدي الحب فلا يجد سوى النصوص والأحرف المتراصة هناك، دارت المعركة في صمت الكلمات السبت أم الإنسان الشريعة أم الحياة الحرف أم الروح مدّ اليد للمعونة أم الاكتفاء برفع اليد في الصلاة!! هناك في ذلك الإنسان اصطدم الحب الغامر الذي جاء به يسوع للإنسان مع القسوة والتشدّد الذي اختلقه الإنسان لموت الإنسان هناك في ذلك الإنسان تسائل الجميع لماذا وجدت الوصايا والناموس والشريعة؟ هل خُلِقَت الوصايا على صورة الله الحرّ فصارت السيّد الذي ينحني أمامه الإنسان؟!! هل وُجِدَت لوأد جنين الحب في القلوب؟ و لزيادة العزلة بين الإنسان والإنسان و بين الإنسان وإله الإنسان؟! هل وُجِدَت لتزيد من قسوة الحياة و تقف شامخة في وجه البشرية في صراعَ بقاءٍ للأقوى؟! لمَنْ وُجِدَ ت الوصية؟ ومَنْ الذي أعطاها؟ أليس هو الله.. إله الحب والدفء والحنان ألم توجد خوفاً على الإنسان من أن يفقد إنسانيّته و يتحوّل من إنسان إلى حيوان يهيم في غريزة وخطيئة ويستوطن أرضًا تلتهمه غدًا في طوفان ألم توجد خوفاً على الإنسان من تخليق آلهة تشاركه فساده وانحرافه وقسوته فتخنق شعلة النور في قلبه وتذيبها ذوبان هناك في ذلك الإنسان كانت الرسالة للبشرية أن الحب هو مقياس الإيمان وقف ذلك الحطام الإنساني وسط الجميع و بدأ التحوّل يجري في القلب الوحيد الشريد فحُبّ يسوع خلق منه كيان و لكن.. هل يمد يده ويُشفَى في سبتٍ؟ هل يُدنّس السبت بقبوله الحياة في يده؟ هناك في أعماق ذلك الإنسان دار صراع آخر فشعاع نور حرية الحياة يريد أن يخترق ظلمة وضبابيّة قيد الحرف و انتصر الحب على السبت و امتدت اليد اليابسة امتدت يد البشرية بالعمل والحياة امتدت لتحتضن ولتساند ولتلامس الجراح الإنسانية امتدت منذ أكثر من ألفي عام و لم تيبس مرة أخرى فحينما تدنو منها تجربة الحرف وحينما تريد الحية أن تهمس في آذانها أن الله يريد مؤلّهي الحرف و متشدّدي الناموس و فريسيو الشريعة تنظر إلى يدها التي انتصرت على الحرف و تنظر إلى قلبها الذي يموج بالحب و تصرخ قائلة: سأحب.. سأحب.. سأحب فالحب يشفي من يحب و من يتقبل الحب |
||||

|
|
|
رقم المشاركة : ( 28 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
المزامير كخدمة تعبدية ونسكية لقد كان التسبيح بالمزامير، وسط الجماعة الرهبانيّة، ممارسة نسكيّة خارجيّة exterior هامّة للغاية، مع الصوم والسهر وحفظ الصمت، وكان يُؤكِّد على تلك الممارسات كلّ آباء البريّة تقريبًا، في نهاية القرن الرابع(1). فالتسبيح بالمزامير هو الممارسة التي تشغل يوم الراهب بأكمله، فقد كان السهر (الذي كان يقضيه الراهب، غالبًا، في ترتيل المزامير) مُحدَّدًا بتلك السواعي التي كان من المفترض على الراهب أن ينام فيها، كما كان الصوم مرتبط بالوقت المُخصّص لتناول الطعام، كذلك الصمت يظهر في الوقت الذي يكون متاحًا للشخص أن يشترك في حوارٍ. ولكن، على الجانب الآخر، كان ترتيل المزامير يشغل كلّ وقت اليقظة في يوم الراهب، تقريبًا. لقد كان هناك ميعادان رسميّان للصلاة في كلاًّ من نتريا والقلالي(2)، يوميًّا. فخدمة السهر كان يُحتفَل بها قبل الفجر، بينما خدمة الغروب كانت في أوّل اللّيل (في ساعة الغسق عند غروب الشمس)؛ وكانت الخدمتان ذا صبغة جماعيّة في منطقة القلالي، خاصّةً في نهاية الأُسبوع، بينما كان يُحتفَل بهما بشكلٍ فردي في القلالي الخاصّة بالمتوحّدين، وكان يُرتَّل في كلّ خدمة منهما اثنا عشر مزمورًا “قانونيًّا”(3) وكان يعقب كلّ مزمور، صلاة، بينما كان ترتيل المزامير أو ترديد بعض المقاطع الكتابيّة؛ “الهذيذ” μελετη يمثّل خلفيّة لأيّ عمل يقوم به الراهب في باقي اليوم، أو في السواعي التي يظلّ فيها الراهب ساهرًا باللّيل. لقد ارتكزت تلك الممارسة، الخاصّة بالترتيل غير المُنقطِع للمزامير أو التأمُّل في الكتاب المُقدَّس، على القول الأوّل (4)first apophthegm الوارد في المجموعة (المفهرسة حسب المواضيع) اليونانيّة Greek Systemic Collection فقد ورد فيها: “ذات مرّة، بينما كان القديس أبّا أنطونيوس في الصحراء، أصابه الضجر acedia، وكانت أفكار الظلمة تلاحقه. فخاطب الله قائلاً: ‘يا ربّ، إنّي أريد أن أخلُص ولكن الأفكار لا تتركني. ماذا أفعل في هذه الضيقة؟ كيف أخلُص؟’ بعد قليل، خرج القديس أنطونيوس إلى خارج [مغارته] فوجد شخصًا يشبهه جالسًا يعمل، ثم يقف ليُصلّي، ثم يجلس ليُكمل عمله في ضفر الخوص، ثم يقف ثانيةً ليُصلّي”. إنّنا هنا نجد أن القديس أنطونيوس يُشكِّل المثال archetype لراهبٍ تخلَّص من حالة الضجر acedia، وذلك من خلال ممارسة بسيطة، تتمثّل في قطع العمل اليدوي للصلاة، بانتظام. وبالرغم من أنّ القول لا يلمّح إلى استخدام القديس أنطونيوس للمزامير أو المقاطع الكتابيّة أثناء الجلوس والعمل في ضفر الخوص، إلاّ إنّ هذا الوضع كان قائمًا في أواخر القرن الرابع، في المكان الذي كان يقطنه مار أوغريس، ممّا جعل من ذلك الافتراض أقرب إلى الحقيقة. يصف لنا بلاديوس ترتيل المزامير الذي كان مسموعًا من قلالي الرهبان في نتريا(5)، والذين كانوا يعملون بصناعة الكتّان. وبالمثل يشهد كاسيان أنّ الترديد المستمر “للمزامير وباقي النصوص الكتابيّة” أثناء “العمل اليدوي المستمر”، هو ممارسة مصريّة كان قد تدرَّب عليها(6). ولا يكتفي كُتَّاب الرهبنة المتأخّرين بالإشارة إلى ترديد المزامير أثناء العمل اليدوي، ولكنّهم يُحدّدون بدقّة عدد المرّات التي يتوقّف فيها ترديد المزامير للصلاة(7). وهذا ما يصيغه لنا القديس إبيفانيوس الذي من سلاميس قائلاً: “يجب على الراهب الحقيقي أن يجعل الصلاة وترتيل المزامير في قلبه بلا انقطاع”(8) لقد كان مُدوّني سِّيَر الحياة الرهبانيّة، مُغرمين بتحديد الكمِّ لتلك “الخلفيَّة الإيقاعيّة” background rhythm المصاحبة لترتيل المزامير والتأمُّل في النصوص الكتابيّة والصلاة، في حياة بعض النُسّاك، وعلى سيبل المثال: كانوا يُدوّنون عدد المرّات، يوميًّا، التي يقطع فيها عظماء الرهبنة، ترتيل المزامير للصلاة، سواء في وضع السجود أو الوقوف أو كليهما؛ فالقديس موسَى الحبشي [الأسود] “كان يُصلّي 50 صلاة” يوميًّا(9) كما شاركه في نفس العدد من الصلوات القديس مكاريوس المصري، أثناء ذهابه وعودته من قلاّيته إلى منسكه السرّي(10)، عبر النفق الذي يربط بينهما. بينما كان يُقدِّم القديس بولس (البسيط) الذي من الفرما، 300 صلاة يوميًّا، وكانت طريقته في إحصاء الصلوات هي: وضع عدد من الحصَى، مُعادِل لعدد الصلوات التي يريد تقديمها، في جلبابه، حيث يُلقي بواحدةٍ منها بعد كلّ صلاة(11). إنّ 200 صلاة يوميًّا هو عدد الصلوات التي كان يُقدّمها أبَّا أبوللو(12)، بينما كان يشترك القديس مكاريوس السكندري ومار أوغريس في تقديم 100 صلاة يوميًّا(13)، وقد قام جابريل بانج Gabriel Bunge بحساب المائة صلاة التي أشار إليها بلاديوس في حديثه عن مار أوغريس، فوجد أنّ مار أوغريس كان يرفع صلاةً كلّ 10 دقائق على مدار اليوم؛ وقد تكون تلك الصلوات التي كان يرفعها مار أوغريس هي مزامير أو بعض الصلوات التي كانت تتخلّل المزامير الطويلة(14). إنّ الهدف من ترتيل المزامير والصلاة بلا انقطاع هو إعادة الذهن مرّة أخرى نحو الله، وكذلك التخلُّص من حروب الشياطين. فقد لاحظ دوجلاس برتون-كرستي Douglas Burton-Christie أنّ التشتيت الذي يحدث خلال ترتيل المزامير، يكون بتحريك الشياطين عن طريق ذكريات الماضي والاهتمامات الشخصيّة، لذا فإنّ ترتيل المزامير يهدف إلى استبدال ذكريات الماضي بأفكارٍ مُقدّسةٍ(15). إنّنا نجد عند القديس أثناسيوس في “الرسالة إلى مارسيلّلينوس في تفسير المزامير”، أهدافًا إيجابيّة أُخرى لترتيل المزامير. وبالرغم من أنّ القديس أثناسيوس لم يُوجِّه كتابه للرهبان بشكلٍ خاص، إلاّ إنّه ينقل رؤية “شيخ مُتجرّد في الحياة النسكيّة” تصادف كونه راهبًا(16). يُمثِّل الجزء الأوّل من هذا الكتاب (فصل 1-9) ملخّصًا للكتاب كلّه وبالتالي لتاريخ الخلاص بشكلٍ عام. ونجد في (فصل 10-11) المميّزات الخاصّة بكتاب المزامير، كما نجد في (فصل 13-26) بعض المزامير التي يمكن قراءتها حسب حالة النفس؛ فالمزامير تُمثّل وسيلة لاستعادة الاتّزان والتناغم في النفس (فصل 27-28). المزامير “ليُقرأ وليُرتّل”(17) λεγέτω και ψαλλέτω كوحدة متكاملة كما هي مُدوّنة (فصل 29) بدون تغيير أو إضافة كلمات (فصل 30). إن الصورة الأكثر شعبيّة وتأثيرًا لسفر المزامير، هي أنّ المزامير بمثابة مرآة للنفس: “يبدو لي أنّ المزامير تُصبح لمَنْ يُرتّلها كمرآة، يُدرِك من خلالها تحرّكات روحه، فيتأثّر ويُردّدها”(18) فالمزامير لا تُظهِر، “كما في مرآة”، حياة الإنسان الظاهرة بمداها المُتّسع فقط، ولكنّها قادرة على تعديل الحياة الداخليّة للإنسان؛ وهذا يحدث عندما يجعل المرتل كلمات المزامير وكأنّها كلماته الشخصيّة، إذ “تخترق” وجدانه الداخلي، فيتحرّك بنخس القلب، مُشارِكًا في ذلك، كاتب المزامير التائب: “فيتأثّر ضمير السامع كما لو كان هو المُتكلِّم، ويتحرّك داخليًّا بكلمات الترتيل وكأنّها لسان حاله الشخصي”(19) وأخيرًا، فإنّ كتاب المزامير بمثابة المُعلِّم الأعظم للنفس: “لأنّ كلّ الكتاب المُقدَّس هو بمثابة مُعلّم للفضيلة ولحقائق الإيمان، بينما يحتوي كتاب المزامير -بشكلٍ خاصٍ- صورة الدورة الكاملة لحياة النفس”(20) فكتاب المزامير هو بمثابة الكتاب التطبيقي (السلوكي) للدورة الكاملة لحياة النفس διαγωγη؛ فتنوُّع الصور المُذهِل الذي تستحضره النفس أثناء الترتيل بالمزامير، يعكس ويدعم اتجاهات الحياة الإنسانيّة في كلّ تعقيداتها. لوقا ديسينجر Luke Dysinger _____ الحواشي والمراجع لهذه الصفحة هنا في موقع الأنبا تكلاهيمانوت:(1) إن مصطلح خارجي exterior والمستخدم في النصّ هنا، يميّز بين تلك الممارسات والممارسات الداخليّة interior أو ضبط الذهن ومراقبة الأفكار وفحص الضمير والاتضاع. (2) إنّ تلك الممارسة (القانونية) البسيطة للصلاة مرتان يوميًّا، قد تطوّرت في العقود التالية، حتّى أصبحت صلاة ليتورجيّة ثابتة تتلى كلّ عدّة ساعات وهو الذي يميّز ليتورجيا = السواعي في الشرق والغرب منذ ذاك الحين. ويؤكّد كاسيان في كتابيه الثاني والثالث من المعاهد Institutes على الممارسة القديمة البسيطة في الصحراء المصريّة، فضلاً عن الاتجاه الأحدث في مجامعه (الرهبانيّة) في بلاد الغال، والذي احتوى على صلوات الثالثة والسادسة والتاسعة. ويتعقّب Taft تلك النقلة في الصلاة، وتحوّلها إلى صلاة قانونيّة متكررة في مصر The Liturgy of the Hours in East and West, pp. 57-73 وإلى الخدمات الرهبانيّة التي انتقلت للمدن في الشرق (pp. 75-91) والغرب (pp.93-140). إنّ هناك بعض الاكتشافات الحديثة في منطقة القلالي Kellia التي أوضحت تغييرات في المعمار البنائي والفني والزخرفي في قلالي رهبان منطقة القلالي والتي صاحبت تلك النقلة الليتورجيّة Die Mِnchssiedlung Kellia, pp. 26-39. (3) يدوّن كاسيان عدد المزامير “القانونيّة” التي كانت تقدّم في كلّ ساعة من سواعي الخدمة وذلك في كتاب المعاهد Institutes 2.12.1. (4) يقول العلاّمة كواستن Quasten: “لا يوجد أي عمل آخر يُعطي فكرةً أفضل عن روح الرهبنة المصرية مثل المجموعة المجهولة المؤلِّف (أو المصنِّف) للحِكَم الروحانية المسمّاة: Apophthegmata Patrum وقد جُمِعت هذه المجموعة ربما في حوالي نهاية القرن الخامس، وتحوي أقوالاً لأكثر الآباء ومتوحدي براري مصر شهرةً، كما تحوي أخبار فضائلهم ومعجزاتهم. وقبل أن تُكتَب باليونانية كان يوجد غالبًا تقليد شفاهي عنها باللغة القبطية. وقد نُظِّمت هذه المقتطفات الأدبية المختارة ربما في القرن السادس بطريقة الأبجدية لأسماء الآباء ثم تُرجِمت إلى لغاتٍ عديدة. وهي تعطي صورةً حيّةً للحياة الرهبانية في وادي النطرون بصفةٍ خاصة، فهي تمثل مصدرًا ذا قيمة فائقة يصعب تقديرها لمعطيات التاريخ الديني والمدني”. فردوس الآباء، راهب من برية شيهيت، الجزء الأول، (الطبعة الأولى: 2005)، ص 15. (المعرّب) (5) Palladius, Lausiac History 7.5, ed. Bartelink, pp. 38-40. (6) Cassian, Institutes 2.14-15, SC 109, pp. 82-6 (7) إنّ رسائل برصنفيوس ويوحنّا تعكس الممارسة كما كانت في فلسطين في القرن السادس. أثناء ضفر الخوص كانت هناك صلاة تفصل عمليّة “ترديد المزامير / الهذيذ بالمزامير”، وذلك بعد الصف الثالث (من الضفيرة). Barsanuphius and John, Letter 143, 23-7, SC 427, p. 522 (8) Apophthegmata Patrum, Greek alphabetical collection, Epiphanius 3, PG 165.64 (9) Palladius, Lausiac History 19.6, ed. Bartelink, p. 100. (10) Ibid., 17.10, pp. 74-6. (11) Ibid., 20.1, p. 102. (12) Anon., Historia monachorum in Aegypto 8.5, ed. Festugière, p. 48. (13) يصف القديس مكاريوس نفسه بأنّه: “صانعًا مائة صلاة” ἑκατὸν εὺχὰς ποιω̑ν Palladius, Lausiac History 20.3, ed. Bartelink, p. 104 ويورد بلاديوس عن مار أوغريس أنّه: “كان يصنع صلوات” ἑποὶει δὲ εὺχὰς ποιω̑ν Lausiac History 38.10, ed. Bartelink, p. 200 (14) يرصد Bunge (Geistgebet, pp. 31-2) “الصلوات” التي تشير إلى التبادل المتناغم للمزامير فضلاً عن الصلوات التي كانت تتخللّها، ويشير Bunge إلى القديس أنطونيوس الكبير، وأيضًا لبرصنفيوس ويوحنّا. Letters 40, 140, 143, 150, and 176; Geistgebet, pp. 32-4. كما يشير إلى بعض النصوص في المجموعة الأثيوبيّة من Apophthegmata Patrum (13, 26, 42, and 43, ed. Arras, Collectio monastica, pp. 66 and 70) والتي يرد فيها أن مثل تلك “الصلوات” تتكوّن عادة من صيغة مقتضبة مثل: يا يسوع ارحمني! يا يسوع أعني! أنا أباركك، يا ربي! (Geistgebet, pp. 39-40) (15) Burton-Christie, The Word in the Desert, pp. 117-29, esp. 124-7. (16) لقد وصف Rondeau روح الجماعة الرهبانيّة والتي يعكسها هذا العمل: Commentaires, vol. ii, p. 222; ‘L’ةpître à Marcellinus’, pp. 196-7. (17) Athanasius, Letter to Marcellinus 12, PG 27.41 (18) Ibid., PG 27.24. (19) Ibid., PG 27.21. (20) Ibid., PG 27.25. |
||||

|
|
|
رقم المشاركة : ( 29 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
ثمن الخلاص، هل نتذكّره؟؟ 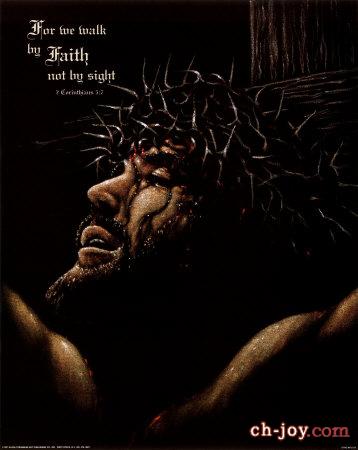 بالنسبة للمسيحي يكون الموت الطبيعي خسارة يا له من امتياز أن نحيا ونموت له أيضًا عن خطاب من أحد المسجونين من أجل الإيمان ثمن الخلاص، هل نتذكّره؟؟قبل مجيء المسيح، كنّا غرباء عن الربّ بل و«أَعْدَاءً فِي الْفِكْرِ، فِي الأَعْمَالِ الشِّرِّيرَةِ» كما يكتب القديس بولس (كو1: 21)، ولكنّنا صولحنا مع الآب بصكٍّ جديد وعهد جديد وُقِّع عليه بدماء الابن الحبيب.. البكر من الأموات.. البداءة.. المسيح يسوع. ذاك الصكّ يعلن أنّ الموت ضريبة الحياة الجديدة التي تنعمون بها، لذا قدّموا لله أثمارًا حسنة إذ تسلكون في جدّة الحياة. قدّموا للربّ أعضاؤكم ذبائح حيّة ناطقة بل وصارخة لمجد الربّ، لأنّكم قد اشتريتم بثمنٍ غالٍ.. بدماء ملكيّة.. بحبًّ فائق للتصوُّر. مَنْ اشتُري بالدماء لا يخشى سفك الدماء.. دماؤه هي وديعته التي تُغتسل بدماء المسيح يومًا بعد يومٍ في انتظار الانسكاب الأخير على مذبح الحبّ.. مذبح الشهادة للموت وللحياة. ولعلّ كلمات كليمندس السكندري تعبِّر عن معادلة الحبّ والشهادة أيّما تعبير إذ يقول: في محبّة الربّ، يفارق [الشهيد] تلك الحياة بمسرّة فائقة. إنّنا ندعو الاستشهاد كمالاً لا بسبب انتهاء حياته على الأرض كما الآخرين، ولكن لأنّه أظهر اكتمال عمل الحبّ. إنّ هناك ثالوثًا مسيحيًّا يشكل قوام حياة الكنيسة على الأرض؛ إنّه العبادة والكرازة والألم. فالعبادة الحقّ تدفع الكنيسة لتخبر عن المسيح.. لتشهد له.. لتعترف به، وهو ما يسبّب لها الألم، لأنّ العالم لا يريد نورًا يفتضحه!! في وعينا الكرازي، لا يمكن أنّ نُصنّف الآخرين إلى أعداء إذ يبغضوننا، لأنّهم قد يصيروا أحبّاء ويظهروا اكتمال عمل الحبّ بقبولهم الإيمان. عينا الله تلك، نتبنّاها، لنرى، بملء الرجاء، إمكانيّة تحوّل الذئب إلى حملٍ وديع يسكن المراعى الخُضر ويشرب من مياه الرّاحة. إنّ كان لنا رجاء في تغيُّر المُضطّهد، بالحبّ، ستتحوّل أنّاتنا الذاتيّة من الألم إلى الكرازة بالمُخلِّص، سيتحوّل صراخنا بكفّ الاضطهاد إلى صراخ بالغفران للمُضطَّهِد. هل يمكن أن يتحقّق ذلك؟؟؟ هل يمكن أن يتولَّد بولس جديد من رحم غفران إستفانوس؟؟ هل يمكن أن نتبنّى كلمات القديس بولس عينه لنقول: «الآنَ أَفْرَحُ فِي آلاَمِي لأَجْلِكُمْ، وَأُكَمِّلُ نَقَائِصَ شَدَائِدِ الْمَسِيحِ فِي جِسْمِي لأَجْلِ جَسَدِهِ»، أي الْكَنِيسَةُ؟؟ هل يمكن أن نتحرّر من ألمنا الشخصي إلى طلب بهاء الكنيسة ونموّها؟؟؟ فقط بالروح، إن قبلناه ليُحرِّكنا نحو الحياة الأفضل لنا ولآخرين، وإن تذكّرنا على الدوام أنّنا مولودين من دماء الخلاص المسفوكة حبًّا.. كيف يستطيع الحمل أن ينتصر على الذئب؟ كيف يمكن للمسالم جداً أن يقهر توحش الحيوانات المفترسة؟ نعم، يقول الرب أنا الراعي لهم جميعاً للصغير والكبير، لعامّة الناس وللأمراء، للمعلمين والمتعلمين، سأكون معكم وأساعدكم وأخلصكم من كل شر. سأروِّض الحيوانات المتوحشة، سأغيِّر الذئاب إلى حملان، وسأجعل المضطّهِدين مساعدين للمضطّهَدين، وسأجعل من يسيئون إلى خدامي شركاء في خططهم المقدسة، أنا أصنع كل الأشياء، وأنا أحلها، ولا يوجد شيء يستطيع أن يقاوم إرادتي. (القديس كيرلُّس الكبير) |
||||

|
|
|
رقم المشاركة : ( 30 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
بالحبّ ننتصر 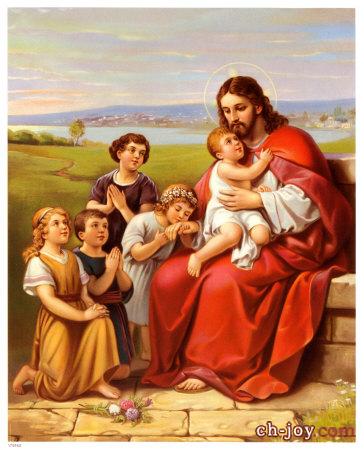 قد يسأل البعض: لماذا نتألّم ونحن لم نفعل شيئًا؟؟ لماذا نُظلَم ونحن أبرياء؟؟ دعني أذكّرهم أنّ المسيح حينما تألّم ترك لنا مثالاً لنتبعه.. تلك هي دعوتنا. بل إنّ أوريجانوس ومن بعده ديديموس الضرير يكتبان بلسان المُخلِّص: القريب منّي قريبٌ من النار والبعيد عنّي بعيدٌ عن الملكوت وذلك لأنّ نيران الاضطهاد مازالت تلاحق ثوب المسيح أينما ذهب، ولكن تلك النيران تعلن قرب ملكوت الله. لم تكن حياة المسيح قبل الصليب مقبولة عند جموع اليهود وقادتهم؛ فقد كان اليهود «يَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ» (يو7: 1)!!! ولازال العالم آملاً في قتل صورته الحيّة في جسده: الكنيسة. يا لقبح الشيطان الذي يرسِّخ عقيدة الموت في صميم الدين ليطلق الأيدي المغلولة بالضمير، حرّة، لسد منابع الطهر وإبكام أصوات الحقّ!! كانت كلمات المسيح حبًّا فجازوه صلبًا. كانت نظراته بلسمًا فسقوه خلاًّ. كانت لمساته شفاءً فطعنوه كُرهًا. كانت صلاته لهم غفرانًا فجلدوه حنقًا. هذا هو يسوع وذاك هو الشيطان. حتى الآن نفس استرتيجيّة الشرّ سارية وفاعلة.. الشيطان يسعى ليبيد صوت يسوع في أعماقنا لئلا يصدح في العالم المحتضر فيشفى.. لأَنَّكُمْ لِهذَا دُعِيتُمْ. فَإِنَّ الْمَسِيحَ أَيْضًا تَأَلَّمَ لأَجْلِنَا، تَارِكًا لَنَا مِثَالاً لِكَيْ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِهِ. الَّذِي لَمْ يَفْعَلْ خَطِيَّةً، وَلاَ وُجِدَ فِي فَمِهِ مَكْرٌ، الَّذِي إِذْ شُتِمَ لَمْ يَكُنْ يَشْتِمُ عِوَضًا، وَإِذْ تَأَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُهَدِّدُ بَلْ كَانَ يُسَلِّمُ لِمَنْ يَقْضِي بِعَدْل. الَّذِي حَمَلَ هُوَ نَفْسُهُ خَطَايَانَا فِي جَسَدِهِ عَلَى الْخَشَبَةِ، لِكَيْ نَمُوتَ عَنِ الْخَطَايَا فَنَحْيَا لِلْبِرِّ. الَّذِي بِجَلْدَتِهِ شُفِيتُمْ (1بط2: 21-24) جلدات المسيح شفاء للبشريّة، وألم المسيحيين إلهام واجتذاب لغير المؤمنين، ومجد للكنيسة عند استعلان ربّنا يسوع المسيح. لم يتحوَّل المسيح قيد أنملة عن ملء الحبّ أمام طوفان البُغضة التي أحاطت به في كلّ موضعٍ حلّ فيه. جاء لخلاص العالم لا لإهلاكه. من المسيح نستلم دعوتنا؛ أنْ نصمد في الحبّ والغفران مهما كلّفنا الأمر. لأنّ المسيح أطلقنا في العالم لنملّحه.. لنحييه.. لنعيده إلى الله. والعالم يبقَى شريرًا حتّى يُلاقي المُخلِّص.. يبقَى مستبيحًا حتى يجالسه على بئر الحياة.. وقتها يتغيّر. لا نتعجّب أمام شرّ العالم، فتلك هي الطبيعة البشريّة بدون المُخلِّص. لنتخطّى ألمنا، ونعلنه حبًّا وغفرانًا وتجديدًا لإنسان العالم. تلك هي نصرتنا.. بل نصرة المخلِّص فينا.. إنّ الله يتدخّل ولكن ليس كما يترجّى البعض؛ فبينما يريد البعض النقمة الإلهيّة وإظهار بأس شعب الله من خلال إذلال المقاومين، نجد أنّ الله يعمل في اتّجاه آخر؛ يعمل على جذب الجميع إلى حضنه؛ المُضطّهِد والمُضطهَد. لكلٍّ مكانه في بيت الآب. نقرأ ما حدث لشهداء ليون بفرنسا (القرن الثاني الميلادي) في الرسالة التي أوردها يوسابيوس القيصري، والمرسلة من ليون Lyons وفيينا Vienne إلى فيرجيه Phrygia (177م)، حينما هاج الوثنيون على المسيحييّن وأعملوا فيهم القتل بمباركة الإمبراطور، نقرأ: “أجساد هؤلاء الذين ماتوا في السجن قد أُلقيت إلى الكلاب وظلّوا [الوثنيون] يراقبون بشغف اللّيل كلّه لئلا يجمع أحدنا شيئًا ليدفنه.. مزقت بقايا هؤلاء إلى قطع صغيرة بواسطة الحيوانات المفترسة. من تفحَّم منهم بالنار وضعوه في كومةٍ في مكانٍ عامٍ ليراها الجميع. حُرست رؤوس وجذوع الآخرين من قِبَل الجنود لضمان بقائها في العراء غير مدفونة لأيّام أخرى.. ظلّ بعضهم يضحكون ويقهقهون وهم يرفعون أصنامهم التي اعتبروها أنّها عاقبت هؤلاء الشهداء!!!” وبدأوا يُشكِّكون المسيحيّين قائلين: “أين إلهكم؟ بما ساعدكم الإيمان الذي أحببتموه أكثر من حياتكم؟ لمدّة ستّة أيام كانت أجساد الشهداء موضع سخرية بكلّ طريقة ممكنة. وفي النهاية أُحرقت وصارت رمادًا وكنست من الأرض التي لم يعد عليها ذرّة واحدة منها لأنّهم كانوا يعتقدون أنّهم بذلك سوف يهزمون الله!! ويفوّتوا عليه فرصة أن يقيمهم ثانية!!!.. كان لسان حالهم يقول: ‘دعنا نرى إن كانوا سيقومون ثانية؟ وإن كان إلههم سيساعدهم؟ وإن كان يستطيع أن يخلِّصهم من أيدينا؟؟’.” إنّ ما حدث في ليون القرن الثاني الميلادي حدث عند الصليب؛ «وَكَانَ الشَّعْبُ وَاقِفِينَ يَنْظُرُونَ وَالرُّؤَسَاءُ أَيْضاً مَعَهُمْ يَسْخَرُونَ بِهِ قَائِلِينَ: خَلَّصَ آخَرِينَ فَلْيُخَلِّصْ نَفْسَهُ إِنْ كَانَ هُوَ الْمَسِيحَ مُخْتَارَ اللهِ» (لو23: 35). يروي لنا القديس غريغوريوس اللاّهوتي بكلمات مؤثِّرة ينتفض من هولها القلم، ما حدث مع الكاهن الشيخ مرقص، من أهل الرستن، إذ يكتب: “كان يُقاد ويُسحب سحبًا. يسحبه الأدنياء من كلّ سنٍّ، بل قُل من كلّ المراتب الاجتماعيّة العالية والدنيا. نساءً ورجالاً، شبابًا وشيبًا. الكلّ كانوا يتبارون ويبالغون في القوّة والقحة والفظاظة ضدّ إنسانٍ واحدٍ في ساحة الشهادة، يثبت ويصمد فيغلب مدينة بأسرها وحده. كانوا يجرّونه من ساحةٍ إلى ساحةٍ، يسحبونه بشعره، حتّى لم يبق منه عضوٌ سليمٌ من الألم والأذى. ولم تبق إهانة أو شتيمة لم تنصبّ عليه من أولئك الذين كانوا ينفذون فيه التعاذيب كما في ميترا. كان يُرفع مُعلَّقًا برجليه ويُنْخَس جسمه بأقلامِ قصبٍ حادّةٍ، تجعل مأساته لهوًا ولعبًا. جعلوا يضغطون جنبيه حتّى تتأذّى عظامه إلى حدّ التكسُّر، ويثقبون أذنيه بخيوطٍ صوفيّةٍ دقيقةٍ ويشرمونها شرمًا. ثمّ علّقوه عاليًا في سلٍّ ودهنوا السلّ وجسمه بالعسل والحلوى حتّى تلسعه النحل والزنابير، والشمس تنصبُّ عليه بأشّعتها المحرقة في وسط النهار. وهنا أيضًا شيءٌ يؤثِّر في الذكر والتسجيل، هو أنّ الشيخ، بل الفتى الشجاع في الجهاد، كان يصنع إشارة الصليب، ويمجّد الصليب، وكان يرى نفسه من عَلُ، كأنّه في قدّاسٍ، وليس في نكبةٍ وشدّة!!”. مثل تلك الأمثلة أكّدت بقوّةٍ، كما كتب القديس غريغوريوس، أنّ: مُلكُ المسيح لن يتوقّف ولو جُنّ الأعداء ضدّه لقد كتب أحدهم متهكِّمًا ومُتعجِّبًا: “ربنا موجود!!” بعد حادث الإسكندريّة. وكأنّه يقول: كيف هو موجود وهو غير قادر على حمايتكم.. حقًا إنّ ربنا نحن المسيحيين موجود، لا ليدخل في صراع مع الفانين على أجساد مآلها للتراب.. إنّه ليس كآلهة اليونان يتصارع على بسط نفوذه بإراقة الدماء وإرهاب باقي الآلهة.. إلهنا لا ينفعل ولا يستشعر خطرًا ولا يُفاجَئ بالأحداث، لأنّه عالم بكلّ شيءٍ وهو يتعجّب من رغبة البشر في وضعه داخل عالمهم بقانونهم القائم على منطق الغاب: البقاء للأقوى!! إلهنا يقف على شاطئ نهر الحياة ليتسقبل محبّيه ويورثهم ملكوتًا لا يزول.. لا يمكن لبشرٍ أن يضع للمسيح طريق الخلاص وطريقته؛ فهو الإله العالم بكلّ شيء.. الإله فوق الزمني.. إن كان خلاص المسيح لأبنائه دائمًا بوقف الألم، سيتوقّف معه المجد!! إن وهب لأحبّائه راحة على الدوام، سينضب سرّ الصليب!! فلنتخيّل أنّ الله قد أوقف الألم عن الكنيسة منذ نشأتها، هل كنّا سنحتفل بشهادة بولس وصلب بطرس وتمزيق مرقص وتقطيع مارجرجس وحرق بوليكاربوس والتهام الوحوش لإغناطيوس.. لقد أحبّوا الضيق والشهادة لينالوا المجد، ومن إيمانهم استلهمنا قوّة حياة وقوّة موت لنصمد وسط ضيقات العالم الحاضر. إنْ طالبنا الله بوقف طَرْقَات الألم عن أبناءه فرّغنا كنائسنا من قدّيسيها ورجالها الأشدّاء الذين ذبحوا أجسادهم طواعيّة بحبّ الثالوث قبل أن يذبحها أعداءهم. كلُّ الإنجيل قائم على سرّ الموت والقيامة.. سرّ الألم والمجد.. إنّه سرّ المسيح المائت / القائم. هل نبحث عن إنجيلٍ آخر؟؟ أم نريد إنجيلاً مُجمَّلاً بنقوش الذهب نقرأه في أوقات فراغنا معتقدين أنّنا بذلك مؤمنون!!! أؤمن بالشمس ولو كانت غير مشرقة! أؤمن بالمحبّة وإن كنت لا أشعر بها! أؤمن بالله ولو كان صامتًا!! (عن نقشٍ لسجينٍ على جدار زنزانته) صمت إلهنا بلاغة أبديّة، وجهالته في عين الآخرين حكمة علويّة، وضعفه في نظر البعض هو محبّة متأنيّة.. فهل نفهم لغته وحكمته ومحبّته؟؟ إن أحببنا المسيح، أحببنا حياته وجراحه وموته وقيامته ومجده.. إن أحببنا المسيح دعوناه ليسكن فينا ليضع هو قواعد سكناه.. محبّتنا له لا تُجزِّئه إلى مسيح القدرة والقيامة واللُّطف والمعجزات والتعاليم السامية، ومسيح الألم والإهانة والصلب والقبر.. هو مسيحٌ أوحد.. إلهٌ أوحد.. إنْ قبلناه قبلنا طريقته ليُحرِّرنا من ذواتنا؛ فخلاص المسيح لنا يكمن في تحريره لنفوسنا وإعدادها لملكوته.. لم يُهدِّد المسيح صالبيه بنار تنزل من السماء لتبيد الأعداء، بل حينما كانت تلك طلبة تلاميذه قال لهم: «لَسْتُمَا تَعْلَمَانِ مِنْ أَيِّ رُوحٍ أَنْتُمَا!. لأَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيُهْلِكَ أَنْفُسَ النَّاسِ بَلْ لِيُخَلِّصَ» (لو9: 55، 56). روح الله يغفر للمسيئين لأنّه يوجِّه البصيرة للمجد. أمام المجد تُنسَى الإساءة بل وتصبح تلك الإساءة عينها قوّة تضرُّع من أجل الأعداء!!! يَا أَبَتَاهُ اغْفِرْ لَهُمْ لأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ الربّ يسوع (لو23: 34) يَا رَبُّ لاَ تُقِمْ لَهُمْ هَذِهِ الْخَطِيَّةَ الشهيد إستفانوس (أع7: 60) حينما كان اليهود يرجمون يعقوب البّار، نادى واحد من الكهنة قائلاً: “قفوا ماذا تفعلون، إنّ البّار يُصلِّي من أجلكم”. وقتها لم يحتمل الشيطان، فتقدَّم أحد الشباب وضربه بهرّاوة خشبيّة على رأسه لئلاّ يُصلِّي!!! لقد صدر حكمٌ بالإعدام على شخص مسيحي في رومانيا، أثناء الثورة الشيوعيّة، وقبل التنفيذ سُمح له بمقابلة زوجته، فكانت كلماته الأخيرة لهم كما يلي: “لا بد لك أن تعرفي أنّي أموت وأنا أحبّ هؤلاء الذين يقتلونني. إنّهم لا يعلمون ماذا يفعلون. طلبتي الأخيرة لكم أن تحبّوهم أنتم أيضًا. لا تكن هناك مرارة في نفوسكم من جهتهم لأنّهم يقتلون الشخص الذي تحبّونه.. سوف نلتقي في السماء”. لقد أثّرت هذه الكلمات في ضابط البوليس السرّي الذي حضر اللّقاء، وفيما بعد أصبح مسيحيًّا بل وسُجِنَ من أجل الإيمان. لقد أرسل القديس إغناطيوس الأنطاكي رسالة إلى أهل أفسس قبيل استشهاده، قال فيها: صلّوا بلا انقطاع من أجل الآخرين لأنكم تقودونهم إلى الربّ على رجاء التوبة افسحوا لهم المجال ليتثقّفوا في مدارس أعمالكم واجهوا غضبهم بالوداعة وتبجُّحهم بالدّعة وشتائمهم بالصّلاة وضلالهم برسوخ الإيمان وفظاظة أخلاقهم بدماثة الطبع ولا تردّوا لهم شرّهم بشرٍّ كونوا لهم أخوة بالرّحمة ولنحاول أن نتشبّه بالسيّد ولنتبارى في حمل الظلم والمهانة والاحتقار وفي تعليق من أحد الأصدقاء، قال: “مقولته تلك لم تُقَل أثناء تأمُّل روحي في زاوية هادئة، ولكنّها قيلت وسط صليل سيوفٍ، وصراخ يموج باللّعنات والشتائم”. وكان تعقيبي على كلماته أنّ هذا يثبت أنّها كلمات الروح، وتعليمه لكلّ مسيحي. أن نغفر تلك فرصّة للتعليم كما يراها القديس غريغوريوس اللاّهوتي، إذ يقول: “فلنسمو ونرتفع عن أولئك الذين ظلمونا. ليتضّح للملأ ماذا يُعلِّم الشيطان للوثنيّين، وماذا يُعلِّمنا المسيح، وكيف يربينا المسيح. أجل لنغتنم الفرصة للتعليم”. بذلك تتحوّل آلامنا، بالغفران، إلى كرازة بالإنجيل. تلك الرؤية المسيحيّة “فوق قدرات البشر”؛ قد يصرخ البعض!!! بالفعل هي كذلك، ولكن النعمة النابتة من مرارة الألم ترفع قدراتنا فوق إمكانيات الجسد والنفس المحدودة. الحبّ المسيحي لا منطقي لأنّه يفوق المنطق. الحبّ المسيحي لا يعرف إلاّ الغفران من فوق الصليب وسط شماتة وهزء وسخريّة الأعداء. لا نلومن الأعمى على تهكّمه على لاواقعيّة النور.. هو لا يعرف النور لأن الظلمة هي موطنه.. لا نستطيع أن نغفر للأعداء بقرارٍ، ولكن بتضرُّع وصراخ لروح الله. تَوَكَّلُوا عَلَى الرَّبِّ إِلَى الأَبَدِ لأَنَّ فِي يَاهَ الرَّبِّ صَخْرَ الدُّهُورِ إش26: 4 ولعلّ هناك في عصرنا الحالي مَنْ يرى في الغفران الإنجيلي حياديّة ماسخة لا تلائم عصر الانتفاضات الشعبيّة وصراخ الحناجر بأفظع الكلمات طلبًا لحقٍّ مُهدر ودمٍ نازف!!!.. إنه فرار من الصليب!!! إنّ حضور الله كان ملموسًا جدًّا أثناء التعذيب من أجل تلك البلايا أحببنا نفوس الصين أكثر، وصلّينا لمن كانوا يُعذِّبوننا امرأة مسيحيّة ممّن تألموا من أجل المسيح في الصين تلك صلاة نيقولاي فليميروفيتش، الأسقف الصربي الذي تكلّم بشجاعة ضدّ النازية، فأعتقل إبّان الحرب العالميّة الثانية، إذ يقول: الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلّوني من الأرض وبعثروا كل مطامحي الدنيوية أعدائي قد غرّبوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئًا ومقيمًا في هذا العالم غير مرتبط به كما يجد الحيوان المُطارَد مخبئًا أكثر أمانًا من الحيوان غير المُطارَد كذلك أنا، لأحمي نفسي من أعدائي وجدتُ ملاذًا مأمونًا عندما التجأت إلى هيكلك حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي لذا يا ربُّ بارك أعدائي ولا تلعنهم! فأباركهم أنا أيضًا ليس أنا، بل بالأحرى هم، مَنْ اعترف بخطاياي أمام العالم لقد جلدوني عندما تردّدت أمام الجلد لقد عذّبوني كلّما حاولت تجنُّب العذابات لقد وبّخوني في حين أنّي تملّقتُ نفسي لقد ضربوني فيما كنتُ أمدح نفسي من الجهل فبارك أعدائي يا ربُّ ولا تلعنهم! فأباركهم أنا أيضا في كلّ مرةٍ قدّمتُ نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق في كلّ مرةٍ تقدّمت بها مثل قويٍّ، كانوا يسخرون منّي وكأني قزمٌ كلّما تمنّيت أن أقود آخرين، كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبيّة كلّما حاولت أن أُغني نفسي، كانوا يمنعونني بيدٍ من حديد كلّما فكّرت بأني سوف أنام بسلامٍ، كانوا يوقظونني في كلّ مرةٍ كنت أحاول أن أبني بيتًا لحياةٍ مديدةٍ هادئةٍ، كانوا يطردونني منه ويهدمونه في الحقيقة، إنّ أعدائي قد حلّوني من هذا العالم ومدّوا يديّ لألامس هُدب ثوبك لذا، بارك أعدائي يا ربُّ ولا تلعنهم! فأباركهم أنا أيضًا باركهم يا ربُّ وكثّرهم! كثّرهم واجعلهم أكثر قساوة عليّ ليكون جريي إليك بلا رجعةٍ ليتحطّم كلّ رجاء بالإنسان، كما تتحطّم شبكة العنكبوت ليحكُم السلام المُطلَق على نفسي ليصير قلبي قبرًا لأخويّ الشريريْن: العجرفة والغضب فأخبِّئ كلّ كنوزي في السماوات وأصير مؤهَّلاً للتحرُّر إلى الأبد من وَهْم الذّات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة الأعداء علّموني، ما يتعلّمه المرء بصعوبةٍ، أنّ ما من عدو للإنسان في هذا العالم إلاّ نفسه وأنّ الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنّهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلبٍ!! فعلاً، من الصعب عليّ أن أخبر مَنْ الذي نفعني أكثر من الآخر أو آذاني أكثر من الآخر: الأعداء أم الأصدقاء فبارك أعدائي يا ربُّ ولا تلعنهم! فأباركهم أنا أيضًا إنّ الإنجيل وكلماته ووعوده عزاء حقيقي للنفس المجروحة وقوّة دافعة للواقع المتلعثم في الخطيئة والإثم. لم يعدنا المسيح بجنائن بل بدماء. لم يترك أرضنا إلاّ من فوق صليب ليعلن أن الصليب هو خنجر العالم لطعن المسيحيين الحقيقيين.. ليست تلك مطالبة بمغفرة خياليّة ومناداة بُحبٍّ حالم، فالحب يتولّد كما بمخاض، يخرج ومعه صديد الكراهيّة العفنة. فالحبّ الحقّ يصارع في تلابيب القلب حتّى ينتصر. يخرج كلمات لا تطاوعها المشاعر حتى يتحوّل إلى مشاعر توجِّه الحياة. لن نستطيع أن نلتقي النعمة وقلوبنا سوداء.. لن نستطيع.. من لا يحمل صليبه لا يقدر أن يكون تلميذًا للمُخلِّص.. قد يريد ويشتهي ولكنّه لا يقدر، ذاك هو تعبير المسيح نفسه. في الحقيقة نحن لا نملك خيارًا؛ فقبول الغفران والحبّ لتسكن النعمة أو الاصطدام بعنفوان الكراهيّة ليملك الشيطان.. لا خيار ثالث. لأَنَّهُ هَكَذَا قَالَ السَّيِّدُ الرَّبُّ قُدُّوسُ إِسْرَائِيلَ: بِالرُّجُوعِ وَالسُّكُونِ تَخْلُصُونَ. بِالْهُدُوءِ وَالطُّمَأْنِينَةِ تَكُونُ قُوَّتُكُمْ إش30: 15 ولكن الغفران هو مرحلة تتجاوز قبول الألم.. هل يطالبنا الإنجيل بعدم الأنين أثناء الألم؟؟؟ الإنجيل لا يُسفِّه ألمنا البشري ولا يُكمِّم صرخات قلوبنا أمام أنهار الدماء، ولكنّه يُعطي الطريق لتجاوزه. فقط بالنعمة نتجاوز الألم، ذاك هو الطريق الأوحد. وطريق النعمة: القلب النقي. ذاك هو المحكّ الحقيقي الذي ننحصر في أركانه الآن؛ كيف نغفر ونحب وسط أعاصير الكراهية المحيطة بنا ووسط رائحة الموت التي تملأ أنوفنا ووسط مذاقة الغضب التي تستوطن حناجرنا. تلك هي التجربة؛ إن نجونا بالحبّ صرنا مسيحيين على شاكلة المسيح.. على صورته الوديعة، وإن قيُّدنا بالكراهيّة صرنا صورة للشيطان بقبحه. اسبني يا ربّ فأصير حرًّا أجبرني على تسليم سيفي فأكون منتصرًا أغوص في مخاوف الحياة حين أقف وحدي احبسني بين ذراعيك فيشتدّ ساعدي جورج ماثيسون ليت النعمة تعبر بنا تلك التجربة المريرة لنكون مشابهين صورة ابنه متجدّدين على شاكلته، لنعلنه كما هو للعالم، لعودة العالم إلى الله. سنطرح أمامك كلّ “لماذا” تدور في عقولنا سنذيبها في لهب الإيمان سنغرقها في مياه الحب سنطرحها في أعماق النسيان سنجعلها تجثو أمامك لتصير “نعم” و“حقًا” و“ليكن” سنجعلها تقول: آمِينَ. تَعَالَ أَيُّهَا الرَّبُّ يَسُوعُ رؤ 22: 20 |
||||

|
 |
|