
 |
 |
 |
 |
|
|
رقم المشاركة : ( 14031 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
الموت علينا حق
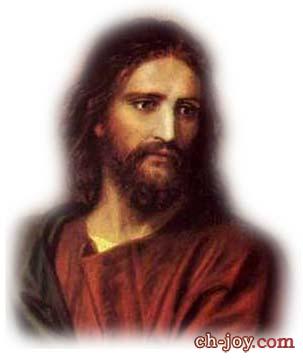 أو قد تسمعها من إنسان متأثرًا بالفعل، رافعًا نظره للسماء، ومعتَبِرًا من مآسي الأرض، ويتمتم متعجبًا: الدنيا فانية، آدي الله وآدي حكمته، الموت علينا حق!! ورغم كونها خاصة بأسوأ حادث وأكأب سيرة؛ وهو الموت، ورغم كونها لقمة سائغة في ألسنة البشر وحوارات الشوارع، إلا أننا هنا سنلقي عليها نظرة عميقة ومفصلة، لنرى فقط الجانب المضيء منها، ولندرك معًا روعة ووجوب ولذة أن نختبر أن “الموت علينا حق”!! “الموت علينا حق” والدخيل! لا جدال أن الموت هو حقيقة يتفق على وجودها جميع البشر، مهما اختلفت دياناتهم أو فلسفاتهم؛ حتى إن اختلفوا في وجود حياة بعد الموت من عدمه، أو في تفاصيل وأسباب الموت نفسه. ويرون أنه لا قوة ولا فلسفة ولا سلطة يمكن أن تمنع مجيء الموت، أو تؤجِّل قدومه، أو حتى تخفِّف من وطأته، لأن “الموت عليهم حق”!! على أن ما يفوت الكثيرين، أن الموت هو عنصر دخيل على التاريخ البشري، وأن الله لم يخلق الإنسان على صورته، وينفخ فيه نسمة حياة، ويهيء الجنة لراحته ومتعته (تكوين1: 26؛ 2: 7، 8) لكي يميته في النهاية!! ولكن الموت دخل خلسةً للبشرية، حين أخطأ أبونا آدم في الجنة، وعصى الله بأكله من شجرة معرفة الخير والشر، وطبقًا للقانون الإلهي غير القابل للتغيير: «أُجْرَةَ الْخَطِيَّةِ هِيَ مَوْتٌ» (رومية6: 23)، صدر الحكم بالموت، وامتد تنفيذ هذا الحكم إلى كل نسل آدم «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَأَنَّمَا بِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ دَخَلَتِ الْخَطِيَّةُ إِلَى الْعَالَمِ وَبِالْخَطِيَّةِ الْمَوْتُ وَهَكَذَا اجْتَازَ الْمَوْتُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ إِذْ أَخْطَأَ الْجَمِيعُ» (رومية5: 12)، وأصبح “الموت عليهم جميعًا هو حق”!! ولأن الموت عنصر دخيل، فقد جاء ابن الله «الَّذِي وَحْدَهُ لَهُ عَدَمُ الْمَوْتِ» (1تيموثاوس6: 16)، و«وَضَعَ نَفْسَهُ وَأَطَاعَ حَتَّى الْمَوْتَ مَوْتَ الصَّلِيبِ» (فيلبي2: 8)، وحينها تلقى الموت “الدخيل” ضربته القاضية في صليب المسيح عندما «أبطل الموت» (2تيموثاوس1: 10)، وتحول الموت الدخيل، إلى حياة أبدية مُعَدَّة لأولاد الله!! وقريبًا سنسمع الكلمات المجيدة في الأرض والسماء الجديدة «وَالْمَوْتُ لاَ يَكُونُ فِي مَا بَعْدُ» (رؤيا21: 4)، وستُبطل للأبد كلمة “الموت علينا حق”!! “الموت علينا حق” والحَبة! وهنا ننتقل لنوع آخر من الموت لا يتذوقه كل البشر، ولكن يختبره نفر قليل من المؤمنين بالمسيح!! وهذا الموت تكلم عنه المسيح في آخر سويعاته على الأرض، عندما قال «اَلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَقَعْ حَبَّةُ الْحِنْطَةِ فِي الأَرْضِ وَتَمُتْ فَهِيَ تَبْقَى وَحْدَهَا. وَلَكِنْ إِنْ مَاتَتْ تَأْتِي بِثَمَرٍ كَثِيرٍ...» (يوحنا12: 24). هنا يخبر المسيح تلاميذه، أن من يبحث عن الحياة والثمر والسعادة في هذا الكون، عليه أن يخضع لقوانين الحياة فيه؛ وأعطاهم مثالاً رائعًا بحبة الحنطة (القمح)، والتي لكي تنمو سنابلها، وتتزايد ثمارها، وتتمم رسالتها في سداد حاجة البشر، عليها أولاً أن تقع في الأرض وتموت؛ لأن الموت هو السبيل الوحيد لحياتها وحياة الآخرين معها؛ فقانون ودورة حياة الطبيعة أن “الموت عليها حق”!! ولأن المسيح كان دائمًا يعيش قبل أن يعلِّم (لوقا24: 19)، فقد قَبِلَ أن يقع ويموت في الأرض، وكان النتيجة المبهرة أنه أثمر ملايين الملايين من المؤمنين، الذين سيملأون أركان بيت الآب الأبدي. والعجيب أنه رغم أنه لم يفعل أي خطية، والموت ليس له “أي حق” عليه، إلا أنه ارتضى أن يموت مثل حبة الحنطة، وينفذ كلامه حرفيًا أمام الجميع، لكي يحظى بنا نحن الثمر الكثير. ولكن من يقرأ كلمات المسيح السابقة بتمعُن، يكتشف أن المسيح بعدما تكلم عن موت الحبة، فإنه نقل التلاميذ فكريًا ليتكلم عن الحياة والخدمة والتبعية « إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَخْدِمُنِي فَلْيَتْبَعْنِي وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا هُنَاكَ أَيْضًا يَكُونُ خَادِمِي. وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ يَخْدِمُنِي يُكْرِمُهُ الآب» (يوحنا12: 26)، وهنا بيت القصيد؛ فكأن المسيح يقول لتلاميذه: أنا هو “الحبة” التي وقعت وماتت، فأثمرتكم أنتم، وأنتم مثلي تمامًا، ومكانكم معي تحت الأرض «حيث أكون أنا يكون خادمي»، وموتكم هو السبيل الوحيد لحياتكم ولتعميم ثمركم. قد تدوسكم الأرجل والأقدام، قد تهبطون من علياء راحتكم ورفاهيتكم، قد تُنتهك كرامتكم وتنحط مكانتكم، قد تقضون أيامكم “مائتين” تحت التراب وبعيدًا عن الأضواء، ولكن لا تقلقوا فهذا هو الموت الذي أبتغيه لكم، لأن “الموت (كالحبة) عليكم حق”!! “الموت علينا حق” والدرس! وفي رأيي المتواضع، أن موت حبة الحنطة السالف ذكره، هو أهم درس في مدرسة الله، وأروع اختبار يمكن أن يختبره المؤمن السماوي في حياته، وليس هذا فقط، ولكني لن أكون مبالغًا حين أرى أن هذا الموت، هو حل لجميع المشاكل الاجتماعية والكنسية على حد سواء؛ فهل رأيت مشاجرة تحدث بين مجموعة من “الأموات” على منصب أو مكانة أو مركز؟!! أو هل سمعت عن تنافس بين مجموعة من “الجثث” على من هو أجمل ومن هو أفصح ومن هو أكثر خدمة وتأثيرًا من الآخر؟! بالطبع لا، فمن يعرف متعة أن يموت، هو الوحيد الذي يعرف كيف يحيا!! عزيزي القارئ، اسمح لي أن أتمنى لك طول العمر وامتداد الحياة، واسمح لي أيضًا أن أتمنى لك ولي، التمتع بروعة هذا الموت!! وأدعوك أن تطلبه من الرب في صلاتك، وأن تقبل كل وسائل “الإماتة” التي يستخدمها الله في حياتك، فقد يسمح لك بانهيار مشروع عالٍ يداعب خيالك (نجاح، عمل، خدمة)، ويفاجئك بـ“وقوعك” من علياء أحلامك بسرعة الصاروخ، فيما يرتفع غيرك بسرعة البرق!! وقد “يرزقك” الله بإنسان يحقِّر من شأنك ومن قدراتك ومواهبك، أو غير ذلك. فلا تقلق لأن كل ما سبق يستخدمه الله لإماتتك، وبالتالي لحياتك وبركتك وثمرك، فلا تَغِر من البذور الطافية على السطح، واقبل الدفن بعيدًا عن الأضواء، واعرف أن سر سعادتك ونصرتك وصلابة شركتك أن تدرك قيمة ومعنى ودرس أن “الموت عليك حق”!! كنت باسأل في حيرة: ليه باتألم، ليه باتحرِم، ليه بانزل والكل طالع ليه الأقدام بتدوسني، والتراب مفطسني، ويوماتي غامسني، وفي الأرض واقع أتاري الموت ده حق عليَّ ومجد ليك وده الطريق اللي قبلي مِشيِّته رجليك واللي بدونه لا خدمة ولا ثمر ولا حياة ترضيك جايلك حابب وطالب موتي عن كلي، وماعنديش لا شرط ولا مانع لحد ما تحيا بحياتك في موتي، وتفاجئني بفَجري اللي ساطع |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 14032 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
أي خدمة
  “أي خدمة” والعَرض! عندما يقول إنسان لأخيه الإنسان “أي خدمة”، فإنه في الواقع يعرض عليه عرضًا، قد يكون ماديًا (أموال)، أو معنويًا (مساعدة أو تدخل ما). وعلى الرغم من أن هذا العرض قد يكون مُحَمَّلاً بالمعاني الرائعة والمشاعر الرقيقة، إلا أنه من كثرة استخدام كلمة “أي خدمة” في مجتمعنا، فقد فقدت معناها وجدّيتها، وأصبحت مجرد عرض شفهي لا يتحول لفعل، وهي أشبه بـ“عزومة المراكبية” لمن يسير على الشاطئ دون جدية في عرضه، فينادي عليه بصوت عالي من وسط البحر “اتفضل” رغم أنه لا يزال في عرضه!! تذكَّرت ملكًا ذُكر في العهد القديم، فارسي ذو شخصية قوية ورهبة مدوية (أستير4: 11)، قدَّم عرضًا للخدمة، لملكة رائعة ذات قيمة كبيرة، هي أستير، إذ قال أحشويرش - وهو في كامل قواه العقلية - «مَا هُوَ سُؤْلُكِ يَا أَسْتِيرُ الْمَلِكَةُ فَيُعْطَى لَكِ وَمَا هِيَ طِلْبَتُكِ؟ وَلَوْ إِلَى نِصْفِ الْمَمْلَكَةِ تُقْضي» (أستير7: 2). وكانت الخدمة التي تحتاجها أستير خلاص شعبها. ولاحظت أن الملك كان جادًا جدًا في عرضه؛ فنفَّذ طلب الملكة رغم التكلفة!! فلم يقدِّم مجرد عرضٍ خاوٍ للخدمة والعطاء المادي، ولكن نفَّذ عرضه بكل وعي وجدّية. إننا كمؤمنين – للأسف – نفتقد لجدية أحشويرش؛ فنحن نعرض خدماتنا (المعنوية أو المادية) للناس، ولكننا لا ننفِّذها بجدّية، مع أننا الأولى بتقديم الخدمات؛ لأننا أتباع المسيح أعظم خادم طرق أبواب البشرية، ولأن طبيعتنا هي «ملح الأرض»، و«نور العالم» (متى5: 13، 14). وبالتالي فقد بقيت خدمتنا للناس مجرد عروض جوفاء، وظللنا غارقين في أنانيتنا المقنَّعة، ونخدم ذواتنا داخل جدراننا، فأصبحنا نقول للناس “أي خدمة” ولا نقدم لهم “أي خدمة”!! “أي خدمة” والقلب وهنا ننتقل لنقطة أخرى أخطر وأهم، وهي عروض خدماتنا لله نفسه!! فكثيرون يتساءلون مثلي: إن كانت الكنائس والاجتماعات مليئة بالخدام والخادمات، وجدول خدماتهم مملوء عن آخره ومُرضي لجميع الأذواق، وهم يعرضون خدماتهم على الله بصراحة في ترانيمهم (يا رب إنني لك أكرس الحياة... جهزنا علشان تستخدمنا...)، وفي صلواتهم (افتح لنا بابًا لخدمتك... أرسلنا حالاً لكرمك...)؛ فلماذا إذاً يتزايد عدد النفوس المكسورة؟ وتكثر بالعشرات العائلات المتعثِّرة؟ ويجلس مئات الشباب في كورتهم البعيدة ولا يجدون حضنًا واعيًا يستوعبهم؟!! ولماذا نبدو وكأننا نقدم “شيكات على بياض” لله، عنوانها “أي خدمة”، وعندما يأتي وقت دفع الدفعة الأولى منها، يبرز التراجع وتظهر الأعذار، ويبدأ كل واحد منا يتنصل من التزامه. والحقيقة أنني أرى سببين لهذه الازدواجية المرعبة؛ السبب الأول - في رأيي - أننا اهتممنا كثيرًا بنوع وتوقيت ومكان الخدمة، ولم نهتم بقلبنا نحن أثناء الخدمة!! وتناسينا أن المسيح؛ الخادم الأعظم، لم يأتِ لنا بـ“لستة” من الخدمات الفارغة لنملأها، ولا بـ“كتالوج” به أحدث الطرق والوسائل المبتكرة للوصول للناس وملامسة احتياجاتهم، ولكنه جاء بالأهم والذي لم يأتِ به غيره؛ جاء بقلب الخادم!! فأخبرنا المسيح أن قلب الخادم يجب أن يكون موحَّدًا ومخصَّصًا له، ولا يخدم أي شخص أو شيء سواه (متى6: 24). وأن من أراد خدمته عليه أولاً أن يتمم شروط تبعيته، «إن كان أحد يخدمني فليتبعني وحيث أكون أنا هناك أيضًا يكون خادمي»، وأن من يخدمه لا يجب أن ينتظر مكافأة معنوية أو مادية من أي إنسان «وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب» (يوحنا12: 26)، وأن من يخدمه عليه أن يضحي ببعض من حقوقه الطبيعية، ومن راحته لكي يرضي من يخدمه (لوقا17: 8). فإن كان قلب الخادم موحَّدًا وملتزمًا وتابعًا ومضحيًا، فإن كل كلمة تخرج منه ستكون نافعة وبانية للآخرين، وأي تصرف سيفعله سيكون مثالاً وقدوة للكثيرين، حتى لو لم يصعد في حياته على منبر، لكنه سيكون امتلك قلب الخادم الحقيقي، وتتم فيه الكلمات «الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح» (لوقا6: 45). ويكون «مستعدًا لكل عمل صالح» (2تيموثاوس2: 21)، وساعتها سيخدم أقل خدمة، وأبسط خدمة، ولكنها لن تكون كـ“أي خدمة”!! “أي خدمة” والفراغ! السبب الثاني في هذه الازدواجية الرهيبة، أننا جميعًا نتزاحم حول خدمات نظنَّها جماهيرية وأفضل من غيرها، فيما نترك أمامنا فراغًا رهيبًا في مكان الخدمة الحقيقية التي يريدنا الرب فيها، وبالتالي فإننا نختار الخدمة المحبَّبة لنا، ولا نخدم “أي خدمة”!! وهنا تبرز روعة المسيح كأعظم خادم، فهو لم يأتِ لينافس الكتبة والفريسين في مكانهم، لكن ذهب للفراغ الروحي والاجتماعي الرهيب، الذي لم يلتفت إليه أحد. فهل رأيت خادمًا يقتحم فراغ الخطاة النفسي (لوقا15: 1)، ويذهب للخطاة في أماكنهم، ويأكل معهم بلا إدانة ولا حواجز بينه وبينهم (متى9: 10-13)؟! وهل رأيت خادمًا يشارك الناس فرحتهم ويحضر أفراحهم، ولا يعتبره تضييعًا للوقت والجهد (يوحنا2: 1-10)؟! وهل سمعت عن خادم «جال يصنع خيرًا» (أعمال10: 38)، ليس ليجمع أتباعًا، فكثيرًا منهم رفضوه وطردوه، لكنه كان يريد فعلاً أن يخدم البشر، ولذلك فرغم قصر فترة خدمته على الأرض فلم تكن كـ“أي خدمة”!! إذاً عزيزي القارئ المغتسل بالدم، إننا مدعوون لنكون خدَّامًا حقيقيين، وليس فقط لنقدِّم عروضًا للخدمة!! فعلى جدّيتنا أن تسبق كلام شفاهنا، وعلينا أن نهتم بقلبنا أمام الله أثناء الخدمة، أكثر من نوع وتوقيت ومكان الخدمة نفسها. وأخيرًا علينا أن نترك خدماتنا المفضلة، ونذهب حين يريدنا سيدنا؛ حيث الفراغ الرهيب في نفوس الناس، وحيث لا يستطيع أن يصل إليهم سوانا، ووقتها سيُخرج الله - مصدر الصلاح - كل عمل صالح فيه فائدة للناس، وكل كلمة تسعدهم وتبنيهم، وسيصنع منا خدامًا لائقين بمجده، ونعيش حياة الخدمة، ولكنها ليست “أي خدمة”!! كتير باخدمك، وأنا مش باصص عليك، ولا همي حالة قلبي وعروضي ما فيها جدية، وأديني بأرضيني وأخدمني وبأعبّي!! أتاريك بتدوَّر على قلبي الخادم، مش مجرد خدمة وخلاص وعايزني أخدمك في مكانك، وسط فراغ واحتياج الناس وتديني قلبك أخدم بيه، وتنشر بيه أجمل إحساس جايلك باعترف بسيادتك وحقك، قبل ما اخدمك يا ربي!! وتكون خدمتي ليك بجد، هي ترجمان حقيقي لحبي |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 14033 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
ما علينا
 كلمة ما أقصرها (فقط حرفين جر “ما” و“على”)، تنتشر كثيرًا بمرادفاتها الرسمية (وبناءً عليه!!)، أو الشبابية (لخَّص، لِم الحوار!!). ولكننا هنا سنغوص في معناها الروحي، وخاصة المرتبط بمسؤوليتنا نحن في العلاقة مع الله، لنعرف كيف يعمل الله “ما عليه”، وكيف يجب علينا نحن أن نعمل “ما علينا”؟!! “ما علينا” والصراع! في مرحلة ما من مراحل الإيمان المسيحي، يجتاز المؤمنين في صراع ليس بالبسيط، فبعد حصولهم على الحياة الجديدة، يكتشفون اكتشافًا مزدوجًا مذهلاً، في الوجه الأول منه؛ أن هناك قائد قدير وحكيم جاء ليتسلم قيادة سفينة حياتهم، وأنه من هذه اللحظة سيضمن لهم أمان المسير وضمان المصير، وفي الوجه الثاني من الاكتشاف؛ أن هذا القائد (أقصد “الإله” بالطبع) لا يفعل كل شيء في السفينة - رغم أنه قادر على ذلك - وأنه يتوجب على المؤمنين أنفسهم أن يقوموا ببعض المسؤوليات معه، لكي تصل سفينة حياتهم لبر الآمان، فكما يوجد “ما عليه” يوجد أيضًا “ما علينا”!! وهنا يضطرب الفكر، ويبدأ الصراع، وتكثر الأسئلة: ما هي مسؤوليتنا وما هي مسؤولية قائدنا؟ ولماذا لا يعفينا القائد من المسؤولية ويقود هو حياتنا دون الحاجة لنا؟! وما الحد الفاصل بين “ما عليه” من نعمة وبين “ما علينا” نحن من مسؤولية؟!! وما يزيد هذا الصراع توهّجًا، أن أغلب المؤمنين يتأرجحون حائرين بين مدرستين فكريتين. المدرسة الأولى تقول: أترك نفسك بالتمام على نعمة الله، فأنت أضعف من أن تشارك الله في قيادة حياتك. وهؤلاء تجدهم دائمًا ينتظرون أن “يثقلهم” أو “يشغلهم” الرب للقيام بمسؤولياتهم المعروفة (زيارات، كرازة، قداسة)، خوفًا من أن يقوموا بها بالاستقلال عنه، فيفقدون الاتكال على نعمته، وشعارهم أن “ما عليه” من نعمة، هو أكبر من “ما علينا” من مسؤولية!! أما المدرسة الفكرية الثانية فتقول: ما هذه الدروشة؟! المسيحية ليست للكسالى والعاطلين؟ فالحياة الروحية طابعها الاجتهاد والتدريب المستمر (2بطرس1: 5). وهؤلاء تجدهم غارقين في التفكير والتخطيط (لجان، نشاطات، جلسات)، خوفًا من الانحراف للدروشة والتواكل على الله!! وشعارهم “ما علينا” من مسؤولية، هو أكبر من “ما عليه” من نعمة!! “ما علينا” والشراكة! ومع قسوة هذا الصراع وشدَّته، وما يصحبه من شكوى إبليس الضميرية، وتيبُّس الحياة الروحية، إلا أن الكتاب المقدس يشرح لنا أن العلاقة مع الله ليست - كما يظن البعض - علاقة صراع بين طرفين، كل منهما له نسبة أكبر من الآخر، ولكنها علاقة شراكة رائعة، تجمع بين الله (الكلي القدرة)، وبين الإنسان (الترابي النشأة)، يقوم كل منهما بمسؤولياته، ليس لأن الله عاجز عن القيام بها جميعًا، حاشا، ولكنه لأنه يُسَرّ أن يشترك الإنسان معه في بعض المشاريع مشتركة، وأن يحدث انسجام كامل بين “ما عليه” وبين “ما علينا”!! وقد طبَّق الله هذه الشراكة عمليًا مع آدم أول إنسان، في عدة مشاريع، منها مثلاً مشروع تسمية الحيوانات والطيور بأسمائهم فنقرأ «وجَبَلَ الرَّبُّ الإِلهُ مِنَ الأَرْضِ كُلَّ حَيَوَانَاتِ الْبَرِّيَّةِ وَكُلَّ طُيُورِ السَّمَاءِ، فَأَحْضَرَهَا إِلَى آدَمَ لِيَرَى مَاذَا يَدْعُوهَا، وَكُلُّ مَا دَعَا بِهِ آدَمُ ذَاتَ نَفْسٍ حَيَّةٍ فَهُوَ اسْمُهَا» (تكوين2: 19). وهنا نجد الله القدير يقوم بـ“ما عليه”، فيخلق الحيوانات والطيور ويحضرها لآدم. ورغم أن الله هو الأقدر على تكملة المشروع بمفرده وتسمية الحيوانات دون الحاجة لآدم، لكن علاقة الشراكة مع آدم جعلته يترك لآدم أن يعمل “ما عليه” أيضًا، ويشترك معه في أن يدعوها بأسماء، فيا للفخر!! “ما علينا” والأمثلة! إذاً فهمنا أعزائي، أن العلاقة مع الله علاقة شراكة وليست صراع، وأن الله يُسَرّ بأن يعمل “ما عليه” ويُسَرّ أكثر بأن نعمل نحن “ما علينا”، وأن هذا لا ينقص من قُدرته أو نعمته، ولا يجعلنا نستقل عنه أو نتكل على غيره بل على العكس يجعلنا دائمًا شاعرين باحتياجنا له؛ وهنا نأتي لبعض الأمثلة التوضيحية، لأناس فهموا علاقة الشراكة مع الله وعاشوها، فأدّوا دورهم ومسؤوليتهم و“ما عليهم”، وفي نفس الوقت قَبِلوا وقدَّروا نعمة الله الذي يصنع “ما عليه” أمامهم على أمجد شكل!!  وهنا أكتفي بمثال فردي ومثال جماعي. وأبدأ بالفردي الذي يخصّ دانيآل الذي «جَعَلَ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ لاَ يَتَنَجَّسُ بِأَطَايِبِ الْمَلِكِ وَلاَ بِخَمْرِ مَشْرُوبِهِ، فَطَلَبَ مِنْ رَئِيسِ الْخِصْيَانِ أَنْ لاَ يَتَنَجَّسَ». فهنا دانيآل عمل “ما عليه”، وقرَّر قلبيًا وإراديًا أن لا يتنجس، وعبَّر عن هذه الرغبة في الطلب من رئيس الخصيان، وكان على استعداد لتحمّل تبعات هذا الطلب الخطير. ولأنه في علاقة شراكة مع الله، فالله أيضًا عمل “ما عليه” «وَأَعْطَى اللهُ دَانِيآلَ نِعْمَةً وَرَحْمَةً عِنْدَ رَئِيسِ الْخِصْيَانِ» (دانيال1: 8، 9). وهنا أثمرت الشراكة بين نعمة الله ومسؤولية دانيآل، وكانت النتيجة قداسة نادرة، وشجاعة بقيت مثالاً للأجيال!! أما المثال الجماعي فعاشته الكنيسة الأولى فنقرأ «وَجَمِيعُ الَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا مَعًا وَكَانَ عِنْدَهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مُشْتَرَكًا. وَالأَمْلاَكُ وَالْمُقْتَنَيَاتُ كَانُوا يَبِيعُونَهَا وَيَقْسِمُونَهَا بَيْنَ الْجَمِيعِ كَمَا يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ احْتِيَاجٌ. وَكَانُوا كُلَّ يَوْمٍ يُواظِبُونَ فِي الْهَيْكَلِ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. وَإِذْ هُمْ يَكْسِرُونَ الْخُبْزَ فِي الْبُيُوتِ كَانُوا يَتَنَاوَلُونَ الطَّعَامَ بِابْتِهَاجٍ وَبَسَاطَةِ قَلْبٍ مُسَبِّحِينَ اللهَ وَلَهُمْ نِعْمَةٌ لَدَى جَمِيعِ الشَّعْبِ»، فهم هنا عملوا “ما عليهم” من نحو مشاركتهم لاحتياجات بعضهم، بكل بساطة ومحبة، وتكوين المجتمع اللازم لأي مؤمن، فكان من الطبيعي أن يعمل الله “ما عليه” أيضًا، وينمّي كنيسته ويضّمها لهذا المجتمع الصحي «وَكَانَ الرَّبُّ كُلَّ يَوْمٍ يَضُمُّ إِلَى الْكَنِيسَةِ الَّذِينَ يَخْلُصُونَ» (أعمال2: 44‑47). وكانت النتيجة كنيسة شاهدة، بقيت مثالاً تتمنى تكراره الأجيال!! وإني أترك لقارئي العزيز، أن يتجوّل ببصره وبصيرته، في كل أرجاء الكتاب المقدس، ليفهم أن في كل عمل عظيم أو مشروع مبهر، كان فيه الله يعمل “ما عليه”، ويترك للإنسان أن يعمل “ما عليه” أيضًا، ليس لأنه لا يقدر أن يقوم بدور الإنسان، حاشا، ولكن لأنه يريد أن يستخدم الإنسان إرادته، ويدرِّب نفسه للقيام بمسؤوليته، فكما قال بولس «اللهَ هُوَ الْعَامِلُ فِيكُمْ أَنْ تُرِيدُوا وَأَنْ تَعْمَلُوا مِنْ أَجْلِ الْمَسَرَّةِ»، قال لنا بعدها «فاِفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ بِلاَ دَمْدَمَةٍ وَلاَ مُجَادَلَةٍ» (فيلبي2: 13، 14). لذا فعلينا أن نترك فورًا دروشتنا، ونحطِّم بأنفسنا شرنقتنا التواكلية، وننطلق للمشاريع الإلهية المُعَدّة لنا، ونكتشف روعة أن الله يعمل “ما عليه”، وأن نعمل نحن أيضًا “ما علينا” عالمين أن الله يعطينا كل ما يلزمنا لنتمم ذلك!! عشت كتير في صراع وهمي، بين النعمة والمسؤولية كنت فيه بألومك وبسأل: انت معايا ولا عليَّ؟! لكن خلاص فهمت قصدك، وعجباني الشراكة معاك وعرفت أنك في نعمتك، عايز تشغَّل إرادتي وياك وتشاركني معاك في مشاريعك، هنا في أرضك قبل سماك جايلك خارج من دروشتي، ومن الأفكار اللي حواليً إديني أفهم دورك وعملك، وأعمل كمان الدور اللي عليَّ!! |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 14034 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
الله ينور
 * قد تسمعها دعاءً من والدتك بعد طاعتك لها: الله ينوَّر سِكتك يا بني!! * أو تسمعها مدحًا من مدرِّسك وقت ظهور نباغتك: برافو الله ينوَّر عليك!! * أو تسمعها سخرية من مديرك عند تأخرك عن العمل كعادتك: الله ينوَّر يا بشمهندس ما لسه بدري!! “الله ينوَّر” والمعرفة في “إعداديتنا” كان مدرس الرياضيات يضع أمامنا مسألة هندسة؛ عبارة عن شكل هندسي واثبات مطلوب منها، ويطلب منا حلها، وعلى الرغم من أن جميع الطلبة تعرف جيدًا نظريات المسألة وطريقة حلها، إلا أن الحل يبقى غائبًا عن معظمهم، حتى يقفز به طالب بصير ويصل إلى هـ.ط.ث (!!) فيرد عليه المدرس بحماس: “الله ينوَّر” عليك يا بني!! فيما يتحسر باقي الطلبة متسائلين عن سبب عجزهم عن الحل مثل زميلهم، رغم أنهم يعرفونه وعلى دراية بنظرياته! فأين المشكلة إذن؟! المشكلة باختصار أن هؤلاء الطلبة المخلصين، كانوا يحتاجون إلى أكثر من مجرد معرفة النظريات وطريقة الحل، فهم يحتاجون لمن “ينوَّر” ذهنهم للحل، فالمعرفة بدون إنارة ذهنية تبقى مجرد معلومات متراكمة لا جدوى منها، ولا تؤدي إلى أي حل. وتظهر هذه المشكلة في الحياة الروحية للناس بشكل أضخم؛ فرغم أننا نعيش في عصر كثافة المعرفة الدينية عن الله، من خلال الكتب والنهضات والقنوات الفضائية ووسائل المعرفة الأخرى، فمع ذلك لا تنطبع هذه المعرفة في تغيير حقيقي للسلوكيات والأخلاقيات، وأصبحت هذه المعرفة مجرد معلومات دينية لا أكثر، ونظريات حياتية تسكن فقط في الدماغ ولا تغير الحياة. وهنا تم كلام الكتاب المقدس «لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم (was darkened) قلبهم الغبي» (رومية 1: 21)، فبدل أن الناس تقودهم معرفة الله ونظرياته وقوانينه (تذكر مسألة الهندسة) لتقوى الله وشكره، قادتهم إلى مزيد من العصيان والزيغان عنه، بل وأظلموا ذهنهم بعيدًا عن نوره، وأصبحت معرفتهم عن الله معرفة جوفاء فارغة من أي معنى أو تطبيق، ولكن ما الأسباب التي دعتهم لذلك؟!! دعنا نعرف... “الله ينوَّر” والأسباب الحقيقة، هناك سببان رئيسيان لهذه المعضلة البشرية، تكلم الرسول بولس عن واحد منها، حين أعلن أن «إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة أنجيل مجد المسيح» (2كورنثوس4:4)، فللشيطان الخدَّاع تكتيك مع البشر في قمة الدهاء، فهو لا يمنع عنهم أن يعرفوا الله أو يسمعوا عنه، أو حتى يتناولوه في أقوالهم المتداولة (راجع: على باب الله، البقاء لله، الله اعلم...)، ولا يضيره كثرة النهضات والمؤتمرات والكتابات، ولكنه يعمل على “إعماء” ذهنهم، فيمنع النور الإلهي أن يخترق البقع المظلمة في حياتهم، فالشيطان يقبل أي شيء غير أن “الله ينور” ذهن الإنسان!! السبب الثاني كان في الإنسان نفسه، فهو يعلم جيدًا أن الله يرى الخطية في أي مكان وفي أي وضع (مزمور139: 12)، وهو يغضب بسببها لأنها ضد طبيعته (1يوحنا1: 5)، ولكن في نفس الوقت يحلو للإنسان فِعل الخطية والتمتع بلذتها الموسمية بعيدًا عن الله؛ ولذلك اختار بإرادته أن يبقي ذهنه مظلمًا، بل أن يتوحد ويتكيف مع هذه الظلمة «أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة» (يوحنا3: 19)، فالإنسان الطبيعي يقبل أي شيء من الله غير أن “الله ينوَّر” ذهنه، لأنه وقتها سيكتشف مدى ظلامه وخرابه. ونتيجة لهذين السببين، أصبح الجزء الأكبر من البشر - وخاصة المسيحيين - عارفين دارسين، حاضرين مواظبين، حافظين “مسمَّعين”، ولكنهم - مع إبليس- مانعين أن “الله ينوَّر” الذهن والقلب والحياة، وأصبحوا في ظلمتهم العقلية ماكثين مستريحين مظلمين!!  “الله ينوَّر” والحل “الله ينوَّر” والحللكن أبدًا لم ييأس الله المحب، وقد أعَدَّ للبشرية حلاً عظيمًا، حين أرسل لهم ابنه الحبيب؛ المسيح يسوع الذي هو «النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان» (يوحنا1: 9)، والذي استطاع بنوره الدائم والساطع والمبهر، أن يغلب أي ظلمة روحية وذهنية مهما كانت قوتها، لأنه «فِيهِ كَانَتِ الْحَيَاةُ، وَالْحَيَاةُ كَانَتْ نُورَ النَّاسِ، وَالنُّورُ يُضِيءُ فِي الظُّلْمَةِ» (يوحنا1: 4، 5)، وبالتالي فهو الوحيد الجدير أن “الله ينوَّر” به الإنسان. ولم يتوقف الحل عند هذا، فالمسيح لم يكن مجرَّد نورٍ مؤقت يظهر قليلاً ثم يختفي، ولم يكن مثل أنبياء العهد القديم الذين كانوا مثل “البطاريات” التي تضيء بعض الوقت، لكن المسيح هو قوة ونبض ومصدر لنور دائم ومستمر ومبهر، فهو يمكن كل من يقبله ويؤمن به ويوصل “كَابل” حياته به أن تسري في حياته طاقة هائلة من النور، فيصبح من «أولاد نور» (أفسس5: 8)، ووظيفته «نور العالم» (متى5: 14)، وعلاقاته عنوانها «من يحب أخاه يثبت في النور» (1يوحنا2: 10). وليس هذا فقط، لكن أكبر مهام هذا النور الحقيقي، هو أن يزيل عملية “إعماء الذهن” التي صنعها إبليس للبشر، بعملية “إنارة الذهن” «لأَنَّ اللهَ الَّذِي قَالَ: أَنْ يُشْرِقَ نُورٌ مِنْ ظُلْمَة، هُوَ الَّذِي أشْرَقَ فِي قُلُوبِنَا، لإِنَارَةِ مَعْرِفَةِ مَجْدِ اللهِ فِي وَجْهِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ» (2كورنثوس4: 6)، وبالتالي حل المسيح المشكلة التي كان يعاني منها البشر- والتي كنا نتناولها في هذا المقال - وأنار معرفة الله عند البشر، وبالتالي تتغير حياتهم وأخلاقهم وأبديتهم. عزيزي القارئ العارف، أثق كثيرًا في كم معرفتك الدينية والكتابية الضخم عن الله، واثق أن هذه المقالة ربما لن تضيف كثيرًا لمعلوماتك المخزونة منذ الصغر، ولكن صدقني أنت تحتاج - مثلي - لا لمزيد من المعرفة، ولكن لأن “الله ينوَّر” ذهننا لهذه المعرفة، فتغيِّر حياتنا وأخلاقياتنا. هيا نُعيد معًا توصيل “كابل” حياتنا به بشكل يومي ولحظي، هيا نطلب منه هذه الإنارة، فنحن بدونه وفي أفضل حالاتنا، معتمين ومظلمين ومحرومين من روعة حقيقة أن “الله ينوّر”. ياللي انت نور في طبيعتك، من قبل حتى ما تقول: ليكن نور وانت اللي عرَّفتنا مين شخصك، وبمعرفتك كان الكل مسرور لكن إبليس بدهائه، عمى الذهن ومنع الإنارة وساق الناس بطريقته، وسرق منهم الإدارة وحوًّل معرفتك لمعلومات في كنايس دوَّارة!! جايلك توصل “كَابل” حياتي بيك، بعد ما صابه العمى والضمور وتشرق على ذهني بأشعتك، لما أسمعك كل يوم تقوللي: صباح النور!! |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 14035 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
طـيب  إذا أضفتها لأيَّة فترة زمنية أنتجت تحية مناسبة لها، ففي بداية العام تسمع وتقول: كل سنة وأنت طيب، وفي بداية كل شهر تسمع من صاحب البيت طالبًا الإيجار: كل شهر وأنت طيب!! أو من المُدَرِّس الخصوصي لك أو لغيرك: كل تيرم وأنت طيب!! هنا لن نغوص في أي من المعاني السابقة، لكننا سنقترب أكثر من معناها عندما تُطلَق على أقوال أو أفعال الإنسان، أو بالحري تُطلَق على الإنسان شخصيًّا أنه “طيِّب”، أو عندما تُطلَق على الإله الحي الحقيقي على أنه وحده “الطيب”!! “طيب” والمعنى كثيرون يعتقدون أن وصف الإنسان بأنه “طيِّب”، في زماننا الغريب هذا، يُعتَبر عيبًا فيه وليس ميزة له؛ فأغلب الناس تظن أن الإنسان “الطيب” هو المتساهل في حقوقه أو حقوق غيره، أو هو المُفَرِّط في هيبته وكرامته، وبالتالي فلا مكان له في دنيا الخُبث والمصالح المتبادلة. ولهذا لا تستغرب أن يتم “قلشك” من فرصة عمل لأنك “طيِّب”، أو يتم رفضك مِن فتاة تُريد خطبتها، لأنك في نظرها “طيِّب”!! لكن عندما بحثت في الكتاب المقدس، مرجعيتنا الأولى والأخيرة، عن معنى الإنسان “الطيِّب”، وجدت أنه أبعد ما يكون عن هذا المعنى؛ فالطيب هو شخص مُريح ونقي، تظهر طيبته في أقوال أو أفعال مُريحة للغير، بدون أي تفريط في حقوقه أو هيبته. فيوسف كان “طيِّبًا” بالكلام عندما هدّأ من روع إخوته بعد موت والده يعقوب، وخوفهم من انتقامه منهم، فقال لهم: «فالآن لا تخافوا! أنا أعولكم وأولادكم. فعزَّاهم وطَيَّب قلوبهم» (تكوين50: 21). وبوعز كان “طيِّبًا” بالأفعال، عندما سمح لراعوث أن تلتقط في حقله، رغم أنها غريبة ووحيدة وعديمة الخبرة، فرَدَّت عليه: «لأنك قد عَزَّيتني وطَيَّبْتَ قلب جاريتك» (راعوث2: 13). وغيرهما الكثير من رجال الله “الطيِّبين”. لذا، عزيزي القارئ الطَيِّب، نحن مدعوون أن نمارس “طيبتنا” مع كل مَن حولنا، سواء بلغة الإيمان المُفرِح التي لا يعرفونها لأن «الغم في قلب الرجل يُحنيه والكلمة الطيِّبة تفرحه» (أمثال12: 25)، أو بأخبار الخلاص المُحيية لأن «نور العينين يفرح القلب، والخبر الطيِّب يسمِّن العظام» (أمثال15: 30)، وأن نُثبِت ذلك بالأعمال الطيِّبة. وقتها ستخرج الابتسامة منهم لأسفل، والمجد أيضًا لإلهنا لأعلى، ويقولون عليك: إنك رجل “طيِّب”. “طيب” والإله الآن نتعمق قليلاً في كلمة “الطيِّب”، ليس باعتبارها أقوالاً أو أفعالاً من أناس “طيبين”، ولكن باعتبارها صفة من صفات إلهنا الذي نعبده. فبجانب أنه القدوس والخالق والراعي والمُحِب، فهو أيضًا “الطيب”، كما أعلنها الكتاب صراحة: «طَيِّب هو الرب للذين يترجونه للنفس التي تطلبه» (مراثي3: 25). ولكن دعني أتجاسر وأسأل: هل كون الرب “طيِّبًا” يعني أنه يتغاضى عن الشر؟! أو أنه يُفَرِّط في حقوق قداسته؟! أو بلغتنا الحالية: هل هو “يفوِّت” أو “يطنِّش” على خطية الإنسان؟! وهل “طيبته” هذه تتنافى مع عدله وحقه؟! الإجابة نجدها في أكثر مكان يتحدث عن “طيبة” الرب وإحساناته؛ أقصد مزمور34، ففي هذا المزمور (مِن فضلك اقرأ المزمور بجانب المقالة) يفيض الكاتب في وصف طيبة الرب وأشكالها؛ فهو “طيِّب” لأنه يستجيب الصلاة (ع4)، وينقذ من المخاوف (ع4)، ويستمع لصرخات المسكين (ع6)، ويُخَلِّص من كل الضيقات (ع6)، ويسدِّد أعواز مُحِبِّيه من الخير (ع10)، وعندما تزيد صفات “طيبته” على أن تُعَدّ، يصدر التقرير النهائي: «ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب! طوبى للرجل المُتَوَكِّل عليه» (ع8)، فيا له من “طيِّب”!! ولكن اللافت للنظر أنه بعد هذا الكلام مباشرة يقول: «هَلُمَّ أيها البنون استمعوا إليَّ فأعلِّمكم مخافة الرب» (ع11)، ثم يبدأ يتكلم عن صون اللسان عن الشر (ع13)، وعدم التكلم بالغش (ع13)، والحيدان عن الشر (ع14)، وأن وجْه الرب ضد فاعلي الشر (ع16)، وأن الشر يُميت الشرير (ع21)؛ فما علاقة كل هذا بأن الرب “طيِّب”؟!! الحقيقة أن “طيبة” الرب لا تتعارض أبدًا مع مخافته، بل بالعكس فكلَّما تمتعت برحمته وطيبته واقتربتَ من قلبه وعواطفه، كلما فهمتَ كم هو قدوس لا يتساهل أبدًا مع الشر، وليس عنده محاباة، فهو قدوس وهو أيضًا “طيِّب”!! “طيب” والصدمة الآن وقد اقتنعت، عزيزي القارئ الطيِّب، بكل ما سبق، فدعني أصدمك بفكرة قد تكون سمعتها أو قرأتها من قبل، فقد اكتشفت أن كل شر يدخل لحياتنا، وكل إهمال وتَسَيُّب وعدم أمانة يكون خلف ستار اسمه: “الرب طيِّب”!! فكثيرًا ما أسأنا فهم “طيبته”؛ فلأنه “طيِّب” فَرَّطنا في العيشة بمقاييس قداسته ونسينا التحريض: «بَلْ نَظِيرَ الْقُدُّوسِ الَّذِي دَعَاكُمْ، كُونُوا أَنْتُمْ أَيْضًا قِدِّيسِينَ فِي كُلِّ سِيرَةٍ» (1بطرس1: 15). ولأنه “طيِّب” صِرنا نخدم الناس ونطلب تقييمهم ولا نخدمه هو وتجاهلنا أنه «لو كنت بعد أُرضي الناس لم أكن عبدًا للمسيح» (غلاطية1: 10). ولأنه “طيِّب” صِرنا أكثر شَبهًا بأهل العالم؛ فطموحاتنا مشتركة ومخاوفنا مشتركة ونسينا: «لاَ تُشَاكِلُوا هذَا الدَّهْرَ، بَلْ تَغَيَّرُوا عَنْ شَكْلِكُمْ بِتَجْدِيدِ أَذْهَانِكُمْ» (رومية12: 2). إذا لنحذر جميعًا، فطيبة الرب معنا لا خلاف عليها، فهو يسمع ويتحنَّن ويترفق ويُغيث ويحمل ويغفر ويتأنى، لكنه أبدًا لم ولن يتساهل مع الشر، ولا “يفوِّت” أو “يطنِّش” على الشر الذي قد يتسرَّب للحياة ويسكن فيها بإرادتنا، ولنعش جميعًا المعنى الحقيقي للإنسان “الطيِّب” الذي يفعل “الفعل الطيِّب” ويقول “القول الطيِّب” لأنه يعرف جيدًا معنى أن إلهه هو “الطيِّب”!! مِن زمان وأنا عارف كويس إنك حنين ورائع وطَيِّب مِن كلامك، مِن صفاتك، مِن مراحمك، من كونك مني قُرَيِّب بس للأسف ياما عملت الشر مِن ورا طيبتك وياما افتكرتك هاتتساهل في مطاليب قداستك وإنك ممكن تفوِّت أو تطنِّش على شر ابنك آه! سامحني يا أبويا، ساعدني أعرف معناك وقيمتك وإنك قدوس وعادل وبار، زي ما إنت كمان “طيِّب”!! |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 14036 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
الله أعلم   سمعتها من مجتمع “الفتاوي” الجالس على “القهاوي”، يتبادلون “الرغي” والكلام عن الفضائيات والأقلام، ثقافتهم منقولة وأقوالهم موتورة (مِن التواتر)، ينهون جلستهم بسؤال وحيد وجواب فريد: هي البلد رايحة فين؟! فيجيبون جميعًا: “الله أعلم!” سمعتها من مجتمع “الفتاوي” الجالس على “القهاوي”، يتبادلون “الرغي” والكلام عن الفضائيات والأقلام، ثقافتهم منقولة وأقوالهم موتورة (مِن التواتر)، ينهون جلستهم بسؤال وحيد وجواب فريد: هي البلد رايحة فين؟! فيجيبون جميعًا: “الله أعلم!”“الله أعلم” والإجابة! تعوَّد العقل البشري عامة، والمصري خاصة، أن “يُفتي” ويجيب على أي سؤال يخصّ غيره، وفي نفس الوقت يتباطأ عن إجابة الأسئلة المصيرية التي تخصه!! فقد تسأل عَالِمًا مَهوبًا: لماذا أنت موجود على الأرض؟ فيجيبك بضحك: “الله أعلم”. أو تسأل شابًّا محبوبًا: أين يوجد الله في حياتك؟ فيجيبك باستهتار: “الله أعلم”. أو حتى شيخًا كهولاً: أين ستقضي أبديتك التي قد تبدأ بعد ساعات؟ فيجيبك بعدم اكتراث: “الله أعلم”!! ورغم أنها إجابة صحيحة تفيد معرفة الله غير المحدودة، وإيقانًا بأنه وحده العليم (راجع “يا فَتَّاح يا عليم” من نفس السلسلة)، لكن قد يتخذ الكثيرون من هذه الإجابة فرصة لإراحة عقولهم وإلغائها، و“حِجة” للهروب من مجال البحث عن الحق والحياة. تمامًا مثلما فعل رؤساء الكهنة والشيوخ، عندما سألوا المسيح: «بِأَيِّ سُلْطَانٍ تَفْعَلُ هَذَا؟ وَمَنْ أَعْطَاكَ هَذَا السُّلْطَانَ؟»، ورَدَّ عليهم المسيح بسؤال له نفس إجابة سؤالهم: «مَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا مِنْ أَيْنَ كَانَتْ؟ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ مِنَ النَّاسِ؟ ففَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ قَائِلِينَ: إِنْ قُلْنَا: مِنَ السَّمَاءِ، يَقُولُ لَنَا: فَلِمَاذَا لَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ؟ وَإِنْ قُلْنَا: مِنَ النَّاسِ نَخَافُ مِنَ الشَّعْبِ لأَنَّ يُوحَنَّا عِنْدَ الْجَمِيعِ مِثْلُ نَبِيٍّ. فَأَجَابُوا يَسُوعَ: “لاَ نَعْلَمُ!”» (متى21: 23‑27). عزيزي القارئ، أخشى أن تكون مثل هؤلاء، الذين يسألون ويفكرون ويتناقشون، بل ويعرفون الإجابة الصحيحة (السماء أو النار)، وفي النهاية يتركون مكان الإجابة فارغًا غير محسوم!! فأنت أدرى بالأسئلة المصيرية التي لا يزال يسألك بها الرب، والتي اختصك بها بطول المجلة وعرضها. فلا وقت للمراوغة! هَيَّا، احسم إجاباتك معه ولا تهرب منه بقولك أن “الله أعلم!” “الله أعلم” والاحتياج! الآن، إن كنتَ قد حسمتَ إجاباتك وتقابلت مع المسيح شخصيًّا، فإليك هذا الأمر المُعَزِّي: إن المسيح اهتم بأمر آخر قد يؤرقك ويُتعبك اسمه: الاحتياج؛ فهو يعلم أن هَمَّ البشر الأول هو كيفية تسديد احتياجاتهم اليومية، وضمان احتياجاتهم “الغَدِّيَّة” (من الغد)! لذلك فليس عجيبًا أن له رسالة مُطَمئنة بشأن الاحتياج، لكن العجيب والمدهش أن الرسالة عنوانها أيضًا: “الله أعلم!” فالمسيح لم يَعِد المؤمنين بحياة بلا احتياج ولا أعواز، ولم يُمَنِّيهم بالمسيحية المُرَفَّهة ذات الخمس نجوم، لكنه استخدم منطق الإقناع في توضيح حقيقية واحدة كافية أن «أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها» (متى6: 32). فإن كان مَن يخترع آلة أو جهازًا هو الأقدر على صيانته وتوفير “لوازمه” و“أكسسواراته”، فكيف لله المُحِب، الذي صمَّم وخلق الإنسان، أن يجهل أبعاد احتياج إنسانه؟! حاشا! فهو أول مَن نَبَّه آدم لاحتياجه للزواج: «وقال الرب الإله: ليس جيدًا أن يكون آدم وحده فأصنع له مُعِينًا نظيره» (تكوين2: 18)، وأول مَن نَبَّه موسى لاحتياجه للصديق والرفيق الذي يسانده: «ألَيْسَ هَارُونُ اللاوِيُّ أخَاكَ؟ أنا أعْلَمُ... هَا هُوَ خَارِجٌ لاسْتِقْبَالِكَ. فَحِينَمَا يَرَاكَ يَفْرَحُ بِقَلْبِهِ» (خروج4: 14)، وهو الذي نَبَّه إيليا لاحتياجه للطعام: «وَقَالَ: قُمْ وَكُلْ لأَنَّ الْمَسَافَةَ كَثِيرَةٌ عَلَيْكَ» (1ملوك19: 7)، وغيرها الكثير من الأمثلة التي تصب في اتجاه واحد أن “الله أعلم” بالاحتياج! “الله أعلم” وكلمة السر! لكن قد يتساءل قارئ ذكي مثلك: ماذا استفدت أنا من عِلم الله باحتياجي دون تسديده؟ وهل سيتدخل الله، أم سيكتفي بمجرد علمه باحتياجي؟! وللإجابة البسيطة والأخيرة، علينا أن نراجع مشهدين، الأول “كتابي” في الماضي، والثاني “مكتبي” في الحاضر! بالنسبة للمشهد الكتابي هو ما حدث في مصر، عندما قرر الله أن يُخَلِّص شعبه من ذُل وعبودية المصريين فنقرأ: «وتَنَهَّدَ بَنُو إسْرَائِيلَ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ وَصَرَخُوا فَصَعِدَ صُرَاخُهُمْ إلى اللهِ مِنْ أجْلِ الْعُبُودِيَّةِ، فَسَمِعَ اللهُ أنِينَهُمْ فَتَذَكَّرَ اللهُ مِيثَاقَهُ... وَنَظَرَ اللهُ بَنِي إسْرَائِيلَ وَعَلِمَ اللهُ» (خروج2: 23‑24). فهنا لم يكتفِ الله بمجرد “عِلمه” باحتياج شعبه للخلاص من الذل والاضطهاد، فهذا الأمر لم يكن خافيًا عليه أصلاً، ولكن “علمه” كان بمثابة كلمة السر (أو الـ password)، التي أدخلها الرب ليُعلن فيها عن بداية تدخله الرهيب لتسديد احتياج شعبه. فعِلم الله له قدرة، وقدرته مُنسجمة مع علمه، فالله أقدر و“الله أعلم!” أما المشهد المكتبي فهو يحدث يوميًّا، عندما يتلقى الموظف أمرًا إداريًّا من مديره، فيكتب تحت الأمر عبارة: “عُلم ويُنَفَّذ” ويُوَقِّع بنفسه تحتها، فإن كان بالنسبة للمدير مجرد “عِلم” الموظف بالأمر يعني تنفيذه وبسرعة، فماذا عن “مدير الكون”؟! هل يكتفي بعِلمه لاحتياجات أحبائه دون تدخله لتسديدها؟! حاشا، فعِلم الله ينسجم تمامًا مع محبته ورحمته، فالله أرحم و“الله أعلم!” عزيزي القارئ المحتاج، مثلي، يقينًا أن لديك احتياجًا شخصيًا لم يتم تسديده (مال، زواج، نجاح، حل لمشكلة)، ويقينًا أن هذا الاحتياج يشغل مساحة كبيرة من تفكيرك (لماذا...؟ متى...؟ كيف...؟ هل...؟)، ويقينًا مُضَاعَفًا أن إبليس يستخدم احتياجك للتشكيك في صلاح الله وأمانته معك. لكن ثِق في قدرة إلهك الذي يسدد ويملأ كل احتياجك في حينه (فيلبي4: 19)! وثِق في حكمته التي تختار التوقيت والطريقة المناسبة لتسديده! وثِق في عِلمه باحتياجك أكثر جدًّا منك أنت، وكل ما عليك أن تُذَكِّر كيانك وتُنعِش إيمانك في صباح كل يوم يُلِح عليه احتياجك بكلمة السر التي أعلنها لك إلهك؛ والتي كنا نتأمل فيها أن: “الله أعلم!” مشغول فكري بِبُكرة، يا ترى إيه شكله؟ وإيه مَجَايبه؟ ومنين أسدد احتياج يومي، أو أهَدِّي إلحاحه ومطالبه؟ مش إنت وَصِّتني إني عمري مانشغل وأهتم؟ وأقنعتني إن بُكرة بتاعي في إيديك مِتلَم؟ فادِّيني تكون كلمة سِرِّي: “الله أعلم!” فأسَلِّمك يومي وبُكرة من كل حدوده وجوانبه! وأستَنَّى تدخل إيدك لصالح واحد محتاج مِن حبايبه! |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 14037 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
يا هــادي
 كلمة بديعة تبرز عند المفترقات وتتراكم كلما كثُرت “اليُفَط” واللافتات، تنتشر في شارع لا يعترف بقواعد المرور، رغم أنها (في الحياة) من أهم قواعد السرور! وهنا سنتأمل في روعتها وغزارة معانيها، خاصةً حين تخرج من فم مسكين تائه يقول: يا هادي! يا هادي والمُفتَرَقات يقولون إن أكثر خطر يهاجم الجندي وهو في صحراء البرية ليس الجوع أو العطش؛ لكنه خطر الضلال والتوهان! نعم فالبرية لا مجال فيها للهداية، وإذا خطا الإنسان خطوة واحدة خطأ (ولو بسلامة نِيَّة)، لوجد نفسه في مكان بعيد جدًّا عن مُبتَغَاه. ويقولون أيضًا إن البرية في ذاتها ليست طريقًا واحدًا؛ بل طريق مليء بالمُفتَرَقات، وهذا سبب صعوبتها وإثارتها في الوقت ذاته. والمُفتَرَقات يمكن تعريفها على أنها الأَفرُع التي تتفرع من طريق الإنسان والتي يستلزم فيها اتخاذ قرار حاسم لمتابعة المسير؛ إما يمينًا أو يسارًا، إما مسيرًا أو ثباتًا. والطبيعي أن هذه المفترقات لا تظهر في بداية حياة الإنسان (أقصد طفولته)، لأنه وقتها يسير في طريق لا فرع له، اختاره أبواه، لا يعبأ بأية مسؤوليات أو احتياجات. وما أن يكبر الطفل حتى يبدأ طريقه في التشعب رغمًا عنه، وتظهر المُفتَرَقات رويدًا رويدًا؛ ففي الإعدادي مُفتَرَقات الصداقة (زميل أو أنتيم!)، وفي الثانوي مُفتَرَقات الدراسة (علمي أو أدبي، أحياء أو كيمياء)، وفي الجامعة مُفتَرَقات الحياة الأكاديمية (مُعيد قسم أو مُعيد سنة!)، وبعد التخرج مُفتَرَقات العمل (حكومي أو خاص!)، تليها مُفتَرَقات الهجرة (AUS أو USA أو NOTHING)، قبل أن تُلِح مُفتَرَقات الزواج (سـ أو مـ أو...!!). وهنا لا يكفي الإنسان لوحة أو “يافطة” ترشده في أي الطُرُق يسير، أو حتى حَدس يتوقع به القادم له؛ لأن كل مُفتَرَق من المُفتَرَقات يعلن على أنه وحده الصحيح والباقي ضلال مُبين. وهذا قد يُغرِقه في بوتقة حيرته قد توصله إلى “بالوعة اليأس”، إلا لو همس لأعلى قائلاً: ياهادي! يا هادي والمرجعيات بمجرد أن يطلب الإنسان خالقه كـ“الهادي”، فإنه من فرط حبه وصلاحه يتدخل على الفور، بل العجيب أنه يمتلك مرجعية رائعة تجعله يستخدم حق التدخل “الفيتو الإلهي” لهداية أي إنسان تائه وحائر في مُفتَرَقات طرقه حتى ولو لم يطلبه. وهذه المرجعية ترتكز على أمرين: أولهما أن الرب يعرف الإنسان: «لأنه يعرف جِبْلَتنا، يذكر أننا تراب نحن» (مزمور103: 14)، والأمر الثاني أن الرب يعرف أن الإنسان كائن قابل للتوهان (مزمور56: 8)!! وأنه أبعد ما يكون عن هداية نفسه، كما أعلنها إرميا: «ليس للإنسان طريقه ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته» (إرميا10: 23)، وأكَّدَها سليمان: «قلب الإنسان يفكر في طريقه والرب يهدي خطوته» (أمثال16: 9). وعلى أساس هذه المرجعية المزدوجة لا مَفَر من تدخل الرب “الهادي”. وتتنوع التدخلات من حيث الطريقة والموضوع. بالنسبة للموضوع فهو يهدي في الزواج: «هداني الرب إلى بيت إخوة سيدي» (تكوين24: 27)، ويهدي في الخدمة: «والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم» (1تسالونيكي3: 11)، ويهدي في السكن: «وهداهم طريقًا مستقيمًا ليذهبوا إلى مدينة سكن» (مزمور107: 7). وبالنسبة للطريقة فمَرَّة يهدي بيديه: «وبمهارة يديه هداهم» (مزمور78: 72)، ومَرَّة يهدي بحقه في كتابه: «نورك وحقك هما يهديانني» (مزمور43: 3)، وإن استدعى الأمر ينزل هو بنفسه (كما فعلها مع شعبه القديم) فقد كان «يسير أمامهم نهارًا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق» (خروج13: 21). فما أروعها مرجعية تجعل “الهادي” يتدخل في حياتنا باستمرار ويهدينا إلى سبل البر «من أجل اسمه» (مزمور23: 3)، بالطريقة التي يختارها، والموضوع الذي يصطفيه. فعلينا أن ندعوه فرحين وفخورين: يا هادي! يا هادي والمستقيمات نأتي أخيرًا إلى مشكلة قد تظهر أمام “الهادي” وهو يمارس عمله معنا؛ مشكلة تُسَمَّى: “المستقيمات” تحدث عندما ندَّعي أننا نعرف أكثر منه، وأن طريقنا واضح ومستقيم أمامنا، وأنه لاحاجة لنا لمن يهدينا فيه. وهنا تتم فينا الكلمات المكررة مرتين: «توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت» (أمثال14: 12؛ 16: 25)، وهذه كارثة حقيقية! وهنا أيضًا لا يتركنا “الهادي” لأنفسنا، بل يصنع معنا أمرًا عجيبًا لحل هذه المشكلة العويصة، تمامًا مثلما صنع مع شعبه القديم بمجرد خروجهم من مصر، فيقول الكتاب: «وكان أن الله لم يهدهم في طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة لأن الله قال: لئلا يندم الشعب إذ رأوا حربًا ويرجعوا إلى مصر فأدار الله الشعب في طريق برية بحر سوف» (خروج13: 18)!! ومن الأعداد السابقة (أرجوك أعد قراءتها في 30 ثانية) نفهم أنه عندما يرى “الهادي” أن الإنسان بنظرته المحدودة قد يختار مُفتَرَقًا ويرفض الآخر، لمجرد أنه يبدو مُستَقِيمًا أو قريبًا، فالأمر يستلزم تدخل “الهادي” ليس بالهداية ولكن بعدم الهداية: «لم يهدهم»!! ليس لأنه لا يحب شعبه أو يتلذذ بتيهانهم، لكن لأنه الإله الحكيم الذي يرى الطريق من نهايته قبل بدايته، ويعرف الخطر القادم من بعيد قبل أن يأتي، ويدرك جيدًا مدى استعداد شعبه ونضجه لمواجهته. لذا فلا ضرر إذا سمح “الهادي” بعدم الهداية السريعة لنا (تأخر سن الزواج، تأخر الحصول على عمل، تأخر شفاء مرض)، لأنه رائع حين يأمر فيهدي سريعًا، ورائع أيضًا حين يدير وجهنا نحو البرية ولا يهدي سريعًا، وفي الحالتين نحن محظوظون بهذا “الهادي”. عزيزي القارئ، يقينًا أنك شاب، ويقينًا أمامك عشرات المُفتَرَقات، ويقينًا مُضاعَفًا أنك تحتاج إلى “الهادي” فيها. صَدِّقني المشكلة ليست في الطريق أو وعورته أو تشابك تَفَرُّعاته أوتشابهها، لكن المشكلة، بل والكارثة، أن تسير في طريقك (مهما يبدو سهلاً أو مستقيمًا) دون أن ينطقها فمك بعوَز قائلاً: يا هادي! إزاي ماطلبش هدايتك، وأمشي في طريقي الحاير واليُفَط حواليَّ بتزغللني، وكلها عليَّ بتشاور مين عارف طريقي بنهايته قبل بدايته ومين كاشف قلبي الجوّاني وغايته ومين يحفظ خطواتي يتوهوا بعيد ويشتوا تعالَ اتدخل في حياتي، بأي طريقة يا قادر! واقنعني إن دورك تهدي، ودوري أقولك: حاضر! |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 14038 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
تعيــش
 * سمعتها من طالب ثانوية ينتظر نتيجة التنسيق، يسمع أقاويل عن الحد الأدنى ويتعشم بالمجموع الأقصى. بعد محاولات يصله خطاب الترشيح بيد شخص مُريح، فيرمقه بنظرته ويشكره قائلاً: شكرًا لتعبك، تِعيش! لطالما انتشرت في معاجم مجتمعنا الدعوات التي تتمنى الصحة والعافية للناس، وكان للدعوات التي تتمنى طول الحياة للإنسان نصيب وافر منها، فأخذت عدة أشكال؛ منها الرباعية (ربنا يطوِّل في عمرك)، أو الثلاثية (يِدِّيك طولة العمر)، أو الثنائية (ربنا يِخَلِّيك)، أو الأحادية (تِعيش)، وهنا سنكتفي بالأخيرة؛ كلمة “تعيش”.  “تِعيش” والمجال: “تِعيش” والمجال:ما أكثر الكلمات التي تربط كلمة “تِعيش” بحرف العطف “واو”، فمخازن كلمات الإنسان تمتلئ منها منذ طفولته؛ فالطفل تعوَّد عندما يسقط وهو يتعلم المشي أن يسمع: “تِعيش وتقع”، وعندما يشتري ملابس جديدة “تِعيش وتدوِّب”، وعندما يفاجأ بما لا يريده يسمع: “ولا يهمك! تِعيش وتاخد غيرها”. وحين يصبح الطفل شابًا تتغير الكلمات المعطوفة عليها تبعًا لمراحله السنية؛ فعند رسوبه في الكلية يسمع: “تِعيش وتدَبْلَر”، وفي المناسبات “تِعيش وتجامل”، أو “تِعيش وتزور”، وهلم جرّا. ورغم أنها كلمة رائعة؛ في معناها السطحي رغبة في إطالة عمر الإنسان، لكنها تُخفي معنًى خطيرًا، يتجسد حين يستخدمها الإنسان ليعطي لنفسه مجالاً متسعًا من الوقت، و“بَرَاحًا” لمزيد من المحاولات، على أساس أنها ليست نهاية الحياة أن تقع أو ترسب أو تشتري ملابس، فهي أمور تتكرر وستتكرر في الحياة طالما أنت “تعيش”. ولكن هناك من الأمور الحساسة التي لا مجال فيها للمحاولات الخاطئة، فلا يمكن أن تقول لصيدلي: “تِعيش” وتصرف دواء خاطئًا! أو لمهندس: “تِعيش” وتبني أساسًا هشًّا! فهنا المجال لا يتسع للأخطاء أو المحاولات الأخرى، لأنها قد تكون الأخيرة، وقد تُفقَد حياة الكثيرين. ويحدِّثنا الكتاب المقدس عن كثيرين ظنوا أن المجال يتسع لمزيد من الوقت والمحاولات للتوبة والرجوع عن الخطية، ولكن للأسف خاب ظنهم. انظر إلى فرعون الذي خدعه مستشاروه قائلين: “تِعيش وتتقَسَّى على الرب”، فسمع الرد من موسى: «نِعِمَّا قلت. أنا لا أعود أرى وجهك أيضًا» (خروج10: 29). وانظر إلى شاول الذي قال لنفسه: “تِعيش وتعصى صوت الرب”، فسمع الرد من صموئيل: «هوذا الاستماع أفضل من الذبيحة... لأنك رفضتَ الرب رفضك من المُلك... ولم يعُد صموئيل لرؤية شاول إلى يوم موته» (1صموئيل15: 22، 23، 35). وانظر إلى الغني الذي خدع نفسه قائلاً: “تِعيش وتكنز بدون الرب”، فكان الجواب من الرب شخصيًّا: «يا غبي، هذه الليلة تُطلَب نفسك منك» (لوقا12: 20). عزيزي القارئ، أخشى أن تكون مثل هؤلاء الذين ظنوا أن المجال أمامهم والوقت في صالحهم ليستمروا في طريقهم الشرير، ولكنهم جهلوا تمامًا أن المواقيت والأزمان في يد القدير لأنه «يُميت ويُحيي» (1صموئيل2: 6)، وهو وحده الذي يضع حدًّا لكل شيء! فما أدراك أن هذه المرة لن تكون الأخيرة؟! “تِعيش” والغرض: هل تعلم، عزيزي القارئ المُخلِص، أننا فيما نُغرِق يومنا بدعوات الحياة والصحة وتمني “العيش” لبعضنا، أننا قانونيًّا لا يمكن أن نتمتع بها، فالواقع أننا - بدون الله - جميعًا أموات! نعم، أموات لأننا ببساطة تعدّينا و«أجرة الخطية هي موت» (رومية6: 23)، وأصبحنا فعليًّا «أموات بالخطايا» (أفسس2: 5)، وبالتالي فلا قيمة لأية دعوات أو تشكرات من “الأموات” لبعضهم حتى لو كان عنوانها الكلمة البرَّاقة “تِعيش”! وهنا أوجد الله المُحِب وسيلة لإعادة الحياة للمائتين، لأن «الله محبة، وبهذا أُظهِرَت محبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به» (1يوحنا4: 8، 9)؛ فابنه الوحيد، الذي «فيه كانت الحياة» (يوحنا1: 4)، هو الوسيلة الوحيدة، وأصبح بإمكان كل من مات بسبب الخطية أن يحيا به. ولأنه هو الوسيلة، فلا يستحق أن يكون غيره الغرض الذي يستحق أن نعيش لأجله، «لأن ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته، لأننا إن عِشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت... فللرب نحن» (رومية14: 7). وهذا حق طبيعي له بسببين؛ الأول لأنه خلق الإنسان للذَّته (أمثال8: 31)، والثاني لأنه اشترى الإنسان بدمه: «فهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام» (2كورنثوس5: 15). وبهذا يكون المسيح هو الوسيلة وهو الغرض الذي نختبر به كلمة “تِعيش”.  “تِعيش” والدلع: “تِعيش” والدلع:اسمح لي عزيزي القارئ، أن أضم نفسي إليك في هذه النقطة، واسمح لي أنها لن تكون كسابق الفقرات، فأنا أعرف أن الكلام السابق ليس فيه جديد عليَّ أو عليك، وأن الاجتماعات والمؤتمرات والكتابات اكتظت به، فجميعنا نعلم أننا لسنا لأنفسنا وأننا فقط مِلك لسيدنا، وأنه لا يحق لنا أن نتحكم في طريقة أو مكان أو اسلوب “عيشنا” له، ولكن لا تغيير يحدث، هل تعلم لماذا لأننا مضروبين بداء “الدلع”! فما زلنا نعتقد أن المجال والوقت يتسعان، وأنه إذا لم نعش اليوم فسنعيش غدًا للرب، والحقيقة أن هذا لا يحدث. عزيزي القارئ، “تِعيش” وتجيب المجلة، “تِعيش” وتقرأ، “تعيش” و“تتبسط” من القصص، “تِعيش” وتقلب الصفحات والأعداد وأنت مستمتع بالإعداد الفني المُبهر! لكن دعني أسألك وأسأل نفسي: متى “سنعيش” له؟! ومتى سنترك حياة “الدلع” الروحي بلا رجعة؟! وأخاف أن نصحو من غفوتنا متأخرًا، فنجد حياتنا تبخَّرت في أحلام وأوهام أرضية، ونشاطات وخدمات هي في الحقيقة للناس، دون أن نختبر حياة الاجتهاد والجُندية الحقيقية التي يجب أن نحياها، والتي بدونها نحن أموات ولو صرخ فينا العالم كله قائلين: “تِعيش”. كترت محاولاتي وأخطائي وستارها كلمة “تِعيش” وأتاريني باهرب بيها منك ورا حجج ما بتنتهيش خلاص جه الوقت اللي أعيش لسيدي بجد ما فيش مجال إن الدلع يفضل يتمد أو أكون لغيره ويشاركه فيَّ حد ده هو الوسيلة والغرض وغيره ما يساويش ولو عشت بغيره أو لغيره، مهما كبرت هأصبح ما فيش |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 14039 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
كتر خيرك
 سمعتها من طالب غرقان قبل الامتحان، يطلق لحيته ويُربي شعره (على أساس أنه بيذاكر)! يصرف الساعات في تصوير “التبييضات” ولا يجد الوقت ليذاكرها!! أخيرًا يعود لمنزله منهكًا، فيجد والده مقدِّرًا “مجهوده” بكوب من الشاي، فيرد عليه: “شكرًا يا بابا كتَّر خيرك”! قد تنظر إليها على أنها “دعوة” لطلب الخير لإنسان صنع معك إحسان، وقد تنظر إليها على أنها وسيلة للشكر تُرفَق مع مثيلاتها “ميرسي” و “ثانكس”!! لكننا هنا سنرتفع عن حوارات البشر، ونتوجه لأعلى حيث مسكن الإله الذي يحب البشر و«يهب خيرات للذين يسألونه» (متى7: 11)، لنعرف الخير المُعّد لنا من يده ونعدِّده فنحمده. كتر خيرك و الألوان بطول التاريخ وعرضه، اختلف الفلاسفة على وضع تعريف محدَّد للخير، فبالنسبة لبعضهم هو لغز يصعب حله، وبالنسبة للآخرين هو قيمة يندر وجودها. لكن اتفق الجميع على أنه حدث أو ظرف يحدث للإنسان يعقبه السعادة والفرح والاكتفاء. لكنن هنا سنعِّرف الخير باستخدام عِلم الألوان؛ فلكل إنسان لونه من الخير الذي يبتغيه، البعض خيره في الأوراق الخضراء ($)، والآخر في الأحجار الصفراء (gold)!! البعض خيره في “البلاطي” البيضاء، والآخر في “البِدَل” السوداء، أو السير على “السجادة” الحمراء!! المهم أن لكل إنسان الخير الذي يملأ عينه أيّا كان لونه! عزيزي القارئ العاشق للألوان، لك أن تحدّد لونك من الخير، وأن تنام تحلم به، لكن دعني أذكرك أن الإنسان في أحسن أحواله لا يجيد اختيار “لون” الخير الصالح له، لأنه في “كتالوجه” مصمَّم فقط على قبول الخير من إلهه. إن لم تصدقني فاذهب إلى داود، الذي اختار لون الهروب “الرمادي” قائلاً: «إني سأهلك يومًا بيد شاول، فلا شيء خير لي من أن أفلت إلى أرض الفلسطينيين» (1صموئيل27: 1)، بدلاً من انتظار لون المُلك “الذهبي”، رغم أنه المرشح الوحيد الممسوح للمُلك!! وأيضًا يونان المبشر الذي ربح أكثر من 120 ألف نفس في يوم واحد، تجده يختار لون الموت “الأسود” قائلاً: «يا رب خذ نفسي مني؛ لأن موتي خير من حياتي» (يونان4: 3)، بدلاً من لون الثمر “الأخضر” ليواصل استخدامه المعجزي وفائدته لهذه النفوس! إن أكثر إنسان يتمتع بألوان الخير الإلهية، هو الذي يترك اختيار اللون الذي يناسبه من الخير لإلهه الذي يحبه، ويكتفي هو فقط بمراقبة إحسانه والرد عليه قائلاً: ما أكثر خيرك.. أو كتّر خيرك! كتَّر خيرك والأسباب لكل شيء سبب، ولكل خير سبب، وإذا عُرِف السبب بطُل العجب! فالمشكلة عند البعض، ليست في تعريف الخير، بالألوان أو بغيرها، لكن المشكلة في كيفية وسبب الحصول على هذا الخير!  فمثلاً رجل الإيمان ابراهيم، ظن في يوم أن امرأته الجميلة سارة، قد تكون سبب الخير بالنسبة له، فقال لها: «قولي إنك أختي، ليكون لي خير بسببك... فصنع لأبرام خيرًا بسببها»، وبالفعل نجح إبراهيم ظاهريًا في إيجاد سبب يحصل به على الخير الذي يبتغيه، ولكنه فوجئ أن نفس سبب الخير (سارة) أضحى سببًا لشر رهيب وكوارث بالنسبة للأخرين؛ فقد «ضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة أبرام» (تكوين 12: 13، 16، 17)، والأكثر من ذلك أن ابراهيم نفسه صُعِق عندما وجد نفسه يبيت في حضن الغنم والحمير، بينما زوجته المحبوبة (سبب الخير) تقترب من حضن رجل آخر! فمثلاً رجل الإيمان ابراهيم، ظن في يوم أن امرأته الجميلة سارة، قد تكون سبب الخير بالنسبة له، فقال لها: «قولي إنك أختي، ليكون لي خير بسببك... فصنع لأبرام خيرًا بسببها»، وبالفعل نجح إبراهيم ظاهريًا في إيجاد سبب يحصل به على الخير الذي يبتغيه، ولكنه فوجئ أن نفس سبب الخير (سارة) أضحى سببًا لشر رهيب وكوارث بالنسبة للأخرين؛ فقد «ضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة أبرام» (تكوين 12: 13، 16، 17)، والأكثر من ذلك أن ابراهيم نفسه صُعِق عندما وجد نفسه يبيت في حضن الغنم والحمير، بينما زوجته المحبوبة (سبب الخير) تقترب من حضن رجل آخر! عزيزي الباحث عن الخير، كُفَّ عن البحث عن أسباب وهمية تظنها ستجلب لك الخير، لأنها قد تجلب لك الشقاء والتعب، أو في أحسن الأحوال ستجلب لك الخير الذي لا تحتاجه! فلا تتخيل أن كلية القمة ستكون سببَ القيمة والفخر لك بين الناس، ولا تظن أن الهجرة ستكون سببَ الأمان بعيدًا عن أخطار البلاد والعباد، ولا تحلم أن الزوجة الجميلة المرحة ستكون سببَ السعادة وعدم الملل؛ فقد تتغير طبيعة الأسباب، وتصبح أسباب الخير هي في الحقيقة موانع له. فالخير هو فقط الذي يأتي من يد الرب الإله بلا أي أسباب، وقتها فقط تتعالى همساتك لإلهك: كتّر خيرِك!  كتَّر خيرك والحصار! كتَّر خيرك والحصار! الآن صديقي الهُمام، لعلك فهمت أن إلهك الصالح يختار لك اللون الذي يناسبك من الخير أفضل منك، ولعلك اقتنعت بعدم جدوى الأسباب البشرية في جلب الخير لك؛ الآن بقي أن تعرف أن إلهك “الخيِّر” لن يعطيك قائمة بالخيرالذي اختاره لك، لكنه وعد أن يحاصرك به من كل جانب، بل وسيفاجئك به على مرِّ الأيام. فمن قدامك «الحياة والخير» (تثنية30: 15)، ومن خلفك «خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي» (مزمور23: 6)، وحين تنام «نفسه في الخير تبيت» (مزمور25: 13)، وحين تسير يتقدمك «ببركات خير» (مزمور21: 3)، وحين تجوع يملأ «نفسًا جائعة خبزًا (خيرًا)» (مزمور107: 9)، وحين تشبع «لا يعوزهم شيء من الخير» (مزمور34: 10)، حتى حينما يأتي الشر، يحوله الرب فتجده «قصد به خيرًا» (تكوين50: 20)، فما رأيك في هذا الحصار المُحكم!! أضف إلى ذلك أنك داخل هذا الحصار، ستتعرف على دُرَّة الخير ومنبعه؛ الرب يسوع شخصيًا؛ فإذا تقابلت معه وتذوقته، سيصبح هو بذاته خيرك، وتكتفي به قائلاً: «أنت سيدي. خيري لا شيء غيرك» (مزمور16: 2)، ووقتها لن تحتمل عينك “ألوان” الخير الموجودة فيه، ولن تتوقع مفاجآته الصالحة في حياتك، وسيكون نشيدك اليومي الصباحي: صباح الخير يا رب.. شكرًا.. كتَّر خيرك! أقولك إيه وانت محاصرني بخيرك من زمان وأطلب ليَّ إيه، وأنا بين إيدين إلهي الحنان يا ريتني أهدا ومانتظرش تيجي الأسباب دي كتير بتخدعني، وكتير بتسد لي الأبواب فخيري وكفايتي فيك وحدك يا رب الأرباب خلاص حرمت اختار ليَّ!! ده أنا عندي عمى ألوان كتّر خيرك إنك حاببني وعايزني، ومقدَّر طبعي كإنسان |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 14040 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
الشـعـب يريــد .....
 سمعتها من شعب أحبه، جدوله اليومي كان: مظاهرات صباحًا، خِطابات ليلاً، حِراسات فجرًا!! بعضهم يريد معرفة الراجل اللي ورا...، والآخر يريد تغيير بلوفر الراجل الذوق...! لكن جميعهم يريد تفسير الخطاب الهلامي: دقت ساعة الزحف.. بيت بيت.. “زنجة زنجة”!! فكان الرد الساخر: الشعب يريد... طوال 18 يوم لم نسمع سواها، في كل مكان وبأي عنوان، حتى تناقلها منا الجيران! ولأنها جملة غيَّرت التاريخ، وتُغيِّر الآن الجغرافيا! ولأنها ارتبطت بالشارع ومن يسكنه؛ فدعنا عزيزي نتأمل فيها، لعلنا نهضم دروسها، ونكشف أسرارها!  الشعب يريد ... والحاجز! الشعب يريد ... والحاجز!تعيش الشعوب المغلوبة على أمرها، خلف حاجز كبير من الخوف والمجهول؛ حاجز بناه الحاكم وحاشيته، وعلَّته الشعوب بنفسها؛ فالحاجز المرعب ليس بقوته العسكرية لكن بهيبته النفسية؛ التي تمنع الناس من الكلام أوالكتابة أو التعبير عن الرأي. وظللنا نحن مثلهم حتى 25 يناير، حين هب الشعب يحطم حاجزه بيده؛ فانهار جدار الخوف تحت أرجل الشعب، وانصهرت رهبة المجهول أسرع من احتراق العربات الزرقاء! وصرخت الملايين: الشعب يريد. عزيزي الثائر، هل تعلم أن بداخلك حاجزًا روحيًا ونفسيًا لا يقل قسوة وضراوة عن هذا الحاجز؟! حاجز بنيته أنت بنفسك، من مجموعة من الأوهام وأنصاف الحقائق التي سمعتها أو كوَّنتها عن الله خالقك، فظننت أنه بعيد عنك رغم أنه «قَرِيبٌ لِكُلِّ الَّذِينَ يَدْعُونَهُ» (مزمور145: 18)، وأنه يرفضك رغم أنه «السَّيِّدَ لاَ يَرْفُضُ إِلَى الأَبَدِ... يَرْحَمُ حَسَبَ كَثْرَةِ مَرَاحِمِهِ» (مراثي 3: 31، 32)، وأنه لا يحبك مع أنه قالها صراحة «أحبهم فضلاً» (هوشع 14: 4)، وأنه لا يريدك رغم أنه «يُرِيدُ أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ يَخْلُصُونَ، وَإِلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ يُقْبِلُونَ» (1تيموثاوس 2: 4). إذًا فحاجزك ليس إلا وهم، وضعه إبليس أمامك لكي يمنعك من الاقتراب لإلهك والتمتع به. لذا أدعوك أن تحدِّد بنفسك ميعاد “ثورتك”، وتحطّم هذا الحاجز في محضر الله، وتعبِّر عن احتياجك العميق له قائلاً: يارب أنا أريد.. أريدك أنت. الشعب يريد ... والاستثناء! القاعدة العامة لثورات الشعوب أن الشعب يريد التغيير والإصلاح، والحاكم نفسه لا يريد؛ حفاظًا على منصبه أو كرامته أو ملياراته! فيتعامل معهم كقلة مندسة أو أصحاب أجندات أو محبي الـ K.F.C! ولكن هل لهذه القاعدة من استثناء؟ نعم، فالكتاب المقدس يخبرنا عن شعب، اختاره الله ليكون “عيّنة” لشعوب الأرض كلها (تثنية 7: 6)، ليس لأنه أفضلهم، لكن لأن الرب بنفسه أحبهم (تثنية 7: 8)، ورغم معاملاته العجيبة معهم بمرور الأجيال، ورغم اختصاصهم بأن أرسل إليهم الأنبياء الواحد يلي الآخر، فقد صدر عنهم التقرير النهائي بلسان ابن الله شخصيًا «يَا أُورُشَلِيمُ، يَا أُورُشَلِيمُ! يَا قَاتِلَةَ الأَنْبِيَاءِ وَرَاجِمَةَ الْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا، كَمْ مَرَّةٍ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ أَوْلاَدَكِ كَمَا تَجْمَعُ الدَّجَاجَةُ فِرَاخَهَا تَحْتَ جَنَاحَيْهَا، وَلَمْ تُرِيدُوا!» (متى 23: 37)!! وهنا نرى العجب: الرب الإله يريد الخير لشعبه، والشعب هو الذي لا يريد!! عزيزي الثائر، لا تَلُم هذا الشعب؛ فربما تكون مثله. وإياك أن تتهم إلهك في داخلك أنه لا يريد الخير والفرح والغنى والحماية لك، أو أن تظنّه مثل باقي الملوك والحكام، الصالحين أو الطالحين، فهل سمعت عن حاكم «يُكَفِّرَ خَطَايَا الشَّعْبِ» (عبرانيين 2: 17)؟! وهل قرأت عن رئيس «مُقْتَدِرًا فِي الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ أَمَامَ اللهِ وَجَمِيعِ الشَّعْبِ» (لوقا 24: 19)؟! وهل شاهدت ملكًا «يَشْفِي كُلَّ مَرَضٍ وَكُلَّ ضَعْفٍ فِي الشَّعْب» (متى 4: 23)؟! بالطبع لا؛ فهو الاستثناء الرائع من الحكام، بل ومن البشر أيضًا! فهو دائمًا يريد، والشعب لا يريد، المهم أنك أنت تريد!  الشعب يريد... والمشيئة! الشعب يريد... والمشيئة!أخيرًا عندي رسالة لك ولنفسي ولجميع شعب الرب، رسالة مفادها أن مصيرنا ومستقبلنا لا تحدّده رغبات الشعوب مهما علت؛ فالشعب لا يريد الصواب دائمًا، بل وتتغير رغباته ما بين الحين والآخر، لكن في كل مرة يقول الناس: الشعب يريد، لابد أن تعلق السماء: ولكن الرب يريد! فمثلاً عندما سأل بيلاطس الشعب في ديمقراطية رومانية: «مَنْ تُرِيدُونَ أَنْ أُطْلِقَ لَكُمْ؟ بَارَابَاسَ أَمْ يَسُوعَ الَّذِي يُدْعَى الْمَسِيحَ؟» (متى 27: 17)، ولكنّ الشعب اختار باراباس، بل واحتفلوا به كقاتل خرج من السجن (والتاريخ يعيد نفسه!)، واستدركوا يهتفون: “الشعب يريد صلب المسيح”!! ولكن، وبعد عدّة أسابيع، وأمام تقريبًا نفس الجمع، وفي حضور “فلول” الكهنة والشيوخ، وقف بطرس وقال لهم في عظته الشهيرة «هذَا أَخَذْتُمُوهُ مُسَلَّمًا بِمَشُورَةِ اللهِ الْمَحْتُومَةِ وَعِلْمِهِ السَّابِقِ، وَبِأَيْدِي أَثَمَةٍ صَلَبْتُمُوهُ وَقَتَلْتُمُوهُ» (أعمال 2: 23)، وكأنه يقول: لقد تم مُرادكم وصُلِب المسيح، ليس لأنكم أنتم أردتم، لكن لأن هذه هي مشيئة الله وخطته لخلاص البشر، فمشيئته مَن في السماء أسبق من هتافكم هنا على الأرض! عزيزي الثائر، مهما علت الهتافات، وصلحت أو خبثت نواياها، فثق أنه لا استفتاء ولا استقواء، لا اتهام ولا أقلام، لا منشور ولا دستور، لا تعيير ولا تهجيير، يمكن أن تسبق مشيئة الله الصالحة التي ستتم كما هي، فـ«لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ» (متى 6: 10)، فوق أي لسان يقول: الشعب يريد! لساك شاكِك وكامِش، ومخبي أوهامك في دارك وباعد بشرَّك عن إلهك، وخوفك كاتمه في جدارك قوم دا فيه ثورة قامت، وبقينا في عهد جديد واتكسَّرت الحواجز واختفت بين الحديد ونطقها الشعب من قبلك: الشعب يريد! ورينا ياللا همتك وابدأ ثورتك وفي إيدك قرارك دي مشيئته سلامة سِكتَك، وسلطان إلهك في جارك |
||||