القسم الثامن: مفهوم الاصطلاحات
"غير المخلوق" و"المخلوق" في التعاليم اللاهوتية للقديس أثناسيوس
بروفيسور بنايوتيس خريستوس
" أستاذ علم الآباء بجامعة تسالونيكى - اليونان"
مقالة في مجلة دورية (دراسات آبائية ولاهوتية)
للمركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية السنة الثانية العدد الثالث يناير 1999
* وفي الواقع لا يمكن ابرير الانطباع العام بأن الصراع بين الأرثوذكسية والأريوسية في القرن الرابع والتعاليم اللاهوتية التي أنتجها، كان يدور فقط حول الاصطلاحات " من نفس الجوهر"، "من نفس جوهر مشابه"، "مشابه"، "غير مشابه". وهذا يتضح ليس فقط من عدم استقرار استخدام هذه التعبيرات بواسطة هؤلاء الذين صاغوها، بل أيضًا تحير القديس أثناسيوس بين التعبيرين الأولون منهما... فالقديس أثناسيوس، البطل الأول للأرثوذكسية ضد الأريوسية، ولكي لا يسبب ردود أفعال فإنه بالفعل أفضل أولًا تعبير " من جوهر مشابه " بدلًا من تعبير " من نفس الجوهر " الذي كان يتسبب في انضمام المسيحيين. لكن عندما أدرك أن أنصاف الأريوسيين أعطوا لتعبير "من جوهر مشابه"، معنى يخالف المعنى الذي قصده هو، اختار التعبير الآخر " من نفس الجوهر " والذي هو تعبير نيقاوى أصيل، وذلك لكي يصل في النهاية إلى الوضع الذي أكد منه أن هذين التعبيرين مناسبين التعبير عن العلاقة بين الأقانيم لذلك يهمنا فقط أن نفهمهما بطريقة صحيحة ونفسر معناهما بطريقة مستقيمة.
* وليس ما أشرنا إليه فقط أدلة أخرى كثيرة تظهر أن هذه التعبيرات والتي تدور حولها تساؤلات كثيرة، لم تحظى حينذاك بهذه الأهمية الكبيرة التي نعطيها نحن اليوم لها.
* وبالرغم أن هذا الاصطلاحات تعكس بالتأكيد بعض وجهات النظر اللاهوتية، وبالأكثر طالما أنها مثلت نقاط مناقشة في المجامع المسكونية التي وضعت قوانين الإيمان، إلا أنها في الواقع كانت بالأكثر " شعارات " في الصراع الدائر، كل كلمة منها تحوى معاني لاهوتية كثيرة كان من الممكن التعبير بها بطريقة كاملة عن التعاليم اللاهوتية الخاصة بعقيدة الثالوث لكل من الأطراف المتصارعة.
* وعلى وجه الخصوص، فإن القديس أثناسيوس لم يعط أهمية كبرى للألفاظ وهذا يتضح في كتابات كثيرة له نذكر منها ما جاء في رسالته الأولى إلى سرابيون عن الروح القدس: "أنه يكفى أن نعرف أن الروح ليس مخلوقًا". وليس هناك حاجة إلى أمور أكثر. إن هذا يوضح أين يوجد بالضبط أساس الخلاف اللاهوتي بين الأطراف المتصارعة: ماهية الروح، مخلوق أم غير مخلوق؟ ماهية الابن مخلوق أم غير مخلوق؟ وتتوقف على إجابة هذه الأسئلة كل باقي الموضوعات اللاهوتية والخلاصية.
* ومن ناحية أخرى نجد أن القديس أثناسيوس يبنى أساس تعاليمه اللاهوتية، بصفة عامة، على محارب اصطلاحات أريوس الآتية: "من العدم"، "كان وقت لم يكن فيه موجودًا، "طبيعة متغيرة"، "مخلوق"، "مصنوع"، وذلك لأن تلك الاصطلاحات لها علاقة واضحة بعملية الخلق...
* إن القطبين المتناقضين في الكون هما "غير الفاني"، "الفاني" وهما يقابلان طريقين للوجود "غير المخلوق"، "المخلوق". وهذا التمييز له علاقة مباشرة بقدرة الله العلاقة، والتي تربط غير المخلوق بالمخلوق. فإن إحضار كائنات مخلوقة إلى الوجود بواسطة القدرات الخلاقة للكائن غير المخلوق تمثل عنصر أساسي للنظرة المسيحية للأشياء فالمسيحيون يربطون الفكرة عن الله بفكرة الخالق.
* مع أن نفس الشيء لا يحدث بين الفلاسفة اليونانيين، ومن غير الممكن ألا تذكر هنا التفسير الخاطئ الذي يقال دائمًا في هذه النقطة. وإنه لموقف غريب لكثير من الباحثين الذين يظهرون المسيحية كعدو للهلينية، غير أنه لا مجال ف\هنا الآن لمناقشة هذه الأمر.
* على أي حال، فإن الإدعاء المعتاد بلأت رأى الفلسفة اليونانية في هذا الموضوع هو على العكس تمامًا من الرأي المسيحي هو إدعاء يستند على سطحية في البحث غير ميررة. لأن الفلاسفة اليونانيين كانوا يعرفون ليس فقط معنى مصطلح " غير الصائر " كما كان يعرفه أثناسيوس، بل وأيضًا مصطلح "خلق". فبالنسبة لكل النظام الفلسفي اليوناني القديم تقريبًا كان هناك فرق بين الواحد، الكائن غير المتغير، وبين الأشياء الأخرى، المتغيرة والوقتية.
* ورغم تأكيدهم على هذا الفرق وقناعتهم الثابتة به، إلا إن فكر الخالق لم تكن موجودة باستمرار في هذه النظم الفلسفية، وإن وجدت فإنها لا تظهر الخالق مؤديًا عمله ولا بنفس القوة، كما هو الحال في الفكر المسيحي.
* وسوف نقصر الكلام هنا عن أهم لأثتيت يمثلان الفكر اليوناني.
أولًا: أفلاطون يميز بين غير المخلوق والذي هو أزلي، وبين المخلوق والذي هو قابل للفداء. غير أنه يضيف بعد ذلك شيء
ثالثًا: وهو "الخاص بالمكان" والذي ربما نستطيع أن نطابقه مع ما يسميه أرسطوطاليس بالمادة. فال "المكان" عند أفلاطون هو المادة التي لا شكل لها والتي يمارس فيها الله فعله.
* أما عند أرسطوطاليس فإن المادة تمثل الضرورة والفداء، وهى تمتد أحد معين ومن بعدها يوجد "عالم غير المتغير"، وهو القدرة، فالقدرة فقط هي الفاعل الأول هي الله والذي عن طريق قدرته الفائقة تجبل المادة مرة أخرى متخذة شكلًا ويخلق عالم الفانيات.
* وبالتالي فإن فكرة الخالق ترد عند كل من أفلاطون وأرسطوطاليس. لكن الخليقة عند الاثنين تظهر وكأنها خلقت من مادة موجودة.
* فالمادة بالتأكيد هي " تقريبًا العدم". فالمادة إذن ليس لها نوع ولا مقدار أو أي شيء آخر من الأشياء التي تحدد الوجود، القائم.
* فعند هؤلاء الفلاسفة، وحسب مسلماتهم، فإن الخليقة كان من الممكن أن تعتبر مخلوقة من العدم، لو كانت المادة هي العدم، أي لو كانت هي "غير الموجود".
* غير أن المادة -حسب اعتقادهم- ليست هي بالعنصر السلبي فقط، بل هي عنصر إيجابي أيضًا. لأن داخلها الميل نحو التشكل، نحو الإمكانية في حدوث شيء، المادة هي قدرة. وهنا بالضبط يمكن أن الفرق بين هذه الآراء الفلسفية والتعاليم المسيحية التي تنادى بأن الخليقة خلقت من العدم، أي من " لا شيء". فالخالق -حسب الفلسفة اليونانية- قد قام بعمل محدد بعناصر موجودة خارجة وفي هذا فإن الخليقة لا توصف كما توصف في المسيحية. ولقد كان من الطبيعي أن الفلاسفة اليونانيين في فكرتهم عن الله لا يصلون بالضرورة ولا مباشرة إلى الخالق.
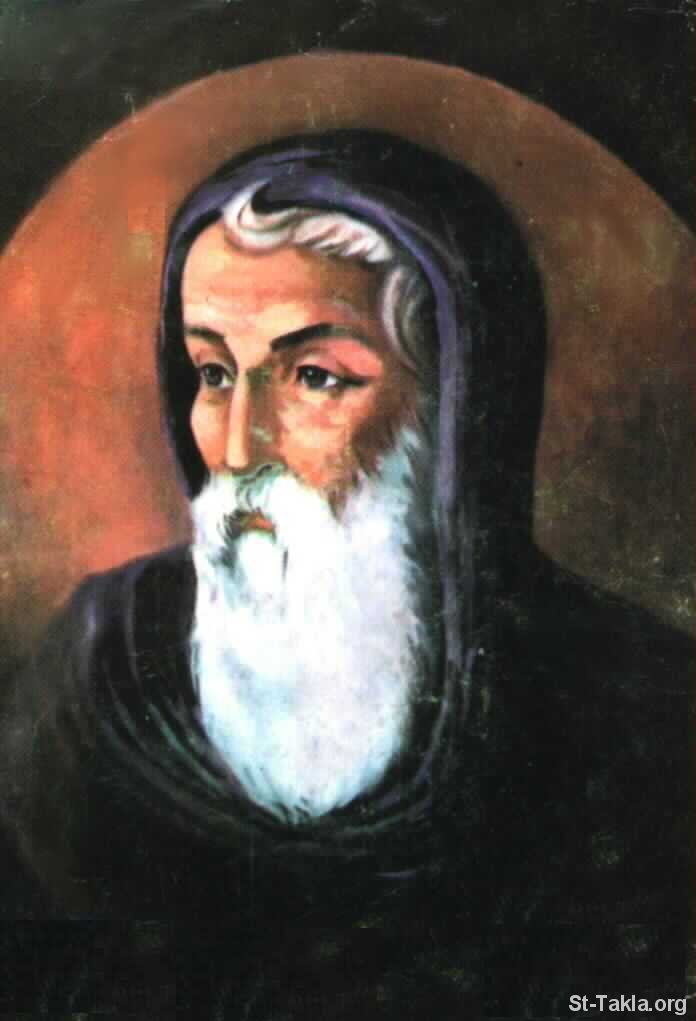
* وكان مناسبًا لهم استخدام مصطلحات "غير الصائر" بدلًا من مصطلحات "غير المخلوق"، و"المخلوق".
* ومع هذا، وكما أتضح مما سبق فإن معاني المصطلحات "غير المخلوق"، "المخلوق" بكل خصائصها توجد ليس فقط في التعاليم اللاهوتية المسيحية بل أيضًا في الفلسفة اليونانية وهنا ما يهمنا في بحثنا الآن.
* وبسبب الأهمية الكبر لمعنى الخليقة في الفكر اللاهوتي المسيحي، فإن القديس أثناسيوس يفضل استخدام مصطلحات "خالق"، "بارى" بدلًا من "غير الصائر" وذلك لأن الأخير يشمل معنى سلبيًا ولا يستطيع وصف القدرة الخلاقة لله. ومع هذا فإن القديس أثناسيوس لا يرفض هذا المصطلح "غير الصائر" بل وأحيانًا يستخدمه طالما أنه كان يمثل شغلرًا على شفاء الأريوسيين في محاولاتهم في التمييز بشدة بين الابن المخلوق والصائر والله غير الصائر". ويستخدم القديس أثناسيوس هذا المصطلح الأخير عادة بتحفظ وفي النادر بغير تحفظ. ومن الجيد أنه يوجه الانتباه إلى أن استخدام هذا المصطلح هو غير مناسب لبيان التميز بين الآب والابن طالما أن هذا المصطلح يدل فقط على التميز بين الخالق والخليقة".
* إن الاصطلاحات "صائر"، "غير صائر" تشير إلى وجود فجوة بين الله والعالم وعدم إمكانية إدراك الله.
* إن الله الذي يوجد بالأكثر في كل جوهر صائر، هو غير مدرك وذلك لأنه هو غير صائر من جهة، بينما الإنسان جاء من العدم وبالتالي فلا تكون هناك "أي شركة أو أي تشابه بين المخلوق والخالق".
* وحسب هذا التمييز فإن القديس أثناسيوس يصف الله مستخدمًا تعبيرات أفلاطون بأنه "غير متغير على كل وجه". بينما توصف المخلوقات على أنها "متغيرة " وذلك لأنها جاءت من العدم عن طريق التغير.
* وبسبب طريقة نشأة هذه المخلوقات فليست هناك وجه شبه حسب الجوهر بينها وبين الخالق. إنما لديها ميل طبيعي نحو الفناء، ميل للنقصان، فطالما أنها أتت من العدم فحتمًا تميل للعودة إلى العدم.
* والعودة هذه ستتم عن طريق الفناء، فالفناء هو نتيجة. هذه النتيجة يمكن التغلب عليها عن طريق إمداد الإنسان بالمشابهة الكبيرة مع الله وحتى إن احتفظ بها بدون تشوه يتمكن من التغلب على حالة الفساد الطبيعي ولأصبح في حالة عدم فساد (عدم فناء).